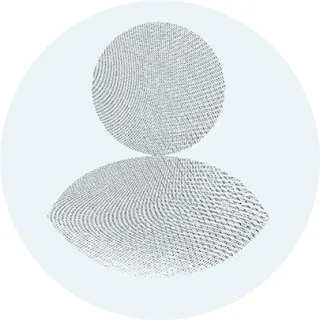حادث آخر، وإسالة دماء، ومظاهرات احتجاج، في دائرة جهنمية من الخصومة كمناظرة بين أبكم وأطرش الحَكَم فيها أعمى.
سأترك لآخرين استكشاف دوافع الرئيس التركي لتصعيد أزمة مع فرنسا، مستغلاً كاريكاتيرات، بعد أربعة عشر عاماً من نشرها، ويومها احتج مسلمون متشددون (بلا ذكر كلمات «كمسيئة») على مبدأ تصوير الأنبياء (وليس الإسلام بالدين الوحيد الذي يحرم تصوير المقدسات).
المثل المصري «لم يشتمك سوى من أبلغك» يدعوني إلى توجيه السؤال (ليس للمتظاهرين ومهاجمي القنصليات) للمثقفين «المجاهدين» ضد فرنسا.
كم منكم يتقن الفرنسية لمستوى فهم بين السطور فيما ينشر في الصحافة، والمعاني غير المباشرة في منشورات سخرية يصعب على أوروبيين آخرين فهمها؟
ويستمر فتح التساؤلات - كالدمية الروسية «ماتروشكا» -كم بينكم، يا متحدثي الفرنسية العرب، يقرأ «شارلي إيبدو» بانتظام؟ وكم داخل المجموعة طالع عدد الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) 2006؟
وليس بين المثقفين، الذين يسكبون الزيت على نار الفتنة، من رفع إصبعه للإجابة عن السؤال الذي طرحته عليهم قبل ثلاثة أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
والقراء يدركون حكاية نصف الآية «لا تقربوا الصلاة.....».
أي أن الأمر متروك للفرد لاستيعاب معاني ما يصادفه من معلومات.
الديانات والعقائد والفلسفات الروحية في بداية انطلاقها كانت موجهة للفرد لا للدول والمنظمات العالمية، أي لسعادة الإنسان والسمو بأخلاقه وسلوكياته ومساعدته على معالجة الأمور بذهن متفتح وقلب صافٍ، لا لاستعادة إمبراطورية سقطت لتَجبَُرها (بفتح الجيم، وضم الباء) على الآخرين.
ما معنى دعوة «المثقفين» الحكومات لتفصيل قوانين حسب طلب أصحاب الدعوة لمنع نشر ما يرونه «غير مناسب»؟
تستطيع الحكومات إصدار القوانين، ومهما كان نبل الغاية فإن تطبيقها في النهاية يعود للفرد، لأن سلوكه يتعلق بتماشي القانون مع مفاهيمه لا مع غاية الآخرين.
في جلسات العلاج يساعد الطبيب النفسي مريضه بأن يغير (ما يعرف بالإنجليزية attitude) أي استجابته وسلوكه تجاه أمور ومواقف ليس بقدرته تغييرها.
فلعن سائق التاكسي أثناء تعطل المرور لن يحرك المركبة، وتحطيم كشك الصحف لأنك قرأت ما لا يعجبك سيجعلك أضحوكة للمارة وخارجاً على القانون وتظل الصحف تنشر ما ليس بقدرتك منعه ولا حتى بقدرة الحكومة نفسها في البلدان التي تحمي قوانينها حرية التعبير؛ فالدستور الأميركي يحمي حق المواطن في حرق وتمزيق رمز الأمة نفسها، أي العلم الأميركي. وبنصيحة الطبيب النفسي كل ما في قدرتك هو الامتناع عن قراءة صحيفة تسبب ارتفاع ضغط دمك، وهو ما دفعني إلى طرح سؤال داخل سؤال كدمية «ماتروشكا» الروسية على المثقفين الغاضبين.
لماذا إذن يفقد مئات الآلاف من المسلمين (كأفراد لا كجماعة) القدرة على تغيير النظرة attitude الفردية إلى ثقافة مختلفة في حوار الأصم مع الأبكم، أو كمن يحاول تثبيت مكعب في ثقب دائري؟
وباستثناءات قليلة، وأغلبها من بقايا زمن النهضة المصرية الذي انتهي قبل نصف قرن، لم أجد بين المثقفين الغاضبين من يفهم آل laïcité (بالإنجليزية secularism) في إطار مفهوم «الجمهورية» الفرنسية. وتختلف الثقافات في ترجمتها وفهمها، بالعربية أحياناً «العلمانية» (من العلم) وأحياناً «العالمانية» (من العالم المادي)، وإذا كانت في جملة باللاتينية تضيف الآنية instantique saecularismo أي ارتباطها الوقتي. وحتى هنا في بريطانيا لا يستوعب أغلب مثقفيها المفهوم تماماً. فبريطانيا ليست بلداً علمانياً - عالمانياً كاملاً بمفهوم الدستور الأميركي، ناهيك عن الهوة العميقة الواسعة التي تفصلها عن فرنسا في هذا المفهوم. غالبية من حاورتهم ينحصر فهمهم لجزئية تحت «اللايستيه» laïcité على أنها فصل الدين عن الدولة، ويقعون في خطأ اعتبارها فلسفة أو آيديولوجيا أو نظام حكم، كالماركسية، أو الليبرالية أو ولاية الفقيه!
الصين والاتحاد السوفياتي والأنظمة الشمولية منعت ممارسة الأديان واعتبرتها «أفيون الشعوب»، ولم تتسامح أنظمة شمولية وثيوقراطية مع الأقليات وأديانهم. لكن في فرنسا، أكثر بلد علمانية - عالمانية على وجه الأرض اليوم، تمارس شعائر عشرات الأديان وتدعم الدولة دور العبادة. فالعلمانية - العالمانية هي أرضية الهوية للجمهورية الفرنسية، كملمح قومي وأسلوب حياة وطريقة تفكير تبدأ مع تعلم الطفل الحروف الأبجدية ونطقها بالفرنسية. وبينما نقول في بريطانيا في المناسبات القومية «حفظ الله الملكة»، وينهي الرئيس الأميركي الخطاب في أوقات التحدي بـ«بارك الله أميركا» لا يقول الزعماء الفرنسيون والساسة في نهاية الخطاب سوى vive la France تحيا فرنسا. فالعلمانية - العالمانية هي الهوية القومية لفرنسا.
والمفارقة أن من فرنسا بدأت الحداثة في مصر، ثم البلدان العربية، بنظام تعليم رائده الشيخ رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873) وكان رافق أول بعثة طلبة مصريين إلى فرنسا منذ مائتي عام بصفته واعظاً دينياً من الأزهر، فقرر أن يوسع مداركه بدراسة العلوم والفلسفة والفيزياء وترجمة الكتب الفرنسية إلى العربية. وتطورت حركة التعليم الطهطاوية في نهاية القرن التاسع عشر إلى حركة النهضة المصرية. لكن انحصرت جهود معظم مفكري النهضة (وتركزوا في الإسكندرية والقاهرة) في محاولة التوفيق بين الدين المسيطر على تفكير الأغلبية في الريف والبلدان العربية، وبين العلوم والاكتشافات ومكونات الحداثة بدلاً من عدم الخلط بينهما. وبالطبع قاومت المؤسسات الدينية المحاولات لأسباب عديدة ودفاعاً عن المقدسات، وهو عامل مشترك بين العصور والحضارات (كمحاكمة غاليليو أمام الفاتيكان في عام 1633 على سبيل المثال لا الحصر). وباستثناء دعوات فردية متفرقة، لم تشهد مصر، وبالتالي البلدان العربية، حركة قوية في مطلع القرن العشرين وطواله لوضع حد للصراع بمقولة «دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله». واستمر الصراع الذي ورثته اليوم الأجيال الشابة المسكينة التي فاتها نظام التعليم المعرفي الذي تلقاه جيلنا على يد أساتذة عصر النهضة المصرية لكنهم ورثوا مفهوماً آخر أكثر خطورة. مفهوم لم ترسخه الحركات الدينية بقدر ما روّجته الحركات القومية الانغلاقية المعادية للحداثة وللديمقراطية، تحت شعار «التحرير الوطني». فرغم استفادة المجتمعات في مصر والبلدان العربية بمنتجات وإنجازات وعلوم واكتشافات وأفكار الحضارة الأوروبية خلال المائتي عام الأخيرة، فقد رسخت في الأذهان ربط النهضة والحداثة بالغرب (أوروبا في جيلنا) بسلبيات الاستعمار في القرن التاسع عشر.
وهي الهوة التي يتسلل منها أمثال إردوغان لحاجة خبيثة في نفس يعقوب.
10:34 دقيقه
TT
أسئلة للمثقفين
المزيد من مقالات الرأي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة