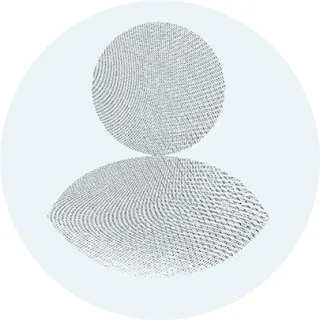نصح ميكيافيلي أميره بأن يبطش كالأسد إن كان قادراً، وأن يناور كالثعلب.
هذه النصيحة طبقها المتصارعون في السودان؛ حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، والبرهان قائد القوات المسلحة، بالتمام والكمال. عملا أولاً بمناورة الثعلب، فأسقطا البشير، ووقفا مع المتظاهرين، وانخرطا في مفاوضات الانتقال الديمقراطي. لكنهما طبقا في عام 2021 ثانياً بطش الأسد، فأطاحا حكومة رئيس الوزراء حمدوك الديمقراطية، وتسلَّما السلطة، فأصبح البرهان رئيساً للمجلس السيادي وحميدتي نائبه؛ وبتسلمهما السلطة فعلياً، لم يعد ثمة مجال للمناورة، فبطشا ثالثاً بعضهما ببعض، أملاً بالنصر، فكانت النتيجة حرب شوارع.
فهل يتحملان وحدهما مسؤولية ما حدث، أم ثمة عناصر أخرى ساهمت في الوصول إلى هذا المنعطف الخطير؟ يكمن الجواب بـ3 عناصر؛ فشل الداخل السوداني، والتردد الإقليمي، والانتهازية الدولية.
تمثل الداخل السوداني بحراك مدني لم يفهم قادته نصيحة ميكيافيلي، فبدلاً من أن يلجأوا للحسم بقوة الشارع، ناوروا كالثعلب، وسلموا رقبتهم للعسكر الذي هو أصل المشكلة.
فالمؤسسة العسكرية في السودان، ومعها قوات الدعم السريع، هي كيان هائل يتمدد في شرايين السودان اجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً؛ فالنخب العسكرية تشرف على صناعات عسكرية ومدنية وعلى موارد طبيعية، ولها ارتباطات شخصية مع قوى الخارج. هذه النخب لا تقبل أبداً بحكومة ديمقراطية تسلبها السيطرة على قرار التحكم بالموارد والمؤسسات الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والعودة إلى الثكنات العسكرية.
كما أن الحراك المدني كان يعوزه شخصية كاريزمية تقوده وتحظى بثقة الشعب، وبسبب ذلك ظهرت قيادة الحراك ضعيفة وعاجزة وقبلت بتنازلات، بل تذويب كيانها السياسي، سواء من العسكر أو الخارج، وبالتحديد من أميركا التي أجبرتهم على الاعتراف بالكيان الإسرائيلي مقابل رفع العقوبات عن السودان، ومن دون الرجوع إلى الشعب، ومن دون الحصول على تعهدات مضمونة، فلم تُرفع العقوبات إلا متأخراً، ولم يحصل الحراك المدني على مساعدات مالية واقتصادية تمكنه من الإيفاء بالوعود للشعب.
فالحراك كان، على عكس قادة الجيش، أقلَّ ارتباطاً بالخارج، ومع تسارع الوقت تراجعت ثقة الشعب به، فأصبح قادته شخصيات غير فاعلة في مفاوضات مملة، ومضجرة، وتحولوا، دونما أن يشعروا، إلى فريق ضعيف، غير قادر على النزول للشارع، أو على نيل دعم قوي من الخارج، أو تجاهل ضغوط إقليمية أو دولية. بعبارة أخرى، الحراك المدني خسر أمام الثعلب العسكري، وتحولت السلطة إلى منافسة شرسة بين حميدتي والبرهان بكل ارتباطاتهما الإقليمية والخارجية.
أما التردد الإقليمي فتمثل بدول عربية هي الأكثر فاعلية في ملف السودان (المملكة، والإمارات، ومصر)، ولا سيما أن الرئيس ترمب لم يكن معنياً بهذا الملف. وبالتالي، تحولت هذه الدول ومعها الاتحاد الأفريقي إلى لاعب كبير؛ وكانت رؤية هذه الدول قيام حكم مدني انتقالي يتشارك فيه العسكر والمدنيون السلطة، وفق خلطة براغماتية تضمن سلاماً قائماً على التوازن. لكن ارتباط العسكر بقوى خارجية أضعف قدرات تلك الدول الإقليمية، وأدى إلى إطالة أمد المراحل الانتقالية، وعندما انقلب العسكر على حكومة حمدوك لم تفرض أميركا عقوبات على الانقلابين، وكذلك الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ما أضعف المسار المدني، وسلم الجميع بالواقع الجديد وتابعوا التفاوض وكأن شيئاً لم يحدث؛ وعندما وصلت المفاوضات إلى نقطة اندماج المؤسسة العسكرية، وقع الخلاف ولم تستطع الدول الإقليمية إجبار حميدتي على الاندماج، أو إجبار البرهان على القبول بقيادة عسكرية مشتركة.
هذا قد يكون سببه غياب الاتفاق بين الدول العربية والاتحاد الأفريقي عن التفاصيل، ولا سيما أن بعض الأطراف ترغب في استمرار الجيش قوةً وحيدة ضاربة، بينما يعارض البعض الآخر اندماج قوات التدخل السريع في المؤسسة العسكرية، لأن ذلك سيضعف قائدها حميدتي، ويحرمه من قوة خاضعة له مباشرة، ويرى آخرون أن الحل بتحقيق معادلة توازن القوى بين الطرف المدني والطرف العسكري.
وبسبب تضارب هذه الرؤى لم تستطع قوى الإقليم ترجيح رؤية على أخرى، أو إجبار طرف في السودان على إبداء تنازلات. لهذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدودة، وانطلق القتال بين العسكر لقناعة كل طرف أنه سيربح.
أما الانتهازية الدولية فتمثلت في التنافس الحاد بين أميركا والصين وروسيا على أفريقيا، ولا سيما السودان، لأن من يتحكم به سيضمن خطوط إمداد وسيطرة على القارة الأفريقية، خصوصاً شرايين التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وقد فتح البشير بوابة التنافس، عندما اقتنع أن الأميركان يطلبون رأسه، واستنجد بالرئيس بوتين لقناعته أنه سيحميه كما حمى بشار الأسد، فسافر عام 2017، وسمح لروسيا بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، متحدياً مصالح أميركا وفرنسا؛ وقد عزز العسكر مؤخراً هذا التعاون عندما زار حميدتي موسكو ودعم بوتين في حرب أوكرانيا وسانده في إقامة قاعدة عسكرية في بورتسودان.
هذا التوجه كان مقبولاً خلال عهد ترمب، وليس مع إدارة بايدن التي تدخلت في الأزمة بالموازنة بين دعم الحراك المدني وإعادة التواصل بقوة مع المؤسسة العسكرية.
بهذا دخل السودان مرحلة استقطاب عزز فيها الأطراف الداخليون أوراقهم مع أطراف دولية، وعلى حساب قوى إقليمية، وداخلية.
وقد تجلى ذلك بقول وزير الخارجية الروسي لافروف إن القانون الدولي لا يمنع روسيا من دعم طرف بالأسلحة. ويقصد حميدتي المتحالف مع شركة فاغنر، بينما عملت أميركا على دعم الجيش بقوة تحت شعار مزيف «إعادة العمل بالمسار الديمقراطي».
لا شك أن ضعف الحراك المدني، وتردد القوى الإقليمية، والاستقطاب الدولي، أدى إلى الواقع المأزوم، ولم يبقَ من أمل إلا أن تنهض دول الإقليم، وخصوصاً بقيادة المملكة، وتستلهم ميكيافيلي، لتوقف الاستقطاب الدولي، وتعمل على إيجاد صيغة إقليمية مقبولة داخلياً، من شأنها أن توقف القتال، قبل أن يتحدر السودان لحرب أهلية قد تنتهي بتفتته... لا سمح الله.
TT
لماذا تَحارَب العسكر؟ وفرصة دول الإقليم لإنقاذ السودان
المزيد من مقالات الرأي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة