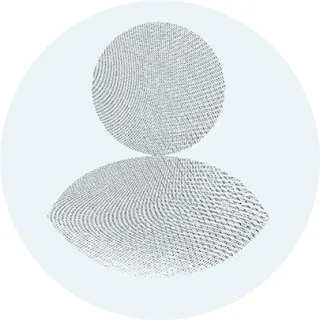لعل علامة الاستفهام التي وقف العالم أمامها ولا يزال مع نهاية ساعات القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني نهار الاثنين الماضي، تمحورت حول فخ ثيوثيديدس المنصوب لواشنطن وبكين، وهل تم تلاشيه، أم أن وراء الأكمة ما وراءها، لا سيما أن الصراع الآيديولوجي بين الجانبين لا يحتمل التعاطي من منطلق التوافقات أو قسمة الغرماء.
عبر السنوات الأربع الماضية استحضر العالم قصة هذا الفخ الذي جرت مقاديره قبل الميلاد ما بين أسبرطة وأثينا، فقد كانت الأولى صاحبة اليد العليا في شبه الجزيرة البيلوبونيزية وقد راعها نهضة أثينا الشاملة عسكرياً واقتصادياً؛ ولهذا قررت القيام بحرب استباقية استمرت ثلاثة عقود متصلة أفضت في نهاية الأمر إلى القضاء على أثينا، وإنهاء العصر الذهبي للحضارة اليونانية.
ويحسب للبروفسور ورجل السياسة الأميركي الشهير غراهام أليسون أنه أول من استدعى هذا التعبير من خلال كتابه الشهير «الاتجاه نحو الحرب: هل تستطيع أميركا والصين تجنب فخ ثيوثيديدس؟»، الصادر عام 2017.
كانت الطريق الشعبوية لهذا المصطلح قد راجت، حيث ظهر في إعلان رأي مدفوع في جريدة «نيويورك تايمز» في 6 أبريل (نيسان) عام 2017 بمناسبة اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وقد ذكر أليسون كلا اللاعبين الرئيسيين في منطقة شرق آسيا، بأنهما يتقاسمان التزاماً أخلاقياً، يوجب عليهما الابتعاد عن فخ ثيوثيديدس، وكأن الماضي يلقي بظلاله على الحاضر.
لماذا يبدو العالم مهموماً ومحموماً بمستوى العلاقات بين بكين وواشنطن؟
من البديهي القول، إنهما عاصمتان باتتا تمثلان عصباً للاقتصاد العالمي، وإن أي اضطرابات ثنائية بينهما يمكن أن تؤثر سلباً على العالم، وتترك تداعيات على أمن واستقرار المسكونة وساكنيها.
عطفاً على ذلك، فإن أميركا والصين مسؤولتان معاً عن أكثر من 40 في المائة من الانبعاثات الكربونية المسؤولة عن التغير المناخي وتداعياته الكارثية حول العالم؛ ما يعني أنه من غير توافق بين القطبين الكبيرين، القائم كما أسبرطة، والقادم كما أثينا، يضحى مآل المناخ الدولي في خطر كارثي لن يوفر أي منهما أو من غيرهما من سكان المعمورة.
عبر 3 ساعات و24 دقيقة جرت حوارات بين جو بايدن وشي جينبينغ، لم يستمع الإعلام إلى ما دار فيها، في حين اعتمد الجميع على البيانات الصحافية التي صدرت عن الجانبين، وجاءت من غير شك مصوغة بلغة دبلوماسية تقليدية معتادة لا تشبع جوع المعرفة إلى مستقبل مسارات ومساقات العلاقات بين الجانبين.
أصاب الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول حين أشار إلى أنه لا يمكن قراءة السياسة العالمية من غير النظر إلى الخرائط الجغرافية، واليوم يبدو من المقطوع به أنه لا يمكن فك شفرات مستقبل العلاقات الأميركية – الصينية، إلا من خلال النظر المعمق إلى التاريخ بين البلدين.
يعتبر مراقبو العلاقات السياسية الأميركية مع الصين، أنها تعيش الآن في مرحلتها الرابعة، حيث استمرت المرحلة الأولى، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 في حالة عداء صريح، حتى حدوث التقارب في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، فقد فضلت الولايات المتحدة كثيراً ألا يفوز الشيوعيون بالصراع الداخلي على السلطة، وهو الصراع الذي استؤنف بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد حدوث ذلك قاتل البلدان على طرفي النقيض خلال الحرب الكورية. لقد شهدت المرحلة الثانية عداءً مشتركاً تجاه الاتحاد السوفياتي، وعملاً مشتركاً بين الولايات المتحدة والصين، لمواجهة التهديد السوفياتي.
لقاء الاثنين الماضي ضربٌ من ضروب البراغماتية الأميركية المطلقة لا النسبية، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، ضمن الحراك الذي يضم الثلاثي التقليدي الساعي في طريق الهيمنة الدولية... واشنطن – موسكو – بكين، والمشهد أقرب ما يكون إلى لعبة الكراسي الموسيقية، ومن يدفع الآخر خارج دائرة الفوز.
ظلت العلاقات الأميركية – الصينية محلّقة في مدارات الواقعية، لا المثالية أو الأخلاقية، فعندما قتلت الحكومة الصينية مئات، وربما آلافاً من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989، اختارت إدارة جورج بوش الأب الحفاظ على العلاقات مع بكين، من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوطات على موسكو.
تالياً، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، دخلت العلاقة مرحلتها الثالثة، التي شهدت زيادة الاستثمار والتجارة، وإدماج الصين في الاقتصاد العالمي.
أخفقت العلاقة في وقت لاحق بسبب فشل الصين في الانفتاح والتوجه عبر اقتصادات السوق المفتوحة، وخطوط طول وخيوط عرض النيوليبرالية الغربية، واعتبر الجميع أن بكين تهدد واشنطن بالردع النقدي، وها هي تتحول الهوينا إلى الردع النووي، بعد أن استقام لها الأمر اقتصادياً وتنموياً.
لماذا إذن تكبدت إدارة بايدن عناء ومشقة الحوار مع الصينيين مرة أخرى؟
التطورات الجديدة التي تسعى لتجنب الفخ القديم، هدفها الرئيسي واقعياً، موسكو وليس بكين، وبخاصة بعد أن علت أصوات أميركية في الداخل تنذر وتحذر من أن الاهتمام الزائد عن الحد بالصين، يعد خطأً استراتيجياً لما يتسبب فيه من إلهاء عن متابعة التقدم الروسي المخيف على الأرض، وفي الفضاء، وقد جاءت تجربة الصاروخ الروسي الذي دمر قمر كوزموس القديم المنطلق عام 1982، ليفتح أعين الأميركيين على الخطر المحدق بمشروعاتهم في الفضاء الخارجي، وهذا غيض من فيض.
لقاء الاثنين الماضي في أفضل الأحوال يؤجل الوصول إلى الفخ ولا يمنعه، لا سيما أن الصين وإن أنكرت علناً الا أنها بالفعل تحاول الترويج لآيديولوجيتها الخاصة في التنمية المستدامة على غرار النهج الكونفوشيوسي، الذي يجابه ويواجه النسق الأميركي الأرسطي الساعي للانفراد بمقدرات العالم.
قبل الانصراف... هل نجحت إدارة بايدن في وضع العصا في دواليب العلاقات الروسية – الصينية؟
إلى قراءة قادمة بإذن الله.
عن لبنان المختنق بالعزّة والسيادة!