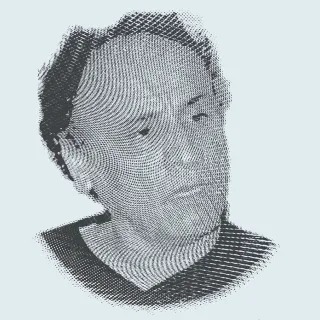يبدو أن كلمة فرنسية صغيرة كثيراً ما جرى استخدامها فيما مضى، على وشك العودة إلى الساحة من جديد: الوفاق. جرى استخدام الكلمة لأول مرة كمصطلح دبلوماسي أوائل القرن العشرين. على سبيل المثال، عندما حاول السفير الفرنسي في برلين - من دون جدوى كما ثبت لاحقاً - تحسين علاقة بلاده المتوترة مع الرايخ الألماني، أو عندما حاول الدبلوماسيون البريطانيون إنجاز الأمر ذاته عام 1912.
إلا أن مصطلح الوفاق أصبح مألوفاً لدى الأميركيين أواخر الستينات والسبعينات، عندما جرى استخدامه لوصف ذوبان الجليد في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
من جانبي، أطرح منذ العام الماضي فكرة أن الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية متورطتان بالفعل في الحرب الباردة الثانية. ولم يبدأ الرئيس دونالد ترمب تلك الحرب، وإنما جاء انتخاب ترمب بمثابة رد فعل أميركي متأخر على التحدي الصيني - الاقتصادي والاستراتيجي والآيديولوجي - الذي كان يتزايد منذ تولي شي جينبينغ منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني عام 2012.
الآن، يخلق فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فرصة للانتقال من المواجهة إلى الوفاق في وقت أقرب بكثير مما كان ممكناً في الحرب الباردة الأولى.
من جهتها، انتظرت الحكومة الصينية حتى يوم الجمعة الماضي قبل أن تهنئ بايدن بفوزه. يمكنك إيعاز ذلك إلى الشعور بالحذر. ومثلما حدث أثناء الحملة الانتخابية، سعى شي ومستشاروه جاهدين لعدم استفزاز ترمب، حيث شعروا بمزيج من الازدراء والخوف تجاهه.
ومع هذا، أقدمت بعض الأصوات غير الرسمية على التعبير عما يدور في خلد شي دونما شك. مثلا، قال وانغ هوياو، رئيس «مركز الصين والعولمة» ومقره بكين، الأسبوع الماضي، إنه يأمل في أن تمد إدارة بايدن الصين والولايات المتحدة... بمزيد من قنوات الحوار والتعاون فيما يتعلق بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتعاون الاقتصادي والتجاري والوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها». وفي حديثه خلال الفعالية ذاتها، صرح نائب وزير الخارجية السابق، هه يافي، بعبارات مماثلة.
قد يكون من المتوقع أن تمس هذه اللغة وتراً لدى حشد خبراء السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي، الذين أمضوا السنوات الأربع الماضية - من «معهد بروكينغز» إلى «مجموعة آسبن الاستراتيجية» إلى «مدرسة كينيدي» بجامعة هارفارد - يتحسرون على هجوم ترمب على نظامهم العالمي الليبرالي الأثير.
قبل ثماني سنوات، التقطت صورة لبايدن بجانب شي وهو يحمل قميصاً يحمل شعار «تعزيز النوايا الحسنة بين أميركا والصين». وعندما سُئل عن التنافس بين القوى العظمى خلال فعالية في ولاية أيوا عام 2019، أجاب بايدن: «الصين ستأكل غداءنا؟ على رسلك، يا صاح. إنهم عاجزون عن معرفة كيفية التعامل مع حقيقة أن لديهم هذا الخط الفاصل الكبير بين بحر الصين والجبال إلى الشرق، أعني الغرب. لا يمكنهم معرفة كيفية تعاملهم مع الفساد داخل النظام. أعني، كما تعلمون، أنهم ليسوا أشخاصاً سيئين، أيها الناس. لكن خمن ماذا؟ إنهم ليسوا منافسين لنا».
ولحسن حظ بايدن، لم يكن لديه سوى القليل من الفرص للإدلاء بمثل هذه التصريحات العبثية، لأن الحملة الانتخابية لهذا العام - بما في ذلك المناظرتان الرئاسيتان - نادراً ما تطرقت إلى السياسة الخارجية، الأمر الذي حرم ترمب من فرصة توضيح مدى تواصله مع مشاعر الجماهير وتوجهاتها، التي أصبحت معادية للصين على نحو متزايد منذ أن غادر بايدن منصبه قبل 4 سنوات.
من ناحية أخرى، لا ينبغي الخلط بين الوفاق والصداقة. أياً كان ما ستتمخض عنه دبلوماسية الرئيس الجديد، فمن غير المرجح أن تكون حقبة جديدة من الصداقة الصينية الأميركية. في الواقع، الوفاق يعني الحد من التوترات المتأصلة في حرب باردة وتقليل مخاطرة أن تصبح حرباً مشتعلة.
من جهته، كتب هنري كيسنجر، الذي كان من نواح كثيرة مهندس الوفاق في السبعينات، أن «الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي متنافسان آيديولوجيان». وليس بمقدور الوفاق تغيير ذلك، فالعصر النووي يجبرنا على التعايش. ولا يمكن للحملات الخطابية الحماسية تغيير ذلك أيضاً».
فيما يخص كيسنجر، كان الوفاق هو الطريق الوسط بين الاسترضاء الذي رأى أنه أدى إلى الحرب العالمية الثانية: «عندما فشلت الأنظمة الديمقراطية في فهم مخططات حاكم شمولي عدواني»، والعدوان الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى: «عندما انجرفت أوروبا، رغم وجود توازن عسكري بها، إلى حرب لم يرغبها أحد وكارثة لم يكن باستطاعة أحد تخيل حجمها».
في مذكراته التي حملت عنوان «سنوات البيت الأبيض» ونُشرت عام 1979، قبل 10 سنوات من النهاية للحرب الباردة الأولى، كتب كيسنجر أن الوفاق يعني إقرار «كل من الردع والتعايش، والاحتواء وبذل جهود من أجل تهدئة التوترات».
واليوم، تجد الولايات المتحدة والصين - مثلما أشار كيسنجر في مقابلة معي في بكين العام الماضي - «في سفوح الحرب الباردة». ومثلما ذكرت من قبل، فإن هذه الحرب الباردة لم يبدأها ترمب، وإنما تولدت عن طموح الصين، تحت قيادة شي، لتحقيق بعض من التكافؤ مع الولايات المتحدة، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، وإنما أيضاً على صعيد سياسات القوى العظمى. أما الأمر الوحيد المثير للدهشة في الحرب الباردة الثانية أن الأميركيين استغرقوا وقتاً طويلاً ليدركوا أنهم يخوضونها بالفعل. والأكثر إثارة للاستغراب، أن الأمر تطلب مطوراً عقارياً متمرداً تحول إلى نجم لتلفزيون الواقع تحول بعد ذلك إلى زعيم ديماغوغي شعبوي لتنبيههم إلى حجم التحدي الصيني الهائل.
جدير بالذكر أنه عندما هدد ترمب لأول مرة بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية أثناء الحملة الانتخابية عام 2016 سخرت مؤسسة السياسة الخارجية منه. أما اليوم، فلم يعودوا يسخرون. ولا يقتصر السبب وراء ذلك على أن المشاعر العامة الأميركية تجاه الصين أصبحت أكثر تشدداً على نحو ملحوظ منذ عام 2017، وإنما في واقع الأمر تعتبر الصين واحدة من الموضوعات القليلة هذه الأيام التي يوجد بشأنها إجماع حقيقي بين الحزبين اللذين يشكلان النخبة السياسية في البلاد.
لقد أمضى أعضاء فريق الأمن الوطني القادم لبايدن السنوات الأربع الماضية في تعزيز شدة مواقفهم من الصين. مثلاً، عبر صفحات مجلة «فورين أفيرز» هذا الصيف، أعربت ميشيل فلورنوي، المرشحة الأقرب لشغل منصب وزيرة الدفاع في الإدارة الجديدة، عن اعتقادها بأنه: «إذا كان لدى الجيش الأميركي القدرة على إصدار تهديدات ذات مصداقية بإغراق جميع السفن العسكرية والغواصات والسفن التجارية الصينية في بحر الصين الجنوبي في غضون 72 ساعة، فإن هذا قد يدفع القادة الصينيين للتفكير مرتين قبل الإقدام، على سبيل المثال، على شن حصار ضد أو غزو تايوان».
من ناحيتها، ترغب فلورنوي في توجيه «البنتاغون» مزيداً من الاستثمارات إلى الحروب السيبرية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والروبوتات والطائرات من دون طيار - وهو طرح يبدو متطابقاً مع ذلك الذي طرحه كريستيان بروز، كبير مستشاري السيناتور الراحل جون ماكين، في كتابه «سلسلة القتل».
إضافة لذلك، اعترف كبيرا مستشاري بايدن من المعنيين بآسيا، إيلي راتنر وكيرت كامبل، بأن إدارة أوباما، مثل سابقاتها، قللت من تقدير الحجم الحقيقي للطموح العالمي لقادة الصين وعزمهم على مقاومة التحرر السياسي.
في العام الماضي، قدم كامبل وجيك سوليفان (الذي كان مستشاراً للأمن الوطني لبايدن، نائب الرئيس آنذاك، خلال 2013 ـ 2014)، ما بدا وكأنه حجة صريحة لإقرار الوفاق بالمعنى الذي طرحه كيسنجر للمصطلح. وكتبا أنه «رغم الخلافات الكثيرة بين البلدين، سيتعين على كل منهما الاستعداد للعيش مع الآخر كقوة كبرى». وأشارا إلى أنه ينبغي أن تجمع سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين بين «عناصر المنافسة والتعاون»، بدلاً عن السعي وراء «المنافسة من أجل المنافسة»، والتي قد تسفر عن «حلقة خطيرة من المواجهات». ويشدد كامبل وسوليفان على أن مقارنات الحرب الباردة غير مناسبة، رغم أن ما يقترحانه يأتي مباشرة من أفكار كيسنجر التي جرى طرحها خلال السبعينات.
ومع ذلك، فإنَّ الدرس الأكبر من وراء الوفاق يبقى بالتأكيد أن أي قوة عظمى يحكمها حزب شيوعي لا تعتبر التعايش السلمي غاية في حد ذاته، بدلا عن ذلك، نجد أن الاتحاد السوفياتي تفاوض بخصوص اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية لعام 1972 مع الولايات المتحدة لأسباب تكتيكية، من دون الانحراف عن أهدافه طويلة الأجل المتمثلة في تحقيق التفوق النووي، ودعم القوات الموالية للسوفيات على نحو انتهازي في جميع أنحاء العالم الثالث.
وكان العامل الحاسم الذي أجبر موسكو على السعي وراء الوفاق، الانفتاح الأميركي على الصين في فبراير (شباط) 1972، عندما سافر نيكسون وكيسنجر إلى بكين لوضع أسس ما تحول بعد 30 عاما إلى «تشيمريكا».
أما الخطر الذي ينطوي عليه الوفاق في الحرب الباردة الثانية، فيكمن في أنه سيجعل من بايدن النسخة الثانية من جيمي كارتر. جدير بالذكر في هذا الصدد أن كارتر ظلَّ ممزقاً على مدار سنواته الأربع في الرئاسة بين جناح اليسار «التقدمي» داخل حزبه ومستشاري الأمن الوطني الأشد صقورية. وانتهى الأمر به إلى مذلة كبيرة عندما مزق السوفيات الوفاق بغزوهم أفغانستان.
وعند النظر إلى كيفية تعامل الصين مع الإدارة الجديدة، الواضح أن بكين لن ترغب في شيء أكثر من وضع نهاية لكل من الحرب التجارية والحرب التكنولوجية التي شنتها إدارة ترمب ضدها. على وجه الخصوص، ترغب بكين في التخلص من الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، والتي حالت فعلياً دون حصول «هواوي» وغيرها من الشركات الصينية على أشباه الموصلات عالية التقنية التي تنتجها ليس شركات أميركية فحسب، وإنما كذلك شركات أوروبية وآسيوية تستخدم تكنولوجيا أو حقوق ملكية فكرية أميركية.
وعلى صعيد الحرب التكنولوجية، يبدو الفريق المعاون لبايدن على استعداد لتقديم تنازلات.
من ناحية أخرى، كانت الحجة المنطقية وراء الوفاق، حسبما طرح كيسنجر كثيراً في السبعينات، هو الاعتماد المتبادل المتزايد بين مختلف جنبات العالم. وتبدو هذه الحجة تحديداً أقوى اليوم، بعدما كشفت جائحة فيروس «كورونا» الحجم الهائل للاعتماد المتبادل على المستوى العالمي.
ومع ذلك، ومثلما كان الحال في عصر كيسنجر، لا يمكن أن يعني الوفاق أن تعطي الولايات المتحدة الصين شيئاً مقابل لا شيء. وإذا اقترفت إدارة بايدن القادمة هذا الخطأ، فلن يمر وقت طويل قبل أن تندم عليه.
- بالاتفاق مع «بلومبرغ»
11:16 دقيقه
TT
كيف يمكن لبايدن وشي الحيلولة دون وقوع حرب ساخنة؟
المزيد من مقالات الرأي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة