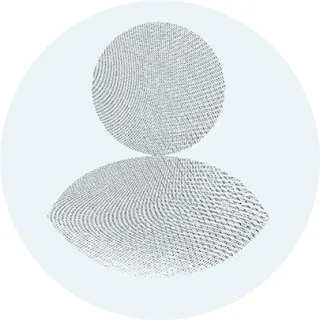يقول بنيامين دزرائيلي، وهو رئيس وزراء المملكة المتحدة مرتين متتاليتين في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر: «لقد ولج العالم بأسره إلى بقعة زلقة لا تتسم بالاستقرار، ولا بد من تثبيت مواقفنا خلالها».
ويزعم أندريه موروا، كاتب السيرة الذاتية الخاصة برئيس الوزراء البريطاني، أن دزرائيلي ربما أدرك في وقت مبكر أن الإمبراطورية البريطانية لم تعد على نفس مستوى القوة التي تمكنها من بسط السيطرة بصفة منفردة، وأنه لا بد من دعوة القوى الأخرى إلى حضور مأدبة القوة العالمية. ولقد أسفرت تلك الرؤية عن عقد مؤتمر برلين الذي بدأت مجرياته في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1884 واستمرت دورة الانعقاد طيلة عام كامل، حتى شهر فبراير (شباط) من عام 1885.
وكانت الحيلة البريطانية تتمحور حول عقد المؤتمر في مدينة برلين الألمانية بُغية التزلف السياسي لأوتو فون بسمارك، المستشار الألماني ذي القبضة الحديدية، ودفعه إلى الاعتقاد الراسخ بأنه الرجل القوي الجديد في عموم القارة الأوروبية، وأنه المحرك الأوحد لمجريات الأمور فيها. وكان المستشار بسمارك، الداعية الأول للحروب الكبرى، قد خُلعت عليه صفة صانع السلام الذي يحاول جاهداً تهدئة التوترات المشتعلة ما بين القوى الاستعمارية المختلفة في القارة الأوروبية العتيقة.
أما فرنسا، التي كانت ما تزال تراودها آلام الهزيمة المنكرة على أيدي الجيش البروسي قبل عقد أو نحوه من الزمان، فهي القوة العظمى الأخرى الموجودة جنباً إلى جنب مع الإمبراطورية النمساوية الهنغارية المتدهورة. ومن بين القوى الأخرى التي تمت دعوتها إلى مؤتمر برلين كانت روسيا، التي كانت هي الأخرى ما تزال تحاول وأد الجراح العميقة التي نالتها إثر هزيمتها في حرب القرم المريرة. وحازت الدولة الإيطالية التي نالت استقلالها حديثاً، فضلاً عن الإمبراطورية العثمانية، التي كانت توصف وقتذاك برجل أوروبا المريض، مقاعد معتبرة إلى المأدبة العالمية المذكورة.
كما تمكنت البلدان الصغيرة الأخرى من شاكلة إسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، والسويد، من الحصول على مقاعد صغيرة إلى مأدبة الكبار. وكان الضيف الذي شكّل مفاجأة للجميع هو حضور الولايات المتحدة، وهي القوة الدولية الوحيدة غير المشاركة في اللعبة الاستعمارية الأوروبية، وإنما ينظر إليها الجميع من زاوية القوة المنافسة على زعامة العالم في تلك الأثناء.
وفي حين أن مجريات مؤتمر برلين كانت تدور حول تقسيم القارة الأفريقية، وجمهورية الكونغو على وجه التحديد، فإن المؤتمر طرح تأييداً ضمنياً لمجالات النفوذ التي تمخضت عن القوى الاستعمارية الأوروبية، في الوقت الذي حازت فيه الولايات المتحدة الاعتراف الدولي بمبدأ مونرو في عام 1823 والذي يفرض قيوداً على فعاليات بناء الإمبراطوريات الأوروبية في نصف الكرة الأرضي الجديد. وكانت الحلول الوسط التي تم التوصل إليها، تشكل أطر حالة السلام الدولية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
واليوم، كما كان الحال في ثمانينات القرن التاسع عشر، ما تزال قوى بناء الإمبراطوريات الكبرى والصغرى، حتى مجرد الراغبين في التماثل والمحاكاة، ينخرطون بقوة في لعبة تقاسم القوى التي لا تعرف الشفقة أو الرحمة.
وتنبع الأنشطة المماثلة الأكثر عمقاً وكثافة في الآونة الراهنة من روسيا والصين.
تعاود روسيا حالياً، وبعد أن تعافت على نحو واضح من تجربتها السوفياتية المريرة، تلمس سبل الطموحات القومية التي طالما ألهمت خيال القياصرة الغزاة خلال القرون السابقة. لقد قامت الحكومة الروسية الحالية بضم مساحات كبيرة من أراضي دولتي أوكرانيا وجورجيا المجاورتين. وظهرت على المسرح الدولي كلاعب حاذق يملك مصير الأزمة السورية بقبضة قوية. كما تواصل بذل المحاولات المستمرة الواضحة في اجتزاء منطقة نفوذ واسعة التأثير في الأزمة الليبية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه شنّ الحروب الباهتة الفاترة ضد البلدان الديمقراطية الغربية. وتستعين الحكومة الروسية بمفهوم «الجوار القريب» في إظهار القوة السياسية والبأس العسكري داخل منطقة القوقاز المتاخمة، وربما بمزيد من التوغل المدروس في أقاليم آسيا الوسطى كذلك. كما تتعامل الحكومة الروسية مع كثير من البلدان، ولا سيما صربيا وإيران، على أنها مواطئ قدم متقدمة ضمن مشروعها القومي، في بناء الإمبراطورية الروسية الجديدة.
بدأت القوى الغربية المتعددة في الاستيقاظ والانتباه إلى التهديدات الروسية الجديدة، وأعربت عن مناوأتها الواضحة لها بخطابات سياسية تحمل لهجات شديدة، وربما مبالغ فيها في بعض الأحيان. وخصصت إحدى المطبوعات الإعلامية المرموقة في المملكة المتحدة غلافها الأسبوعي الأخير في توصيف ما سمته «المخطط الروسي لتقويض أركان الحضارة الغربية». وعلى غرار ما جرى في خمسينات القرن المنصرم، عندما شاعت مخاوف الرأي العام في الغرب من «الذعر الشيوعي الأحمر الذي يدخل كل بيت»، كان بعض المراقبين والمحللين في الغرب المعاصر يبصرون اليد الروسية التي تعبث بكل شيء، بما في ذلك محاولات المملكة المتحدة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، حتى التدخل السافر غير المبرر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
أما الصين، من جانبها، فلقد باتت تستعرض مظاهر القوة، في أرجاء العالم كافة، في الوقت التي تمارس فيه مختلف درجات التنمر وشتى محاولات الرشوة مع بعض جيرانها، في محاولة حثيثة لإخضاعهم تحت إرادتها. وعندما تستلزم الضرورة، فإنها تفتح النيران المباشرة وتدخل في مغامرات عسكرية رعناء، على غرار ما حدث أخيراً على خط وقف إطلاق النار مع الهند. وتتعامل الحكومة الصينية مع بعض البلدان في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية، من واقع أنها «محتجزات» إقليمية تخلى عنها سادتها السابقون وباتت متاحة لكل من يبسط سيطرته عليها أولاً.
ومرة أخرى، نشهد اليوم أيضاً محاولات عدة من بناة إمبراطوريات «الأقزام».
فهناك تركيا، التي تحاول جاهدة اقتطاع ما يمكنها اقتطاعه من سوريا المجاورة، ونراها تتحدث في صلف عن مراجعة جديدة لمعاهدة لوزان في عام 1923. كما تأمل في اجتزاء جزء خاص بها من العراق، فضلاً عن استعراض القوة في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال قبرص، وقطر، وفي أذربيجان.
وتطل علينا إيران بمحاولات أخرى للبقاء ضمن اللعبة، إما من خلال حروب الوكالة أو عن طريق ميليشيات المرتزقة، تماماً كما نشهد عياناً بياناً في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن منذ سنوات.
أما الهند، من جانبها أيضاً، فقد فرضت هيمنتها على عدد من بلدان الجوار، ولا سيما نيبال وبوتان، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الحثيثة لضم الجزء المتنازع عليه منذ عقود في إقليم غامو وكشمير الحدودي.
وبصفة إجمالية، من النواحي الاقتصادية، والسياسية، حتى العسكرية، ما تزال القوى الغربية تحت القيادة الاسمية للولايات المتحدة، منخرطة في القارات كافة، ولكنها تتصرف علناً كما لو أن الأمر لم يعد يعنيها في صغير أو كبير.
وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيسين أوباما وترمب تظهر النزعة الانعزالية على الصعيد العالمي من دون أن تتخلى أبداً عن مركز الصدارة.
وما تزال فرنسا من بين القوى الأوروبية النشطة في بعض أجزاء القارة الأفريقية، بما في ذلك الحرب المصغرة ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي. وفي الآونة الأخيرة، حاولت فرنسا المطالبة بلعب دور حامي الحمى والمنقذ الأول للبنان الذي يستشرف حافة الانهيار.
أما بالنسبة إلى ألمانيا، فيبدو أن وزير خارجيتها لا يملك أي طموحات واضحة سوى التودد إلى ما تبقى من جسد الاتفاق النووي البائس الذي أبرمه أوباما مع إيران.
وعلى الرغم من المزاعم القائلة بأن البريكست سوف يتيح لبريطانيا الاضطلاع بدور أكبر على المسرح الدولي، فما من دلائل تؤكد أن القيادة السياسية الجديدة في لندن تملك المقدرة على صياغة الاستراتيجية العالمية من مستوى القوى الدولية ذات الحجم المتوسط.
وربما يمكننا اعتبار الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية عملاقة لا يُستهان بها، بيد أنه لا يتجاوز حجم الأقزام على مسرح القوى العالمية.
وربما لا تتحول الحرب الفاترة الراهنة إلى حرب حقيقية ساخنة، ولكن لا ينبغي على أي عاقل أن يغفل عن المخاطر المتضمنة.
وفي حين أن الحرب التقليدية الواسعة النطاق تحمل التكاليف الباهظة بالنسبة إلى أغلب البلدان، فإن حروب الشوارع من شاكلة زرع العبوات الناسفة، أو العمليات الإرهابية، أو الهجمات السيبرانية، أو غارات الطائرات المسيّرة، صارت متاحة، حتى لأشباه الدول، على غرار إيران. ربما تكمن الحاجة إلى عقد مؤتمر جديد، على غرار مؤتمر برلين الأول، من أجل تهدئة الأمور على الصعيد العالمي ومحاولة بناء نظام دولي جديد يقوم على القواعد المحترمة من الأطراف المعنية كافة. بيد أنه في الوقت الذي قد لا نشهد فيه انعقاد الدورة المقبلة لمجموعة الدول السبع الكبرى، مَن سوف يأخذ زمام المبادرة والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي جديد؟
إنه سؤال تستحق الإجابة عنه جائزة المليون دولار!
8:17 دقيقه
TT
بقعة زلقة في شؤون العالم
المزيد من مقالات الرأي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة