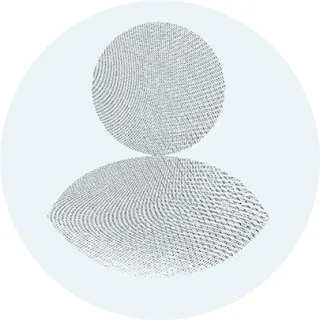نأتي الآن إلى المستند الثاني الذي اتكأ أحمد عدنان عليه، في أن المستقبل للصوفية بعد القضاء على وباء «كورونا».
يقول أحمد عدنان في مقدمة هذا المستند: «منذ ثورة يوليو (تموز) 1952، وربما قبلها، حرص النظام العربي على تدجين الإسلام الرسمي واستخدامه، وقد حرص ضباط يوليو على استتباع المؤسسة الدينية الرسمية واستضعافها، وقلدتها الجمهوريات العسكرية العربية، وهذا ربما خدم الدين بلا قصد، من حيث ربط الاعتدال بالإسلام الرسمي».
لن نحار في تحديد السنة التي رأى أحمد عدنان أن النظام العربي ربما (!) بدأ فيها تدجين الإسلام الرسمي واستخدامه (!)، رغم أنه تركها لنا مفتوحة، إذ لم يقيدها بتاريخ معين.
السنة ستكون 1945، وتحديداً 22 مارس (آذار)، مع التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية. ففي هذا التاريخ نشأ ما يسمى النظام الإقليمي العربي المكون من سبع دول عربية مستقلة، هي: مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، والعراق، والسعودية، واليمن. فقبل هذا التاريخ لا يصح الحديث عن نظام عربي بصيغة المفرد.
لنقل إذن إنه يتحدث عما بين سنتي 1945 و1952.
لنبدأ من السعودية واليمن، ولنخرج لبنان من النقاش؛ لأن لبنان في تلك السنوات وقبلها، كان ولا يزال ذا وضعٍ استثنائي، فدولته دولة طوائف دينية.
السعودية في تلك السنوات كانت تسعى إلى إنشاء مؤسسة دينية. والإرهاص الأول لهذه المأسسة كان في عام 1953، والشكل أو الطراز الذي احتذاه بعض علماء الدين السعوديين بقيادة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بناء تنظيم لها، هو جامع الأزهر.
اليمن وضعها كان مشابهاً للسعودية في تلك السنوات، فهناك علماء وقضاة ومدارس دينية في الجوامع؛ لكن لم يكن هناك تنظيم وهيكلة لها؛ لكن يختلف اليمن عن السعودية في أن الإمام يحيى حميد الدين كان إماماً في الدين والسياسة؛ لأنه في الأساس عالم دين مجتهد. أما ابنه أحمد الذي خلفه بعد اغتياله في ثورة الدستور سنة 1948، لم يكن كذلك. فهو حاكم سياسي وقائد عسكري، وتلك السنوات في اليمن كانت سنوات اضطرابات وهيجان ثوري سياسي.
سوريا مع وجود علماء دين فيها، لم تتشكل فيها مؤسسة دينية على الطراز الإسلامي العتيق. وفي تلك السنوات كان الحضور الديني في الدولة وفي الحياة العامة يمثله «الإخوان المسلمون». وثمة واقعة في تاريخ كتابة الدساتير العربية هي معلومة عند المختصين في هذا المجال وفي تاريخ الدولة الحديثة في سوريا، تعزز ما ذهبت إليه. هذه الواقعة فيها حيثية من حيثيات النقاش لها صلة بالنظام الإقليمي العربي الذي كان في تلك السنوات في طور النشأة.
هذه الواقعة هي أنه حين مناقشة دستور سوريا قبل صدوره عن الجمعية التأسيسية في 5 سبتمبر (أيلول) 1950، ثار جدل حاد حول فقرة في المادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة؛ إذ اعترض عليها نائبان. وقد تعدى هذا النقاش الحاد اللجنة التأسيسية، فخرج إلى الشارع. المؤيدون لهذه المادة كان أمهرهم في الدفاع عنها النائب مصطفى السباعي، المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في سوريا. وطرح أن تكون هذه الفقرة، هي: «دين رئيس الجمهورية الإسلام». وأن تضاف فقرة إلى المادة الثالثة، وهي: «الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع». وانتهت اللجنة إلى قبول هذا الحل الوسطي.
الحيثية التي أشير إليها، هي قول السباعي: «إن النص على أن دين الدولة الإسلام عامل قوي من عوامل الوحدة الشعبية بيننا وبين إخوتنا العرب، ومظهر رسمي من مظاهر التقارب بين دول الجامعة العربية، فلماذا نهمل أقوى عامل من عوامل الوحدة العربية شعبية ورسمية؟».
أما الأردن، فلم تكن فيها مؤسسة دينية. وأما العراق فلقد كانت فيه مؤسسة دينية، هي النجف. وهذه المؤسسة رغم صلة النظام الملكي آنذاك الودية بها، فإنه لم يكن بالإمكان لهذا النظام أن يدجِّن – وهذا اللفظ الثوري لأحمد عدنان – إسلامها لأسباب معروفة. وقد قفزت على جامع الإمام الأعظم في بغداد؛ لأنه لم يكن له في تلك السنوات ولا قبلها شأن يذكر في الحياة العامة في العراق، ولأنه كان منذ عام 1923 تابعاً لديوان الأوقاف.
ما يصح أن نطلق عليه تسمية مؤسسات دينية بنمط قروسطي في ذلك الوقت، إضافة إلى النجف، هو جامع الأزهر، وجامع الزيتونة، وجامع القرويين. والأزهر كان يختلف عن النجف وعن الزيتونة وعن القرويين في تلك السنوات، بأنه شهد طيلة النصف الأول من القرن الماضي بعض الإصلاحات التحديثية الطفيفة والشكلية.
ما يدخل في نطاق نقاشنا هو جامع الأزهر، وسننظر في دقة قول أحمد عدنان إن السلطة المصرية في تلك السنوات التي حددناها قد دجَّنت إسلام جامع الأزهر واستخدمته.
وقبل أن ننظر في هذه القضية، وعطفاً على الملحوظات السابقة، سأنبه إلى ما يلي:
لا يجوز في مثل القضية التي تعرض لها أحمد عدنان أن يصدر حكماً مبنياً على وجه الاحتمال؛ لأنه يتوفر فيها وعنها تاريخ تفصيلي ودقيق.
ليس واضحاً لنا - كما في جملته أعلاه - بماذا استخدم النظام العربي الإسلام الرسمي: هل استخدمه في تدجينه فقط، أم هو استخدمه في غرض أو أغراض سيئة أخرى؟!
من الواضح للقارئ المدقق أن جملة «وربما قبلها» تخص مصر، وأنه يعني بها جامع الأزهر، ولا يعني بها دار الإفتاء ولا هيئة الأوقاف، فهاتان الجهتان جهتان حكوميتان أسستهما الحكومة المصرية. الأولى أسستها في آخر القرن التاسع عشر، والأخرى أسستها في الثلث الأول منه.
من الواضح للقارئ المدقق هذا القصد؛ لأنه عطف تلك الجملة على جملة سابقة، وهي: «منذ ثورة 1952».
التاريخ السابق، رغم أنه تاريخ محوري بالنسبة لمصر، وتاريخ مؤثر في العالم العربي بعد مضي سنوات قليلة على قيام حركة «الضباط الأحرار» بالاستيلاء على السلطة، فإنه ليس العام الذي ضمت الحكومة المصرية فيه جامع الأزهر إليها.
فهذا الأمر حصل بعد ما يقارب العقد من قيام تلك الحركة. وأرى أن أحمد عدنان في هذا التحديد اعتمد رواية «الإخوان المسلمين»، رغم أنه يكاشف «الإخوان المسلمين» بالخصومة في السياسة والفكر!
والحق أنه في هذه المفارقة ليس وحده، فثمة آخرون من السعودية وغير السعودية ضللتهم روايات «الإخوان المسلمين» وأقاصيصهم عن التاريخ الثبت والأمين والموضوعي، سواء أكان هذا التاريخ تاريخاً سياسياً أو غير سياسي.
بعد أن كشفنا ما يعنيه أحمد عدنان بالإسلام الرسمي قبل قيام ثورة يوليو، أقول: إنه في جملة «وربما قبلها» تعامل - بغرض حسن بقصد الدفاع - مع جامع الأزهر بوصفه متلقياً سلبياً، لا ينفعل ولا يتفاعل، طرفاً منزوع الشخصية، مفرغاً من المصالح والمطامح والرغبة في النفوذ الديني والنفوذ السياسي والاجتماعي. فهو – بحسب تصوره وعباراته – كيان قابل للاستتباع والاستضعاف والتدجين فقط!
تصور أحمد عدنان هذا قائم على الافتراض وعلى الرجم بالغيب. فللأزهر دور أساسي في الحياة العامة في مصر، ومنها السياسة، منذ عهد سلاطين المماليك. وفي أيام الاحتلال الفرنسي كانت له الزعامة الشعبية. والأزهر هو الذي ساند محمد علي باشا في نيله ولاية مصر، وعارض بقوة وإلحاح عزله واستبدال والٍ آخر به. وفي ثورة 1919 كان له تاريخ وطني مشهود في النضال ضد الإنجليز.
أغفل أحمد عدنان في طرحه للعلاقة ما بين السياسي والديني أنه في تاريخنا العربي والإسلامي القديم والحالي، تعتمد السياسة على الدين، وأن الدين يعتمد على السياسة، وبالتالي، فالعلاقة بينهما هي علاقة تساندية وتعاضدية، تفيد السياسي وتنفع الديني. وأنه ليس بالضرورة أن علاقة التعاون والتضافر إذا ما قامت بينهما، ستكون علاقة أحادية حدية، يستتبع السياسي فيها الديني ويستضعفه ويدجنه دوماً وأبداً. فقد يحدث العكس، وهو أن يضعف الديني سلطة السياسي ويجور على سلطانه ويفتئت على اختصاصه.
تصور أحمد عدنان للعلاقة بين السياسي والديني بطريقة أحادية حدية، بحيث تكون هذه العلاقة لمصلحة السياسي والسياسة وعلى حساب الديني والديانة، هي التي جعلته يقول هذه الجملة المتناقضة: «وقد حرص ضباط يوليو على استتباع المؤسسة الدينية الرسمية واستضعافها»!
التناقض في هذه الجملة، أن هؤلاء الضباط حين استتبعوا الأزهر للجهاز الحكومي بعد سنوات من نجاح حركتهم في الاستيلاء على السلطة، كان هدفهم الاستقواء به، سياسياً ودينياً وثقافياً وفكرياً، داخلياً وخارجياً، فكيف يتسنى لهم أن يستقووا بمن يعملون على إضعافه؟!
ولماذا يعملون على أضعافه، والأزهر لم يكن معارضاً سياسياً ودينياً لحركتهم مع قيامها، ولا في بداياتها؟ بل إن الأزهر عبر شيخه الدكتور عبد الرحمن تاج اصطف إلى جانب عبد الناصر، وإلى جانب أغلب ضباط الثورة، في النزاع الذي نشب بينهم وبين الرئيس محمد نجيب. وأدان في بيانٍ أصدره شيخه ومعه مشايخ الأزهر وأعضاء جماعة كبار العلماء، «الإخوان المسلمين» بعد محاولتهم اغتيال عبد الناصر في حادثة المنشية الشهيرة!
إن هذه الغائية الشريرة لا يقول بها سوى «الإخوان المسلمين». وهكذا نجد أنفسنا مرة ثانية أمام رواية إخوانية مضللة؛ لكنه يختلف فيها عنهم، بحكمه بأن «استتباع المؤسسة الدينية الرسمية واستضعافها» الذي - كما أدعى - قلدت الجمهوريات العسكرية العربية فيه ضباط ثورة يوليو، «ربما خدم الدين – بلا قصد – من حيث ربط الاعتدال بالإسلام الرسمي»!
وهذا الحكم العجيب يقول ضمناً، إن الإسلام الرسمي قبل أن تستتبعه الجمهوريات العسكرية العربية، وقبلها نظام ثورة يوليو، كان إسلاماً غير معتدل!
ومع اختلافه معهم في حكمه العجيب هذا، فإنه يتفق معهم في أصل روايتهم المضللة، وذلك في جملته الاعتراضية، وهي أن تلك الأنظمة السياسية لا تستهدف خدمة الدين؛ بل غايتها الإضرار به وبأهله، وإنْ خدمته فهي قد خدمته بلا قصد! وللحديث بقية.
10:34 دقيقه
TT
خصومة في السياسة والفكر وتبعية في الرواية والحكم
المزيد من مقالات الرأي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة