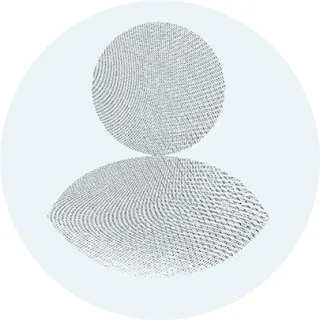الكلام الكثير عن أمن الخليج لم ينافسه خلال العقد الماضي سوى الكلام عن «فقدان نظام دمشق شرعيته»...
طبعاً، نعرف، ويعرف السوريون قبل غيرهم، كيف تطوّرت المواقف العربية والدولية من المحنة السورية. والأمل الوطيد ألا يسير أمن الخليج في الاتجاه نفسه.
ثم إن الأحداث المتلاحقة في الخليج ما عادت تترك مجالاً للتخمين والتأويل. فأساساً، هناك في طهران قيادات تبدو مطمئنة إلى أن الغرب لن يقاتلها... بل حتى غلاة متشدّديه يفضلون الحوار المفضي إلى التعايش على الصدام المفضي إلى تكلفة مجهولة.
حتى اللحظة، ونظرياً على الأقل، رهان هذه القيادات صائب...
في حسابات القيادات النافذة في طهران اليوم أن خطة الابتزاز الأمني، المتمثلة بمصادرة ناقلات النفط والتصعيد عبر الطائرات المسيّرة «الدرون»، ورفع السقف سياسياً وإعلامياً... خطة محكمة تؤتي أكلها وتوصل الرسالة إلى مَن يعنيهم الأمر في الغرب بوضوح، ألا وهي:
أولاً، أن إيران غير خائفة، بل، على العكس، تتحرّك باتجاه تصعيد لا يريده مهدّدوها، وبالتالي يكشف نياتهم.
وثانياً، أن رسالة «التحدي» هذه ستزكّي حجة دعاة الحوار مع إيران «القوية» في الدول الغربية، ولا سيما، في أوروبا، ناهيك من الحزب الديمقراطي والأوساط المناوئة للرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة.
ثالثاً، التردد الغربي، إذا ما استمر على ما هو عليه، سيفقد القوى الغربية الكثير من الثقة التي ما زالت الدول الغربية تتمتع بها في العالم العربي، وبالذات في دول الخليج... وهذا، حتماً، يصب في مصلحة إيران.
رابعاً، أي تصعيد إيراني يمرّ من دون رد غربي يعزّز مواقع النظام داخلياً، ويرجح كفة العزة القومية على المعاناة الاقتصادية من العقوبات.
خامساً، التصعيد يقوّي مكانة إيران كلاعب إقليمي و«رقم صعب» تستطيع قوى مثل روسيا والصين المراهنة عليه في أي ترتيب مستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط.
كل هذه العناصر، وغيرها، تعتمد عليها القيادات التي تحرّك حجارة الشطرنج في طهران اليوم، مستغلّة انقسام الرؤى وتباين النيات وتناقض المصالح داخل «الكتل» المقابلة. وفي الواقع، لا بد من القول، إنه حتى هذه اللحظة، وبصرف النظر عما يمكن أن يكون قيد الإعداد وراء الكواليس
ما زالت ردات الفعل الغربية باردة كي لا نقول ضعيفة. فعلى الرغم من التهديدات المتكرّرة خلال الأشهر الفائتة، اتسمت الإشارات الواردة من واشنطن ولندن وغيرهما من العواصم الغربية بالتناقض... وفي بعض الحالات، بالاعتدال.
الرئيس ترمب، الذي بنى جزءاً لا بأس به من «صدقيته» السياسية «على استعادة أميركا عظمتها»، بدأ حكمه بمؤشّرات محدودة تعكس اختلاف مقاربتها لمقاربات سلفه الديمقراطي باراك أوباما شملت قصفاً على مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص بوسط سوريا. ومن ثم، أعلن ترمب خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وخروجها منه. غير أن الإدارة الجمهورية الجديدة سرعان ما تركت الشأن السوري للروس باستثناء اعتبارها هضبة الجولان المحتلة «أرضاً إسرائيلية». وباستثناء تشديد العقوبات الاقتصادية وتكثيف التهديدات السياسية لإيران، أكد الرئيس ترمب غير مرة أن إدارته لا تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني. ثم، اختار راند بول، السيناتور الجمهوري اليميني المتشدد الرافض بعناد أي مواجهة عسكرية مع طهران، موفداً خاصاً للبيت الأبيض للشؤون الإيرانية.
هذا على مستوى الإدارة والحزب الجمهوري، أما بالنسبة للديمقراطيين وبعض الإعلام الأميركي الليبرالي المؤثر، فإن الموقف من طهران ومطامعها الإقليمية إيجابي جداً، مع الأسف. والجانبان، الديمقراطيون والإعلام الليبرالي، يريان أن المعركة الأهم هي تلك التي يخوضانها ضد ترمب وكل ما يمثل... بما في ذلك موقفه من إيران. وبالتالي، فهما يتجاهلان عمداً وتكراراً أطماع طهران في اليمن، ورغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب، وهيمنتها الفعلية على العراق وسوريا ولبنان.
وحيال ما يخصّ أوروبا الغربية، فالوضع أقل سوءاً بكثير بالنسبة لمتشدّدي طهران. إذ لم تتوقف لحظة سياسة الاسترضاء والملاطفة منذ خروج واشنطن من الاتفاق الدولي. وكانت فرنسا وألمانيا، وكذلك مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، طليعة الإصرار على التقارب مع طهران وكسب ودها، وما كانت بريطانيا - رغم انشغالاتها الداخلية مع «أزمة بريكست» وانتظارها حكومة جديدة - ببعيدة عن نهج الاسترضاء.
ومع أن تطوّرات الأيام القليلة الفائتة، ربما صدمت الأوروبيين، وظهر امتعاض من عدة جهات رسمية أوروبية حيال المكابرة العدوانية الإيرانية، فإن ردة الفعل على اعتراض «الحرس الثوري» ناقلتين بريطانيتين و«مصادرتهما» في مياه الخليج جاءت ضعيفة للغاية.
في مثل هذه الأجواء، تواصل روسيا استعادة نفوذها «السوفياتي» القديم في بعض دول المنطقة، مستفيدة من السلبية الأوروبية والارتباك الأميركي.
البداية، باسم التصدّي لـ«الإسلام السياسي»، كانت في سوريا ومصر، بعدما اعتبرت موسكو أنها أخرجت من المعادلة في كل من العراق وليبيا.
في مصر وفّر التغيير السياسي الذي حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد تجربة حكم «الإخوان» الأرضية المثالية لموسكو كي تثبت وتعيد نسج تحالفاتها ضمن «جبهة» تواجه ما تعتبره قيادة الكرملين «عدواً مشتركاً». وفي سوريا، كانت موسكو منذ اندلاع الثورة الشعبية السورية تسعى إلى تصويرها على أنها محاولة من جماعات «إسلامية متشددة» للاستيلاء على الحكم. وبمرور الوقت، أتيح لها ولدول أخرى، حرف اتجاه الثورة وتهميش مطلقيها المدنيين الحقيقيين وإبعادهم عن مراكز القرار. ومن ثم التأكيد عبر «مسار آستانة» على الشقين «العسكري» و«الإسلامي» مع شريكتيها في هذا المسار... إيران وتركيا.
علاقات موسكو مع طهران، بما فيها تلك المتصلة بالشأن النووي ليست جديدة. غير أن الجديد، كان استثمار الروس اندفاع واشنطن في رعاية طموح الانفصاليين الأكراد في كسب ود أنقرة، ولا سيما، بعد إسقاط الأتراك طائرة عسكرية كانت تقصف الثوار السوريين قرب الحدود التركية بشمال غربي سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ومنذ ذلك، الحين تغيّر اتجاه الريح في أنقرة، رغم «إسلاميتها»، ثم أخذ يظهر تباين الأولويات بين موسكو وطهران على الساحة السورية.
كل هذه الاعتبارات تبقى في صميم فهم ما حدث ويمكن أن يحدث في الخليج.
10:34 دقيقه
TT
رهان إيران وخطط روسيا... أمام تصوّر أميركا للمنطقة
المزيد من مقالات الرأي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة