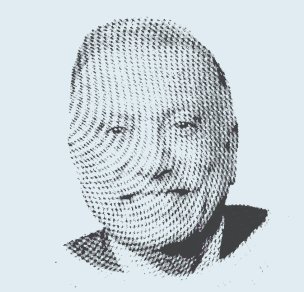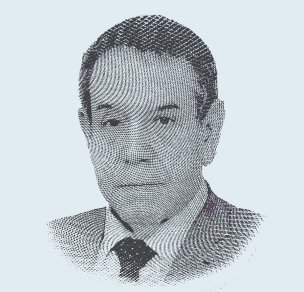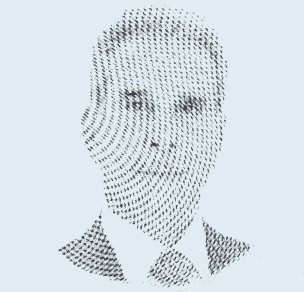بينما ينشغل العالم -ساسةً وإعلاماً ونُخباً وجمهوراً- بتصريحات مفاجئة وصادمة، أو مقترحات وخطط مثيرة للدهشة والجدل، يوماً بعد يوم، تجري عملية أخرى في أناة وتدرج ناعمين؛ وهي عملية «توجيه النظام الآيديولوجي العالمي نحو اليمين الشعبوي».
قبل أكثر من عقدين من الزمن، كان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، كوفي عنان، يتحدث إلى طلاب وأساتذة جامعة ييل الأميركية عن العولمة التي أظهر اهتماماً وشغفاً كبيرين، خلال فترة ولايته، بمحاولة تعزيز آثارها الإيجابية، واحتواء ما قد ينجم عنها من تداعيات ضارة.
ومن بين ما قاله عنان خلال حديثه آنذاك: إن العولمة عبارة عن «تدفق متزايد على الصعيد العالمي، للسلع، والخدمات، ورأس المال، والتكنولوجيا، والمعلومات، والأفكار، والأيدي العاملة».
وفي محاولته لتشخيص الهدف الأعلى الذي يبتغيه من شيوع العولمة وتعزيز آلياتها وتفعيل رؤيتها، عدَّ الوصول إلى حالة من «الاندماج والاحتواء» تحقيقاً لذلك الهدف، على أن يجري ذلك بطريقة تحد إلى أكبر درجة ممكنة من العواقب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية السلبية، التي يمكن أن تنشأ عند تطبيقها.
تُعد تلك طريقة إيجابية ومتفائلة للتعامل مع مفهوم العولمة على الصعيد الأممي بكل تأكيد، ولاحقاً سيُنسب لكوفي عنان قوله: إن «التشكيك في العولمة أشبه بالتشكيك في قانون الجاذبية»، وهو في مقاربته تلك إنما يؤكد أن العولمة واقع عالمي لا يمكن دحضه من جهة، وأن فوائدها عظيمة وشاملة للمجموع الإنساني من جهة أخرى، من دون أن ينفي تماماً إمكانية أن تنشأ أضرار جانبية عند تفعيل آلياتها الضخمة والمؤثرة من جهة ثالثة.
ستعرف العولمة لاحقاً كثيراً من التشكيك واللغط، عندما تخرج الانتقادات والشكاوى من بلدان «الأطراف» النامية؛ خصوصاً عن التهميش والاستتباع لصالح دول «المركز» المتقدمة، وستجتهد آليات أممية ومنظمات مجتمع مدني وبعض الدول، في محاولات لإحداث التوازن بين إيجابيات العولمة من جانب، وتداعياتها الضارة من جانب آخر، وسيكون الجميع متوافقاً -على الأقل من الناحية النظرية- على أن تفاعلات العولمة تحتاج إلى قدر وافر من الإنصاف، وإلى درجة من الاحترام للخصوصية والمصالح الوطنية، ضمن سعيها الدائب لـ«الاندماج والاحتواء».
لكن مياهاً كثيرة جرت في «نهر العولمة» الذي لم يعد متدفقاً وصافياً كما كانت الرغبات؛ إذ بدا أن آليات العولمة نفسها خضعت لعملية استغلال من قوى مُناهضة، وأن تلك القوى أحسنت استخدام تلك الآليات، وأبدعت في تسخيرها لمفاهيم مُناقضة.
وتحت عناوين براقة وجذابة من نوع «أميركا أولاً»، أو «ألمانيا مزدهرة مرة أخرى»، أو «عائلات قوية من أجل أمم قوية»، أو «لنجعل أوروبا عظيمة من جديد»، سيتم تسخير شبكات وممكنات عولمية قوامها «السوشيال ميديا»، و«الذكاء الاصطناعي»، و«الإعلام الحر»، و«التبادل التجاري»، و«الهجرة والتعايش»، من أجل توجيه النظام الآيديولوجي العالمي نحو اليمين باطراد.
وفي الانتخابات العامة التي جرت خلال العقد المنصرم، في مجتمعات غربية، شكَّلت لأكثر من عقدين منطلقاً ورافعة رئيسة للعولمة فكراً وآليات، شهدنا صعوداً مُطَّرداً للتيارات اليمينية، وبينها من انطوى على نزعات شعبوية ومتطرفة. وقد كان بعض هذا الصعود عائداً لإخفاقات مُنيت بها طبقات الحكم التقليدية في تلك المجتمعات؛ لكن معظم هذا الصعود كان نتيجة مباشرة لاستخدام الآليات العولمية ذاتها.
لذلك، لم يكن مستغرباً أن تلجأ دول مثل روسيا والصين إلى إحداث حقيقة «الإنترنت السيادي» التي هي ممانعة خالصة لفكرة العولمة ذاتها، وكان ذلك بدواعي الحفاظ على الأمن القومي. وفي تلك الحقيقة، سيلجأ هذان البلدان إلى التأكد من بناء جدران «عزلة رقمية» يمكن تفعيلها في حال «الخطر»، وسيستثمر بلد مثل الصين بضراوة ونهم في بناء آليات اتصال و«ذكاء اصطناعي» محلية، وخاضعة للشروط المُبتغاة عند «صيانة الأمن القومي» من «تهديدات مفترضة».
لكن شبكات اليمين «الشعبوي والمتطرف» التي تمتد عبر القارة الأوروبية، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتربح في الانتخابات، أو تحسن مراكزها السياسية، ستستمر في تقويض آليات العولمة نفسها باستخدام مقوماتها الفريدة.
وعبر تلك المقومات -وفي المقدمة منها منصات «التواصل الاجتماعي» وأدوات «الذكاء الاصطناعي» القادرة على تسخير الخوارزميات وإشاعة الأخبار المُضللة- ستنجح الأحزاب اليمينية في بث دعايتها، وحشد المناصرين، وإعادة توزيع الحظوظ الانتخابية، وتحقيق التقدم.
لقد حدث ذلك في الانتخابات المجَرية والفرنسية والأميركية والإيطالية والنمساوية، وصولاً إلى الانتخابات البريطانية والألمانية، والحبل على الجرار.
تتعرض العولمة -أو الجزء الإيجابي والبنَّاء فيها- لأخطر اختبار في هذه الأثناء، وهو الاختبار الخاص بقدرتها على حرمان أعدائها من تسخير آلياتها لتحقيق أهدافهم... والنتيجة حتى الآن مُحبطة ومُخيبة.