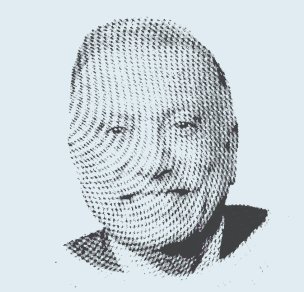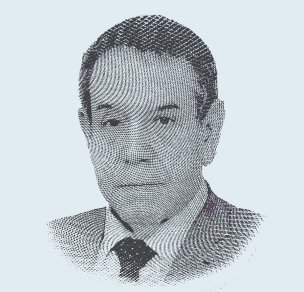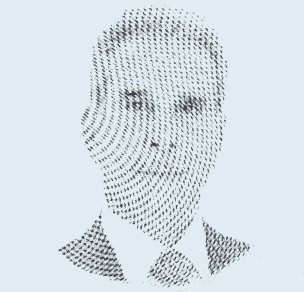ومثلُ المتنبي، الذي بلغَ في سماءِ الإبداع مبلغاً عليّاً، من يَكثر حاسدوه في الدنيا، وكلَّما ازداد تألقاً، ازداد حُسَّاداً، ولا يحتاجُ للحصولِ على جيش من الحسَّاد إلى أكثرَ من العمل على الخصال الحميدة، والسجايا الطيبةِ العديدة، ومواصلةِ الترقّي في الهمم العالية، والترفُّع عن الرزايا. وهذا المسلك كفيلٌ بصناعةِ العشراتِ من الحسَّاد، وبعد أسابيعَ يزدادون عدةً وعتاداً فيصبحون في عدادِ المئات، والعدد في ازدياد. قليل يمرّون بهذه الدنيا، فيتلقّفهم كل مريض النفس، بحسدٍ لا حدّ له ولا صد، ولا رد. وما عرفَ هذا المسكين الكرم، إلا في الحسدِ، فباتَ يقضي نهارَه وليلَه يتقلَّب في الحسد، متنقلاً من دائرةِ حسدٍ إلى دائرةِ حسدٍ أخرى... ولك أن تقرأ الجملةَ السابقةَ بما يوافقُ هواك حينَها! ومن عجائبِ الدُّنيا التي لا تنقضِي، هي ما ينتصب في ذهنِك كعلامةِ استفهامٍ بارزة، من الجاهلِ الذي يدفعُه إمعانُ جهلِه إلى أن يحسدَ العاقلَ على ما يبكِي منه المحسود! ولا تحتاج للحصولِ على فرقةٍ من الحُسَّاد - يزدادون مع الأيامِ ولا ينقصون - إلى أكثرَ من أن تكونَ مقتنعاً بأنَّه لا يليقُ بك إلَّا أن تتسابقَ معهم. أما الجاهل فإنَّه لا يتورَّع عن حسدِ ذي العقل، على ما يبكي منه العاقل. وخيرُ من صوَّر هذا المشهدَ المضحك، المبكي، أبو الطيب المتنبي، في داليتِه التي أنشدَها بيومِ عرفة، وهو يُهمُّ بالفرارِ من مصر كافور:
مَاذَا لَقِيتُ مِنَ الدُّنْيَا؟ وأَعْجَبُهُ:
أَنِّي بِمَا أَنَا بَاكٍ مِنهُ مَحْسُودُ
ما ألقاه من الدنيا فيه من العجائب ما لا ينقضِي، لكنَّ أعجبَ ما لقيته هو أنّي أُحسد على ما يبكيني، فهل ثمةَ جهلٌ مثل جهلِ حاسدٍ يحسدُ العاقلَ على أمرٍ بلغَ من منافرتِه له أنَّه يبكيه! وحسدُك على ما يبكيك أعجبُ العجب، والأمرُ فادحٌ فلا تغرنَّك ميمٌ تسبقُ صائبَ! إنَّ طعانَ الدَّهرِ في جسدي أبلاه فلم يعدْ لديَّ موضعٌ من قلبي أو كبدي شيئاً:
لَمْ يَتْرُكِ الدَّهْرُ مِن قَلْبِي ولَّا كَبِدِي
شَيئًا تُتَيِّمُهُ عَينٌ ولا جِيدُ
يَا سَاقِيَيَّ أَخَمْرٌ فِي كُؤُوسِكُمَا
أَمْ فِي كُؤُوسِكُمَا هَمٌّ وتَسْهِيدُ؟
أَصَخْرَةٌ أَنَا مَا لِي ما تُغَيِّرُنِي
هَذِي المُدَامُ ولَا هَذِي الأَغَارِيدُ؟
إِذَا أَرَدتُّ كُمَيتَ اللَّونِ صَافِيَةً
وجَدتُّهَا وحَبِيبُ النَّفْسِ مَفْقُودُ
مَاذَا لَقِيتُ مِنَ الدُّنْيَا وأَعْجَبُهَ
أَنِّي بِمَا أَنَا بَاكٍ مِنهُ مَحْسُودُ؟!
أَمْسَيتُ أَرْوحَ مُثْرٍ خَازِنًا ويَداً
أَنَا الغَنِيُّ وأَمْوالي المَواعِيدُ
وفي قصيدةٍ أخرى يقول:
وما لكَلَامِ النَّاسِ فيمَا يُريبُني
أُصُولٌ ولَّا للْقائِليهِ أُصُولُ
أُعَادَى على ما يُوجِبُ الحُبَّ للفَتى
وأهْدَأُ والأَفْكَارُ فيَّ تَجُولُ
والحسدُ من أرذلِ خصالِ البشر، وأخسّها، وأوضعِها، فتخيَّل أي نفسٍ عند الحاسد، تلك التي ترضَى أن توصفَ بهذه الأوصاف، الدُّونية فيا لَحقارةِ الهم، ويا لتفاهةِ المهتم. ومن لؤم الحاسدِ، أنه موكل بالأدنى، فالأدني، والأقل فالأقل، ولا يعرف أنَّ حاسداً تحوَّلَ عن حسَّادة، أو تراجع عن حسده، وما عُلم عنه إلا زيادة بقعةِ الحسد مع تقادم الأيام، حتى توشكَ رقعةُ الحسد أن تملأَ بصرَ الحاسد، وتسدَّ عينَه القادحة شراراً، ونفسَه الفائضةَ ضرراً. لقد دعا ذلك، معاوية بن أبي سفيان، حكيم العرب، ليقول:
«يمكنني أن أرضِيَ الناس كلهم، إلا حاسدَ نعمةٍ، فإنَّه لا يرضيه منها إلا زوالُها». ووقعَ أبو الطيب بجلاءٍ على المعنى ذاته، فقال:
سوى وجعِ الحسَّادِ داوِ
فإنَّه! إذا حَلَّ في قلبٍ فليس يزولُ
فإن رمتَ مداواة عللك،
فداوِ علةً غير وجعِ الحسَّاد،
فهو مرض لا يُرجى برؤه،
وهو إذا حلَّ في قلبٍ ما فليس يزولُ.
واستخدمَ للحديث عن وقوعِ الحسد من القلب: (حلَّ)، ولم يقل نزل أو وقع أو... وحلَّ هنا تعني استوطنَ ومكث، وإذا كان الأمر هكذا، فأبشر بطول سلامة يا مربع. ومن اشتقاقات حلَّ أنَّها بعد ذلك تتطوَّر إلى دلالاتٍ أخرى منها ما تصنعه من حائل بين ما حلت به وغيره من مساحات، فكأنَّ حلَّ تهبُ صاحبَها صكَّ ملكية الأرض التي حلَّ بها، من دون شراء، ولا بيع. ويلحق ببيت المتنبي في الحديث أنَّه فيما هو باكٍ منه محسودُ، ما يذكره ابن نعيم. ما نسبَه علي القاسمي في «معجم الاستشهادات الموسع» للمتنبي، وأحسبهُ وَهَمَ: هم يحسدوني على موتِي فوَا أسفَا، حتَّى على الموتِ لا أخلو من الحسدِ! وهنا تطوَّر الحسد وازداد عسفاً في دلالته ومساحته، فبلغ الحسد على موته. وترى المتنبي كرَّر في البيت «كؤوسكما» مرتين، الأولى متسائلاً... أخمرٌ في كؤوسكما؟ والخمرُ مادةٌ محسوسة، ومن مظانّ وجودِها أن تكونَ في كؤوسِ الطلى لتسقيَ المتنادمين، أمَّا الهمُّ فليس بمادة محسوسة، بل هو مادةٌ معنوية، وليس مظنة لوجود الهمّ والتسهيد أن يكونا في الكؤوس، فمادتُهما لا تتناسب لتكونَ في الكؤوس، فلماذا تساءلَ المتنبي عارضاً في سؤاله المعنوي بالحسي، وهما لا يتناسقان مع بعضهما البعض؟! إنَّ كثرةَ كؤوسِ الخمر التي عبَّها المتنبي وسقاه إياها ساقياه، لم تجعل أيَّ أثرٍ من آثارِ شرب الخمر يظهر عليه، فلا تغير أصابَ جسَمه ولا رسمه، ولا لسانَه ولا بنانَه، وفي الوقت ذاته تمكَّن الهمُّ منه، وأثقلَ كاهلَه، وكدَّر خاطرَه، وحيث كانَ الهمُّ أتَى معه بالتسهيد، وهو السهر ومجافاة النوم، وفي الكليات أنَّ السَّهرَ، عدم النوم اختياراً والتسهيدَ مجافاةُ النومِ إجباراً. ويكادُ الهمُّ والتسهيدُ يكونان توأمين متَّصلين ببعضهما بعضاً، فلا يحلُّ الهمُّ إلا جلبَ معه السهادَ، ومجافاةَ النوم. فهم يفتئتون على من يحسدون زوراً، ويدَّعون عليهم كذباً، فيقولون عنهم ما ليس فيهم، في مقدمات تبدو منطقيةً قبل نشر رذيلةِ حسدهم! أمام هذا الكذب، لا يجدُ المتنبي أيَّ غضاضةٍ في إظهار عدم اكتراثه بأكاذيب الحسدة التي كالوها له، فهو يعرف حاله، ويعرف حالتهم، وصفاء حاله، ويقوده إلى ألا يعبأ بهذه الترهات.