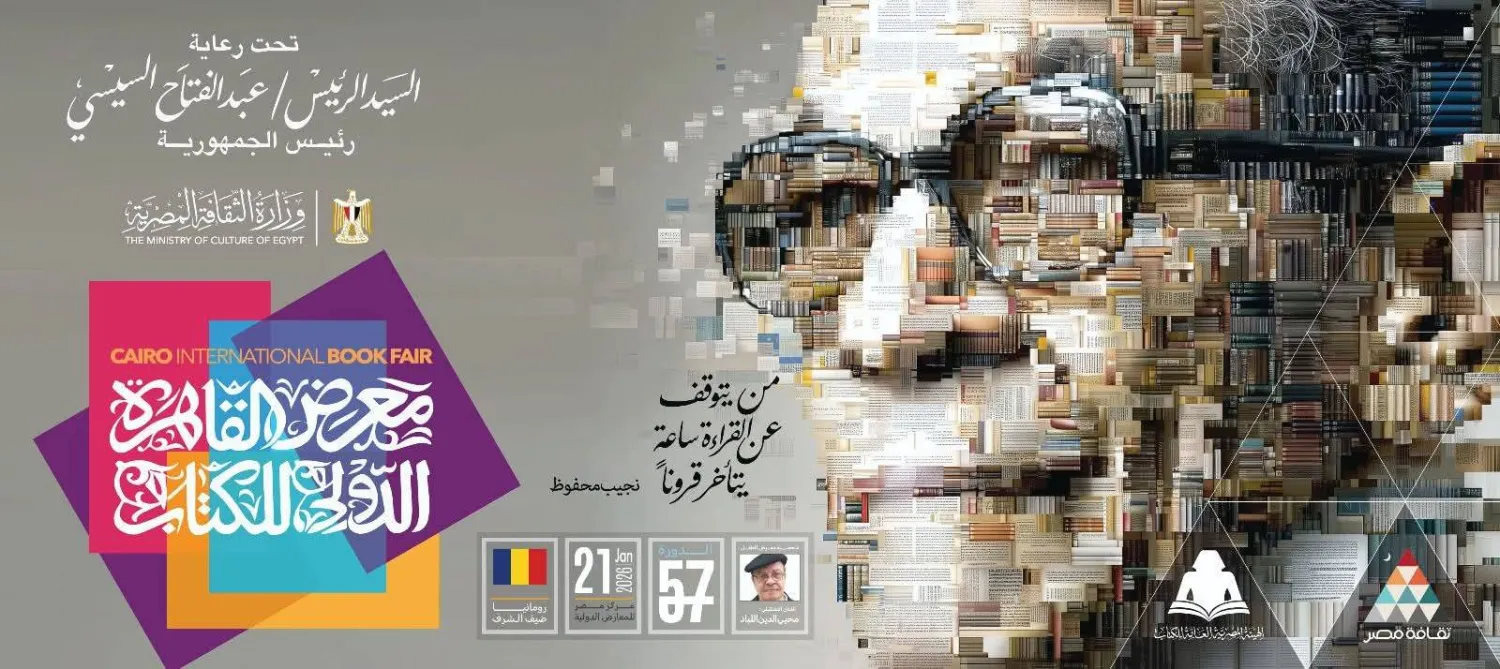من بين الكتب التي استعرضتها الصحافة البريطانية حديثاً استوقفني كتاب من إدوين غَيْلْ Edwin Gale البروفسور الأسبق في الطب في جامعة بريستول، المعنون «النوع البيولوجي الذي غيّر نفسه» مع عنوان فرعي تابع «كيف أدى الازدهار إلى إعادة تكييف البشرية لنفسها».
يطرح الكاتب تصوراته عن أن وفرة الغذاء أدت إلى الوصول إلى نمط «المخلوق الاستهلاكي» الذي تطورت لديه سمات بيولوجية لم تكن موجودة لدى سابقيه من الأنماط البشرية. وإن كان النوع البيولوجي يتحدد بجيناته المتوارثة وبالوسط المحيط لنشأته، فإن الكاتب يرى أن هذا النوع البيولوجي الجديد من الإنسان، غيّر نفسه فعلاً بعد أن ازداد وسطه المحيط - الذي صنعه هو بنفسه - تأثيراً، مع ازدياد الوفرة وانتشار التعليم.
ربما تبدو التصورات التي يقدمها الكاتب غريبة في كونها تتحدث عن نمط «بيولوجي» حديث، إلا أن علينا أن نتذكر أن النشاطات البشرية قادت إلى خلق بيئة غير مسبوقة على الأرض، فقد أدت الثورة الصناعية، وخصوصاً منذ نهاية أعوام الأربعينات في القرن الماضي إلى انطلاقة عظمى في ميدان الأبحاث والتصنيع؛ ما زاد من تلوث البيئة بالمواد الجديدة والانبعاثات الضارة وملوثات التربة والجو والماء. وقد ارتد هذا الأمر على الإنسان على شكل أمراض تنفسية وقلبية وسرطانية، بل إنه أثر حتى على بنية الإنسان البيولوجية؛ إذ أشار العديد من الأبحاث مثلاً إلى تدهور القدرات التناسلية للرجال في أوروبا بعد أن قلّت حيوية وحركية الحيوانات المنوية وأعدادها لديهم، بتأثير الملوثات حسبما يعتقد.
وإضافة إلى ذلك، يبدو أن تأثير الإنسان على الأرض قاد مجموعات من العلماء في الجيولوجيا إلى اعتماد نوع جديد من العصور الجيولوجية يمثل «العصر الجيولوجي الناجم عن التأثير البشري».
ويسمى هذا العصر «الأنثروبوسين»، وهو حقبة مقترحة يعود تاريخها إلى بداية التأثير البشري الكبير على جيولوجيا الأرض والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك، على سبيل المثال، تغير المناخ بسبب الإنسان.
النمط الجديد للإنسان الذي يتحدث عنه البروفسور غيل في كتابه يشتمل على خصائص بيولوجية ملاحظة، منها أن الإنسان المعاصر أضحى أكثر طولاً، وأكثر شحماً، وأطول عمراً، وأكثر تعاطفاً مع الآخرين، بل - وربما كما يقول - أكثر ذكاءً من كل أسلافه السابقين.
ووفقاً للكاتب الذي يستطرد في تأملاته، فإن الإنسان مر في الماضي بأول نمط، هو «الصياد - جامع القوت» الذي كان يتسم بطول قامته وطول رجليه ورشاقته؛ ما أهله لملاحقة الغزلان لزمن طويل، ويتمتع بأسنان ممتازة لانتفاء الحبوب والسكر من غذائه، كما أنه لم يتعرض لأي جائحات من الأمراض؛ لأن مجموعاته الصغيرة كانت تعيش متناثرة. ولا يعرف عنه معاناته من مرض السكري أو أمراض الشرايين، وعند الهرم لم يكن يزداد وزناً ولا يرتفع لديه ضغط الدم.
أما النمط الثاني للإنسان من الناحية التاريخية، فهو «الإنسان الزراعي» الذي ظهر بانطلاق الثورة الزراعية قبل 10 آلاف عام التي أدت إلى ازدياد تعاسة الإنسان، وفقاً للمؤلف. إذ هنا بدأت حياة الاستقرار وقلّ التنوع الغذائي؛ ما أدى إلى صغر حجم الإنسان وعيشه لأعمار أقصر، مصاباً بفقر الدم متعرضاً للفيروسات التي تنتقل من قطعان الماشية أو الحيوانات البرية التي تدور حول مستوطناته. وفي الوقت نفسه، ظهرت «المرأة الزراعية» التي ازدادت قوة عضلات اليدين لديها بعد أن عكفت على طحن الحبوب على مدار الزمن.
ويضم الكتاب مقتطفات تضفي عليه نوعاً من الظرافة عند حديثه عن عادات تسمين العروس لدى قبائل في نيجيريا داخل غرفة خاصة لأشهر عدة، ومخاطر استخدام الاسترويدات المصنعة للكمال الجسماني.
وعودة إلى النمط الجديد للإنسان، يتحدث الكاتب عن بزوغ فجر الوفرة الغذائية مع تطوير الأسمدة الزراعية. ويقول، إن السمنة هي أهم خصائص وعلامات النمط «البيولوجي الاستهلاكي» الجديد، مشيراً إلى أن السمنة ليست مرضاً، بل إنها جانب من نمط الإنسان الجديد؛ ولهذا فهو لا يوافق على مصطلح «وباء السمنة» الشائع؛ إذ إنه لا يشكل على سبيل المثل الخطر الذي تشكله أخطار التغيرات المناخية في الأرض.
ويقول، إن «ازدياد السمنة قد تصادف مع الانحسار المدهش لأعداد الوفيات بأمراض الشرايين التاجية في القلب»، مضيفاً أن سبب ذلك غير معروف، ربما قد يكون ناجماً عن سرعة التدخل العلاجي والإقلاع عن التدخين.
وعموماً، فإن «الإنسان أكثر تكيفاً الآن مع السمنة من السابق»؛ إذ أصبح الرقم 60 سنة للعمر حالياً معياراً شائعاً مقابل الرقم 50 سنة في السابق، كما أن «وزن 80 كيلوغراماً الآن قد حل كمعيار محل الـ70 كيلوغراماً في السابق».
وبشكل ظريف يقول، إن الحديث عن السمنة هو عملية تمييز اجتماعي؛ فالرفاهية والغنى يرتبطان بالرشاقة، بينما ترتبط السمنة بالفقر، و«هكذا أصبح النبذ أو العزل الاجتماعي مرتبطاً بالسمنة؛ إذ يغدو الأغنياء أكثر غنى بينما يغدو الفقراء أكثر سمنة»!
ويشير الكاتب إلى أن محو الأمية وانتشار التعليم أديا إلى ازدياد تعاطف النمط الجديد مع الإنسان مع أقرانه.
وتعتبر المراهقة أيضاً إحدى خصائص النمط الجديد للإنسان؛ «فالأطفال يدخلون الآن طور المراهقة في أعمار أصغر بـ4 سنوات تقريباً عما مضى». وتشير الإحصاءات في السويد مثلاً إلى أن متوسط العمر لأول دورة شهرية للفتيات انخفض من 16.5 إلى 12.5 سنة من بين القرنين التاسع عشر والعشرين.
ويشير الكاتب إلى أن المجتمعات المعاصرة تلجأ إلى وضع كبار السن في «خانة المرضى» بدلاً من أن تتقبل حقيقة أن العمر المتقدم –بكل صعوباته - هو جانب من جوانب النمط الجديد من الإنسان. ويقول منتقداً، إن نطاق «المعايير الاعتيادية» التي تتعلق بالوزن أو ضغط الدم وغيرهما يتم تحديدها لنطاق من البالغين الشباب... ولذا؛ فإن أي تغير في تلك المعايير، خصوصاً لدى كبار السن يعتبر غير صحي... وأن علينا أن نجبر على اعتبار حبوب الدواء جزءاً من الحياة مع تقدم العمر».
The Species That Changed itself
How Prosperity reshaped Humanity
By Edwin gale