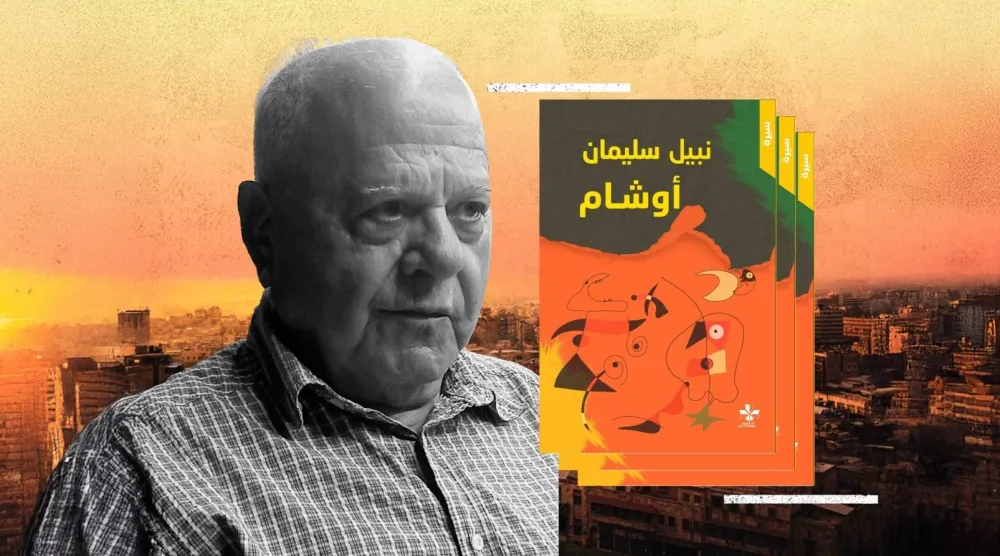عن دار «إضاءات» بالقاهرة، صدرت طبعة جديدة من كتاب «الدراما» للكاتب المسرحي والناقد الإنجليزي أشلي ديوكس، والذي يعد أحد المراجع التأسيسية في فن المسرح منذ أن صدرت الطبعة الأولى منه عام 1927.
ويتناول المؤلف في كتابه الذي ترجمه محمد خيري، وراجعه الدكتور عبد الحميد يونس، العديد من عناصر فن الدراما، مثل أنواع هذا الفن وأهمية الإخراج والتمثيل، لكنه يتوقف بشكل خاص عند فكرة الجمهور وكيفية التعامل معه، بخاصة بعد أن أصبحت هذه الفكرة «لغزاً» مع تطور فنون المسرح وأشكاله التجريبية لدى الكثير من صنّاعه، وأصبح السؤال اللافت: هل ينبغي الخضوع لها أو تجاهلها أو هناك حل وسط؟
ويشير المؤلف إلى أن أصحاب المسارح اعتادوا أن يطلقوا على «المشاهدين» كلمة «الجمهور»، وهي تسمية تعبر عن مدى الأثر العام للدراما، ولكن تلك التسمية تدفعهم إلى التسرع في الوهم بأنه لا يوجد سوى «جمهور» واحد فقط؛ وعلى ذلك يقال عن مسرحيةٍ ما إنها «ما فوق مستوى الجمهور»، وعن أخرى إنها من النوع الذي يرغب فيه الجمهور. ويلفت الكتاب إلى أنه في كل عام تُنفق أموال طائلة في محاولة إلى إشباع حاجة جمهور «وهمي»، في حين أن هناك أنماطاً مختلفة من جمهور المسرح، ولكل منها ذوقه الخاص، كذلك يوجد دائماً «جمهور مستتر» مثل الجمهور المثقف الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشر، وكان قد كف عن ارتياد المسرح وما لبث أن أقبل عليه مع تألق الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن في الدراما الاجتماعية.
ومن ثم، يوضح الكتاب أن لكل مسرحية جيدة جمهورها الخاص سواء أكانت مسرحية لشكسبير أم كوميديا موسيقية، ويختار صاحب المسرح الذكي جمهوره من الجماهير العديدة التي يمكن أن يجتذبها، وهو لا يسعى إلى تثقيف هذا الجمهور الذي يتألف من أفراد من عامة الشعب، كما يضم أناساً مثقفين مثله، لكنه يعمل على الملاءمة بين ذوقه وذوقهم. وقد يفقد في سبيل ذلك بعض المال، لكنه لن يفقد أبداً ما يفقده زميله الذي يمضي حياته يتلمس عناصر النجاح الشعبي فقط؛ لأن الجمهور بالنسبة له ليس حقيقة من الحقائق، ولكنه وهْم من الأوهام التي تسيطر عليها.
في مقابل كل شخص يقرأ كتاباً ناجحاً تجد عشرة أشخاص يشاهدون مسرحية ناجحة
ويذكر الكتاب في هذا الصدد أن جمهور المسرح متغير من الناحية الكمية باستمرار بصرف النظر عن قوة الدراما أو روعتها، فالمسارح تتمتع أحياناً بنجاح غامض كما تعاني فترات غير مفهومة من الركود، وهي تتأثر بالتغيرات المفاجئة حتى التقلبات الجوية الطارئة. ولم توقظ الحرب الأوروبية ملكة الخيال والمشاعر عند رواد المسرح، ولكنها هبطت بمعظم المسارح في البلدان المتحاربة إلى أدنى مستوى من الذوق وصلت إليه منذ أجيال. وقد يتعرض عالم الملاهي لكارثة بسبب أزمة سياسية أو إضراب يقوم به عمال النقل أو فترة حداد قومي، ولا يدهشنا إذا رأينا صاحب المسرح يميل إلى تتبع أوهام الجمهور في شيء من الرهبة الأسطورية. إنه يرى في كل ليلة عدداً من الناس المجهولين له الذين لا نعرف أبداً مَن منهم حضر المسرحية بناء على الإعجاب بممثل معين من ممثلي العرض، ومَن منهم اجتذبته إلى المسرح فنون الدعاية والإعلان، أو مَن منهم استجاب لإعلانات الصحف.
وفي الختام يركز الكتاب على سيكولوجية جمهور المسرح، ويذكر أنهم يبدون كمخلوقات ذات أمزجة وأهواء غريبة ولا يمكن تعليل ما يقومون به من تصفيق، قد يضحكون ذات مساء من أعماق قلوبهم على عبارة يسمعونها في الليلة التالية في صمت ووجوم. وهكذا تنتابهم حالات من الحماس ومن الفتور، ومن المرح والعبوس، ومن الرقة والخشونة. ويشعر الممثلون بهذا التغيير في مزاج الجمهور قبل مرور عشر دقائق من الفصل الأول، ثم ينطلقون في التعليق عليه خلال فترات ما بين الفصول. ولا شك في أن لغز الجمهور يكمن إلى حدٍّ ما في حجمه، ففي مقابل كل شخص يقرأ كتاباً ناجحاً تجد عشرة أشخاص يشاهدون مسرحية ناجحة. يدخل المسرح عدد ضخم من المشاهدين وهويتهم غير معروفة، ثم يغادرون أبوابه دون أن يتركوا وراءهم أثراً. هذا الجمهور لا يعرف بصفة عامة شيئاً عن المؤلفين، وهو يعرف القليل عن الممثلين، ويجلس ساعتين أو ثلاثاً منهمكاً في مشاهدة ما يُعرض أمامه من تمثيل، ثم لا يلبث أن يختفي في ليل من النسيان.