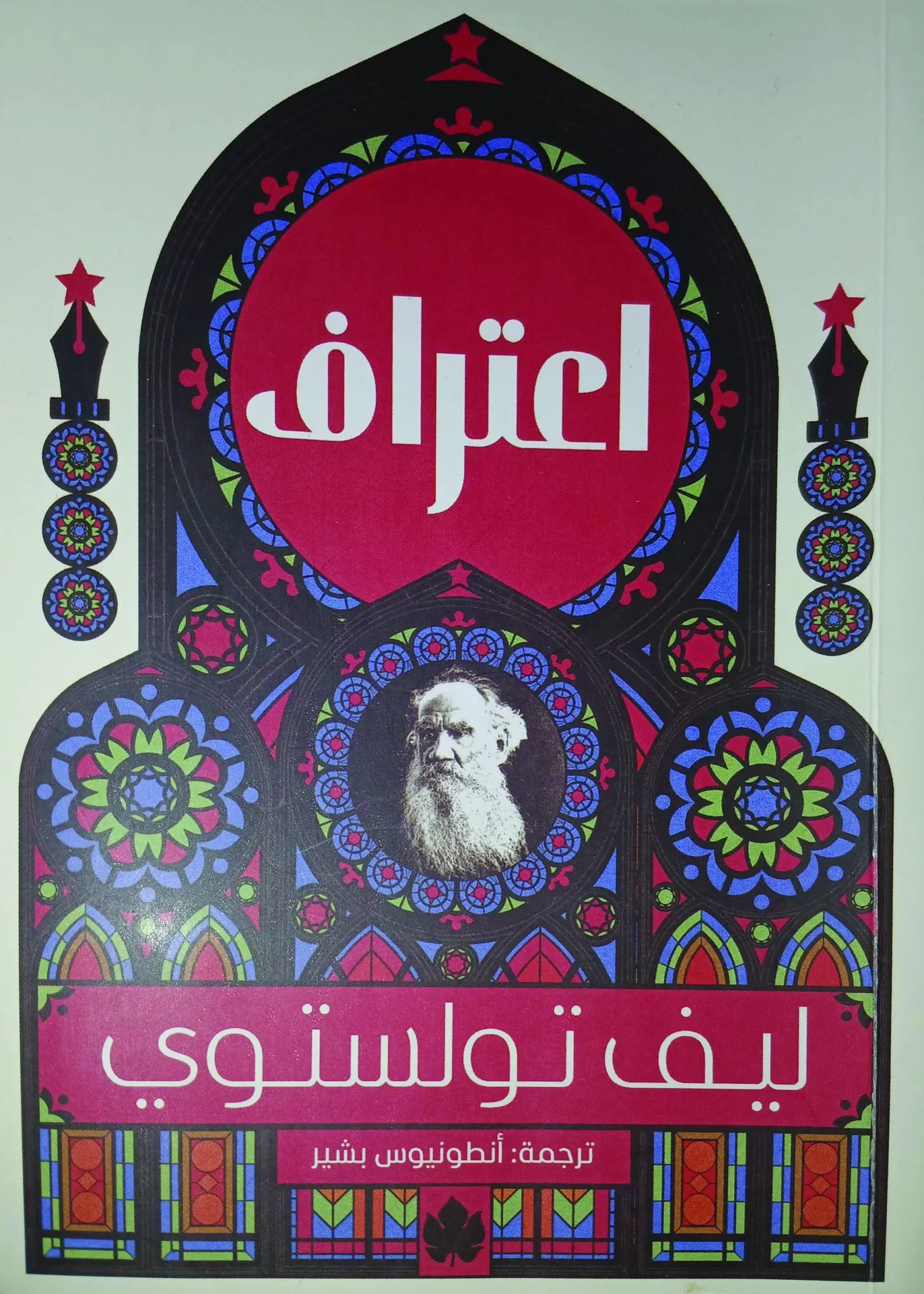ربما يكون مناسباً للمؤرخين المعنيين بتاريخ الفكر المعاصر أن يشرعوا من يومهم في صياغة مراجعات حول تجربة جدّ ثريّة مسرحها الأساسي بريطانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان لها الأثر البالغ في تطوير المعارف الإنسانيّة عبر فروع العلوم الاجتماعيّة، وإنقاذ الفكر الفلسفي المادي الذي أطلقته الماركسيّة قبل قرنين وكاد يتحجّر قوالب ثلجيّة في المرحلة الستالينيّة من تاريخ اليسار.
تلك التجربة؛ التي يتفق الباحثون هذي الأيّام على وسمها بمدرسة «الماركسيّة الثقافيّة» البريطانيّة، وتضم أسماء ساطعة مثل ستيوارت هول وريتشارد هوغارت وريموند ويليامز... وغيرهم، تمثل بديناميكيتها العمليّة ومعطياتها النقديّة وإنتاجاتها الفكريّة نداً موازياً بعمقه للتيار الثقافي الآخر بالغ التأثير في الغرب؛ وأعني به «مدرسة فرنكفورت»؛ إن لم يتفوّق عليه بالفعل. لقد استفادت الأخيرة من حقيقة أنها سبقت اليساريين البريطانيين إلى بناء منهجيّة نقديّة صارمة بعقدين على الأقلّ، كما كان انتقال عتاولة «الفرنكفورتيّة» من أمثال ثيودور أدورنو، وماكس هوركيمر، وهيربرت ماركوزه، إلى الولايات المتحدة بداية الأربعينات قد منحها مساحة معرفيّة وقدرة انتشار هائلتين بالاستفادة جانبياً من ماكينة الثقافة الأميركيّة الجبارة، مقارنة برفاقهم البريطانيين الذين عاشوا تجربتهم بين دمارين: الحرب العالميّة الثانية، والثاتشريّة النيوليبراليّة في وقت كانت فيه الإمبراطوريّة البريطانيّة العجوز قد فقدت أسنانها، وتحوّلت إلى مجرد جزيرة رماديّة باهتة تجاه الغرب من البرّ الأوروبيّ.
لكن التجربتين؛ كلتيهما، خرجتا اليوم من سياق القيادة الثقافيّة المباشرة، وتحطمت طاقتهما الدافعة على صخرة أزمة اليسار الوجوديّة بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتيّ، وقد مرّ ما يكفي من الوقت لإعادة قراءة المرحلة كلّها بتجرد بعيداً عن الانحيازات اللحظيّة والانفعالات المباشرة بالأحداث، لا سيما فيما يتعلق بالبريطانية منها التي لم تحظ حتى راهن الوقت بتأريخ تستحقه.
أهميّة المهمّة هذه ليست متأتية من القيمة الرّفيعة لنتاج المدرستين الألمانيّة والبريطانيّة كلتيهما الفكري فحسب؛ والذي رغم كل شيء فإنه ما زال أفضل الأدوات المعرفيّة المتوفرة لنقد تجربة العيش في المجتمعات المعاصرة، بل وأيضاً لأن المنهج الرائد الذي سلكتاه بالتوازي انطلاقاً من الفكر الفلسفي المادي يمثل ثورة مفاهيم كليّة (برادايم) أكاديميّة شاملة في تحليلها لمنتجات الميديا والإعلام ونتاجات المجموعات الحضريّة وتمثلات ثقافات الشباب والإنتاج الأدبي والفنيّ، والهياكل الثقافيّة التي أنشئت حولها مفاهيم مثل العرق والجندر، والثقافة الشعبيّة، كما طبيعة الآيديولوجيا، وهو تحليلٌ كُسرت فيه الحدود بين التخصصات المعرفيّة الضيقة كالفلسفة والتاريخ والاجتماع والأنثروبولوجيا والسّياسة والفنون واللغة؛ بحيث أمكن الحديث لأوّل مرّة عن ممارسة معرفيّة عريضة عابرة لأبواب العلم في رؤية الأشياء والأحداث والعالم. وفوق ذلك كلّه فقد أطاحت - المدرستان بالتوازي دائماً - بذلك التفريق الملفّق بين ثقافة عليا رفيعة وأخرى شعبية وضيعة، وجعلتا منهما صعيداً ثقافياً واحداً وإن ضم تمثّلات متفاوتة.
نشأ تيار «الماركسيّة الثقافيّة» البريطاني بوصفه محاولة من مثقفين وأكاديميين - جاء كثيرون منهم من خارج النّخب الإنجليزيّة التقليديّة - لفهم التحوّلات المفصليّة التي كانت تعيشها بلادهم بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية في الثقافة والفكر والمجتمع بدت الأدوات الماركسيّة التقليديّة - التي هيمن عليها الاتحاد السوفياتي والشيوعيون الكلاسيكيّون وتمحورت حول العوامل الاقتصادية والسياسيّة - غير كافية لفهمها، ناهيك بنقدها. لقد تأكد حينها أن الطبقات العاملة في الغرب لن تقوم بثورات على نسق الثورة الروسيّة عام 1917، فكان مهماً للجميع البحث عن صيغ أخرى مختلفة من الصّراع الاجتماعي وبناء أدوات مواجهة ممكنة في ظل قواعد اللّعب داخل ديمقراطيّات الرأسماليّة المتأخّرة.
مدرسة فرنكفورت (انطلقت من معهد العلوم الاجتماعيّة بجامعة غوته في فرنكفورت بألمانيا؛ ولذا جاءت التسمية) التي سبقت التيار البريطاني بعقدين تقريباً كانت نشأت في ظل ظروف مماثلة عاشتها ألمانيا إثر الحرب العالميّة الأولى، وشهدت رأي العين فشل الثورات اليساريّة الأوروبيّة جميعها باستثناء نموذج «الحزب الطليعي» في روسيا عام 1917، كما عاصرت صعود الفاشيات بوصفها أداة ثورة مضادة من قبل تحالف البرجوازيات - الأرستقراطيات في غير ما بلد. وقد قدّمت فرنكفورت إسهامات لافتة ثمنت بمجملها دور العوامل الثقافيّة والآيديولوجية في الحياة الاجتماعية المعاصرة، وبحثت هناك تحديداً عن الأسباب التي تفسّر خنوع الطبقات المحكومة.
ومع أن المفكّر الإيطالي أنطونيو غرامشي كان سبق الجميع في تثوير الفكر الماركسي وتوظيفه أداةً معرفيّة شاملة الطابع لتحليل المنهجيّات العمليّة التي تلجأ إليها الطبقات الحاكمة في فرض هيمنتها على المجتمع، إلا إن الهزيمة القاسية التي لحقت باليسار الإيطالي ما بعد الحرب العالميّة الأولى، وإبعاد غرامشي إلى السجن وقتله البطيء هناك من قبل السّلطات الفاشستيّة، وعدم ترجمة أعماله أو نشرها في العالم الغربي حتى بداية السّبعينات من القرن الماضي... تسبب ذلك كله في تأخر اطلاع منسوبي المدرستين لعقود عدة على التجربة الإيطاليّة المثيرة للاهتمام.
ما جمع بين المدارس الفكريّة الثلاث هذه كان رفضها الحتميّة الاقتصادية التي بدا أن ماركسيّة تلك الأيّام بقيت مصرّة على أولويتها في تفسير سلوك المجتمعات. ومع ذلك، فإن اختلافات منهجية كثيرة جعلتها أيضاً تتمايز؛ بل وتتباعد أحياناً. فبينما كان توجُّه «فرنكفورت» فهم نتاجات الثقافة المعاصرة بوصفها أدوات سيطرة تستهدف تحويل الكتل الشعبيّة إلى مستهلكين سلبيين للأفكار، وتجعلهم تدريجياً غير قادرين على نقد ما يعرض عليهم أو إدراك تأثيره على سلوكهم المجتمعي أو فهم علاقتهم بالعالم، فإن «الماركسيّة الثقافيّة» البريطانيّة، ورغم اعترافها بسيطرة الطبقات الحاكمة على معظم الإنتاج الثقافي، كان ديدنها أن ترى الأمور من وجهة نظر متلقي ذلك الإنتاج، وتدلّل على أن ذلك المتلقي بإمكانه أيضاً أن يستهلك تلك المادة بصفة نقديّة وأن يستجيب لها بطرق مبدعة، لتتحول بذلك الثقافة - في عُرفها - ساحة مواجهة بين الجانبين لا يمكن حسمها بالمطلق لصالح أحدهما. وحده غرامشي، مع ذلك، كان قدّم خريطة دقيقة ومتكاملة لآلية عمل منتجي الثقافة في المجتمعات المعاصرة، والتي يمكن للطبقات المحكومة الاستفادة منها في بناء أساليب المواجهة. وللحقيقة فإن الأميركيين الذين اطلعوا على التجارب الثلاث انقسموا بينها؛ وإن كان غرامشي تحديداً حاز إعجاب مثقفي الإمبراطوريّة وأجهزتها الذين استعاروا بعضاً من أفكاره في بناء برامجهم لاستهداف مجتمعات تسعى الإمبراطوريّة لمد مظلّتها فوقها لا سيّما خلال الحرب الباردة وما تلاها من ثورات ملونة.
أيضاً فإن المدارس الثلاث تباينت كثيراً في الصّيغة التي تبنتها لناحية العلاقة بين النظريّة والممارسة. «فرنكفورت» رفضت وجود علاقة مباشرة بينهما، وعدّت الفكر النقدي عملاً ثورياً متكاملاً ليس له أن يرتبط بالضرورة بنضالات الطبقات العاملة. ومع أنهم بمجملهم كانوا يقبلون فكرة لينين بأن الطبقات العاملة ليس بمقدورها إنجاز شيء دون حزب ثوريّ، إلا إنهم رفضوا بشدّة التجربة البلشفيّة بوصفها تؤدي إلى ديكتاتورية بيروقراطيّة تخنق الأصوات المعارضة. وقد تجنّب أغلبهم العلاقات المباشرة بالأحزاب الرّاديكاليّة. في المقابل، لم تجد «الماركسيّة الثقافيّة» بطبعتها البريطانيّة - رغم احتكاكات سلبيّة الطابع أحياناً مع الطبقة العاملة أو نقاباتها على الأقل - أي تبرير للتعالي على الجمهور، بل وعدّت دائماً أن مهمتها في المحصلة توعيته وتنويره، ولذلك فإنها احتفظت دائماً بمسحة شعبويّة، وكثيراً ما التقى رموزها بمجموعات من الطبقة العاملة في إطار أنشطة تثقيفيّة كانت تنظّم باستمرار من قبل جمعيات العمّال. أما «الغرامشيّة» بوصفها فكراً؛ فقد كانت نتاج قراءة واعية بعين مثقفة لتجربة مباشرة مديدة في قيادة النشاط العمالي على الأرض، وتحليل للخبرات اليوميّة من المصانع والمتاريس والشوارع، في صحف ومنشورات تقرأها أساساً الطبقة العاملة.
لم تكن تلك التجارب وحدها صيغ انتقال اليسار في الغرب من الماركسيّة الكلاسيكيّة إلى آفاق أرحب من خلال التدقيق بمسائل الثقافة واعتبارها الأساس في تمتين الهيمنة التي تمنحها العوامل الاقتصادية. فالفرنسيون مثلاً أنتجوا بدورهم تياراً من النقاد المثقفين الذين قدموا فلسفات جريئة انطلق معظمها بشكل أو بآخر من ماركس، لكنها انتقلت إلى فضاءات أبعد. لقد قرأ الفرنسيّون غرامشي قبل غيرهم من الأوروبيين، وتأثروا به بشكل أو بآخر، لكن أعمالهم بقيت على العموم متمحورة حول إنجازات مفكرين نجوم أفراد أمثال رولاند وفوكو وألتوسير، دون أن تتحول يوماً إلى مدرسة متكاملة كما عند الألمان والإنجليز.
إنها مرحلة ثريّة تستحق التسجيل.
مدارس فكرية غربية ثارت على الحتمية الاقتصادية
مرحلة ثرية تستحق القراءة بعيداً عن الانفعالات المباشرة بالأحداث

لويس ألتوسير

مدارس فكرية غربية ثارت على الحتمية الاقتصادية

لويس ألتوسير
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة