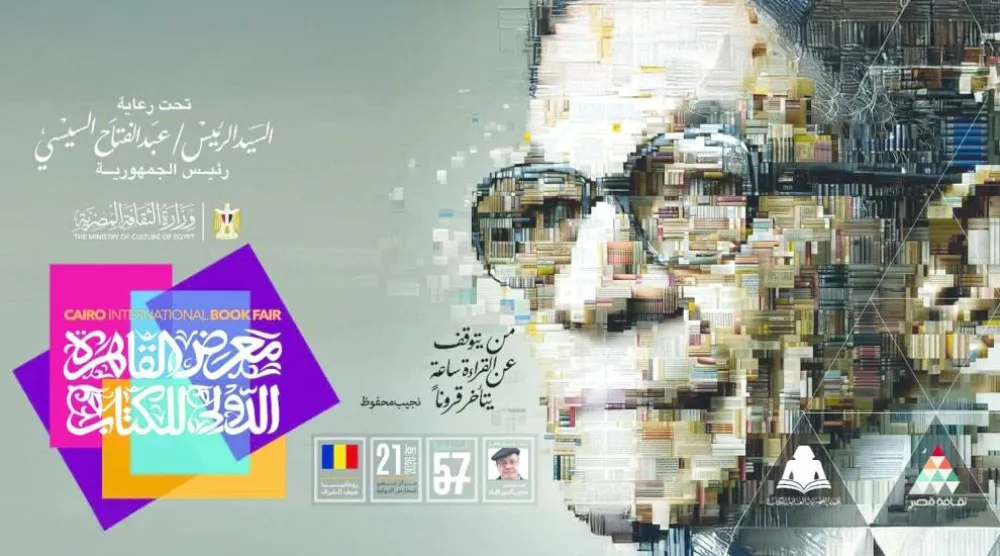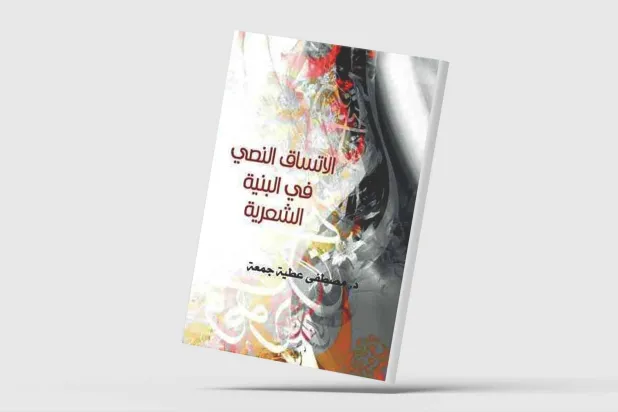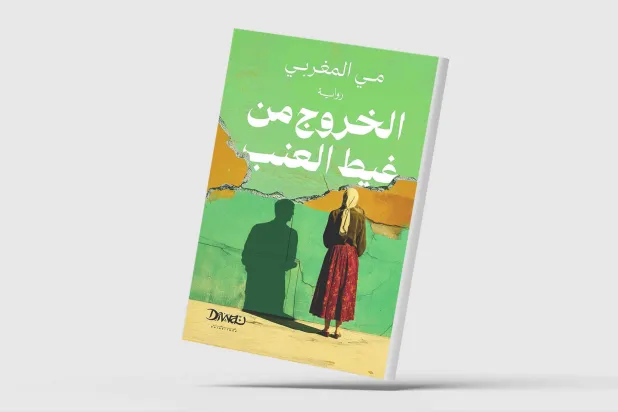كان كتاب محمّد بن إسحاق النَّديم الوراق (تـ: 380هـ) «الفهرست» معجماً لأسماء الكُتب أكثر مِنه للرِّجال؛ وهو مِن الأعمال المبكرة في هذا الشّأن، ثم أتت مِن بعده الفهارس. تجد في هذا المعجم مئات الكتب المفقودة، التي لا أثر لها حتّى يومنا هذا، لكن العديد مِن هذه المفقودات، التي ذكرها النّديم، ثم ياقوت الحموي (تـ: 626هـ) في «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» (معجم الأدباء)، ظهرت نصوص في كتب اطلع مؤلفوها عليها واقتبسوا منها، ومَن جمع هذه الاقتباسات وأظهرها في كتاب مثل جهود مصطفى جواد (تـ: 1969) وجمعه للضائع مِن «معجم الأدباء»، جامعاً مادة كتابه ممن اعترفوا بالأخذ مِن الحموي، مطلعاً على معجمه قبل ضياع صفحات أو فصول منه. هذا يجعلنا نقرُّ للمؤلفين الأقدمين بأنهم أمناء في ذِكر مصادرهم، وليس مثلما يُشاع، ويؤخذ عذر للسرقة والاعتداء على جهود الآخرين.
مِن أسباب الضّياع، مِن غير عوادي الزّمن، أو حرق المكتبات، أو أفعال الغزاة، أو منعها مِن التداول فيقضي عليها الإهمال، التلخيصات التي يقوم بها بعضهم، فيهمل الأصل لطوله ويظل المختصر متداولاً، مثل كتاب «مختصر كتاب البلدان»، والكتاب الأصل عنوانه «أخبار البلدان» لابن الفقيه (القرن الثّالث الهجريّ)، الذي ضاع ثم عُثر عليه بعد الاختصار، فوجد أن المُختصر أهمل بلداناً عديدة مِن الأصل، فورد في خاتمة الكتاب «تم الاختصار» (طبعة ليدن 1302هـ)، ثم جاء مَن نشر النَّاقص (السّواد، والأهواز، والتُّرك) محققاً، بجهود المحققين: ضيف الله الزّهراني ومريزن عسري، وصدر عن جامعة أم القرى بمكة (1997).

حصل الإنقاذ مِن أعداء ومِن أصحاب، فلولا ردود المعتزلي أبي الحُسين الخياط (تـ: 290هـ) على أبي الحُسين أحمد بن يحيى الرّاونديّ (تـ: 245هـ)، ما وصلنا كتابه «فضيحة المعتزلة»، الذي ردَّ به على كتاب عمرو بن بحر الجاحظ (تـ: 255هـ) «فضيلة المعتزلة»، فكان كتاب «الانتصار والرّد على الملحد بن الرّاونديّ»، والأخير كان معتزلياً ثم عدل عن الاعتزال، فصار عدواً. لا وجود لأصل ولا منسوخ لـ«فضيحة المعتزلة» لكنه وصل كاملاً بفضل الرّد عليه، ولو عَلم الخياط شيخ المعتزلة في زمانه أنَّ رده سيحيي كتاب عدوه، ما ردّ عليه، وفي العصر الحديث قام الباحث عبد الأمير الأعسم (تـ: 2019) بجمع نصوص الرّاونديّ، التي رد عليها الخياط، وأصدرها بعنوانها: «فضيحة المعتزلة»، لكن جاءت بعض نصوص الفضيحة متداخلة مع نصوص الرَّدِّ، فظهر كأن الراوندي يرد على نفسه، ويرميها بأقذع النُّعوت.
كذلك لولا رد ابن الرّاوندي ما شمر شيخ المعتزلة الخياط عن ذراعه؛ وترك لنّا تاريخاً لأفكار ومقالات المعتزلة، وكان دفاعه عن الجاحظ، الذي يشير إليه بشيخنا، وبالفعل كان الجاحظ أحد شيوخ الاعتزال، مع كل مَن ردَّ عليهم الرَّاوندي. كذلك كتاب «فضيحة المعتزلة» أرخ لمقالات مَن عاصرهم مِن المعتزلة، وكان هو مِن داخلهم. إنها أسباب ومسببات، فكمْ مِن كتابٍ صار سبباً لتأليف ضده، وبذلك تنتعش الأفكار، فلا نعلم أن للجاحظ كتاباً في «حيل اللُّصوص» لولا مَن عيره به قائلاً: «وأما كتبه المزخرفة فأصناف منها حيل اللُّصوص، وقد عَلم بها الفسقة وجوه السَّرقة» (البغداديّ، الفرق بين الفِرقِ)، ولولا ما استشهد به الآخرون فيما كتبوا عن اللُّصُوص.
إذا كان الخياط أنقذ كتاب «فضيحة المعتزلة» لخصمه اللدود أبي الحسين الرّاونديّ، فإن محباً أنقذ كتاب «الأخبار» للجاحظ، الذي ما زال مِن المفقودات، ولم يجمعه أحد، كي يصدر مستقلاً؛ فنشوان الحميريّ (تـ: 573هـ)، وهو يُعد مِن معتزلة اليمن، وهم بالأصل الزّيدية، مِن معتزلة بغداد، أنقذ جزءاً مِن كتاب الجاحظ المفقود «الأخبار»، ذكره أبو الحُسين الخياط بعنوان «تصحيح مجيء الأخبار».
شغل كتاب «الأخبار» مِن كتاب نشوان الحميريّ «الحور العين» (دار أزال 1985) تسع عشرة صفحة (270 - 289)، نقدرها بنحو أربعة آلاف كلمة، ولا نظن أن الكتاب كامل، لكن أهميته لنشوان الحميريّ كمعتزلي هو ما يُعد بمثابة الجرح والتّعديل في الحديث؛ فيما قاله شيخ المعتزلة وفيلسوفهم إبراهيم بن سيار النَّظام (تـ: نحو 230هـ)، وهو أستاذ الجاحظ، فعنوان «الأخبار» المقصود به روايات الحديث، التي يراها النّظام متناقضة، ويتهم الرواة في هذا التّناقض.
بطبيعة الحال، لم يهتم أصحاب السنن والصّحاح، ولا أصحاب الجرح والتّعديل بمثل هذا الكتاب، لِما بين المعتزلة وأهل الحديث مِن خلاف كبير؛ يصعّب اعتراف بعضهم ببعض. بعد نشوان الحميريّ، وربّما عنه مباشرة، لا عن كتاب «الأخبار» نفسه، نقل النصّ إمام زيديّ ومعتزلي، متأخر عن الحميري بنحو ثلاثة قرون، مِن اليمن أيضاً، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى (تـ: 840هـ)، في كتابه «المُنية والأمل في شرح الملل والنِّحل» (ص 46- 59). كانت مجلة «لغة العرب» البغداديّة قد اهتمت بكتاب «الأخبار» (1931)، ونشرت النّص نقلاً عن «المُنية والأمل» (المجلة التاسع 1931).
ورد في مقدمة النّص: «قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب (الأخبار): بعد، فإن الناس يحضون الدين من فاحش الخطأ، وقبيح المقال، بما لا يحضون به سواه من جميع العلوم والآراء والآداب، والصناعات؛ ألا ترى أن الفلاح والصائغ والنَّجار، والمهندس، والمصور، والكاتب والحاسب، من كل أمة، لا تجد بينهم من التفاوت في الفهم والعقل والصناعة، ولا من فاحشة الخطأ وإفراط النقص، مثل الذي تجد في أديانهم، وفي عقولهم، عند اختيار الأديان؛ والدَّليل على ما وصفت لك: أنَّ الأمم التي عليها المعتمد، في العقل، والبيان، والرَّأي، والأدب، والاختلاف في الصِّناعات، من ولد سام خاصة: العرب والهند والرُّوم والفرس، ومتى نقلتهم من علم الدِّين، حسبت عقولهم مجتبلة وفطرهم مسترقة» (الحميريّ، الحور العين).
يميز الجاحظ في كتابه بين الأُمم، وكلُّ أمة بما تختص، أو ما تحسنه، وعدَّ العرب مخصوصة بالبيان واللُّغة «ليس مثلها في السِّعة لغةً، وقيافة الأثر مع قيافة البشر... وللعرب الشّعر الذي لم يشاركهم في أحد مِن العجم». ثم يميزها عن العجم قائلاً: «وقد سمعتُ للعجم كلاماً حسناً، وخطباً طوالاً، يسمونها أشعاراً، فأمَّا أن يكون لهم شعرٌ على أعاريض معلومة، وأوزان معروفة، إذا نقص منها حرفٌ أو زاد حرفٌ، أو ترك ساكن، أو سكن متحرك، كسره وغيره، فليس يوجد إلا للعرب» (نفسه). ثم يُعدد خصائص بقية الأُمم.
لا وجود لأصل ولا منسوخ لكتاب «فضيحة المعتزلة» لكنه وصل كاملاً بفضل الرّد عليه، ولو عَلم الخياط شيخ المعتزلة في زمانه أنَّ رده سيحيي كتاب عدوه ما ردّ عليه
غير أنّ الأهم في الكتاب هو توضح التقليد في العقائد، الدّينية والمذهبيّة، أنها لا تؤخذ بالنّظر إنما بالتقليد، قال: «وقد تجد الأخوين ينظران في الشَّيء الواحد فيختلفان في النَّظر، ولربما نظر النَّاظر فيصير له في كلِّ عامٍ قول، ولربما كان ذلك في كل شهر؛ فصح أنَّ دين النَّاس بالتقليد لا بالنَّظر، وليس التَّقليد إلى الحقِّ بأسرع منه إلى الباطل» (نفسه).
كذلك جاء في أهمية الكتاب نقد الأخبار في رواية الحديث؛ وهذا يفيد بالحث على مراجعة الرّواية، فعليها توضع قوانين العقوبات، والعبادات والمعاملات، وكلُّها تهم النّاس وسياسات القضاء، فتراه يقول: «كيف يجيز السَّامع صدق المخبر، إذا كان لا يضطره خبره، ولم يكن معه علم يدل على صدق غيبه؛ ولا شاهد قياس يصدقه، وكون الكذب غير مستحيل منه مع كثرة العلل؛ التي يكذب النَّاس لها، ودقة حيلهم فيها، ولو كان الصَّادق عند النَّاس لا يكذب، والأمين لا يخون، والثِّقة لا ينسى، والوفي لا يغدر، لطابت المعيشة، ولسلموا من سوء العاقبة» (نفسه).
ليس كتابا «فضيحة المعتزلة»، و«الأخبار»، الفريدين اللذين أنقذتهما مِن الضِّياع كُتب، للرد في الكتاب الأول، أو الاستشهاد في الكتاب الثّاني، بل كتبٌ كثيرةٌ، فُقدت أصولها وضاع ما نُسخ منها، لكن يمكن إحياؤها باستخراج نصوصها مِن بطون الكتب، بهدى ما قام به المحقق المعروف إحسان عباس (تـ: 1993) في كتابه «شذرات مِن كُتب مفقودة في التَّاريخ» (1988)، جمع فيه نصوصاً لثلاثين كتاباً مفقوداً، على شاكلة كتاب «الأخبار» للجاحظ، فالرَّجل كان محققاً، والتحقيق عادةً يحتاج إلى مطالعة وتصفح مئات الكتب المصادر، فوجد ما وجده من الاستشهادات مِن كتب مفقودة، وقال عما دونه يسيراً، قياساً بالعدد الهائل مِن الضَّائعات.