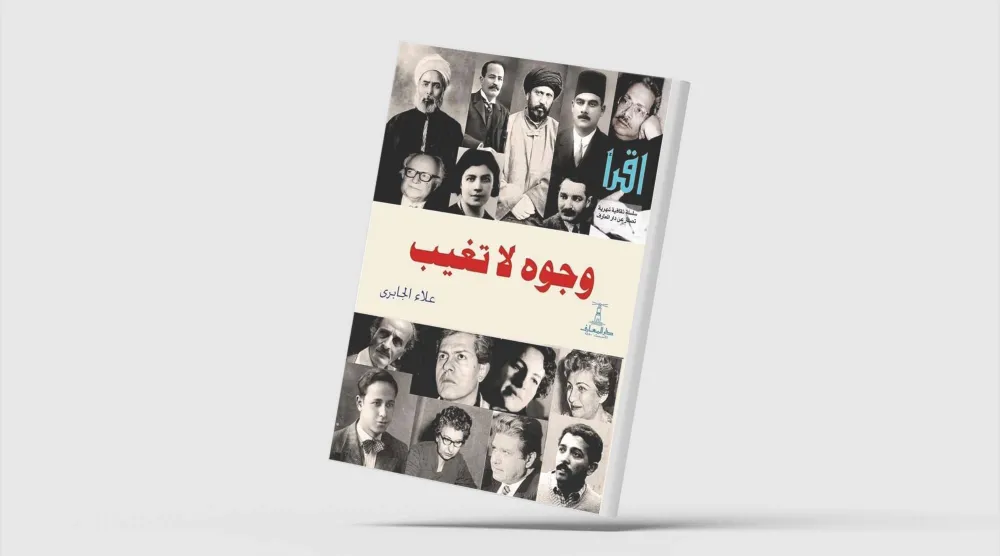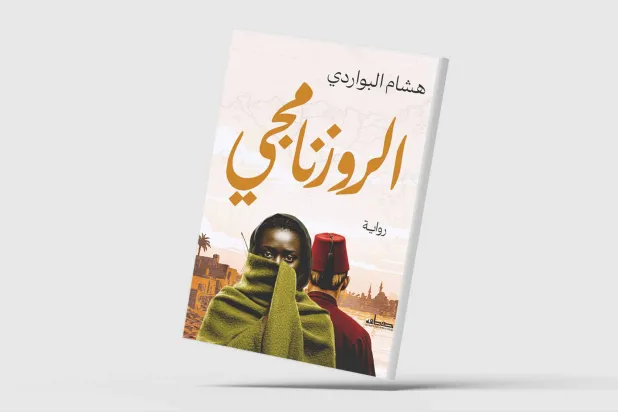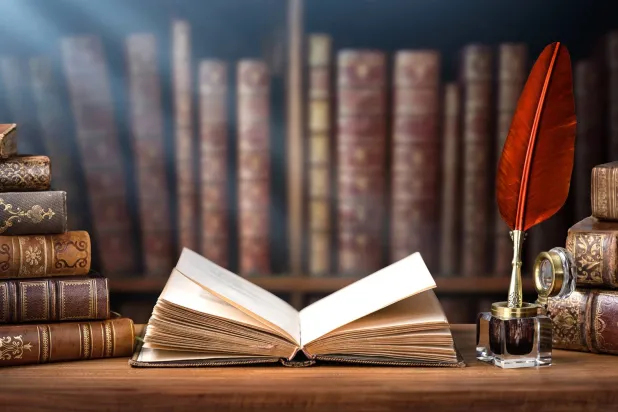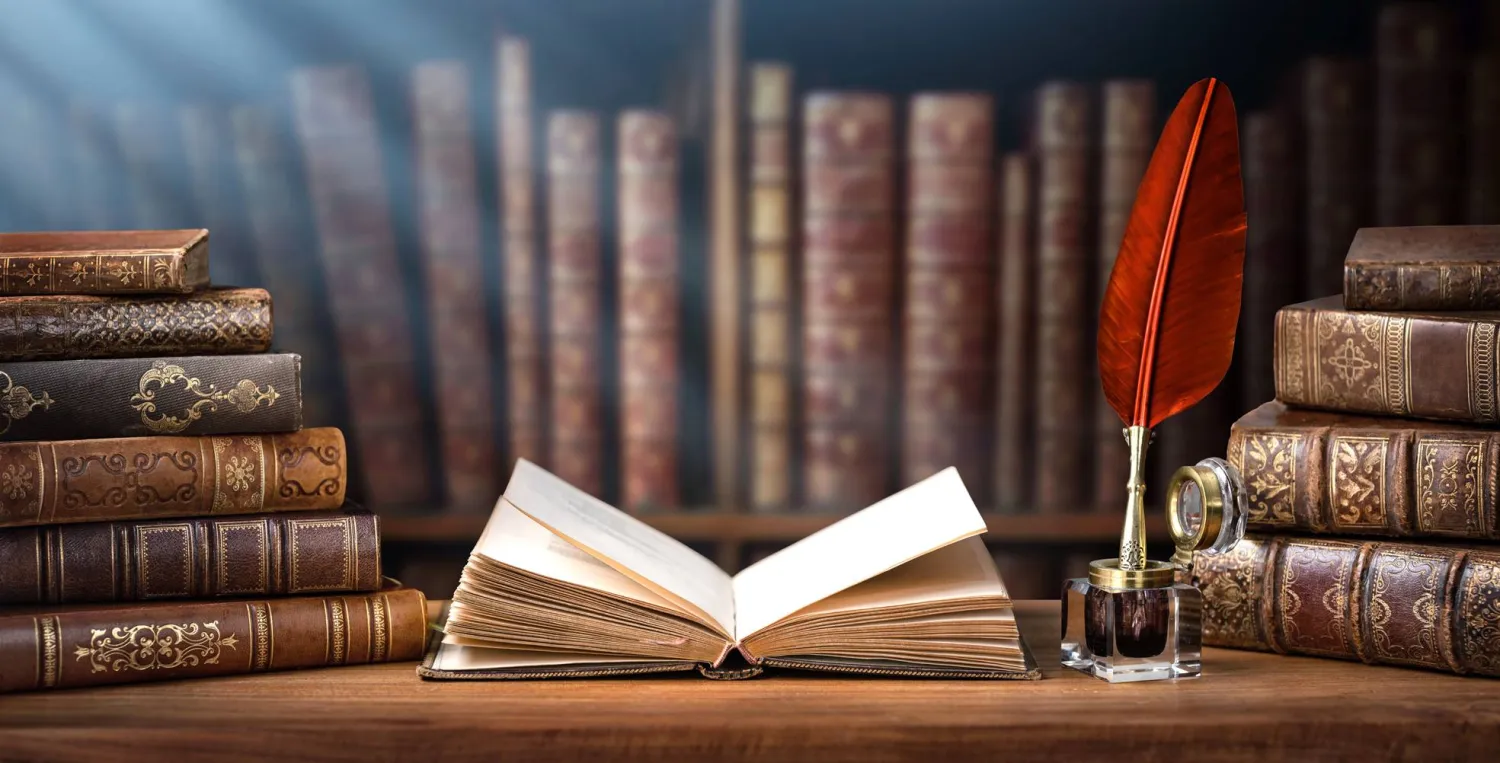يبرهن الدكتور سمير الخليل، أستاذ النقد الأدبي الحديث في الجامعة المستنصرية ببغداد، في كتابه النقدي الجديد «روايات ما بعد الكولونيالية - اليانكي: التحولات الفنية والفكرية والثقافية» الصادر عام 2023، على أنه ناقد متمرس وجاد، ويدرك شروط الممارسة النقدية الحداثية. فقد عرفنا عنه في سلسلة مؤلفاته النقدية حرصه على الجمع بين النقد النظري والتطبيقي في اشتغالاته النقدية، وتركيزه بشكل خاص على المظاهر السوسيو - ثقافية، التي تحملها النصوص الروائية، ولذا فقد رأيناه خلال السنوات الأخيرة ينحاز إلى مفهوم «النقد الثقافي»، وهو مدرسة نقدية أسس لها في نقدنا العربي الدكتور عبد الله الغذامي من خلال كتبه وأطروحاته المختلفة. وذهب الدكتور سمير الخليل لاحقاً أبعد من ذلك عندما أقدم على مغامرة كبيرة تتمثل في إعداد معجم خاص بـ«النقد الثقافي» هو «دليل مصطلحات النقد الثقافي» عام 2016، كما قدم أطروحة مهمة تتعلق بمخرجات النقد الثقافي في كتابه «الرواية سرداً ثقافياً» عام 2020، وسبق له أن نشر مجموعة كبيرة من الدراسات والكتب النقدية التي تتخذ من «النقد الثقافي» مرشداً لها؛ منها: «النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب» عام 2013، و«فضاءات النقد الثقافي» عام 2014، و«دراسات ثقافية: الجسد الأنثوي... الآخر... السرد الثقافي» عام 2018، و«الشعر والتمثلات الثقافية» عام 2021... وغيرها.
ينفي الكتاب الصورة المضللة التي حاول البعض إشاعتها باتهام المثقف العراقي بـ«السلبية تجاه هذا الاحتلال أو الترحيب به»
وقد عمد المؤلف إلى تطبيق مفاهيم «النقد ما بعد الكولونيالي» التي تسعى إلى فحص النصوص الأدبية والثقافية التي أنتجت في بلدان كانت واقعة في الماضي تحت هيمنة الكولونيالية وبشكل خاص ما تسمى «الامبراطورية»؛ إشارة إلى السيطرة البريطانية على كثير من بلدان العالم الثالث في آسيا وأفريقيا. لكنه في كتابه هذا عمد إلى فحص وقراءة النصوص الأدبية الحديثة التي كتبها روائيون عراقيون لمواجهة الاحتلال الأميركي (اليانكي) للعراق بعد عام 2003 حصراً.
ويحدد الناقد في «المقدمة» التي استهل بها كتابه النقدي هذا برنامجه النقدي بالقول:
«وهاجس قراءتنا هو رصد ديناميكية الرواية الآن في العراق وتمثيلها السردي لموضوعات نحسبها تجسيداً لمفاهيم ما بعد الكولونيالية الأميركية (اليانكية)، والكيفية التي ضمت استراتيجية جديدة... وتوظيف واعٍ من الروائيين، وبتقنيات يتحول فيها النص، عبر المتخيل السردي، إلى حقيقة إبداعية لا تحيل إلى بديل آخر غير الواقع الذي انبثقت منه وتفرعت عنه» (ص 6).
ونوه الناقد بأنه قصد بعنوانه الفرعي للكتاب: «التحولات الفنية والفكرية والثقافية» المنحى النقدي لدراسة أثر الاحتلال الأميركي العسكري في طبيعة السرد الروائي، وما أحدثه من تحولات في الرواية العراقية، وتأكيد أن «الكولونيالية اليانكية» قد أفرزت تأثيرات واضحة في الرواية على مختلف المستويات الفنية السردية والثقافية والاجتماعية.

ففي قراءته النقدية لرواية أحمد خلف «الذئاب على الأبواب» الصادرة عام 2018، يؤشر الناقد إلى كثير من العلامات السيميائية لمرحلة ما بعد الاحتلال وتشظي الواقع، وضياع الإنسان، المتمثلة في ظاهرة الجثث المجهولة والموت اليومي المجاني. ولذا؛ تكتسب الرواية سماتها الواقعية وتحولها إلى وثيقة تاريخية ومدوّنة لرصد الأحداث المفصلية والمنعطفات الكبيرة. ويتوقف الناقد أمام دلالة قرار البطل حمل السلاح لمواجهة العدو الذي يترصده، بوصفه يمثل لحظة التنوير الأخيرة، والشفرة المتوهجة في خاتمة الرواية.
ويشخص الناقد في رواية «سيدات زحل» للروائية لطفية الدليمي تتبعاً لآركيولوجيا الخراب وانكفاء الوقائع منذ عصور بعيدة وحتى عصر الاحتلال الأميركي الكابوسي، وفضلاً عن ذلك؛ نجحت الرواية في رصد يوميات الحرب والعنف، والقهر السياسي والاجتماعي، وممارسات قتل النساء، كما استطاعت المؤلفة عبر هذه المدوّنة السردية تقديم تاريخ للخراب، والاستبسال للخلاص منه.

ويستقصي الناقد مظاهر «النقد ما بعد الكولونيالي» في رواية «عمتي زهاوي» للروائي خضير فليح الزيدي، فيلاحظ أن النتاج الروائي في مرحلة ما بعد الاحتلال يكشف وبيسر عن هيمنة الخطاب الغرائبي وتجلياته العجائبية وأشكال الفانتازيا، ذلك أن الروائي في حقبة ما بعد الاحتلال لم يجد فضاءً للاشتباك مع الواقع الملتبس سوى التأطير اللامنطقي واللاواقعي، لرصد التغيرات الراديكالية التي عصفت بالحياة بكل ميادينها ومفاصلها، ومنها مظاهر الانقلاب التراتبي والقيمي، وظهور قيم ومستحدثات جديدة وغريبة، وصعود نسق طبقي جديد. ويرى الخليل أن رفض العمة «زهاوي» تصميم عمارة السجون الأميركية يمثل موقفاً رافضاً لمشاريع الاحتلال. ويسترعي الناقد الانتباه إلى دلالة التحالف بين الفكر الفقهي وبين الغرب الأميركي بوصفه محاولة لاستثمار القوى الغريبة الجديدة الفكر الديني في استراتيجيات الغزو بصيغته العسكرية أو الفكرية، كما يتجلى ذلك في التحالف بين فكر «الشيخ زريق التونسي» الديني وفكر الأميركي «يوهان» الإباحي.
ويكشف الناقد في قراءته رواية «نبوءة فرعون» للروائية ميسلون هادي عن نزعة الرواية لإدانة النظام الدكتاتوري الصدامي، وكذلك إدانة وتعرية الاستبداد الاحتلالي بكل ضراوته وشراسته، وتشير الرواية إلى أن الحياة أصبحت بحاجة إلى طبيب، لكن مصير الناس وضياعهم وسط البركان الاحتلالي (اليانكي) الأميركي يضع المصير المحتوم لابتلاع هذا الحلم أو النبوءة التي تتحول إلى كابوس.
ونوه الناقد بأن رواية «تذكرة إلى الجحيم» للروائي عباس لطيف تجسد واقع ما بعد الاحتلال، وبأنها استطاعت التشابك مع إفرازاته، وتصوير حياة الإنسان والمجتمع وطبيعة الصراعات السيكولوجية والمظاهر الشاذة. ولذا؛ فالرواية فككت الواقع برؤية استبطانية، وقدمت مظاهر التردي، والانكفاء القيمي، وتفكيك الأواصر الإنسانية، ذلك أن هذا الواقع لم يكن إلا تعبيراً عن دوافع ومحركات ناجمة عن الاحتلال الأميركي، وصعود الطبقات غير المؤهلة لتأسيس قيم جديدة.
ويرى أن رواية «رقص السناجب»، وهي أيضاً للروائي عباس لطيف، وفقت في أن تميط اللثام عن ارتباط مظاهر الخراب بالاحتلال الأميركي بكل إفرازاته.

ويعد الناقد رواية «طشاري» للروائية إنعام كجه جي أنموذجاً لإدانة النزعة الكولونيالية اليانكية؛ إذْ تمركزت الدلالات حول إفرازات النزعة اليانكية ما بعد الكولونيالية. فالهيمنة الاحتلالية بنسختها الأميركية قد وضعت لمسات القبح والتشظي للإنسان العراقي على مستوى تفتت الهوية والكينونة الإنسانية. وأكدت الرواية أن النزعة الكولونيالية الأميركية تمثل أحد تمظهرات العولمة المتوحشة والنيوليبرالية واستراتيجيات الصدمة وتفكيك الأوطان.
ولاحظ الناقد أن الروائية إنعام عبد الكريم في روايتها «الصمت» قد استثمرت واقع (أو مفردة) الاحتلال الإنجليزي للعراق للترميز إلى الاحتلال الأميركي، حيث إن طقوس الاحتلال وإفرازاته هي نفسها؛ لأن اشتراطات الاحتلال الأميركي ومقدماته تنبئ عن نتائج وظواهر تعيد نفسها.
ووثقت رواية «قيامة بغداد» للروائية عالية طالب، من جهة أخرى، الجانب المأساوي من جهة المرأة العراقية في خضم حرب السنوات الثماني، كما جسدت الجانب الثقافي والإعلامي بعد الاحتلال، وما حدث من إفرازات وسلبيات وظواهر تعكس طبيعة تناقضات المرحلة وظهور الخلل والارتكاس.
وتؤرخ رواية «دع القنفذ ينقلب على ظهره» للروائي خضير فليح الزيدي لمرحلة الحصار والحروب والانقلابات، وصولاً إلى مرحلة الاحتلال وإفرازاتها، والترهيب وظواهر الموت والخطف والعنف والإقصاء وانشطار البنية السوسيولوجية وتخلخل المنظومة الأخلاقية والقيمية عموماً.
ويرى الناقد أن رواية «تراتيل شرقية» للروائي سلام حربة تكشف عن تداعيات ما بعد الاحتلال الكولونيالي؛ ومنها التحالف بين الإرهاب والاحتلال من جهة وبين الشرائح الطفيلية والاحتلال من جهة أخرى. فقد عمدت الرواية إلى توثيق مرحلة الإرهاب ومظاهره، ومنها التحالف الضمني بين الاحتلال وإفرازاته وبين تشكل ظاهرة الإرهاب وارتباطها بالفكر التكفيري.
إن قراءة متأنية وموضوعية لكتاب الأستاذ الدكتور سمير الخليل عن روايات ما بعد الكولونيالية اليانكية في الأدب العراقي تكشف عن طبيعة الجهد الاستقصائي الكبير الذي بذله الناقد للحفر داخل أنفاق البنى السردية للوصول إلى الدلالات المخفية والمنظورة المتعقلة بمحور الدراسة، فضلاً عن الكشف عن الأنساق الثقافية المغيبة المقترنة بتمظهرات البعد ما بعد الكولونيالي في الروايات قيد الدراسة. وبذا يمثل هذا الكتاب جهداً استقصائياً رائداً يغني «النظرية ما بعد الكولونيالية» من خلال رصد جانب جديد يختلف عن «كولونيالية الإمبراطورية البريطانية»، ونعني به «الكولونيالية الأميركية اليانكية» عبر احتلالها العراق عام 2003.
وهذا الكتاب، من جهة أخرى، هو شهادة مهمة وأمينة عن موقف المثقف العراقي بشكل عام، والروائي بشكل خاص، تجاه الاحتلال الأميركي للعراق، وهو ينفي الصورة المضللة التي حاول البعض إشاعتها باتهام المثقف العراقي بالسلبية تجاه هذا الاحتلال، أو الترحيب به، ذلك أن هذا المثقف مارس منذ البداية سياسة الرفض والمقاومة والاحتجاج على هذا الوجود المتوحش، الذي أسس لسلسلة لا تنتهي من السياسات التي قادت إلى تدمير البنى التحتية للمجتمع وتشويه منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية واستبدال منظومة استهلاكية طفيلية بها، فضلاً عن خلق بؤر للعنف تهدف لتشويه الهوية الوطنية، وتُشَرْعِن لنظام المحاصصة الطائفية والإرهاب والفوضى والعنف... الذي يهدف إلى تفتيت المجتمع وطمس هويته الوطنية.