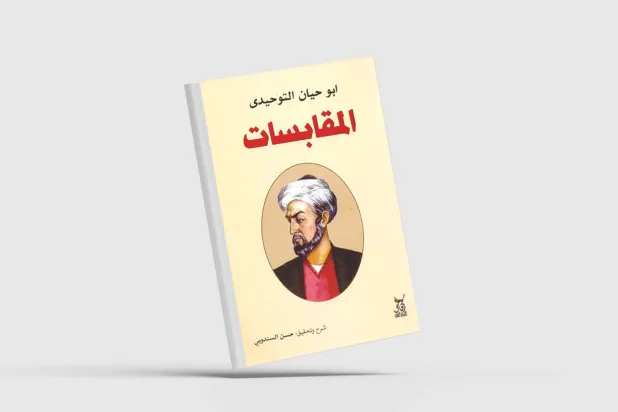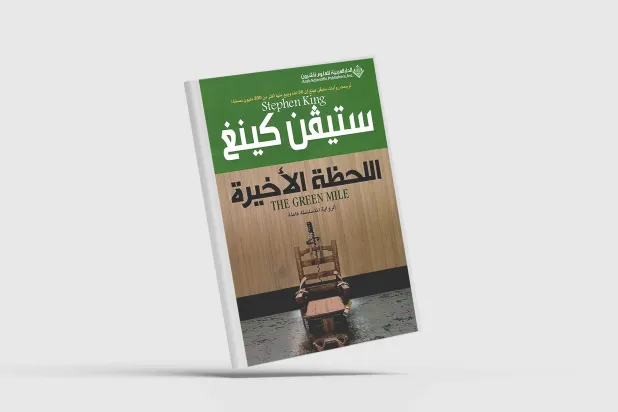لطفية الدليمي
قرأت باهتمام غير عادي ما كتبه الأستاذ حسونة المصباحي بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في «ثقافية الشرق الأوسط» بشأن أحدث روايات الكاتب العالمي ماريو بارغاس
كثيراً ما يحصلُ أن ترى طفلاً أو يافعاً يلاعب جهازه الجوال أو عصا التحكّم في لعبته الإلكترونية بسرعة فائقة فنتوهّمُ فيه معرفةً. الأداء شيء والمعرفة شيء آخر.
أقرأُ - بكثير من التفكّر والاستبصار والمتعة - التنقيبات الثقافية للدكتور سعد البازعي، تلك التنقيبات التي نراها شاخصة أمامنا في مقالاته الثرية أو في كتبه العديدة
قبل ما يقاربُ العشر سنوات ترجمتُ - في سياق ترجمات منتخبة لحوارات مع روائيات وروائيين من شتى الجغرافيات العالمية - حواراً مع الروائي الأسترالي توماس كينيللي…
قد نرى مغالاة في تخصص ثلاثي الأطراف (فلسفة وسياسة واقتصاد) لكنّ جامعة أكسفورد البريطانية تدرّسُ هذا التخصص المشتبك منذ سنوات بعيدة.
تقترن كلّ حياة طويلة في العادة بمناسيب أعظم من الخبرات التي قد ترتقي لتكون «حكمة» تتعالى على محدّدات الزمان والمكان والبيئة.
قد تساعد بعض الحِيَل التشويقية واللمسات البوليسية في كتابة رواية تبيع بالملايين؛ لكنّ هذه الحِيَل ما كانت وسيلة لانضمام كُتّابها إلى نادي كِبار الروائيين.
تفكّرتُ كثيراً في غلاف الكتاب الماثل أمامي. مثّل عنوانه «مهنة القراءة» صدمة قوية لي لم أختبر مثيلاتها من قبلُ. نحنُ نقرأ منذ سنوات بعيدة، لكننا أغفلنا التساؤل؛ هل نقرأ من أجل أن تكون القراءة مهنة لنا؟ هل القراءة مهنة حقيقية؟ حتى لو كان ممكناً من الناحية الواقعية أن تكون القراءة مهنة؛ فهل يجب أن نجعلها مهنة؟rnلا أحسبُ أنّ مؤلف الكتاب (برنار بيفو، وهو كاتبٌ فرنسي ومقدم برامج ثقافية شهير)، أو مترجم الكتاب، وهو الناقد المغربي سعيد بوكرامي، قصدا بمهنة القراءة أي توصيف يفهم منه القارئ أنّ القراءة مهنة بالمعنى المتداول؛ عملٌ يتقاضى معه القارئ أجراً يعتاشُ منه.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة