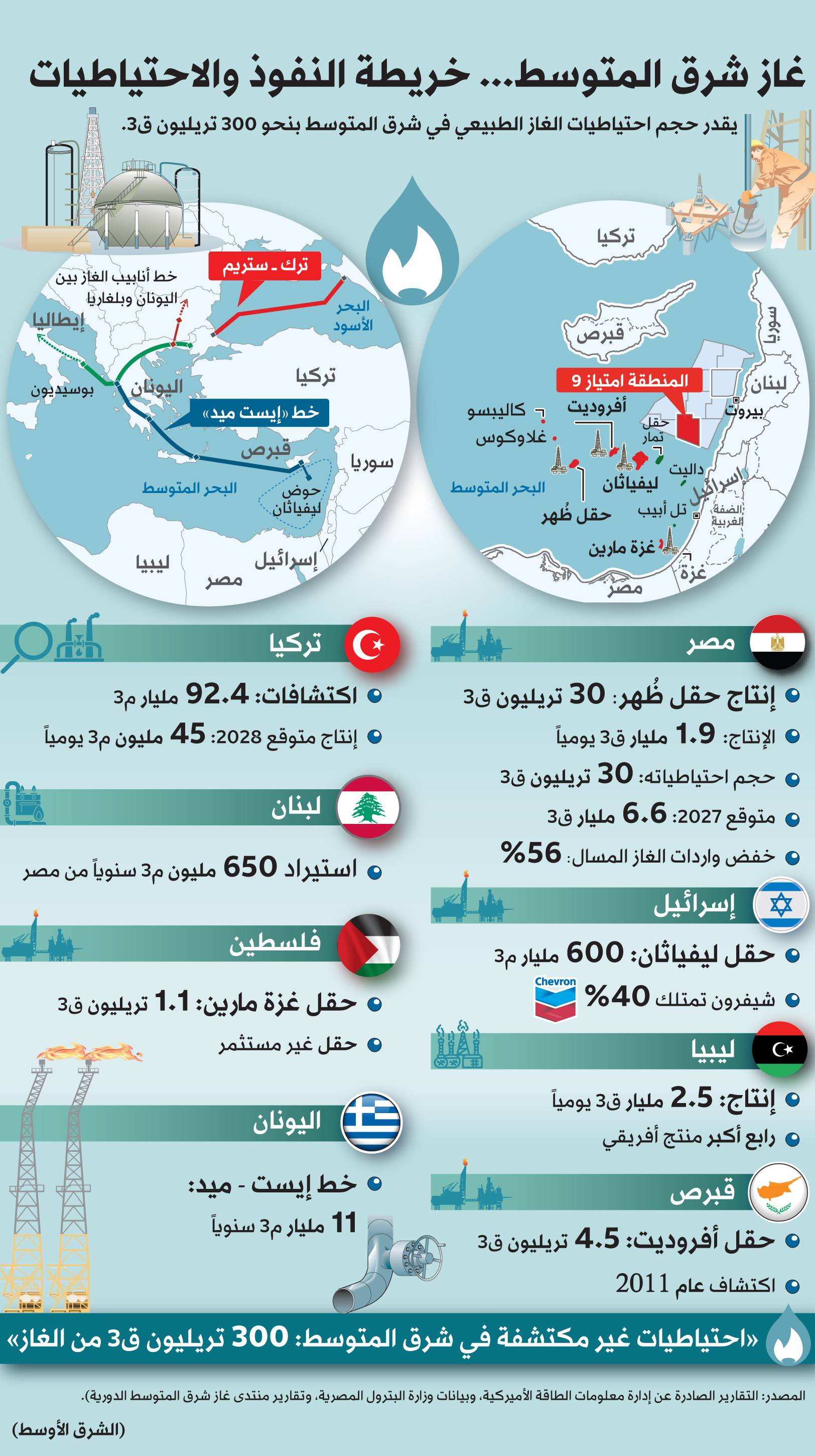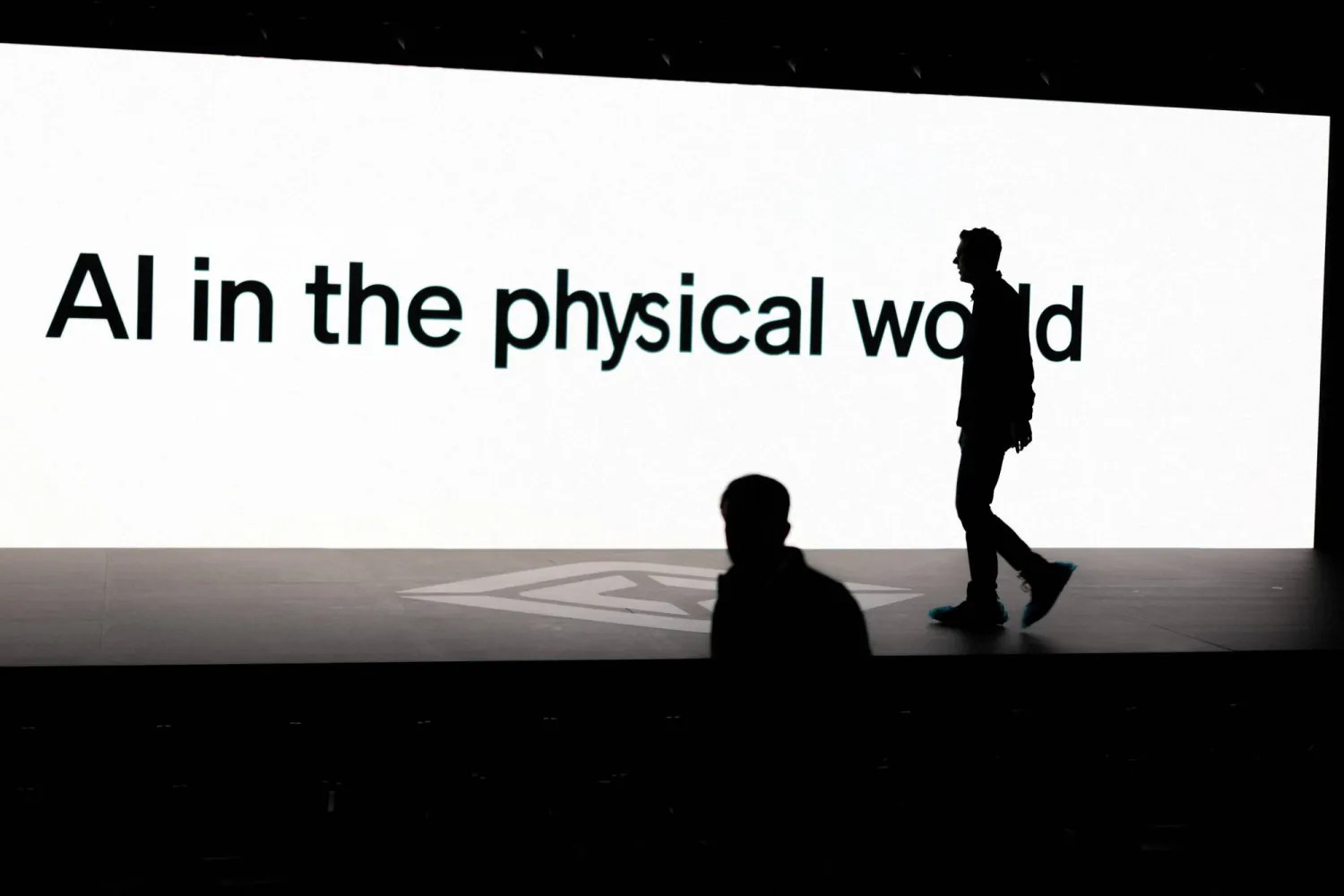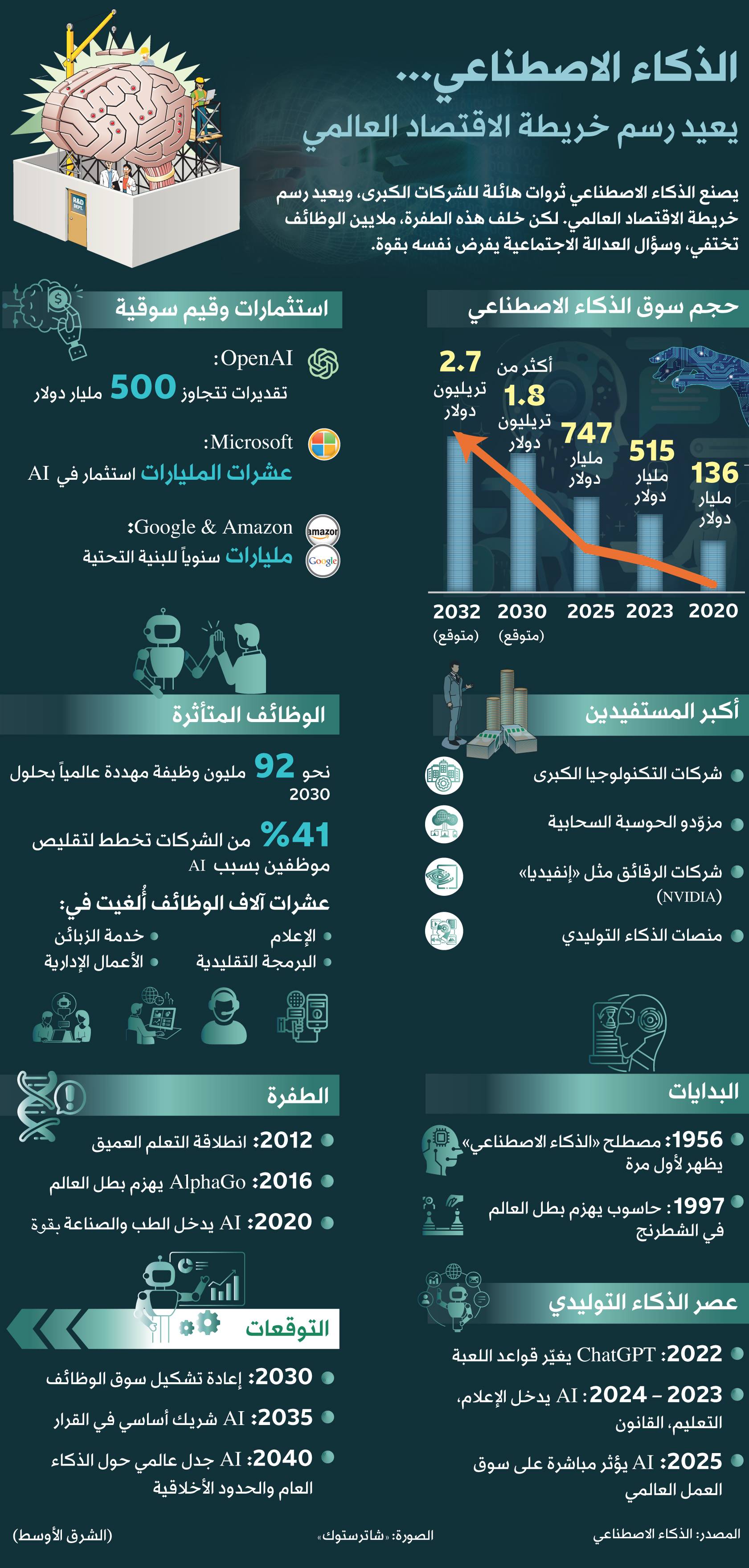لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في فصول حياة يحيى السنوار «أبو إبراهيم»، رئيس حركة «حماس» الذي أعلنت إسرائيل قتله، قصة خاصة. فيه وُلد في أزقة مخيم خان يونس قبل ستة عقود ونيّف ليبدأ رحلة حياة مليئة بالمحطات الصعبة والمثيرة والشائكة، وفيه نال حريته من السجون الإسرائيلية بعد أكثر من عقدين أمضاهما فيها، وفي الشهر ذاته أطلق «الطوفان» نحو غلاف غزة مخلِّفاً وراءه ارتدادات كبرى هزت أرجاء المنطقة والعالم، قبل أن تتمكن إسرائيل من تصفيته في أكتوبر أيضاً.
نشأ السنوار في مخيمات الصفيح بغزة وبين أزقتها الضيقة بعدما نزحت عائلته من مدينة المجدل عقب «نكبة 48». طاله نصيب من شظف العيش وقسوته. طبعت الظروف القاسية علاماتها على شخصية الطفل الذي وقف شاهداً على «نكسة 67». راكمت السنوات التي تلت رصيداً من الغضب والسخط في صدره، فاقمتها يوميات البؤس في غزة ومخيماتها مخلّفةً «رغبةً ملحّة بالانتقام» لازمته لعقود تلت. كان في حديثه ونظرته للصراع دائم الحديث عن «النكبة» وما تركته من معاناة ممتدة لأهله، كان لديه تطلع دائم لإحداث «صدمة وتغيير في موازين القوى»، كما يقول من عرفه.
تلقَّى يحيى السنوار تعليمه في مدارس مخيم خان يونس وأكمل دراسته بعدها بالجامعة الإسلامية التي تخرج فيها بشهادة في الدراسات العربية. بدأ نشاطه بالعمل الطلابي والتنظيمي حينذاك تحت مظلة «الكتلة الإسلامية» ومنها شق طريقه إلى أدوار أوسع تكللت بتأسيس جهاز «المجد»، الجهاز الأمني الداخلي لـ«حماس» المضطلع بأدوار حساسة أبرزها ملاحقة العملاء والمرتبطين بأجهزة الأمن الإسرائيلية.
قاد نشاطُه الأمني إسرائيل لاعتقاله أواخر الثمانينات. اتهمته السلطات الإسرائيلية بقتل أربعة «متعاونين» فحكمت عليه بأربعة أحكام مدى الحياة. تنقّل بين السجون الإسرائيلية شمالاً وجنوباً وقضى فترات طويلة في غرف العزل.

قاد «حماس» داخل السجون، وحمَل «هاجسه الأمني» معه. أتقن اللغة العبرية، ودرّس النحو الصرف لرفاقه، وقاد إضرابات ومفاوضات، وربح جولات وخسر أخرى. بدا الوقت ثقيلاً داخل السجن فيما دارت عجلة الصراع خارج أسواره؛ انتفاضات وحروباً وسرابات سلام. أكثر من عقدين في الأسر لم ينالا من قناعة الرجل بقرب نيل حريته. خطف شقيقه جندياً إسرائيلياً وبادلته «حماس» بألفِ أسير فلسطيني. كان يحيى على رأسهم. خرج ليلعب أدواراً بارزة شكّلت معالم جديدة للصراع.
في أعقاب السابع من أكتوبر، ملأ اسم السنوار الدنيا وشغل كثيراً من دوائر الأمن والسياسية في إسرائيل وخارجها. أثار الرجل عاصفةً من التساؤلات حول شخصيته وأفكاره ورؤيته للصراع وكذلك الدوافع وراء قراراته وحسابات تكاليفها، لا سيما لما أحدثته من انعكاسات وما خلَّفته من تبعات كبيرة وثقيلة.
تحدثت «الشرق الأوسط» إلى «رفاق القيد» ممن عاشوا معه وعرفوه واقتربوا منه خلال سنوات الأسر في السجون الإسرائيلية. يرسم الأسرى السابقون من مشارب سياسية وفكرية متنوعة «صورةً طبَقيّة» عن «العقل المدبر» لـ7 أكتوبر وأفكاره وقيادته لحركته داخل السجون وعلاقته مع الفصائل الأخرى وصولاً إلى الدوافع التي أوصلته إلى ساعة الصفر صبيحة السابع من أكتوبر، وحسابات الحرب الممتدة ومآلاتها.
اللقاءات الأولى
يسرد عصمت منصور، أسير سابق كان ينتمي لـ«الجبهة الديمقراطية» وأمضى سنوات في السجون الإسرائيلية التقى خلالها السنوار، جانباً عن انطباعاته الأولى بعد لقائه في سجن عسقلان أواخر تسعينات القرن الماضي: «حينما تلتقي السنوار ترى إنساناً عادياً، بسيطاً ومتديناً»، بيد أنه يحمل أيضاً «صفات القسوة والحِدّة في التعامل. هو رجل متدين لكنه ليس خطيباً ولا منظِّراً. تحضر الخلفية الدينية في تشكيل علاقاته، ولا يمكن أن يتعامل معك بمعزل عن موقفه المسبق».

تَظهر تجربة السنوار في صغره قبل دخوله السجن مبكراً وقضائه فترة طويلة فيه، جليّة في سلوكه ونظرته لما حوله وتعامله مع الآخرين. يقول منصور إن طفولته القاسية رسمت معالم «حقده» وصاغت توجهاته السياسية، مضيفاً: «هو لا يقبل المساومة، ولا يرى إمكانية للحلول أو إمكانية للتوصل إلى صيغ واتفاقيات إلا في إطار التكتيك».
عبد الفتاح دولة، أسير سابق ينتمي لحركة «فتح» أمضى سنوات في السجون الإسرائيلية، كان قد التقى السنوار أول مرة عام 2006. سبقت انطباعاته عن الرجل اللقاء معه، إذ تناقل الأسرى «صيت السنوار» من سجن إلى آخر ورسموا صورة عن رجل «حاد الطباع وصاحب قرار».
تلك الانطباعات عززها اللقاء الأول الذي جمعهما في سجن بئر السبع الصحراوي. يقول دولة: «يحيى السنوار الشخص الاجتماعي الإنساني يختلف عن القيادي الحمساوي. يحيى السنوار الذي تتناقش معه في قضايا عامة يختلف عن الذي تخوض معه في قضايا فصائلية. هنا يكون اجتماعياً وهناك يكون متعصباً، تشعر كأن الرجل بشخصيتين».
أما صلاح الدين طالب، أسير سابق ينتمي لحركة «حماس» وكان قد قضى سنوات في السجون مع السنوار وأُفرج عنه مع السنوار ضمن صفقة التبادل، يستذكر لقاءه الأول مع «أبو إبراهيم» فيقول: «يلفتك تواضعه، وعلاقته المرحة مع الشباب». بيد أن رفيق الأسر يلفت إلى أن طبيعة القيادي الحمساوي الأمنية جعلته مختلفاً عن قيادات الحركة الآخرين، فهو «ليس داعيةً، هو مؤسس جهاز (مجد) الأمني وهذا ينعكس إلى حد كبير على شخصيته. فرغم علاقاته الاجتماعية القوية فإنه في الجانب الأمني كان شديداً وقاسياً».

«هوس أمني» في السجون
داخل السجون كما خارجها، ظل السنوار رجل الأمن الأول. أواسط التسعينات تلقَّت حركة «حماس» وخلاياها في الضفة والقطاع ضربات موجعة متتالية تمثلت في اغتيال أجهزة الأمن الإسرائيلية عدداً من قادتها كان أبرزهم يحيى عياش وعماد عقل، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة لنشطاء الحركة، وإحباط عدد كبير من الخلايا العسكرية. أحدثت هذه التطورات هزات كبيرة داخل أركان الحركة وبعثت بارتدادات عمَّقت المخاوف من اختراقات أمنية واسعة. ألقى هذا بظلال ثقيلة وقاتمة على أحوال الحركة داخل السجون ودشن «مرحلة الهوس الأمني» في تاريخها. كان السنوار محرك هذه المرحلة وضابط إيقاعها.

يستذكر طالب هذه «المرحلة الصعبة» التي اضطلع خلالها بأدوار أمنية برفقة السنوار داخل المعتقلات. اتسعت رقعة «الهوس» وطالت تنظيم «حماس» في كل السجون، «كان هناك تحقيقات واستجوابات، كانت الملفات الأمنية تنتقل بين السجون ومنها إلى الخارج. خلّف ذلك حالة هوس أمني فكانت هناك اختراقات واغتيالات واعتقالات ولم تكن الحركة جاهزة أمنياً أو لديها تجربة ناضجة للتعامل مع ذلك بطريقة مثالية».
تحوّلت غرف حركة «حماس» لمراكز للاستجواب والتحقيق. طالت الاتهامات بالعمالة الكثيرين. يقول طالب إن بعضهم «ثبتت عمالته» بيد أن كثيرين وقعوا ضحية لـ«فوبيا الأمن»، مضيفاً: «كانت مرحلة صعبة لم يخرج منها أحد بسلام».
ويشير عبد الفتاح دولة إلى أن عمليات التحقيق كانت تجري مع «كل من تدور حوله أي شكوك»، ما خلّف تبعات مأساوية، «أشرف السنوار على عديد من عمليات التحقيق الداخلي. ربما كان يفلح بالوصول إلى بعض المتساقطين هنا أو هناك، لكن البعض قُتل تحت التعذيب وتبين لاحقاً أنهم من أفضل أبناء الحركة».
السنوار و«القسّام»
كان السنوار داخل السجون الإسرائيلية مطلع التسعينات حين برزت إلى الواجهة «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وشرعت بتنفيذ سلسلة من العمليات ضد أهداف للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. ورغم أن السنوار كان منخرطاً في الجانب الأمني فإنه اعتُقل مبكراً بينما كان العمل العسكري في طور الإعداد والتطوير. بدأت علاقة السنوار مع شخصيات من الجناح العسكري لـ«حماس» تنشأ وتتطور أكثر داخل السجون، إذ بدأ عدد من الأسماء البارزة بالوصول إلى السجون والمعتقلات.

يقول منصور: «السنوار من البداية ذهنُه وعقليته أمنية؛ عنده هوس أمني ونظرة أمنية للمحيط ويعيش هذا الهاجس كل الوقت. حتى قراءاته عن إسرائيل غالبيتها أمنية وعن تركيبة الجيش والمخابرات. لذلك هو لديه هذه الخلفية والقابلية للانخراط مع الجناح العسكري».
هذه العلاقة التي تشكلت ونضجت مع الجناح العسكري دخلت لاحقاً فصلاً جديدة بعد إتمام «صفقة شاليط» وخروج «أبو إبراهيم» ورفاقه من السجن عام 2011. كان محمد السنوار، شقيق يحيى الأصغر، مسؤولاً بارزاً في الجناح العسكري ومشاركاً في عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والاحتفاظ به لسنوات قبل إطلاق سراحه بموجب صفقة التبادل. أسهم شقيق السنوار وكذلك رفاقه الذي خرجوا معه من السجون، ناهيك بـ«رصيده» الذي يحظى به بالحركة، في فتح أبواب الجناح العسكري أمام القادم الجديد. يقول منصور إن هذه العوامل جعلت من السهل على السنوار «الاندماج في محيط العسكريين وإيجاد نفسه فيه».
شاليط والصفقة
قلبت عملية أسر الجندي الإسرائيلي شاليط والمفاوضات التي أعقبتها حول صفقة التبادل معطيات عديدة لدى السنوار وغيَّرت مصيره ومصير رفاقه. كان السنوار على رأس قائمة الأسماء التي طالبت «حماس» بالإفراج عنها. عززت التحولات التي خلّفها ملف شاليط مكانة السنوار داخل السجون وخارجها، إذ شرع بلعب أدوار متقدمة في ملف التفاوض.
يقول منصور: «السنوار بعد 2006 غير السنوار قبلها. بات يمثل مفتاحاً ومركز تجمع قوة كبيرة بسبب شاليط وبسبب سيطرة حماس على غزة بعدها. حماس أضحت نظاماً يحكم منطقة وتمتلك قوة وفي قبضتها أسير، وهذا الأسير بيد شقيق السنوار».

يشير منصور إلى أن قضية شاليط أعطت السنوار داخل السجون «قوة غير مسبوقة لم يسبق لأي قائد من حماس أن امتلكها سوى أحمد ياسين وصلاح شحادة اللذين كانا من الجيل الأول في السجون».
أصبح السنوار حينها عنوان الصفقة القادمة ومفتاحها. بات يمارس هذه القوة التي وقعت بين يديه لتعزيز مكانته وسلطته وقدرته على صناعة القرار داخل السجون وخارجها. يقول منصور: «بات يتصرف كشخص يقول للأسرى: (أنا باقدر أروّحك من السجن وباقدر أخلّيك). وهذا مارسه ليس لأسباب شخصية فحسب بل كانت لديه معايير مختلفة لها علاقة بمشروعهم وتفكيرهم وأولوياتهم».
كانت مفاوضات الصفقة بين إسرائيل و«حماس» قد قطعت شوطاً كبيراً حين دخل السنوار على خطها ورفض مخرجاتها وبدأ مساراً جديداً. يستذكر دولة أن مسؤول ملف التفاوض الإسرائيلي في قضية شاليط «حضر إلى السجون وتفاوض بشكل مباشر مع يحيى السنوار الذي ظهر أنه سيكون صاحب تأثير كبير».
ورم في الرأس وإنقاذ بمروحية خاصة
بينما كانت المفاوضات بشأن تبادل الأسرى تزداد زخماً وتقترب من نهاياتها، تعرَّض السنوار لوعكة صحية كادت تودي بحياته. أربك ذلك الحسابات وأضاء إشارات القلق لا سيما لدى الجانب الإسرائيلي. كان السنوار اللاعب الأول فيها. تفاقم وضعه الصحي ما حدا برفاقه في زنازين العزل بسجن السبع جنوب إسرائيل لحثه على الذهاب لعيادة السجن. يقول دولة: «كان السنوار عنيداً، كان يرفض دائماً الاستعانة بإدارة السجون». ازداد وضعه سوءاً وخطورة وفقد وعيه، مما اضطر رفاقه في السجن إلى نقله إلى العيادة، «حين بات الوضع صعباً، أجبروه على الذهاب»، يقول دولة.
أحدث وصول السنوار إلى عيادة سجن بئر السبع ذاك النهار إرباكاً كبيراً لدى إدارة السجون التي أعلنت حالة الطوارئ في السجن على الفور وأغلقت القسم الذي يقيم فيه السنوار. يسرد دولة تفاصيل تلك اللحظات التي رافقت الانتكاسة الصحية: «جاء ممثل عن إدارة سجن السبع وأخبرنا بأن المؤشرات تشير إلى أن السنوار يعاني وضعاً صعباً».
في تلك الأثناء حطّت مروحية في مهبط السجن، حسب دولة، وأقلّت السنوار على وجه السرعة إلى مستشفى «سوروكا» ليدخل بشكل عاجل إلى غرفة العمليات. وجد الأطباء ورماً حميداً في الرأس سارعوا إلى استئصاله. خضع السنوار لعملية «معقدة جداً وخطيرة» كاد يفقد حياته خلالها.
مثّل دخول المروحية على خط عملية الإنقاذ حدثاً استثنائياً وخلّف روايات متضاربة لدى الأسرى الثلاثة. يقول دولة إن «حالة السنوار كانت الأولى حسب تجربتي» بينما أشار منصور إلى أنه لا يتذكرها جيداً، فيما نفى طالب ذلك، موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجون حينذاك «كانت في الإطار العادي جداً».
يقول منصور إن الإسرائيليين حتى اليوم «يعيّرون» السنوار بعلاجه، مضيفاً أن مديرة مصلحة السجون ومديرة استخبارات السجون في حينها عبّرت في أكثر من مناسبة مؤخراً عن «عمق ندمها على إنقاذ حياة السنوار».
وعكس التعاطي الإسرائيلي مع مرض السنوار حالة من الإرباك الكبير لديها خلّفتها الخشية العميقة من أن يُلقي وضع السنوار الصحي بظلال ثقيلة على مسار صفقة شاليط في مراحلها الأخيرة. يلفت منصور إلى أن «لا أحد كان سيصدق في العالم أنهم لم يغتالوا السنوار أو يصفّوه وهو ما كان سيُلقي بانعكاسات كبيرة على الصفقة».
السنوار والبرغوثي وسعدات تحت سقف واحد
جمع سجن «هداريم» المركزي شمال إسرائيل السنوار بقيادات فلسطينية بارزة على رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات. بدأت العلاقة بين الثلاثة الكبار تتشكل داخل قسم العزل الجماعي هناك. «كان بينهم احترام كبير واستطاعوا أن يجدوا لغة مشتركة». يستذكر منصور: «هذا لا يجعلهم متطابقين في وجهات النظر لكن أتصور أن بينهم حالة ثقة واحترام تُمكّنهم من العمل معاً وتعطي تصوراً للعلاقة مستقبلاً».
عمل الثلاثة معاً، فخاضوا إضرابات داخل السجون وصاغوا مبادرات ورسائل للخارج أبرزها «ميثاق الأسرى للوفاق الوطني» ربيع عام 2006 الذي مثّل محاولة لرأب الصدع الواسع بين نقيضي المشهد السياسي الفلسطيني، حركتي «فتح» و«حماس».
عقب التوقيع على «وثيقة الوفاق»، يسرد دولة أنه نقل رسالة من سجن «هداريم» على لسان توفيق أبو نعيم، المقرب من السنوار، إلى سجن «بئر السبع»: «قال لي بالحرف: أبلغ عباس السيد والإخوة الذين شاركوا في التوقيع على (وثيقة الوفاق) أنهم سيندمون على اليوم الذي وقّعوا فيه عليها»، يستذكر دولة. خلّف ذلك انطباعاً لديه أن السنوار كان معارضاً للوثيقة. بيد أن منصور يرى أن أي موافقة من «حماس» داخل السجون «ما كانت لتتم دون مصادقة (أبو إبراهيم)».
يضيف منصور في قراءة سيناريوهات ما بعد الحرب، أن «إطلاق سراح الأسرى وبينهم مروان البرغوثي يأتي في سياق البحث عن شريك في (فتح) والمنظمة يكون السنوار قادراً على العمل معه».
«القسام» بعد 2011
بعد إطلاق سراحه من السجون بموجب صفقة التبادل عام 2011، مضى السنوار إلى تعزيز حضوره داخل صفوف حركته وتدعيم دوره داخل جناحيها لا سيما العسكري. عام 2012 انتُخب عضواً في المكتب السياسي للحركة وعلى الفور تولّى ملف التواصل مع الجناح العسكري. شرع السنوار خلال هذه المرحلة بلعب أدوار أوسع متكئاً على علاقته المتينة بالعسكريين وصولاً إلى انتخابات عام 2017 التي خرج منها على رأس المكتب السياسي للحركة في غزة مطيحاً بأسماء وازنة أبرزهم إسماعيل هنية. كان توجه السنوار فور خروجه من السجون إلى «أن يسيطر ويحكم وأن يكون الرقم (1) في صياغة الأمور في غزة»، كما يرى منصور.

ظل السنوار على رأس الحركة في غزة، وصولاً إلى استحقاق انتخابي جديد سبق السابع من أكتوبر بعامين. خرج منه مرة أخرى زعيماً لـ«حماس» في غزة. بدت المنافسة هذه المرة شرسة للغاية بين السنوار وشخصيات وازنة في الحركة. أعاد مسؤولو الانتخابات الداخلية التصويت «ثلاث أو أربع مرات» لضمان فوز السنوار. يقول منصور إن ذلك جاء تحضيراً لـ«لحظة 7 أكتوبر»، مضيفاً: «كان واضحاً أن لدى السنوار و(القسام) مخططاتهم».
لعب زعيم «حماس» أدواراً بارزة خلال هذه الفترة واهتمّ «بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ الحركة» بتطوير العمل العسكري. يقول طالب: «الصوت الأعلى هو للعمل العسكري ومن دونه لكان السنوار شخصاً رمادياً مثل الآخرين».
طموح الرقم (1)
كثيرة هي المحطات في حياة السنوار التي يظهر فيها الرجل الطموح لاعباً بارزاً أو منفرداً يدير مجرياتها وتفاصيلها ويجني ثمارها نفوذاً وسلطة. يرى دولة أن السنوار «لا يقبل بأن يكون مرؤوساً. هو لا يقبل إلا أن يكون الرجل رقم (1) في الحركة. هو مصاب بالطموح حتى لا نقول الغرور، الذي كان يدفعه وهو داخل السجن لأن يكون دائماً الرجل الأول في الحركة».
خلال العقدين الماضيين، كثفت إسرائيل من ملاحقاتها واغتيالاتها لقادة «حماس» فأخرجت من المشهد قادة الصف الأول مما دفع بشخصيات جديدة في الحركة إلى الواجهة. يقول دولة: «لا يشعر السنوار بأن من حق أيٍّ من القادة الحاليين أن يكون رئيساً عليه، ولا يقبل بذلك أبداً».
مؤشرات مبكرة على «الطوفان»
يشير دولة إلى أن انطباعاً لطالماً أحاط بالسنوار أنه «لفعلٍ كبير»، عززته خطاباته والرسائل التي أطلقها أكثر من مرة للأسرى في السجون، موضحاً أن «صفقة شاليط تركت العديد من عناصر حركة (حماس) وقيادات (القسام) الأوائل بالسجون، ولذلك شعرت الحركة بأنها قصّرت». يقول دولة إن حالة من الانزعاج طالت أسرى «حماس» بعد الصفقة، ووجَّهوا رسائل ناقدة وغاضبة إلى القيادة، مشيراً: «ربما شعر السنوار بأن عليه التزاماً أخلاقياً تجاه تصحيح ما لم تتمكن صفقة شاليط من تنفيذه».

يستذكر طالب خطاب السنوار الأول بعد الإفراج أمام الجماهير في ساحة الكتيبة وسط غزة: «كنت حاضراً على المنصة حين قال: (اليوم نغزوهم ولا يغزوننا). رأى أن صفقة التبادل كسرة لإسرائيل ويمكن أن يَبني عليها كسرات أخرى».
يرى منصور أن عوامل عدة التقت لدى السنوار قبل «7 أكتوبر» ورجحت كفّة «الجانب العقائدي» في قراءته الصراع، «جرًب السنوار مصالحة مع السلّطة وفشلت، جرّب التوصل إلى صفقة تبادل للجنود مع إسرائيل وفشلت. جرب رفع الحصار، جرب كل الطرق لإيجاد مخرج لوضع غزة ويحرر الأسرى وفشل، فلم يبقَ أمامه سوى هذا الخيار». يستدرك منصور: «لو كان هناك خيارات أخرى، «7 أكتوبر» ما كان ليحصل».
إسرائيل و«رمز الحرب»
منذ بداية الحرب على غزة، أضحى السنوار عنواناً رئيسياً للحملة العسكرية على القطاع وصورة لشكل الانتصار الذي تطارده المؤسستان العسكرية والسياسية في إسرائيل. يرى منصور أن إسرائيل حوّلته «رمزاً» لهذه المواجهة، وحمَّلته المسؤولية الكاملة عمّا جرى، «إسرائيل بدأت تبحث عن صورة واسم يلصق في ذهن العالم ويصبح مثل هتلر وصدام والقذافي وتشاوشيسكو والديكتاتوريين في العالم. جاء ذلك محاولة لاختزال كل (حماس) وكل الذي يحدث وكل القضية الفلسطينية في شخص وشيطنته».
يرى منصور أن شكل نهاية الحرب في ذهن الإسرائيليين مرتبط بمصير السنوار، «هذا إمَّا بإخراجه؛ فيصبح إخراج السنوار كفرد أو مجموعة أشخاص كأنه فعلاً إخراج لـ(حماس) من غزة، أو اعتقاله، أو تصفيته، أو بقائه مطلوباً ومطارداً، ليكون ذلك مسوغاً للاستمرار في عمليات الملاحقة ويتحول مثل الأشخاص الذين يديرون حركة من داخل نفق»، مضيفاً: «لكن كلما أصبحت سيطرة إسرائيل على الأرض أكبر، أصبحت مهمة السنوار أصعب، وصار الذهاب إلى الخيارات الأخرى أقرب».

السنوار «البراغماتي»؟
يرى من عرفوا السنوار أنه أدار في بعض مراحل الأَسْر سياسة «براغماتية». يقول منصور: «ربما يُفاجأ البعض أنه شخص يعقد صفقات. عقَد صفقات في مراحل سابقة مع الإسرائيليين، وهو قادر على التوصل لحلول وسط ومساومات في مراحل معينة لكن ضمن توجهاته».
لكن بينما باتت إسرائيل تصف السنوار بالرجل «الحي الميّت» حتى قبل أن تتمكن من قتله، يرى منصور أن أي زعيم إسرائيلي الآن أو مستقبلاً لن يكون قادراً على التعايش مع بقاء السنوار في قطاع غزة، «حجم الحقد والتحريض والاتهامات والمسؤوليات التي أُلقيت عليه، والتعبئة التي قامت بها إسرائيل للشارع والإعلام وعلى مستوى العالم لا تُمكّن إسرائيل من الرجوع خطوة للوراء أو عقد صفقة معه تُبقيه في غزة في وضع طبيعي». مضيفاً: «لا يمكن لإسرائيل أن تسلّم ببقائه حياً».