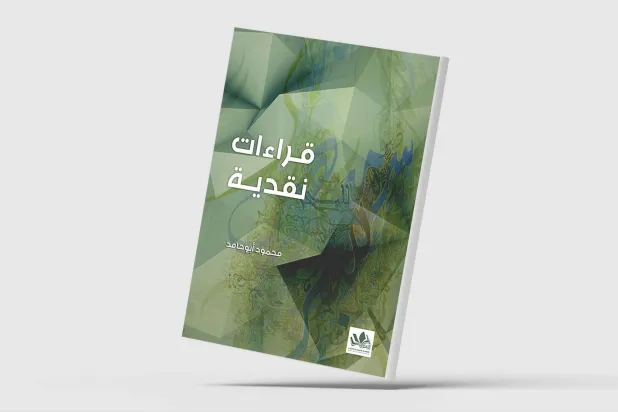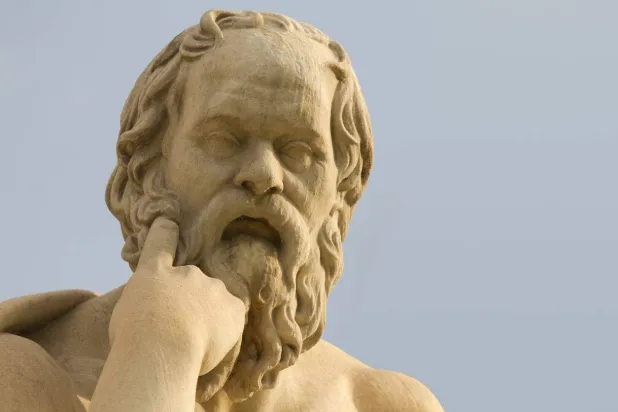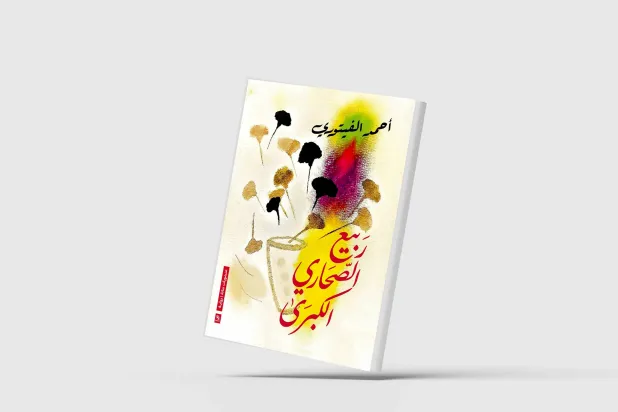كنت أحدق في الفناء الفارغ أمامي، مأخوذاً بصورة رجل أسمر بلحية شعثاء يعزف الساكسفون، مرسومة على جدار مقابل، ولا أعرف كيف ربط ذهني بين هذه الصورة وصورة رجل لم أعش من زمنه إلا سنوات قليلة، ربما كانت دقائق الفيديو الذي تسرب أمامي في «اليوتيوب»، عن فترة حكمه وتفاصيل القبض عليه ومحاكمته ومن ثم إعدامه، قد رتبت لذلك الخلط، ربما كانت تلك اللحية الشعثاء التي ميزته في آخر الصور التي بقيت في الأذهان، ربما هي الذاكرة الجينية التي ترفض أن تغادرنا، حتى مع هجرتنا من البلاد.
قطع اتصال ما على الهاتف فكرة الربط الغريبة التي امتهنها دماغي للحظات، ظللت أنظر إلى طلب الاتصال بالكاميرا متحيراً لوهلة، قطعته لأعاود الكتابة لها، غير أنها أرسلت لي ذلك الصوت المجروح الذي أعرفه وقد أنهكته الحمى «أحتاج إلى أن أشفى برؤيتك»، هي تدرك أني أتهرب من اتصال الكاميرا، لما يترتب عليه من طلب صوت منطوق، لكنها كانت تصر على الصورة القاسية التي ترطمني بالواقع، هذا اليوم كانت تلح بشكل استثنائي، وتردد أنها مريضة وأن رؤيتها لي ستشفيها، وما إن رأتني على الشاشة حتى صرخت: «يااااه... كم بت تشبه أباك في هذه القساوة!».
صمت قليلاً وأنا أغوص في ثقب أسود ذاتي عميق، كتبت لها كأني أعاقب اشتياقها: «أكثر مما تظنين بكثير...».
التقطت المخفي من القصد بسرعة، صمتت ولم ترد، كنت أعلم أن صوراً ومواقف كثيرة تمر في ذاكرتها، أعلم بأن ألماً صامتاً مكبوتاً لسنوات كان يتقلب راقصاً في قلبها، أحسست بحقارتي المطوية في عمق هذه العبارة، رفعت الجهاز وقربته من عنقي، كعقاب أستحقه بجدارة عن لا أباليتي بفرحتها لرؤيتي، خرج ذلك الصوت، معدنياً خانقاً ومتشنجاً، قلت: «لا عليك يا أمي، إنها دعابة فقط».
بالطبع إن للدعابة نبرة وبسمة وطريقة لم توفرها هذه العصي الصغيرة في يدي، عصاً تمس عنقي فتحرر ذبذبات الكلام المختنق، بآلية غبية دون حس، عصاً تنطق عني ناشرة عاهتي بحقارة غالبة، أمام الناس، أو أمام الكاميرا، وهي تضعني في حضن آلام بعيدة ببرود قاتل.
منذ أن فقدت صندوق نطقي الأسود، قبل أربع سنوات، وأنا أطفو على موجة حلم صارخ «الشعب يريد إصلاح النظام»، لأصحو على حقيقة واقعة، لم تصلح حنجرتي أو رئتي المثقوبة بالدخان، والخذلان، في صالات عمليات متكررة ومتوالية لسنوات، لم يترمم صوتي، ولا ثقب روحي الأسود.
صحوت بنصف وجه، ونصف إدراك، أتعرف على هذا الكائن الجديد الذي أصبحت عليه، وهو يحاول الوصول إلى طريقة لإفهام من حوله بما يحتاج إليه، بلغة دون نطق، كلمات تهيم في صوت مسحوب وحنجرة مستأصلة.
الصائح الصارخ، الراقص اللاعب، الضاحك الحالم، أصبح من دون صوت، من دون كلمة، من دون ملامح، بحنجرة آلية تطبطب بغباء على قلب أم موجوعة، بصوت روبرتي يحاول أن يداعب البعاد، ويوصل اللحظات الآثمة، بهذه العصا الناطقة، أتوجس فيها وألعنها، قد تبدل كلمتي كما تبدل صوتي؟ مؤامرة مدسوسة في عنقي هذه الحنجرة المأجورة، خيانة أحملها بيدي، وأفصح عن وجودها في حياتي كل لحظة.
خائنة هي الروح حين تصير بعيدة عن صاحبها، خائنة إلى الحد الأحقر حين تشتاق إلى حضن الأم أو وجه الحبيبة الهاجرة، هل استبعدت حقاً عن تلك الذاكرة كل هذه المسافة اللاإنسانية، نعم لقد فعلتها صالات العمليات، صفعتني بضعفي ووحدتي، في بقاع أراض بعيدة وبلاد محتجبة.
«صندوق أسود للنطق»، هكذا كان يدعو أبي «حنجرته»، بعد أن أوقفها مضطراً، سنوات السجن الخمس، قصة تقلبت ذكراها في ذهن تلك المرأة التي تدعى أمي مراراً وتكراراً، على الطرف الآخر من الأرض، وما إن نبهتها إلى عمق مناف لما قصدته من الشبه بيني وبين أبي، قصة متوازية على خطوط الزمن المتقاطعة، حين يبيع رجل آخر ما تبقى من أثاث بيته، على أرصفة ساحة التحرير، في أول أيام تشرين، وسنوات الجوع تحاصر الروح البشرية، كان أبي ذلك البائس الذي وضعه القدر في أيدي رجال الأمن دون سابق إنذار، يطالبونه بأسماء وأسماء لا يعرفها، يطالبونه بقصة لا يفهم تفاصيلها، يستمع دون أن ينطق، يتحمل كل أنواع الضرب دون كلمة، يصمت لسنوات خمس، صم بكم فهم لا ينطقون، النطق هزيمة، خيانة علنية، النطق ساحة مفتوحة لمطالبات معتمة، والبكم كان ملجؤه الوحيد الأمن، عاشه وتمادى في تقمص دوره، حتى بعد أن خرج من سجنه متفاجئاً، وسقط أمامه الصنم متفاجئاً صامتاً أيضاً، «صندوق أسود للنطق» قال ذلك وهو يشير نحوها ومن ثم صمت إلى الأبد.
هنالك ذكريات معاندة ترسلك إلى أبعد نقطة من الوجع فجأة، ذكريات تتمدد وتنتفخ، وتتلوى وتتوارى، لكنها لا تتبدد، كلما هربت من استعادة مشاهدها الخبيثة، تعيدك دون رحمة إلى نقطة البداية، أنت والأب الصامت، الحنجرة الآلية، والحنجرة المخنوقة، ماذا لو عاد للحياة الآن وتعثر بقصتي، ماذا لو أنه شاهد هذا الصامت الهارب من الكاميرا؟
- هل تظنين أن فكرة الاستنساخ الحدثي بيني وأبي - وبعيداً عما حول كلينا من أحداث - فكرة مقنعة؟ كتبت لأمي متسائلاً دون أن أنتظر جواباً منها. وعلى خلاف العادة وجدت أن النقاط تتراقص في أفق كتابتها، فهي تكتب الآن ولربما هي تكتب ما لا تستطيع قوله، قالت:
- أتخيل أن مليارات من البشر استعرضهم الرب فأخذ يفرز أتعسهم حظاً ليضعه في هذا البلد على مر القرون، أفتظن أن ما حدث لك أو لوالدك لم يحدث مع شاب أكادي أو سومري أو آشوري مسبقاً، أفلا تجزم معي أن أُماً من أمهاتهم كانت قد شهدت ابناً لها وقد تهشمت رقبته أمامها، مثلي...؟ أفلا تخال أن أحدهم اضطر إلى صمت سحيق لينجو بحياته مثل أبيك، نعم إننا شعب نستنسج تاريخ الألم، الثقل، الحمل، هل تخال أن مثلاً نتداوله مثل «أبناء الحمولة» قد جاء من فراغ؟
بدت لي لوهلة كطفلة ضائعة في فراغ، ترسم رمزاً ما على حائط مهمل لتستدل به، نظرت لي بكلمات صامتة تتدفق من مقلتيها المتعبتين.
رفعت العصا إلى عنقي، رددت الشعر الأقرب إلى قلبها بصوت المعدن البارد ذاته: «يا هي يبو المستحه يلعينك ولاية.... بيها الفرح والحزن يتلاكن حجاية».
وابتسمت هي بالفرح والحزن دون أن تنطق بالـ«حجاية».