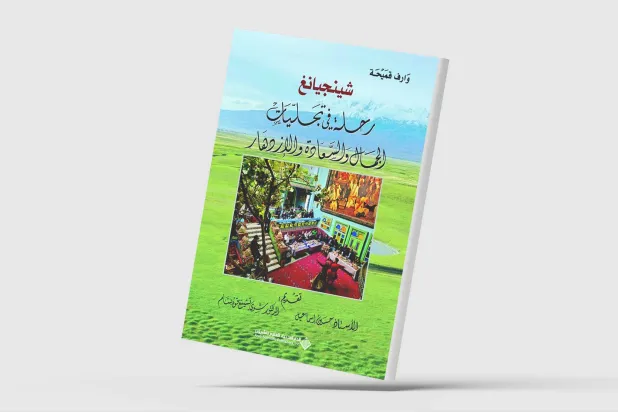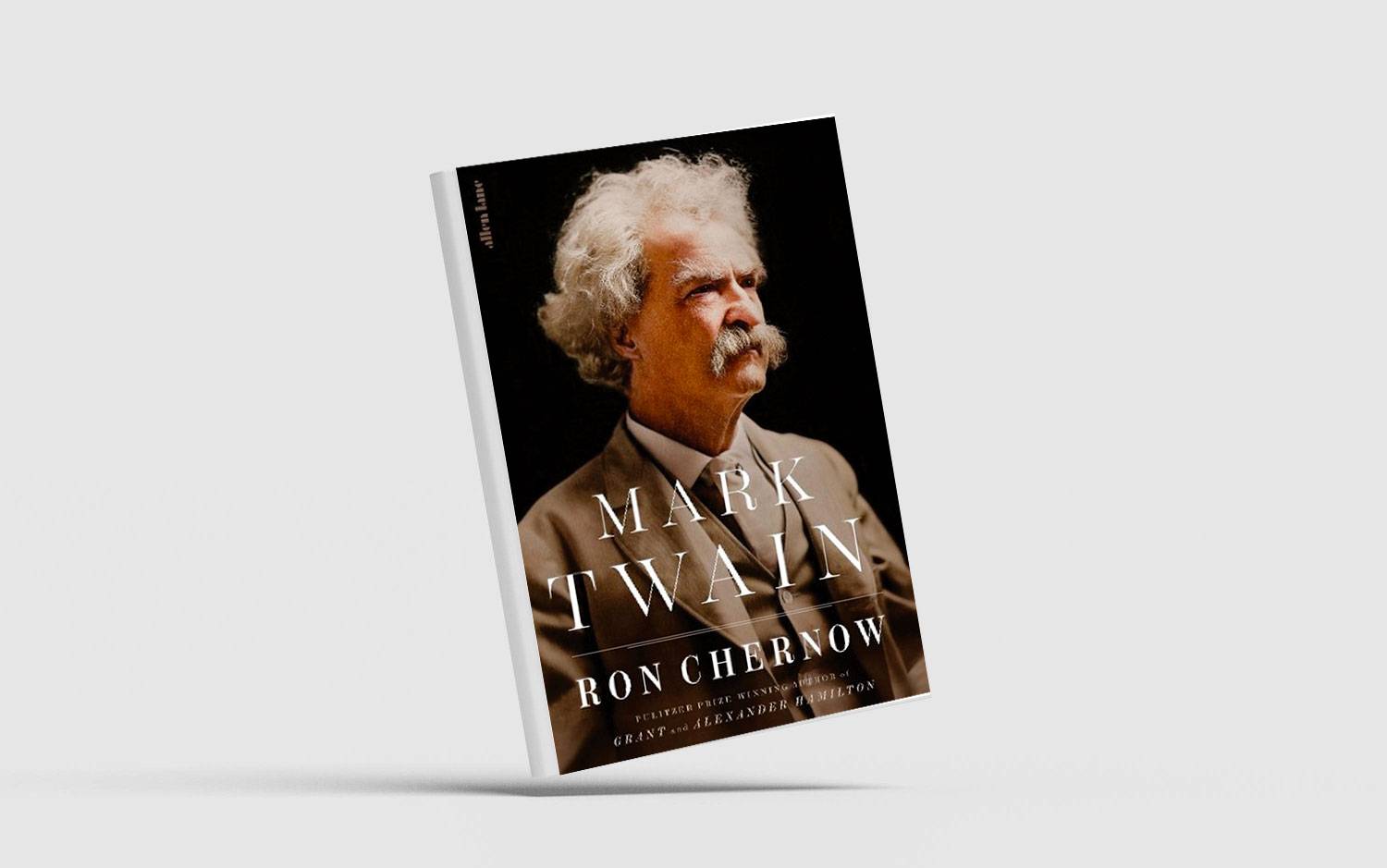لو طلبْنا إلى جمهرة منتخبة من الناس - مختلفة المشارب المهنية والتوجهات الثقافية - توصيفَ إنسان العصر الحالي، فأظنُّ أنهم سيتفقون على وصفه بـ«الإنسان الرقمي».
سيُسهِبُ بعضهم في كيل الخواص المستحسنة لمن غادر عصر الأمية الرقمية وامتلك شيئاً من القدرة التقنية المقبولة والكافية لكي يبحر في لُجّة المحيط الرقمي بكلّ تفاصيله التي تستعصي على إتقان فرد واحد حتى لو جعل عمره كلّه منحة مجانية لهذا التدريب الساعي للإتقان.
يحقُّ لهؤلاء إعلاءُ شأن الانتماء ونيل شرف عضوية الإمبراطورية الرقمية المتغوّلة والباسطة سطوتَها على كلّ مناحي الحياة المعاصرة. لو ساءلْنا هؤلاء: إتقانُ بعض جوانب العالم الرقمي ليس ثقافة، أو لنقُلْ إنه ثقافة منقوصة لأنه معرفة تقنية تقوم على تنميط المعرفة البشرية في نطاق خوارزمي صارم، فسيجيبك بعضهم: لا شأن لي بتعريفات الثقافة وخواصها الإجرائية. ألا ترى معالم السطوة الرقمية شائعة في كلّ مكان؟ لن يفيدك شكسبير أو دانتي أو لايبنز بشيء لو كنت أمياً رقمياً؛ أما لو امتلكت بعض أسرار العالم الرقمي، فحينذاك سيكون شكسبير أو دانتي أو لايبنز أقرب لإكسسوارات ثقافية. أقول هذا على افتراض أنّ هؤلاء المسكونين بسحر العالم الرقمي من الأجيال الشابة سمعوا أو عرفوا شيئاً عن رموز ثقافية وأدبية وفلسفية من أمثال شكسبير ودانتي ولايبنز.

مِثْلُ هذا الكلام أحسبُهُ باعثاً على شجون كبرى؛ لأنه يخلطُ حوابل الأمور بنوابلها حتى لتتيه علينا الرؤية الدقيقة في عصر ملتبس ومشتبك. سأحاول توصيف حالنا الثقافية الحاضرة في متتالية منطقية خطية مُسبّبة كما يفعل المناطقة:
- عصرنا الحالي محكومٌ بثلاث قوى تقنية صارت المعالم الأساسية لثقافته: سطوة تقنية رقمية، تغوّلٌ خوارزمي، استعمار بياناتي. أنت اليوم لستَ سوى بصمة بياناتية مرصودة ومُتابَعة من قبل كبرى الشركات التقنية (خصوصاً الستّ الكبار المعروفة التي تتحكمُ في مفاتيح عوالمنا الرقمية).
- تميل الأجيال الشابة إلى إبداء مرونة دماغية عظمى في التعامل مع المعطيات الرقمية وعالم الأعمال المرتبطة بها (تصميم المواقع الرقمية مثلاً)؛ ولمّا كانت هذه الأعمال هي المفضّلة حالياً فهذا يمثّلُ مصدر دافعية أعظم لخوض تجربة التطوّر والارتقاء الرقمي. من الطبيعي أن تتعاظم مناسيب الدافعية عندما يرتبط العائد المالي مع نمط الثقافة السائدة بدلاً من أن تُطْلَبَ الثقافةُ لذاتها ولمفاعيلها الجمالية والفلسفية الخالصة. أحسبُ أنّ الشاب المعاصر في كلّ العالم يسعى لنيل مكافآت فورية عن أي جهد يبذله، ولم يعُد يرتضي بالعوائد المؤجلة التي كانت المثاقفة القديمة ترتضيها. الثقافة من غير عوائد مالية تبدو موضة متقادمة عند كثيرين.
- ثمّة إشكالية تنشأ مع الأجيال ما قبل الشابة، وتتعاظم مقادير هذه الإشكالية كلّما تقادمت أعمارُ الناس. يكمنُ جوهرُ هذه الإشكالية في «الهجنة الثقافية (Cultural Hybridity)» التي عاشوها واختبروها بين الأنماط الثقافية ما قبل الرقمية ونظيراتها الرقمية. لا يعوز هؤلاء (أو دعونا لا نعمّم. لِنَقُلْ في أقلّ تقدير بعضاً من هؤلاء هجناء الثقافة) العزيمةُ والاصطبارُ على مكابدة متطلبات الهجنة الثقافية. كثيرون منهم أتقنوا وسائل العالم الرقمي وأدواته وطوّعوها، وأفادوا فائدة كبرى برهنت أحياناً أنها كانت أفضل من حيث النتائج ممّا انتهى إليه بعض الشباب من متغوّلي القدرة على الأداءات الرقمية والتفاعلات الخوارزمية والانغماس حتى قيعان البيانات السحيقة. لم يعُدْ مناسباً أن يخدعنا أحدٌ بالقول القاطع إنّ الدماغ الشاب أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع مستلزمات السيولة الرقمية من أدمغة الأكبر سنّاً. براهين تجريبية كثيرة أثبتت أنّ الشغف الروحي والانجذاب العقلي والتدريب العزوم على فاعلية معرفية هي فواعل تتقدّمُ أحياناً على سطوة المرونة الدماغية لدى الشباب. دعونا لا ننسى أنّ المرونة الدماغية لدى الشباب ليست أعْطية مجانية. كلّ خصيصة لا يتعهّدُها المرء بالرعاية والتدريب ستذوي وتنطفئ.
- كثيراً ما يحصلُ أن ترى طفلاً أو يافعاً يلاعب جهازه الجوال أو عصا التحكّم في لعبته الإلكترونية بسرعة فائقة فنتوهّمُ فيه معرفةً. الأداء شيء والمعرفة شيء آخر، وقبل هذا وذاك الثقافة شيء ثالث مختلف ومتمايز تماماً. قد يتفوّق طفل في السادسة من عمره من حيث سرعة أدائه على أستاذ في قسم هندسة الكومبيوتر في معهد «MIT» قضى كلّ عمره المهني في تصميم الألعاب الإلكترونية. هذا ليس مثالاً غريباً، وكثيرة هي الأمثلة المناظرة له. المثير في الأمر أنّ كلاً من الطفل وبروفسور «MIT» قد لا يعرفان «كلكامش»!!!. قد يصلح «كلكامش» مثالاً لقياس الفوارق الثقافية بين الناس مثلما يصلح برنامج «Office» معياراً لقياس الأمية الرقمية بينهم.
- يميل المرء ذو النزوع الفلسفي غالب الأحيان لتخليق فلسفة توفيقية بين القديم والجديد؛ بين متطلّبات الحاضر ونزوعات الماضي (النوستالجية)؛ لكنّ الأمر لا ينجح دوماً، وقد يبدو أحياناً كأنّه مزاوجة قسرية فاشلة قد تقود إلى الإحباط والاكتئاب.
لم يعُدْ مناسباً أن يخدعنا أحدٌ بالقول القاطع إنّ الدماغ الشاب أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع مستلزمات السيولة الرقمية من أدمغة الأكبر سنّاً
يحصلُ أحياناً أن ينتاب المرءَ من ذوي الهجنة الثقافية الضجرُ من التقنيات الرقمية، والسطوة الخوارزمية والبياناتية المتغوّلة؛ فيسوقه خياله النوستالجي إلى عصور سابقة خلت من هذه السيولة الرقمية المتفشّية. قد يبلغ هذا التوق النوستالجي أحياناً حدّ «الاكتئاب الأبستمولوجي» المتمظهر في شكل «متلازمة (Syndrome)». لا أخفي أحياناً أنني أصابُ بهذا الاكتئاب الذي لم يجد طريقه بعدُ إلى الأدبيات المعتمدة في «علم النفس السريري (Psychiatry)»، خصوصاً في الدليل التشخيصي الأميركي المسمّى «DSM». أعترفُ بأنني أستخدمُ «متلازمة التوق لإنسان عصر النهضة» بوصفها ابتكاراً شخصياً من غير أن تكون شائعة أو مشخّصة أو مستخدمة في المصادر الطبية.
لماذا التوق النوستالجي لإنسان عصر النهضة بالتحديد؟ لأنه العصر الذي شهد فورة غير مسبوقة من عقلياتٍ عبقرية لمعت في غير حقل معرفي (دافنشي، وغاليليو، وأنجيلو، لايبنز...) فضلاً عن تعزيز النزعة الإنسانية المتعالية على كلّ انحيازات دينية أو لاهوتية مقفلة. يبدو عصرنا بكلّ تقنياته المتقدّمة ظلّاً باهتاً لعصر النهضة؛ إذن لن يكون الأمر غريباً عندما يتوق أحدنا لذلك العصر حتى لو بلغ توقه تخوم الاضطراب النفسي.
معروفٌ في الأدبيات الطبية أنّ كلّ متلازمة تعني طائفة من الأعراض لو تحقق بعضها (وليس كلها) فقد يصحُّ التشخيص بهذه المتلازمة. أظنُّ من خبرتي الشخصية أنّ بعضاً من أعراض «متلازمة التوق لإنسان عصر النهضة» هي التالية:
- نفور شامل من السيولة الرقمية بين حين وآخر.
- محاولة الابتعاد عن الأجهزة الرقمية بين حين وآخر (لن تنجح محاولات الابتعاد الكامل لفترات طويلة لأسباب مسوّغة).
- النفور من فرط التخصّص (Hyperspecialization) المعرفي و/ أو المهني.
- الانغماس المفاجئ في قراءات مطوّلة تنتمي لأساطين عصر النهضة.
- الشعور بالضيق من التفاصيل التقنية حتى لو كانت تفاصيل صغيرة لا تعدو تحميل تطبيق جديد لا يستلزم أكثر من دقيقة أو دقيقتين.
- مقاطعة القراءة الإلكترونية، والاقتصار على قراءات ورقية حتى لو كان الأمر أكثر تكلفة ولا يمتلك مسوّغاته الكافية.
- الشعور بالفتور الذهني، وتهافت الرغبة، وخفوت الدافعية لدى التعامل مع كلّ منتج رقمي.
كيف السبيل إلى التعامل مع هذا الاكتئاب الأبستمولوجي؟ أولاً: لا داعي للهلع. جرّبْ أن تقرأ قوائم الكتب المنشورة حديثاً، فستجد أعداداً ليست بالقليلة منها تحمل عناوين نوستالجية (أو من مشتقات النوستالجيا) إلى عصور مضت. لن يعني الأمر اختلالاً كبيراً لو نما داخل أحدنا توقٌ حنيني لسنوات الثمانينات أو السبعينات أو الستينات من القرن الماضي، وليست مثلبة ثقافية أو نكوصاً معرفياً أو رجعية مفاهيمية لو تملّكنا توقٌ إلى مثال «إنسان عصر النهضة الأوروبية» الذي كتب المنظّر الثقافي ماثيو آرنولد مُسْهِباً في توصيفه، والحال ذاتها تصحُّ لو دفعَنا عقلُنا بحثاً عن نمط العقلانية الرفيعة في كتابات أبي حيان التوحيدي والجاحظ ونظرائهما من أعاظم الناثرين العرب.
كلّ عصر تسود فيه تقنية محدّدة ستكون له منعكساته السلوكية والذهنية على الكائن البشري: ستخفت فيه مهارات محدّدة لمصلحة تعزيز مهارات مستجدّة، وستذوي ذائقة فلسفية لمصلحة ذائقة فلسفية جديدة مطبوعة بتوقيع التقنية المستجدّة. يبدو لي أنّ جذر «الاكتئاب الأبستمولوجي» عند بعض البشر يكمن في حجم القطيعة المعرفية بين «المهارات التقنية والذائقة الفلسفية» السائدة في كلّ عصر. المعادلة واضحة: كلّما تعاظمت القطيعة المعرفية زادت احتمالية الاضطراب الذهني والاكتئاب الأبستمولوجي، ونمت بواعث التوق النوستالجي إلى ثقافة عصر سابق قريب أو بعيد.
يبدو لي من طبيعة التأسيسات الثقافية المستجدّة في عصرنا هذا أنّ توقنا الحالي إلى مثال «إنسان عصر النهضة» سيكون أيسر في التحقق بكثير من توق الإنسان إلى حالنا نحنُ، التي نشكو منها، بعد عشر سنوات أو عشرين سنة!
القطائع المعرفية والثقافية تمضي بوتيرة أسرع بكثير ممّا نحسب أو نتخيل.