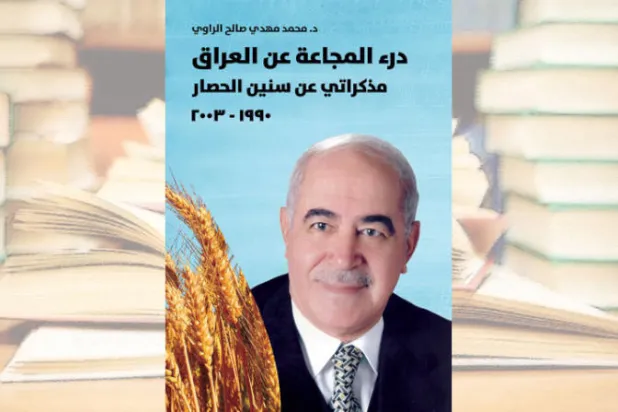يروي رئيس الحكومة اللبناني الراحل صائب سلام في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من مذكراته، قصة المفاوضات التي انتهت بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية في لبنان سنة 1970، والذي أنهى الحكم الشهابي وما كان يعرف بتدخل «المكتب الثاني» (استخبارات الجيش اللبناني) في الحياة السياسية. ويكشف سلام أن موقف القاهرة السلبي من عودة فؤاد شهاب إلى رئاسة الجمهورية كان أحد الدوافع وراء عزوفه عن الترشح في تلك السنة.
ويتحدث سلام في هذه الحلقة عن زيارته القاهرة للتعزية في وفاة الرئيس جمال عبد الناصر التي حصلت بينما كان مكلفاً تشكيل الحكومة الأولى في عهد فرنجية، ويروي تفاصيل عن لقائه مع الرئيس أنور السادات.
وتصدر مذكرات صائب سلام عن دار نشر «هاشيت أنطوان» وستكون متوفرة في مكتبات لبنان، بدءاً من الغد 28 يونيو (حزيران)، وعلى موقع «أنطوان أونلاين».
في أواسط يوليو (تموز) 1970، أخذت معركة الرئاسة في لبنان تحتدم جدّياً، وذلك وسط أوضاع محلية وعربية في غاية التوتّر، فمن ناحية، كان هناك الصراع بين القاهرة و«المقاومة الفلسطينية» حول شروع القاهرة في قبول مشروع الحلّ السلمي الذي كان يُسمّى في ذلك الحين «مشروع روجرز»، ومن ناحية ثانية، كانت هناك الصراعات العربية/ العربية المتفاقمة. ففي سوريا صراعات عنيفة على السلطة، وكذلك الحال في السودان. أما في منطقة الخليج، فالبريطانيون يستعدّون للجلاء، ومطامع إيران تتضاعف. وكان هناك ما بدأ يتّخذ سمة الحقيقة في القاهرة نفسها: لقد بات مؤكّداً أن الرئيس عبد الناصر مريض وعلى نحو جدّيّ.
- الاستعداد للانتخابات الرئاسية... هل يعود شهاب؟
أمضيتُ طوال يوم الأربعاء في 28 يوليو في اتّصالات ولقاءات انتخابية، للتوفيق بين وجهات نظر «الحلف الثلاثي» ووجهة نظر كمال جنبلاط. وفي هذا السبيل، اجتمعت طويلاً بشوكت شقير، ثمّ بكاظم الخليل، ثمّ دعوتُ إلى اجتماعٍ مسائيّ، حضره عديد من النوّاب والفعاليات، ومن بينهم كامل الأسعد وكمال جنبلاط وتقي الدين الصلح. وخلال ذلك الاجتماع، استعرضنا العديد من الأسماء المرشّحة، ثمّ فجأة ومن دون مقدّمات، طرحتُ اسم سليمان فرنجيّة –للمرّة الأولى على الأرجح– فما كان من كمال جنبلاط إلا أن تراجع من فوره مستنكراً الأمر. تجاوزتُ الموضوع ولم أجب، ولم أحبّ أن أحدّد الأمر أكثر من ذلك، أما هو من جهته، فقد عرض عدّة أسماء كان بعضها مقبولاً، مثل اسم فؤاد عمّون. في النهاية، اتفقنا على أن ننتظر لنرى كيف سيتطوّر الأمر مع «الحلف الثلاثي»، وأن ننتظر الاجتماع الذي دعا إليه جوزف سكاف بعد يومين. وفي الوقت نفسه بلغنا أنّ يوسف سالم، بالاتفاق مع رينيه معوّض وغابي لحّود، رئيس «المكتب الثاني»، بدأ يدعو النوّاب إلى الاجتماع في اليوم التالي، وأنّ دعوته شملت نائبي الضنيّة رغم عدم تماشيهما معهم، ومن هنا تبيّن أنّهم باتوا على شعور بالضعف، ما جعلهم مستعدّين لأي تنازل لأي نائب آخر.
ومن جهتنا تعدّدت اجتماعاتنا، وكان مأزقنا أنّنا -رغم اتفاقنا على ضرورة التخلّص من الحكم القائم- لم نتمكّن من الاتفاق على مَن سنأتي به، فشمعون غير مقبول عربياً، وبيار الجميّل لا يحظى بالإجماع، وإدّه بدأ ينفرط عقد المؤيّدين من حوله. فماذا نفعل؟ هنا كان اقتراح وجيه تقدّم به شوكت شقير، وهو أن نطلب من كلّ الفعاليات المارونية الحليفة لنا أن تجتمع وتتّفق على ماروني مناسب نؤيّده نحن بالتالي؛ لكن هذا الاقتراح ما لبث أن تلاشى.
بعد ذلك، خلال اجتماعاتنا مع كمال جنبلاط، بدا الأمر وكأنّه استقرّ على مرشّحَين لا يوافق هو على أحدهما (حبيب كيروز) ولا نوافق نحن على الثاني (الجنرال جميل لحّود)، وعادت الأزمة تطلّ برأسها. ومع هذا، رحنا نسعى جدّياً لترشيح حبيب كيروز؛ خصوصاً أنّ استمزاج رأي سليمان فرنجيّة في الأمر بعد عودته من سفر طويل قاده إلى موسكو وبلجيكا، كشف عن تحبيذه للفكرة. أما بالنسبة إلى فؤاد شهاب، فإنّه تلقّى تلك الآونة بالذات دعماً كبيراً، تمثّلَ فيما نُقل عن الرئيس عبد الناصر –عن طريق سفير مصر الذي بلغ الأمر لنسيم مجدلاني– من أنّه يؤيّد عودته. ومع هذا، فإنّ أركان السفارة نفوا ذلك، وكذلك فعل حسن صبري الخولي، كما أخبرنا كمال جنبلاط الذي التقاه في المطار، مضيفاً أنّ الخولي طلب إليه أن يتوجّه إلى مصر لمقابلة عبد الناصر يوم الخميس؛ لكن يوم الخميس كان متأخّراً بالنسبة إلينا؛ لأن صبري حمادة كان قد قابل فؤاد شهاب وعاد إلى المجلس ليبلغ الجميع بأنّه ربما يعيّن جلسة الانتخاب آخر الأسبوع. أما من ناحية شهاب، فكان لم يزل حتى ساعتها ممتنعاً عن إعلان ترشيحه. البعض يقول إنّها مناورة، أما أنا فكان اعتقادي أنّه حقاً لن يترشّح إلا إذا وفّروا له مسبقاً أكثرّية محترمة. وفي جميع الأحوال كان يبدو واضحاً أنّ جمع مثل تلك الأكثرية غير ممكن. غير أنّ هذا لم يمنع الاتّصالات معي من أجل إعلان موقف إيجابي من شهاب، فكان جوابي الوحيد: «فليعلن بصراحة أنّه مرشّح، وأنا مستعدّ عند ذلك لكلّ حوار، ولكن على الأسس والمبادئ التي مشينا عليها حتى حينها».
إلى ذلك الحين، كان «الحلفيون» لا يزالون ينظرون بعين الجدّية إلى ترشيح بيار الجميّل، ولكن فجأة بدأوا يشعرون بأنّه لم يعد بإمكانهم أن يتمسّكوا به طويلاً، وأخذوا يفاوضون «الكتائبيين» على أن يتخلّى الجميع لصالح مرشّح آخر يمكنه أن يأمل جمع الأصوات اللازمة. وكان اسم شمعون في ذهنهم؛ لكن حين فاتحوني بالأمر استبعدتُ الفكرة كلّياً. من ناحيته، أخبرني جنبلاط مساء يوم الأربعاء بأنّه كان في اجتماع حزبي قرّر أن يدعم الجنرال لحّود حتى النهاية ومهما كانت النتيجة. لم أعلق على الأمر كثيراً؛ بل استفدتُ من مزاج كمال جنبلاط المرح والمنفرج عند ذلك المساء، واقترحتُ عليه أن يجتمع بسليمان فرنجيّة عندي في البيت. وبالفعل، حضر الاثنان إلى بيتي عند المساء، وكان ذلك أول لقاء بينهما بعد طول جفاء، فكانت النتيجة أن أثار اللقاء ضجّة كبيرة في البلد، والحقيقة أنّ الاجتماع الذي دام نحو ساعة كان ودّياً، تطرّقنا فيه إلى بحث عديد من الأمور، ومن بينها التوتّر القائم آنذاك بين الفدائيين الفلسطينيين وعبد الناصر، وهنا أخبرني جنبلاط بأنّ الفدائيين طلبوا منه أن يتوجّه إلى مصر لمقابلة عبد الناصر وإقناعه بمواقفهم. عند ذلك أخبرت جنبلاط بأنّ ممثّل عبد الناصر، حسن صبري الخولي، آتٍ من دمشق ومعه رسالة له من عبد الناصر، يطلب إليه فيها أن يؤيّد شهاب، فانتفض جنبلاط واستنكر ذلك، ثمّ قال إنه على أي حال سوف يُفهِم الخولي حقيقة الوضع، وأنّه ليس بإمكاننا أن نؤيّد شهاب في أي حال من الأحوال... وانتهى الاجتماع وسط مناخ في منتهى الودّ بين فرنجيّة وجنبلاط، ما سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي كبير على أوضاعنا، وفعل القنبلة على نفسية خصومنا الذين كانت قوّتهم الأساسية تقوم على تمزيق صفوفنا.
في سياق هذه المحاولات، اتّصل بي ناظم القادري، وأبلغني رسالة من فضل الله دندش، العامل مع «الشهابيين»، فحواها أنّ أنطوان سعد، من «المكتب الثاني»، يريد الاتّصال بي لمناقشتي في بعض الأمور، وبعد أخذ وردّ اجتمعتُ بسعد، ومعه دندش والقادري، في بيتي بالدوحة. وكانت خلاصة الحديث أنّ شهاب يريد إنقاذ البلد؛ لكنه لا يمكنه ذلك إلا إذا تحالف مع الجناح الإسلامي، وبالتحديد مع صائب سلام.
عدنا إذن إلى الأسطوانة نفسها، أسطوانة أنّني إذا أيّدت شهاب أضمن رئاسة الحكومة. وهنا وجدتُ لزاماً عليّ أن أعود، أنا نفسي، إلى تكرار أسطوانتي التي يعرفونها: أفهمتهم أنّني لست ممن يتطلّعون إلى رئاسات أو كراسي، وأنّ همّي أن يقوم البلد على أسس صحيحة حتى يرتاح الرأي العامّ والشعب. وأفهمتُهم خصوصاً أنّ لدي أصدقاء مثل كامل الأسعد وجوزف سكاف أتعاون معهم، ولا أريد أن أنفصل عنهم في أي حال من الأحوال. وهنا لمّحوا إلى أنّ رئاسة المجلس ستكون مضمونة للأسعد، فكرّرت أنّ المسألة ليست مسألة كراسي. وطال بحثنا للأمور، وكان سعد يردّد أنّه إنما أتى حاملاً منديل السلام الأبيض، وليس من حقّي أن أردّه هكذا! فقلت له: «ليست المسألة مسألة منديل أبيض أو أسود، المسألة مسألة مبادئ وشعب ووطن». وهنا قال ناظم القادري: «للبحث صلة وسنعاود الحوار»، فقلتُ إنّ حواري الأساسي هو مع رفاقي، فقال سعد: «نحن لا نعرف غيرك... أنت القوّال وهم الردّادون».
وانتهى الاجتماع وهم يأملون أن يتمكّنوا من استمالتي، أما أنا، فكنتُ أفضّل أن أبقى معارضاً شرط أن أحافظ على كرامتي وكرامة الشعب. ومن ناحية ثانية، كان هناك جديد أساسي قد طرأ في ذلك اليوم بالذات، فالفكرة التي طرحتُها ذات يوم عَرَضاً على كمال جنبلاط، بدأت الآن تأخذ طريقها... وها هي الصحف تتحدّث عن إمكانية ترشيح سليمان فرنجيّة الذي بات يمكن القبول به من ناحية «الحلفيين»، كما من ناحية كمال جنبلاط.
أنا شخصياً، رغم حبّي وتأييدي لسليمان، كنت أعلم على أي حال أنّ الذين كانوا ينادون به هم أنفسهم الذين يُبدون خوفهم من ألا يكون كفؤاً لرئاسة الجمهورية بسبب عدم ثقافته، ولأنّه لم يتجاوز حتى حينها كونه نائباً عن ضيعته. وإضافة إلى هذا، كنت متحفّظاً جدّاً تجاه تصرّفاته، وعناده الذي يمكن أن يوصله إلى الشطط، إضافة إلى خشيتي من بوادر التعصّب الطائفي التي كانت قد بدأت تظهر لديه في الآونة الأخيرة، والتي يمكن أن تزداد حدّة بعد وصوله إلى الحكم، إذا وصل؛ حيث إنّ نظْرته إلى المسلمين والعرب باتت جافّة، إن لم أقل عدائية.
أما بالنسبة إلى التدخّلات الخارجية، فيمكن عند هذا المنعطف تسجيل ثلاث ملاحظات:
• أوّلها، تكرار زيارة السفير الجزائري لي، ومحاولته التوفيق بين وجهات نظرنا المتعارضة والدفاع عن المواقف الفلسطينية، إضافة إلى مواصلة أبو يوسف (من «فتح») العمل معنا، مقابل أن نحاور عبد الناصر باسم «فتح».
• الملاحظة الثانية، جواب أتى من السعوديين فحواه أنّهم لم يروا ضرورة أن يتدخّلوا في المعركة.
• أما الأمر الثالث والأهمّ، فكان ما نقَله لي جنبلاط، من أنّه اجتمع بحسن صبري الخولي في بغداد، فأبلغه الأخير أنّ مصر لا تؤيّد شهاب ولا «الشهابية». في جميع الأحوال، عرفتُ أنّ القاهرة أرسلتْ في الآونة الأخيرة ثلاثة رسميين إلى لبنان، بينهم محمد نسيم، المطّلع على أحوال المنطقة وتفصيل الوضع اللبناني، وكانت مهمّة البعثة دراسة الرأي العامّ اللبناني وموقفه من قضيّة الانتخابات المقبلة.
بقي أن أذكر في هذه المناسبة ما نقله إليّ سفير الجزائر عن السوريين، وعلى لسان نور الدين الأتاسي، من أنّهم ليسوا موافقين، في أي حال من الأحوالّ على عودة شهاب رئيساً للبنان، وأنّهم سيحاربون مثل هذه الفكرة بكلّ قوّتهم.
- مناورات ومشاورات قبل ترشيحنا فرنجيّة
كانت تلك هي الصورة يوم الأول من أغسطس (آب) 1970: شدّ وجذب، تأييداً أو مقارعة لعودة شهاب إلى الحكم، وبدْء ترسّخ فكرة أن يكون سليمان فرنجيّة هو مرشّح المعارضة، مع موافقة جنبلاط الضمنية على ذلك، وموافقتي أنا أيضاً، رغم تحفّظاتي على سليمان فرنجيّة. ويبدو أنّ انتشار فكرة ترشيح هذا الأخير، جعل «الشهابيين» يعتقدون أنّنا لم نكن جادّين في الأمر، وأنّنا كنا نطرح اسمه لأنّنا مرتبكون ولسنا قادرين على إيجاد مرشّح قوي وحقيقي. ولمّا كنت أنا هدف تحرّك «الشهابيين» الأساسي، لذلك عادوا يتّصلون بي، وعاد سامي الخطيب للتحرّك طالباً مقابلتي عن طريق العديد من الفعاليات المحليّة، مثل محمود الحكيم وعبد الحفيظ كريدية وغيرهما، ومن جهة أخرى، كان ناظم القادري يشدّد الضغط عليَّ لحساب فضل الله دندش، ومن ورائه أنطوان سعد، اللذين يبدو أنّهما خُيّل إليهما أنّ لقائي الأول معهما كان ناجحاً ويعِد باتفاق قريب. أما أنا، فكان جوابي الوحيد: فليترشّح شهاب ولنبحث الأمر بعد ذلك.
وكان الشهابيون يتّصلون بكامل الأسعد الذي اضطرّ أمام الشائعات العديدة التي دارت حول الموضوع، إلى عقد ندوة صحافية نفى فيها أي اتفاق معهم. ولكنْ كانت هنا مشكلة حقيقية، فلئن كنّا -جنبلاط وأنا- قادرين على تأييد ترشيح سليمان فرنجيّة، فإنّ الأسعد لم يكن قابلاً بذلك، واعتراضه له سببان:
• أولهما، موقف فرنجيّة من «المقاومة الفلسطينية» وصولاً إلى إقامته معسكراً لتدريب المقاتلين ضدّها في زغرتا.
• وثانيهما، ما يراه من عدم كفاءة سليمان فرنجيّة لشغل منصب رئيس الجمهورية.
لكن كان من الواضح لي أنّ هذا الأمر سوف ينتهي على خير، وأنّه ليس كفيلاً بإلقاء أي ظلّ على تحالفي مع كامل الأسعد.
وفي الوقت الذي ازدادت فيه حدّة التحرّك، جاءني أحمد إسبر ليقول لي ما هو جديد حقاً، وهو أنّ غابي لحّود أخبره، بصورة قاطعة، بأنّهم إنما يعملون للإتيان بإلياس سركيس رئيساً للجمهورية؛ لأن شهاب ليس وارداً، وهو نفسه لا يقبل. وأنا كنتُ فهمت شيئاً من هذا على لسان أنطوان سعد الذي كان قد أكّد لي أنّ شهاب لن يترشّح إلا إذا ضمن نوعية ناخبيه، قبل أن يضمن عددهم.
ولعلّ هذا ما دفع رشيد كرامي إلى التوجّه للقاهرة لاستطلاع رأيها النهائي في الأمر، بعدما تقاربت الآراء والتحليلات بصدد الموقف المصري، ولقد سبقتْ عودة رشيد كرامي إلى لبنان شائعات وأخبار عن أنّه لم يلقَ في زيارته لمصر سوى الفشل.
والمؤكّد أنّ فشل رحلة كرامي القاهرية كان السبب المباشر لخروج شهاب عن صمته أخيراً، وإصداره ليلة الثلاثاء 4 أغسطس، بياناً أعلن فيه عزوفه عن ترشيح نفسه؛ لأن المؤسّسات، على حدّ قوله: «لم تعد تحتمل، ولأنّ الوضع العامّ مهترئ، والاقتصاد متدهور...». كان واضحاً أنّه يريد عبر بيانه أن يهوّل على مَن سيقبل الترشيح، وكأنّ لا أحد يمكنه إصلاح الأمور.
كثيرون طلبوا منّي أن أعلّق على بيان شهاب؛ لكنني رفضت. المهمّ كان بالنسبة إليّ أنّ علينا أن نتحرّك على نور، وأن نعرف من هو خصمنا الحقيقي، لنعرف إلى من سينتهي اختيارنا. وكان لدينا في الواقع عدّة مرشّحين، من بينهم ريمون إدّه بالطبع الذي كان ترشيحه يَلقى معارضة أساسية من كمال جنبلاط. أما مرشحنا الأوفر حظاً فكان يبدو سليمان فرنجيّة، رغم أنّني أنا شخصياً كنت لا أزال راغباً في أن يكون ريمون إدّه... فسليمان لن يكون -في جميع الأحوال- من القوّة بحيث يعرف كيف يتصدّى جدّياً للأجهزة التي ستظلّ تحاول السيطرة على الحكم، مهما كانت هويّة الرئيس المقبل.
وفي سياق عملي لصالح إدّه، نجحتُ يوم 6 أغسطس، في جَمعه بالسفير الجزائري شهاب طالب الذي كان يرفض لقاءه في البداية رفضاً كاملاً. ولمّا كنت أعرف ما للسفير الجزائري من تأثير على القوى التقدّمية في البلد، وخصوصاً على كمال جنبلاط، كان اجتماع إدّه به ضرورياً. والحقيقة أنّ الاجتماع كان طيّباً ودام حوالي ساعتين. وفي اليوم التالي، اجتمعت بجنبلاط الذي كان يستعدّ لزيارة القاهرة لبحث قضيّة الوجود الفلسطيني، فطلبتُ منه أن يقنع المسؤولين في القاهرة بألا يعترضوا على أحد، مما يعطينا حرّية التصّرف وحرّية الحركة. وكان ذهني خلال ذلك كله متّجهاً صوب إدّه؛ لأنني مقتنع بأنّه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يبدّل الأوضاع، وأن يكون رجل دولة مسؤولاً.
واقترب موعد الانتخاب، وتواصلت المناورات والمشاورات ليلاً ونهاراً. وراحت المواقف تتقلّب والأعصاب تتشنّج. وفي يوم 14 أغسطس رشّح كميل شمعون نفسه رسمياً عبر بيان مسهَب، كان فيه ما يرضي الوضع العربي، وكذلك الوضع اللبناني بالطبع. وكان للبيان ردّ فعل كبير في لبنان، أما ردّ فعل «النهجيين» فكان قاسياً، وعبّر عنه كثيرون، منهم: رشيد كرامي، وعبد الله اليافي، وعدنان الحكيم، وعثمان الدنا، وغيرهم، أما أنا فأردتُ أن أكون متحفّظاً في ردّ فعلي، وخصوصاً أنّني كنت غير راغب في أن أصرّح سلباً أو إيجاباً تحت وطأة أي انفعال. كان موقفي المبدئي هو التريُّث في انتظار التشاور مع الزملاء الرفاق، قبل إعلان أي رأي في هذا الموضوع، وهكذا رحتُ أكثّف الاجتماعات مع الرفاق الأقربين، ولا سيما مع كامل الأسعد وجوزف سكاف اللذين لم يكونا أقلّ منّي انفعالاً، خشية من ردّ الفعل الذي سيُبديه كمال جنبلاط، علماً بأنّني كنت صلَة الوصل بينهما وبينه، وهدّأت من روعهما مؤكّداً لهما أنّه إن كان جنبلاط سينفصل عنا بسبب ما قد يجدّ، فليكن هو نفسه مسؤولاً عن ذلك، إذ يُستحسن بنا ألا نبادر نحن بأي رّد فعل سلبي تجاهه. بعد ذلك، اجتمعت بكمال جنبلاط في بيت شوكت شقير، وكنت قد أرسلتُ له عن طريق أصدقائي من محازبيه محاولاً إقناعه بترشيح ريمون إدّه؛ خصوصاً بعدما رشّح شمعون نفسَه، وهذه المرّة وجدتُه منفتحاً؛ لكنه قال لي إنّه لن يتّخذ موقفه (اليوم)، إذ عليه أولاً أن يستشير أركان حزبه وأصدقاءہ، ولقد لمستُ منه -على أي حال- بعض الميل لتأييد ريمون إدّه. وكان جنبلاط على موعد للالتقاء برشيد كرامي (في الغد)، وكان قد تسرّب إليّ أنّ رشيد كرامي مستعدّ لمؤازرة ريمون إدّه، وأنا من ناحيتي ما إن علمتُ بهذا حتى أرسلتُ لكرامي من يقنعُه بالمشي مع إدّه، بعدما تخلّى شهاب عن مشروعه بالعودة؛ خصوصاً أنّني أعرف أنّ كرامي لم يكن راغباً في إلياس سركيس.
كان يخامرني الانطباع بأنّ ذلك اليوم سيكون يوماً حاسماً، فقد أخبرني السفير المصري بأنّ القاهرة لا تقف موقف التأييد أو الاعتراض من أي مرشح، ومن ناحية شمعون كنت أحسب أنّه مستعدّ لتأييد إدّه، رغم أنّه هو نفسه مرشّح؛ بل هو مستعدّ لأن يقنع «الكتائب» بتأييد إدّه، وشمعون سرّب إليّ ذلك عن طريق غسّان تويني، فاستغربتُه بعض الشيء؛ لكنني قبِلتُه على علّاته، وصار عليّ الآن أن أحسم الأمور بين ريمون إدّه وسليمان فرنجيّة، وأن أقنع كمال جنبلاط بذلك، علماً بأنّه بات شبه مؤكّد أنّ «النهجيين» سوف يرشّحون إلياس سركيس.
لم يكن إدّه هو المرشّح الأمثل بالنسبة إليّ؛ لكنه الأفضل بين كلّ الأسماء المطروحة، إذا استثنينا مرشّحاً من الخارج هو الشيخ فريد الدحداح.
كان اليوم التالي، 15 أغسطس، يوماً حاسماً، وكان يوم سبت، ولم يبقَ على موعد جلسة الانتخابات سوى يومين. ومن هنا اختلطت الأمور أكثر وأكثر، وبات شبه واضح لنا أنّ كرامي وجنبلاط اتفقا على أن يكون الشيخ فريد الدحداح مرشّحهما. لم يكن لي اعتراض عليه؛ لكنني كنت أريده مرشّح تسوية لا مرشّح معركة، والفارق بين الحالتين كبير! أما جنبلاط فقد تشبّث بموقفه، وجاء ليقول لي إنّنا إذا لم نوافق معه على الدحداح، فإنّه سيكون مضطرّاً لقطع الطريق على شمعون، وللانضمام إلى «النهجيين» وانتخاب إلياس سركيس. طلبت منه أن يتروّى حتى الغد؛ لكنه أخذ يضغط بشكل كان من الواضح منه أنّه يريد أن يحشرنا، ومع ذلك استخدمتُ التروّي معه، وكنت أعلم أنّ أيّاً من الأمور لن يُحسم نهائياً اليوم، وأنّ اللعبة كلها سوف تُلعب غداً، الأحد.
- فرنجيّة رئيساً
وبالفعل، جاءت التطوّرات الأساسية يوم الأحد، وكانت مدهشة، أوصلتنا إلى انتصار مفاجئ لم نكن نتوقّعه.
بدأ الأمر منذ الصباح، خلال اجتماع «تكتّل الوسط»؛ حيث قرّر «التكتّل»، ترشيح سليمان فرنجيّة، خلافاً لما كان كمال جنبلاط يتوقّع. وانفضّ ذلك الاجتماع على أساس أن تجتمع لجنة خماسيّة، منّي ومن كامل الأسعد وجوزف سكاف وسليمان فرنجيّة وحبيب كيروز، بعد الظهر، بكمال جنبلاط. وبالفعل، جاء جنبلاط بعد الظهر وراح يبدّل مواقفه، بمعدّل موقف في الدقيقة، فمرّة يطرح اسم الجنرال لحّود، ومرّة يقول إنّه يسعى لمرشّح تفاهم، وثالثة يقول إنّه في حال استمرار شمعون سوف يضطرّ لتأييد إلياس سركيس، ترَك الجلسة وهو لا يقرّ له قرار، فتداولنا الأمر بحزم، ثمّ اتّخذنا القرار النهائي بترشيح سليمان فرنجيّة. وكان ذلك بعدما حلّلنا الأوضاع ووضعنا كافة الحسابات والاحتمالات، وطرحْنا جانباً كلّ تحفّظاتنا تجاه فرنجيّة. ثمّ، لجعل ذلك الترشيح نهائياً ورسمياً، دوّنّا وثيقة بذلك ووقّعناها جميعاً، نحن الخمسة أولاً، ثمّ نسيم مجدلاني الذي استدعيناه من الجبل، فلمّا تردّدَ أرسلنا له إلياس سابا فأحضره. وبعد ذلك توجّه سليمان فرنجيّة إلى شمعون الذي تنازل له ووقّع الوثيقة، ثمّ وقّعها الأخَوان عبد المجيد وعبد اللطيف الزين.
وكان للخبر وقْع الصاعقة في البلد، أما كمال جنبلاط فقد سارع إلى الاتّصال بي معاتباً... فناقشتُه في الأمر. وبعد ذلك، حين علم جنبلاط بأنّ شمعون أيّد فرنجيّة، وأنّ ريمون إدّه فعل الشيء نفسَه، سارع إلى الاجتماع بأركان حزبه والقوى التقدّمية واليساريين والشيوعيين، ثمّ التقوا جميعاً بإلياس سركيس أكثر من ساعتين، وكانت أخبار الاجتماع تتوالى إليّ، وأحسستُ في لحظة بأنّ جنبلاط بات على وشك إعلان تأييده لسركيس، فما كان منّي إلا أن أرسلتُ لقادة «المقاومة الفلسطينية» أخبرهم بالأمر، وطالباً منهم أن يضغطوا عليه. ثمّ اتّصلتُ بشوكت شقير للغاية نفسها. وأعتقد أنّ هذا كله قد فعل فعله، إذ خرج سركيس من عند جنبلاط غير متّفق معه، وبتّ شبه واثق من أنّنا سنكسب المعركة؛ خصوصاً أنّنا، تحسّباً لأي طارئ، طلبنا من الشيخ فريد الدحداح أن يتّصل بجنبلاط ليخبره أنّه ليس مرشّحاً وأنّه يؤيّد سليمان فرنجيّة. وبعد ذلك ذهب إليه عبد اللطيف الزين ونسيم مجدلاني، فعادا من عنده برسالة لي ولسليمان فرنجيّة، تتضمّن... تهنئة لفرنجيّة بالفوز. ومع هذا طلب جنبلاط أن نصبر عليه قليلاً، ريثما يجتمع بأعضاء «جبهة النضال» ليتّخذوا الموقف النهائي.
وتمّ كلّ شيء كما كنا نريد، وجرت الانتخابات يوم 17 أغسطس، وكان الفوز من نصيب مرشّحنا سليمان فرنجيّة، وفي ذلك انتصار كبير لنا، كلّل جهودنا وصراعنا الطويل مع «المكتب الثاني».
أما أنا، فبعد نجاح سليمان فرنجيّة، شعرت بشيء من الراحة، ولكنّني شعرتُ أيضاً بأنّ ثمّة معارك جديدة تنتظرني.
- تأثّري بوفاة عبد الناصر
كنا في خضمّ ذلك كله، حين وصلَ إلينا من القاهرة أسوأ نبأ يمكن أن يصل... نبأ وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. وأنا، مثل كلّ الوطنيين في لبنان، ومثل كلّ الشرفاء على امتداد العالم العربي، وفي العالم كله، صعقني النبأ، ووقفتُ دقائق غير مصدّق حين نُقل إليّ، رغم أنّني كنت على علم بخطورة حالة الرئيس عبد الناصر.
أمام هول ذلك النبأ، أحسستُ بأنّ الانتصارات كلّها واهية، وأنّ العالم قد انتهى، ورحتُ أتساءل في قرارة نفسي عن جدوى كلّ شيء، إذا كان الموت يأتي في النهاية ليخطف زعيماً كان مالئ الدنيا وشاغل الناس، وكان طوال ما يقارب من عشرين عاماً محور حياتنا العربية، ومبعث آمالنا ومُحرّك الأحداث العنيفة والكبيرة التي كانت مصدر عزّتنا وكرامتنا ذات يوم.
أمام هول الفاجعة، راحت شفتاي تتمتمان بارتجاف: «لا حول ولا قوّة إلا بالله... إنا لله وإنا إليه راجعون».
- زيارتي ضريح عبد الناصر، والرئيس بالوكالة أنور السادات
صحيح أنّ وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ليلة 28 سبتمبر (أيلول) 1970 كانت حدثاً جللاً واستثنائياً؛ لكن لأن مسيرة الحياة لا تتوقّف رغم كلّ شيء، كان علي أن أتجاوز حزني –العامّ والخاصّ– وأن أفكّر بالمسائل السياسية والحكومية. ولئن كنت ذُهلتُ أمام نبأ وفاة الزعيم العربي الكبير، فإنّي ذهلتُ أيضاً أمام ردود الفعل على ذلك الرحيل في لبنان. وشعرتُ أمام التعبير الرهيب للشعب اللبناني عن تأثّره بالحدث المروّع، بأنّ الوفاء ليس كلمة؛ بل هو فعل وذهنية، كما شعرتُ بفداحة المصاب وبكمْ أنّ شعوبنا بحاجة إلى أبطال، وكم كان عبد الناصر بطلاً استثنائياً. ولئن كان حزّ في نفسي أن يرحل عبد الناصر في وقت تبدو فيه الأوضاع السياسية العربية مبهمة؛ بل وعلى الرغم من المساعي الهائلة التي بذلَها لحقن الدماء في الأردن، من خلال تجاوزه لمرارته إزاء مواقف الطرفين منه. كان يحزّ في نفسي أنّ عبد الناصر قضى في وقت تتراكم فيه الظلال على علاقته بالقضيّة المقدّسة... قضيّة فلسطين.
من ناحية مبدئية، وبسبب قربي الشديد والشخصي من جمال عبد الناصر في الماضي، كان من المفروض أن أشارك في التشييع؛ لكن، بما أنّ شارل حلو كان لا يزال هو الرئيس الفعلي للبنان، ومعنى ذلك أنّه هو الذي سيرأس وفد لبنان في تشييع الرئيس عبد الناصر، رفضتُ الذهاب تحت رئاسته، وآثرت أن أؤخّر سفري لعدّة أيّام. وفي تلك الأثناء، تطوّرت الأوضاع السياسية في لبنان؛ حيث استقالت الحكومة، ما إن تسلّم سليمان فرنجيّة الحكم فعلياً، وكان ذلك يوم السبت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وفي يوم الاثنين التالي، وكما كان متوقّعاً، كُلّفتُ بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما كان هناك إجماعٌ على هذا خلال الاستشارات النيابية المعتادة. فأجريتُ الاستشارات، واجتمعت بالرئيس فرنجيّة للتوصّل إلى تحديد التشكيلة الوزارية معه. لكن سرعان ما بدأ الخلاف بيننا؛ حيث كانت العقبة الكبرى رغبتي أو إصراري على أن تكون حقيبة الدفاع لريمون إدّه، وحين رفض فرنجيّة ذلك، ما كان منّي إلا أن بادرتُ إلى الاعتذار، مرّة ثانية وثالثة؛ لكنه استبقاني وانتهى الأمر إلى تشكيلة أعطينا فيها وزارة المالية والتصميم لريمون إدّه، فإذا رفض نأسف لذلك ثمّ نأتي بغيره. وتولّيت أنا إخبار الصحافيين بذلك، ثمّ تلاني عمر مسّيكة، الأمين العامّ لرئاسة مجلس الوزراء الذي أعلن صدور المراسيم قائلاً إنّ الأسماء لن تُعلن إلا عند الصباح، وعند الصباح باشرتُ الاتّصال بالوزراء المعنيين لإخبارهم، وكان الأول ريمون إدّه الذي رفض رفضاً قاطعاً، ولم أكن مستغرباً لذلك، ثمّ تلاه في الرفض كميل شمعون، أما كمال جنبلاط فتذمّر وتململَ واعداً بأنّه سوف يجتمع بحزبه ثمّ يتّخذ قراره... وبدأت الأمور تميع. هنا اتّصل بي سليمان فرنجيّة طالباً التوقف عن إبلاغ الوزراء؛ لأن الأمور لا يمكن أن تجري على ذلك النحو. وبالفعل توقّفتُ عن ذلك، وعن كلّ نشاط، إذ كان عليّ في ذلك اليوم، يوم الخميس، أن أسافر إلى القاهرة للتعزية في وفاة الرئيس عبد الناصر. ولم يكن بإمكاني أن أتراجع عن ذلك أو أؤجّله، بعدما كنت قد أعلنته في الأسبوع الفائت، حين سئلت عن السبب الذي جعلني لا أرافق الوفد الذي ترأسه الرئيس السابق شارل حلو.
توجّهتُ إلى مصر في طائرة خاصّة، على رأس وفد نيابي كان من أعضائه: كامل الأسعد، ورائف سمارة، وجعفر شرف الدين، وناظم القادري، وأحمد فاضل، وعبد اللطيف الزين، وباخوس حكيم، وتقي الدين الصلح، وغيرهم.
كان الاستقبال في القاهرة رائعاً جدّاً، ليس فقط من حيث نظرتي إليه؛ بل كذلك من حيث تأثيرُه في القاهرة، ثمّ في بيروت، بعدما عدنا في اليوم التالي، وراحت الصحف والإذاعات ومحطّات التلفزة تتحدّث عن الزيارة. وكان في استقبالنا في المطار صلاح الشاهد آمر تشريفات الرئيس المؤقّت أنور السادات، مع فريق عسكريّ. وكان أول ما فعلناه حال وصولنا أن توجّهنا إلى ضريح الرئيس الراحل، وقد كان تأثّري بالغاً عند قراءة الفاتحة على قبر الرئيس؛ حيث استعدتُ ذكرياتي معه، ومواقفه العظيمة وتضحياته والأمور العظيمة التي حقّقها. كنت أشعر بأنّ هذا الرجل قد وهَبَ حياته حقاً لأمّته العربية كلها، وخطر في بالي أنّه سوف يأتي يوم نفهمه فيه أكثر وننصفه فيه أكثر.
بعد زيارة الضريح، توجّهنا إلى قصر الضيافة الذي يحمل اسم «قصر العروبة»، للاستراحة بعض الوقت، ثمّ قصدنا بيت الرئيس عبد الناصر لتعزية أبنائه وإخوته وإخوانه. وكان هناك خالد عبد الناصر، وإخوة الرئيس الراحل، وبعض أقربائه، وصهره، فعانقتُهم جميعاً وقبّلتهم بتأثّر بالغ، وكانوا واقفين جميعاً عند الباب في استقبالي، ثمّ دخلنا معاً، وكان البيت مليئاً بالرجال. أما النساء فكنّ في الطابق الأعلى. وبعد ذلك، جاءني صلاح الشاهد ليسرّ في أذني بأنّ عليّ أن أتوجّه إلى خارج القاعة، فتوجّهتُ وحدي، وكانت عند باب الغرفة هدى جمال عبد الناصر فعزّيتها، وكان التأثّر بادياً علينا نحن الاثنين. وناداني صلاح الشاهد مرّة ثانية فإذا بي أجد السيّدة حرم الرئيس عبد الناصر تقابلني، وقال لي الشاهد إنّها لم تنزل من جناح النساء لتجتمع بأحد قبلي أو تتقبّل أي تعازٍ من أحد؛ لكنها حين سمعتْ بأنّي موجود نزلت من الطابق الأعلى. وعزّيتها بدورها متأثّراً، والتقطت لنا صورة نُشرت في صحف لبنان ومصر، وكان لها دوي كبير وتأثير أكبر. وقد قيل لي يومها إنّها بعدما غادرنا القاعة أنا ورفاقي وقعتْ مغشيّاً عليها.
بعد بيت الرئيس عبد الناصر، ذهبنا لمقابلة الرئيس بالوكالة، أنور السادات، وهو صديق قديم لي كنتُ قد تعرّفتُ إليه خلال الأعوام الأولى للثورة. كان اللقاء به حارّاً، وحين تعانقنا، كان التأثّر بادياً على الجميع، ثمّ تبادلنا بعض عبارات التعزية والتعبير عن مشاعر الودّ، وبعدها دخل السادات في الحديث مباشرة، فقال إنه بحاجة إلى تأييد الإخوة العرب ومساعدتهم. وبعد ذلك دخلنا أنا وهو وكامل الأسعد بمفردنا إلى مكتبه؛ حيث بقينا نحو ساعة وربع الساعة نتداول الأمور الراهنة. ومما علق في ذهني يومها من الحديث ومن تشعّباته، ما أخبرَنا به عن اجتماعه بالموفد الأميركي ريتشاردسون الذي سأله، أول ما سأله، عمّا إن كانت مصر لا تزال مستعدّة للسير في الحلّ السلمي، فقال له السادات، حسب ما روى لنا: نعم بالتأكيد وبكلّ تصميم.
ومع هذا قال له السادات إنّ مصر مصرّة على عدم سحب صواريخها من جبهة القتال مهما كانت الظروف، وأضاف أنّ الأميركيين الذين لا يكفّون عن التجسّس على المصريين، بدلاً من أن يطلبوا من مصر سحب صواريخها، عليهم أن يفوا بتعهداتهم التي كانوا قد قطعوها بخصوص عدم إعطاء إسرائيل أي أسلحة خلال فترة وقف إطلاق النار؛ لأنهم بدلاً من الإيفاء بتعهداتهم في هذا المجال لم يتوانَوا عن تزويد إسرائيل بستٍ وثلاثين طائرة من طراز «فانتوم»، إضافة إلى مبلغ 500 مليون دولار.
وقال السادات إنّ ريتشاردسون طلب منه أن يقبلوا بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، فكان رَدّ السادات الرفض الباتّ؛ لأن نظرية مصر تقوم على عدم جواز التفاوض مع عدوّ يحتلّ الأرض. «فلتنسحب إسرائيل ونتفاوض على كلّ شيء بعد ذلك»، هكذا قال له السادات كما أكّد لنا بنفسه. وأشار السادات إلى أنّ الأميركيين يحاولون الاستفادة من غياب عبد الناصر، للضغط على مصر أكثر وأكثر.
كان بعد هذا حديثٌ طويل عن الدول العربية، وموقف كلّ دولة من الأخرى، والواقع أنّ السادات كان يرى أنّ وضع البلدان العربية متفسّخ تماماً؛ حيث لا توجد أي دولة تؤيّد الدولة الأخرى، وتساعدها، ولهذا طلب منا السادات أن يؤيّد لبنان مصر، كما طالبَنا بما كان عبد الناصر يطالبُنا به دائماً، أي أن يبقى لبنان جسراً بين مصر والعالم، وأن يستخدم موقعه ومكانته في سبيل الضغط على الأميركيين والإنجليز.
وكانت مناسبة للبحث في شؤون المسلمين في لبنان، فرسمتُ للسادات صورة واضحة –من وجهة نظري طبعاً– عن أوضاعنا، ثمّ عرّجتُ على مواقف سفير مصر عبد الحميد غالب في الماضي، وخصوصاً إزاء «المقاصد»، وشرحتُ له تفاصيل المعركة التي دارت من حول «المقاصد» وكانت موجّهة ضدّي بتوجيهٍ سافر من السفارة المصرية. ثمّ قلتُ له إنّ كثيراً من الأطراف يتستّرون بـ«الناصرية» شعاراً ليعملوا في الواقع لصالح «الشهابية»، مما يلحق الضرر بالمسلمين كما بمصير المجتمع الإسلامي في لبنان.
- حكومة الشباب
عدنا من القاهرة مساءً، ومن فوري توجّهتُ لزيارة الرئيس فرنجيّة، ورويتُ له الشؤون التي تهمّه من مداولاتنا مع أنور السادات، ثمّ أخبرتُه أنّني بتّ شديد الإرهاق ولذلك سأذهب لأنام، على أن أوافيه في اليوم التالي لمواصلة البحث في قضيّة التشكيلة الحكومية.
وبالفعل، ذهبتُ إليه في اليوم التالي فكان منشرح الصدر، على غير عادته، وعاودنا البحث في تشكيلة الحكومة العتيدة، وقلّبنا مختلف التصوّرات والتشكيلات الممكنة، وأدركنا أنّ أيّاً من التشكيلات التقليدية التي سنضعها لن تنال رضا الجميع ولا موافقتهم، فماذا نفعل؟
بكلّ بساطة: نراعي الظروف الجديدة ونُحْدث «ثورة صغيرة». فما هي هذه الثورة؟ بكلّ بساطة أيضاً: حكومة شباب جُدد من خارج الأوساط السياسية التقليدية. رميتُ الفكرة وأنا أشرح مدى ما سيكون لها من ردّ فعل لدى الرأي العامّ، وكنت أعتقد أنّ الرئيس فرنجيّة سيرفض الفكرة من فوره؛ لكنني فوجئت بموافقته عليها. وهنا طرحتُ أمامه عدّة أسماء على سبيل المثال لا الحصر: نديم دمشقية –مثلاً- للخارجية، وهنري إدّه، والدكتور جميل كبّي، وغسّان تويني للتربية، بين أسماء أخرى. ولم يُبدِ فرنجيّة موافقته وحسب؛ بل بدتْ عليه الحماسة الشديدة. وقال لي: «أنا معك، اذهب وفاوض النوّاب في محاولة أخيرة منك تجاههم، فإذا رفضوا، وهم سيرفضون قطعاً، تكون حرّاً في تشكيل الحكومة التي تتحدّث عنها. أما إذا وقف المجلس ضدّنا ورفض منحنا الثقة، فليس هناك أسهل من حلّ المجلس وإجراء انتخابات جديدة». وأضاف: «أنا معك... فإما أن نبقى معاً، وإما أن نذهب معاً».
هذا الكلام شجّعني طبعاً على مفاوضة النوّاب من موقع المطمئنّ، فاجتمعتُ مع كمال جنبلاط، ثمّ اجتمعتُ بكثيرين غيره، منهم كامل الأسعد وجان عزيز. وكانت نتيجة تلك المشاورات تشكيلة مؤقّتة من 16 نائباً، أدخلتُ فيها جوزف سكاف الذي كان يعدّ عقدة من العقد؛ لأن سليمان فرنجيّة يرفض إدخاله من خارج المجلس، أما أنا فكنت أصرّ عليه بسبب ما له لديّ، وفي نظري، من موقع خاصّ، فهو كان معنا على الدوام في السرّاء والضرّاء ولا يجوز أن يبقى خارجاً.
حملتُ هذه التشكيلة وذهبتُ إلى الرئيس فرنجيّة بعد ظهر اليوم نفسه، فوجدتُه متلكّئاً ومتردّداً، يعترض حيناً على سكاف وحيناً على بويز، أختارُ إدّه فيطالب بإدوار حنين، وحين أقول له عدنان الحكيم يقول لي أمين الحافظ، ثمّ يفرض علي إسبر، وبعد ذلك ينصح بأخذ شاهين وفوّاز عن الشيعة في الجنوب، فأقول له إنّ هذا لا يعطي شيئاً لكامل الأسعد، فيقول: فليكْتفِ كامل الأسعد برئاسة المجلس. إثر هذا كلّه ساد التوتّر، وبدأ يتضخّم بيننا، وأدركتُ أنّه يسعى، لسبب ما، إلى عرقلة كلّ حلّ أتوصّل إليه. استدعَينا مستشارينا الشخصيين والمشتركين، من أمثال جورج أبو عضل وعزّت الحافظ، وتوسّعتْ رقعة النقاش؛ لكننا لم نصل إلى أي نتيجة، وخامرتني فكرة الاعتذار فاقترحتُها؛ لكنّه رفضها بسرعة. ركّبنا تشكيلات أخرى؛ لكن لم تحظَ أي منها بالموافقة، فحيناً نتّصل بشمعون فيعترض، وحيناً يعترض جنبلاط، وفي أحيان كثيرة يكون الاعتراض من فرنجيّة نفسه.
وراح ذلك يتكرّر خلال الأيّام التالية... إلى أن انتهى الأمر باتفاقنا على العودة إلى فكرة «حكومة الشباب» التي لم يعدْ منها بدّ؛ خصوصاً أنّ الفكرة قد تسرّبتْ إلى أوساط الرأي العامّ فأسفرتْ عن حماسة شديدة. وهكذا تشكّلت تلك الحكومة التي كان كلّ عناصرها من أصحاب الفكر والجدارة، من الذين لم يُعرفوا في السياسة من قبل –باستثناء قلّة منهم– لكنّهم عُرفوا كمبدعين في مجالاتهم.
وهكذا أعلنت التشكيلة وكانت قنبلة إيجابية ضجّ لها الرأي العامّ، وتناقلتْ أخبارَها صحف العالم كله، وبدا واضحاً أنّ الحكم الجديد يريد ضَخّ دم جديد في الحياة السياسية اللبنانية. وكان من الطبيعي للنوّاب أن يتململوا إزاء ذلك الواقع الجديد الذي نفرضه عليهم، وكان في مقدّمة المتململين شمعون و«حزب الأحرار» اللذان راحا يتقرّبان، في نوع من الردّ علينا، من «النهجيين» وصبري حمادة ورشيد كرامي وعادل عسيران، وغيرهم. أما أنا، فكنت أجد الدعم التامّ من الرئيس فرنجيّة ومن كامل الأسعد الذي بات، بالطبع، مرشّحنا الوحيد والمنطقي لرئاسة المجلس النيابي.
زيارة لمذكرات رئيس الوزراء اللبناني الراحل صائب سلام (1): صارحت حافظ الأسد بمآخذي على دور سوريا السياسي والعسكري في لبنان
زيارة لمذكرات رئيس الوزراء اللبناني الراحل صائب سلام (2): الأميركيون أمنوا حماية أبو عمّار يوم خروجه من بيروت