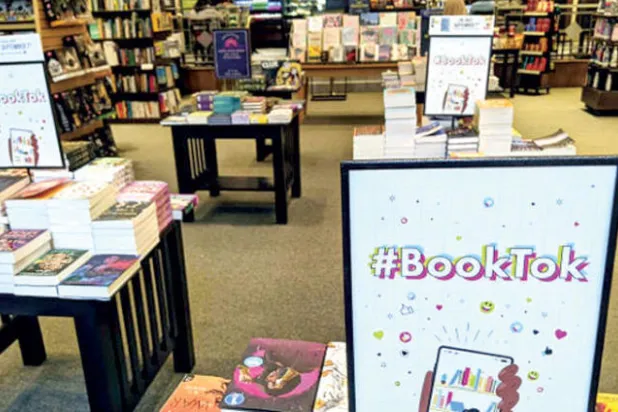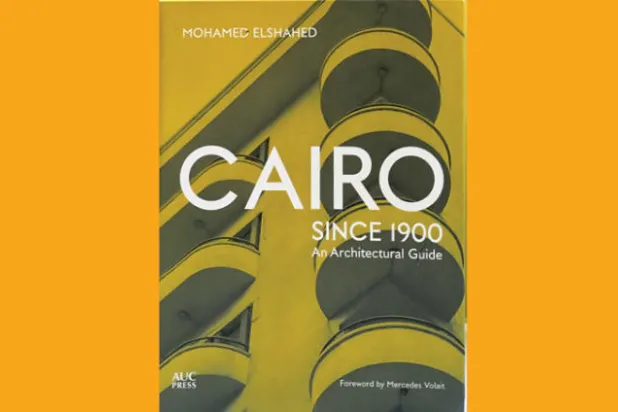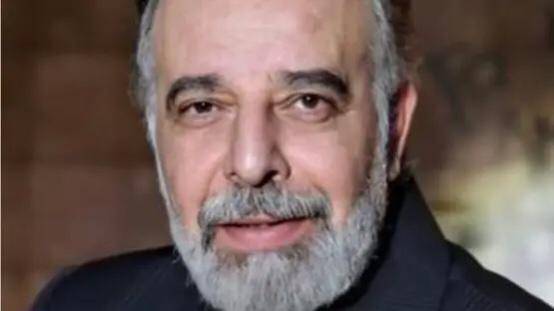يكاد الفعل الأدبي بمجمله يكون حنيناً لا مفرّ منه: إلى ماضٍ انقضى، أو أماكن ارتدناها، أو إلى أشخاص مروا بنا. ولعل مفتتح الحكايا الشعبيّة التقليدي: «كان يا ما كان في قديم الزّمان...» أبلغ تعبير عن ذلك التمازج العضوي بين ما يعرف اليوم بـ«النوستالجيا» وصنعة الأدب على تنوع أشكالها التعبيريّة، بل إن مفكرين غربيين معاصرين، مثل إريك ساندبيرغ، ذهبوا إلى الزعم أن الأدب هو في الخلاصة شكل فني يعبّر عن «النوستالجيا»، إن لم يكن عبر ارتباط صريح بماضٍ محدد؛ ففي الأقل على شكل عاطفة من الحنين والهوس بما قد كان، تجدها تتسرب من بين ثنايا النص.
وإذا كان في هذا الزّعم من مبالغة، فإن تاريخ الأدب في كل ثقافات العالم متخم بالنّصوص التي تتحدث عن الماضي، وشخصياته، وتحكي تعلقاً يكاد يكون مرضياً بأحداثه الفاصلة، وهو أمر لم تنج منه الثقافة الأدبيّة المعاصرة، رغم الوعي المتزايد بالأبعاد السلبيّة لظاهرة «النوستالجيا» عموماً، والمحاولات الرائدة لكثير من التيارات التقدميّة الرائدة لاستكشاف مساحات مستقبليّة وما ورائيّة لتجارب البشر بعيداً من سطوة التاريخ.
تغيّر معنى مصطلح «نوستالجيا» في العقدين الأخيرين، بعد أن بقي لمدة طويلة وصفاً لحالة أقرب إلى العصاب المرضي عن شعور ممض يغزو الأجساد حين يفرّ أصحابها من حاضرهم إلى الماضي، سواء بالخسارات التي تستعاد بما رافقها من انزعاج وحزن، وحتى باللحظات السعيدة التي يجتاحنا مزاج التفجّع لأنّها لم تعد موجودة في حياتنا. ولعل جذر الكلمة من اليونانيّة الذي يتكون من دمج مقطعين ليعطي معنى «استعادة الألم المرتبط بالحنين للوطن» تفسير كاف للثيمة العامة التي يحملها المصطلح.
لكننا الآن مدينون للرّاحلة سفيتلانا بويم بالتصور الأكثر تفهماً لـ«النوستالجيا» الذي بتنا نمتلكه الآن، وذلك بفضل محاولتها التأسيس لاستعادة علميّة للمصطلح من براثن التحليل النفسي والأمراض السيكولوجيّة، واستقراء الجوانب الأخرى الأعمق لارتباط الناس بصور الماضي، وذلك في كتابها الثمين «مستقبل النوستالجيا» (2001).

ووفق بويم، فإن «النوستالجيا» حنين لمنزل، أو حال، أوّل، لم يعد موجوداً أو متاحاً، أو إنّه لم يوجد قط، مما يعني أن النظر بلوعة وتشوّق إلى الماضي لا يعني بالضرورة تذكّر الماضي كما كان بالفعل، بل إعادة تشكيل كليّة له: حذفاً وحجباً، وتعديلاً وتشويهاً، بل وافتعالاً، في ضوء خبرتنا المعيشة منذ ذلك الحين، لتكون النتيجة أشبه بـ«يوتوبيا» مدينة فاضلة أكثر منها بتنقيب عن آثار قائمة بالفعل.... ماضٍ ليس ذهبيّاً بقدر ما هو ماض مذهّب.
واللافت فيما خلصت إليه بويم، ذلك الارتباط الوثيق والتزامن الذي يتجاوز حيّز العشوائيّة بين تفشي «النوستالجيا» وتعدد مظاهر الحنين إلى الماضي والأوقات التي يشهد فيها مجتمع معيّن مراحل من التفكك الاجتماعي والانقسام السياسي والمصاعب الاقتصادية؛ إذ يبدو أن «النوستالجيا» في شكلها الأكثر رجعيّة تقدّم للبشر اليائسين آليّة دفاع في مواجهة التسارع المطرد في إيقاعات الحياة، والاضطرابات السياسيّة وغياب الاستقرار.
ومع ذلك، فينبغي لنا ألا نقرأ هذه الظاهرة بوصفها شعوراً رجعيّاً محضاً، بل قد تكون حاملاً لتغيير جذري عبر توجيه الحنين إلى ماضٍ كان ممكناً لولا الوضع القائم، وبالتالي فهو ماضٍ يسير المرء نحو تحقيقه واقعاً في المستقبل عبر نقض الحالي. وهكذا؛ بدل أن يكون تفسيرنا لـ«النوستالجيا» في العمل الأدبي مقتصراً بالضرورة على أنّها محافظة وردّة، فإننا أقدر على استكشاف جوانب محتملة ذات طبيعة تغييرية وثوريّة، أي إن الأدب قد يشوبه حنين إلى الماضي يكون وقوداً لاندفاعة تستهدف تطويع الحاضر للحلم، ومواجهة الاستعمار أو الاحتلال أو الاستبداد. وقد طرح إدوارد سعيد هذه الصيغة البديلة من خلال التساؤل حول: «كيف تتخيل ثقافة تسعى إلى الاستقلال عن الإمبريالية ماضيها؟». ويخشى ديريك والكوت، في الإجابة عن سعيد، من أن «فقدان الذّاكرة يصبح التاريخ الحقيقي للعالم الجديد ما بعد الاستقلال».
لكن هذا النموذج الآخر الممكن لمعنى «النوستالجيا» في الأعمال الأدبيّة المعاصرة هو الاستثناء لا القاعدة، سواء أكنا نرصد الثقافة الغربيّة (لا سيّما بنسختها الأهم الأنغلوفونيّة)، أم حتى الإنتاج الفكري والفني في العالم العربي حيث الأعمال الأكثر شعبيّة تدور في فلك استعادة حالة وجود سابقة مثاليّة، أو ماضٍ ذهبي نبيل غير ملّوث بتعفّن اللحظة الحاضرة. فـ«النوستالجيا» اليوم، بكل تعقيدات أشكال الحنين إلى الماضي التي قد تتقمصها، تبدو بشكل متزايد أداةً لخدمة الأفكار الأكثر رجعية في السياسة اليمينية، ومخططاً ملهماً للتأكيد على، أو إعادة تأسيس، هياكل السلطة التي جرى تصوّرها بوصفها مهددة، أو بصدد الانهيار.
على أنّ الفصل بين وجهي «النوستالجيا» قد لا يكون حاسماً وجليّاً، بل قد تتصارع مشاعر الحنين إلى الماضي بين منحى رجعي وآخر تقدمي في منظومة جدليّة الطابع، لا يمكن إدراكها سوى في خضمّ عبور مناخ زمانيّ/ مكاني محدد، إذ لا تلبث تتحول إلى صيغة أخرى قد تكون نقيضة تماماً لدى الانتقال إلى مناخ آخر.
وإذا تناسينا التفسيرات المرتبطة بعوامل التحليل النفسي (الفردي والجماعيّ) لأسباب استعانة البشر بـ«النوستالجيا» أو وقوعهم تحت سطوتها، يتبقى هنا السؤال المركزي: لمَ نحتاج إلى أداة تستلهم آلام الماضي في التعبير الأدبي من حيث المبدأ؟
هذا التساؤل الذي نطرحه اليوم بمعرض رفاهيّة التحليل الأدبي كان مسألة جذريّة عند ظهور ما نسميها «الحداثة الغربيّة» التي قامت على أساس رفض التقاليد، وقادت تحولاً متعمداً ضد كل حنين إلى الماضي، ووصمت كلّ من تعلّق بصوره بـ«الرجعيّة» و«الجمود» و«الثورة المضادة». وقد سعت «الحداثة» فيما انبثق عنها من نتاج أدبي وفني (ومعماريّ) إلى تفكيك التسلسلات الهرميّة الموروثة في المجتمعات لمصلحة بنية جديدة، أكثر ارتباطاً بالعقلانيّة، وتقدم المعارف، وتوسع الآفاق. ومع ذلك، فإن محاولات الحداثة (الغربيّة) لابتداع الجديد انطلقت بشكل أو آخر من استدعاء القديم لنقضه، وهكذا تلّوث انشغالها بالمستقبل دوماً بمرجعيّات ونقاط انطلاق ماضوية، وتحول رفضها الصاخب والظاهر للتقليدي إلى احتفاء ضمني به بوصفه مكوّناً تأسيسياً للعالم الحديث.
يصف تي. إس. إليوت هذا التداخل (الجدّلي الطابع) بين «الحداثة» و«التقاليد» في كتابه «التقليد والموهبة الفردية» (1919) حيث يدافع عما يسميه «الحس التاريخي» الذي ينطوي ليس على تصور الماضي بصفته ماضياً فقط، ولكن على فهم وجوده بصفته استمراراً لهذا الماضي، حيث «المعنى التاريخي يجبر الإنسان على تجاوز (سجن) الكتابة مع مجايليه إلى الشعور بأن كل أدب أوروبا من هوميروس إلى كل أدب بلده وثقافته المعاصرين، له وجود متزامن، ويؤلف معاً نظاماً متزامناً» يحكم النتاج الأدبيّ.
ولعل أعمال الروائي الآيرلندي جيمس جويس، بحكم انشغالها بالقبض على اللحظة الراهنة في مدينة معاصرة، يفترض أن تكون الأكثر تحرراً من عقد «النوستالجيا» و«الماضي المذهّب»، لكن الواقع يقول إنها أفضل تمثيل لهذا الحس التاريخي المضمر في النصوص الحداثية والذي وصفه إليوت؛ إذ لا تبتعد أعماله كثيراً من التقاليد الأدبيّة الآيرلنديّة والأوروبيّة بوصفها إطاراً عاماً، وكل منها انعكاس متعمّد لعاطفة حنين إلى الماضي، أو إلى وقت مضى منذ ذلك الحين.
لاحقاً تحول دور «النوستالجيا» في «أدب ما بعد الحداثة» من موضع التأسيس إلى مربّع الاشتباك المباشر النقدي بالنظر إلى وعينا المتزايد بالطبيعة المتضاربة للذاكرة التاريخية التي تفسح المجال بسهولة للتزوير، والإسقاطات الخاطئة، والذاتية، والانفعال باللحظة الحاضرة. وتبدو «النوستالجيا» لنا اليوم أقرب إلى انعكاس واستجابة لحالتنا الحالية أكثر منها لحالاتنا الماضية، ويمكن لها أن تغير الطريقة التي نتصور بها ماضينا وبالتالي حاضرنا، دون أن تمنحنا القدرة على استعادة الماضي بالكامل، ليبقى كل جهد في هذا الاتجاه بمثابة بحث دائم «عن الزمن الضائع»؛ على حد تعبير الروائي الفرنسي مارسيل بروست.