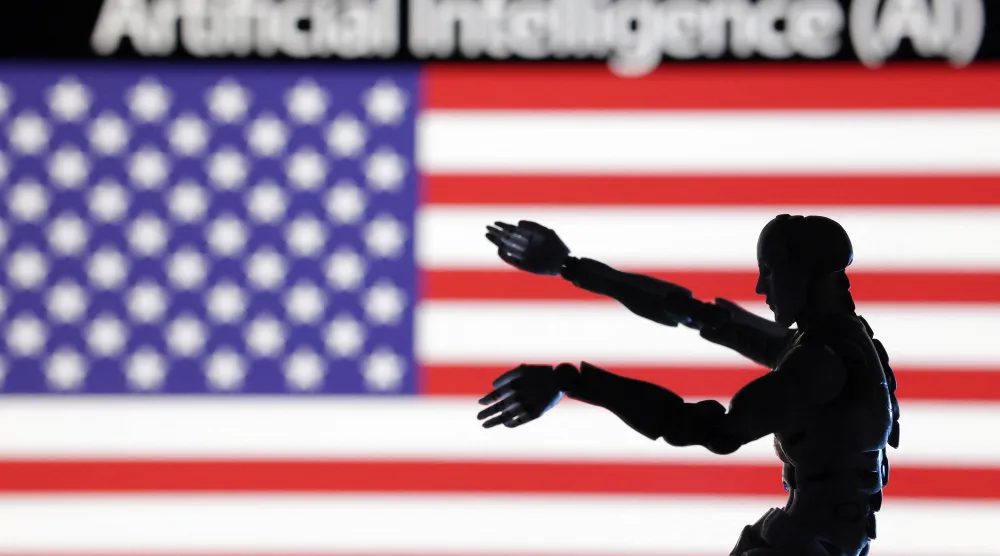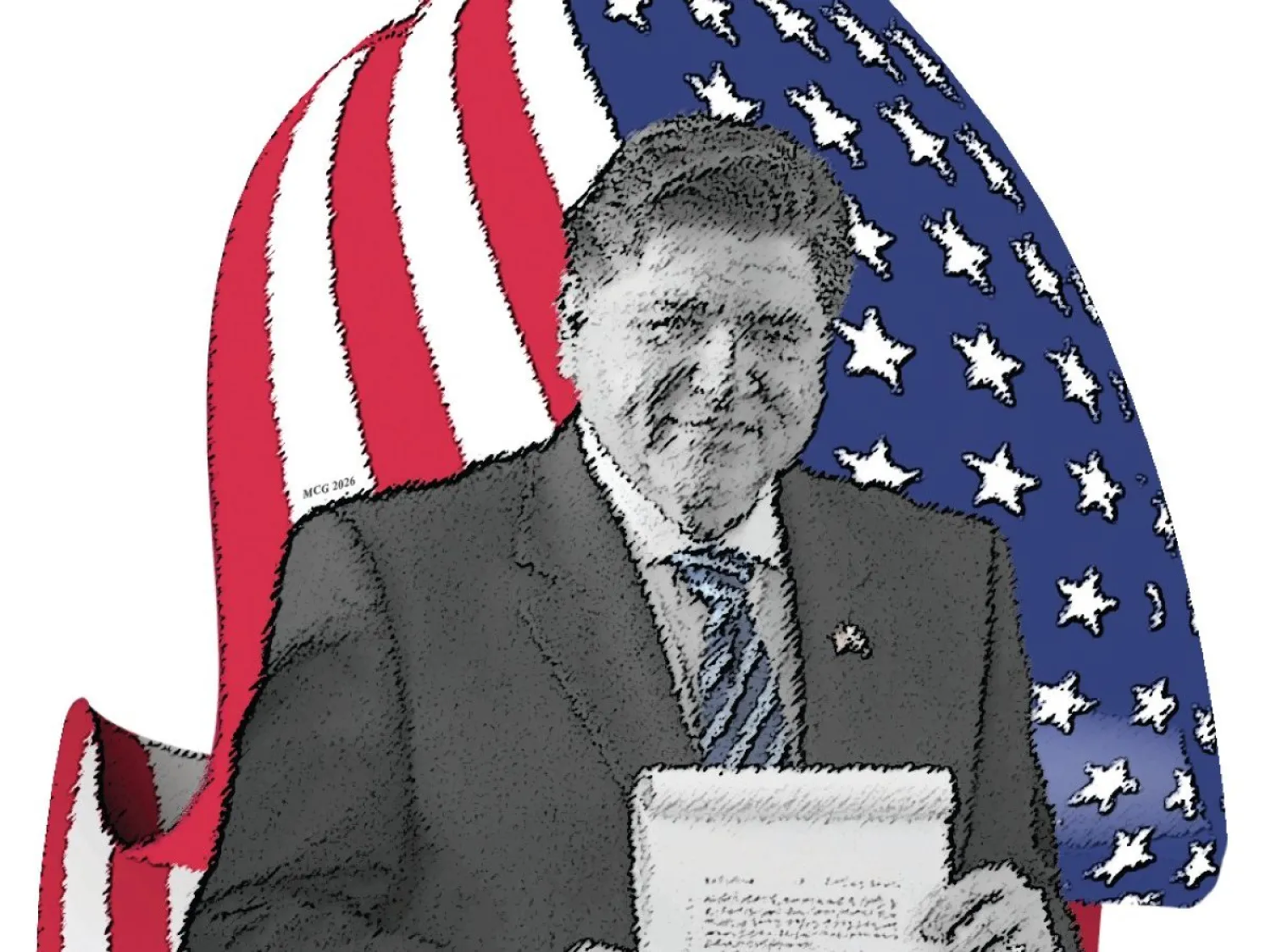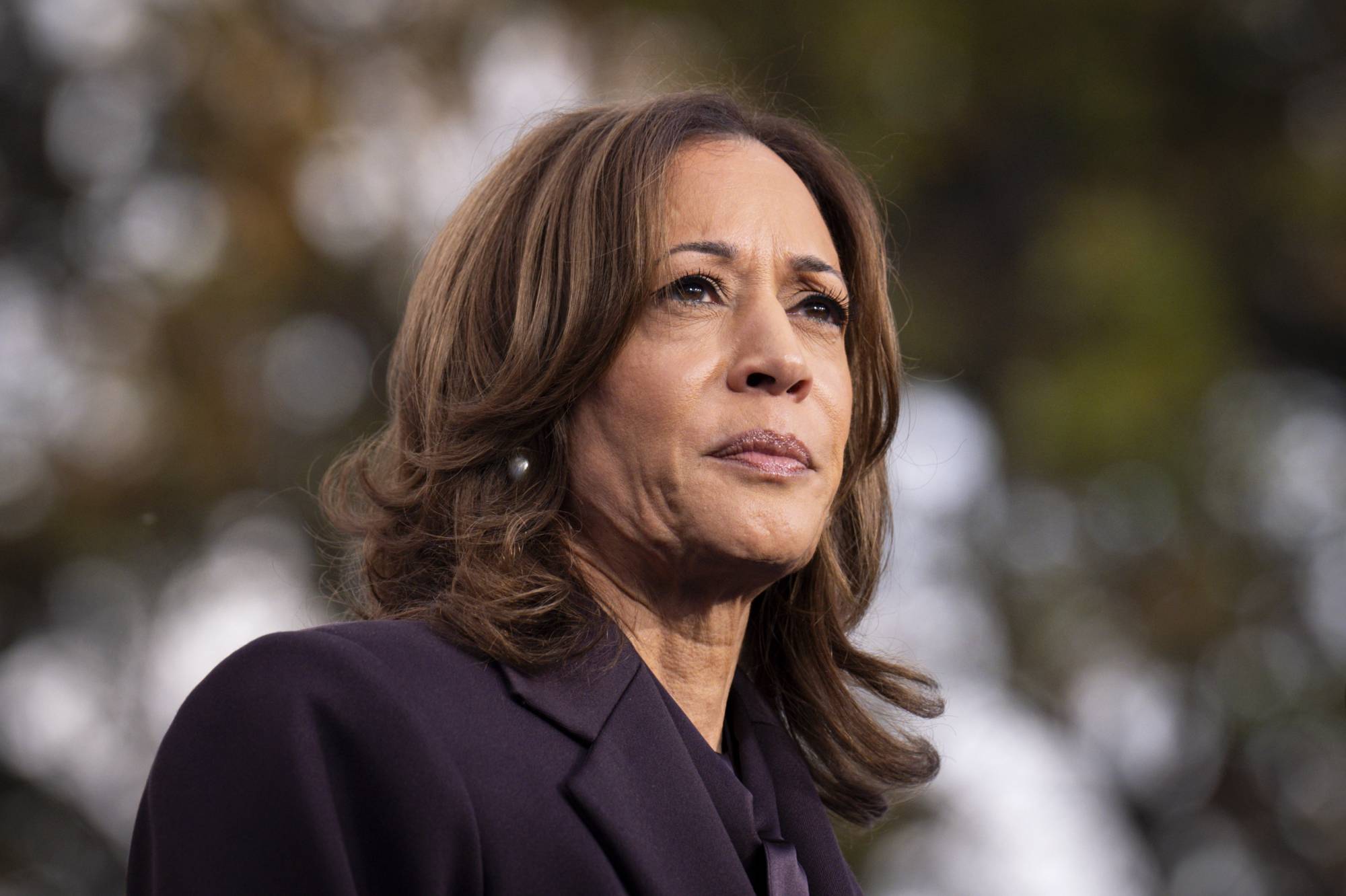انقطاع الغاز الروسي بشكل شبه كلّي عن ألمانيا منذ بضعة أيام، أدخل البلاد في متاهة من انعدام اليقين فيما يتعلق بأمن الطاقة. وكما كان يخشى كثيرون، أوقفت روسيا فعلاً ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط «نورد ستريم 1»، وأبقت على كميات ضئيلة جداً من الغاز الذي يصل ألمانيا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا.
على الرغم من أن هذا الانقطاع في الغاز لم يأت فجأة، فإن تأثيره لم يكن بالضرورة أقل. ذلك أنه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير (شباط) الماضي، كانت ألمانيا تستورد أكثر من 55 في المائة من غازها من روسيا. إلا أن هذه الكمية انخفضت إلى 34 في المائة في أبريل (نيسان) بعد دخول العقوبات الأوروبية حيّز التنفيذ وردّ روسيا بتخفيض واردات الغاز إليها، حتى وصلت في أغسطس (آب) الماضي إلى أدنى مستوياتها، ولم تتجاوز كمية الغاز الروسي الـ9 في المائة من حاجات ألمانيا من الغاز، قبل أن يتوقف تقريباً قبل أيام. ومع أن شركة «غازبروم» تقول، إن سبب وقف ضخ الغاز تقني ويعود لقطع يتعيّن على شركة «سيمنز» الألمانية إصلاحه وإعادته، فإن ألمانيا ترفض هذه الحجج وتؤكد أن السبب محض سياسي، أن روسيا أصبحت «شريكاً غير موثوق به» فيما يتعلق بالغاز.
أيضاً، شركة «سيمنز» الألمانية التي تصون الخط مع شركة «غازبروم»، نفت أن يكون هناك أي سبب تقني يعيق إعادة ضخ الغاز، وقالت، إن العطل يمكن إصلاحه بسرعة عبر أعمال الصيانة الدورية، ثم إنه تكرّر في السابق من دون أن يعيق إمدادات الغاز.
بغض النظر عن السبب، تظل النتيجة واحدة هي أن الغاز الروسي توقف. وبات السؤال الشاغل في ألمانيا، هل يمكن للبلاد أن تجتاز فصل الشتاء من دون الغاز الروسي؟
الحكومة الألمانية تعترف بأن التعايش مع وقف الغاز الروسي لن يكون سهلاً على ألمانيا، لكنها تؤكد أنها قادرة على اجتياز الأشهر المقبلة. ولقد كرّر المستشار الألماني أولاف شولتس هذا التطمين أمام «البوندستاغ» (مجلس النواب) هذا الأسبوع، قائلاً، إن الخطط التي اعتمدها ألمانيا في الأشهر الماضية وبدء تخليها عن الغاز الروسي عاملان ساعداها على الوصول إلى مرحلة مطمئنة. وللعلم، تستخدم ألمانيا الغاز في التدفئة بشكل أساسي وأيضاً لتشغيل المصانع الكبرى. وهي تنتج منه أقل من نصف حاجتها من الكهرباء، في حين تستند إلى موارد أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة.
في الواقع، تحاول ألمانيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا انتزاع نفسها تدريجياً من الحاجة إلى روسيا من دون أن تتسبب بالكثير من الضرر. وبدأ الوزراء في الحكومة والمستشار شولتس رحلات مكّوكية إلى دول العالم بحثاً عن موارد بديلة للغاز، من كندا إلى السنغال والجزائر. ولقد نجحوا بضمان واردات إضافية من النرويج التي باتت الآن مزوّد ألمانيا الرئيس بالغاز؛ إذ تصل نسبة الواردات من هناك إلى 38 في المائة، إلا أنها عندما حاولت أخيراً زيادة هذه الواردات اصطدمت برفض من النرويج التي أبلغتها بأنها الآن تورّد لها الغاز بطاقتها القصوى ويستحيل رفع هذه النسبة أكثر. وهكذا باتت هولندا موردها الأساسي الثاني؛ إذ تؤمّن الآن 24 في المائة من حاجات ألمانيا من الغاز.
> زيادة المخزون وترشيد الاستهلاك
من جهة ثانية، بالإضافة إلى استعداد الحكومة الألمانية لتنويع مصادر الغاز، فإنها عملت على زيادة مخزون البلاد من الغاز بسرعة، وحدّدت لنفسها مهلاً زمنية لملء الخزانات قبل فصل الشتاء. ومع أن سعة الخزانات المتوافرة الآن وصلت إلى أكثر من 86 في المائة فهي قد لا تمتلئ بأكثر بكثير من ذلك، رغم أن الحكومة تريد الوصول إلى نسبة 90 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كي تضمن مخزوناً يكفي لشهرين أو ثلاثة. ولكن قد يكون هذا الهدف صعباً الآن بعدما أوقفت روسيا ضخ غازها إلى ألمانيا كلياً.
في أي حال، يقول خبراء، إن ألمانيا قادرة الآن على اجتياز الأشهر القليلة المقبلة بالمخزون الموجود لديها الذي سيكون كافياً حتى فبراير المقبل على الأرجح، رغم أن الأمر يعتمد على مدى درجات برودة فصل الشتاء المقبل. ففي العام الماضي مثلاً، أظهرت أرقام رسمية بأن استخدام الغاز انخفض بنسبة 10 في المائة عن العام الذي سبق؛ لأن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدل.
وربما دفعت أسعار الغاز، التي كانت قد بدأت ترتفع قبل الحرب في أوكرانيا، مع زيادة الطلب عليها إثر إعادة الفتح بعد جائحة «كوفيد - 19»، بالمستهلكين لاستخدام كميات أقل من الغاز تفادياً لفواتير باهظة.
بعض الخبراء ينصحون اليوم الأفراد والمصانع بتقليص استخدام الغاز إلى حدود الـ20 في المائة، على الرغم من أن الحكومة الألمانية الاتحادية لم تصدر بعد قرارات بهذا الشأن، باستثناء تلك المتعلقة بالمقار العامة. ومع أن الحكومة تكتفي حالياً بالدعوة للاقتصاد في استخدامه، فإن ثمة تفكيراً جدياً الآن بإمكانية تقديم مكافآت للشركات التي ترشّد استهلاكه. وما يستحق الإشارة هنا، أن الحكومة قررت منع رفع درجات التدفئة داخل الابنية الرسمية إلى أكثر من 19 درجة مئوية، وتحاشي استخدام الماء الساخن في الحمّامات داخل تلك الأبنية والحمّامات العامة، وكذلك إطفاء أنوار المحال التجارية ليلاً. كذلك، اتخذت بعض الولايات إجراءات إضافية لتوفير الطاقة، مثل برلين التي بدأت إطفاء أنوار المعالم التاريخية ليلاً.
أيضاً، تراهن الحكومة على خزانات إضافية للغاز المُسال كانت أقرّت شراءها، والمفترض أن يصبح اثنان منها جاهزين بحلول نهاية العام. ويمكن لهذين الخزانين أن يزيدا من مخزون البلاد من الغاز المُسال، وبالتالي يؤمّنان حاجاتها لأشهر إضافية. ولكن هنا مشكلة أخرى، هي أن سعر استيراد الغاز المُسال من الولايات المتحدة وكندا بشكل أساسي، أعلى بكثير من سعر الغاز الآتي من روسيا والنرويج وغيرها من الدول التي يصلها الغاز منها إلى ألمانيا عبر الأنابيب؛ ما يعني زيادة العبء المالي على المستهلكين.
> وسائل طاقة بديلة
على صعيد آخر، دفع نقص الغاز الروسي بألمانيا كذلك للتفكير في وسائل طاقة بديلة كانت قررت التخلي عنها. من هذه الوسائل معامل الطاقة النووية التي كانت قرّرت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل إغلاقها بعد «حادث فوكوشيما» في اليابان عام 2011، رغم أن هذه المعامل النووية - وعددها 17 معملاً - كانت تنتج ثلث حاجة ألمانيا من الكهرباء لغاية العام 2011. وبالفعل، أغلقت هذه المعامل تدريجياً منذ ذلك الحين.
مقابل ذلك، عوّضت ألمانيا عن هذه الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بالغاز والطاقة المتجددة. وكانت ما زالت 6 معامل نووية تنتج الطاقة، أغلقت 3 منها نهاية العام الماضي، وكان من المقرر إغلاق الثلاثة المتبقية نهاية العام الحالي. وحتى قبل أيام قليلة بقي المستشار شولتس مصرّاً على أن تمديد حياة هذه المعامل أمر غير وارد، متحججاً بأسباب تقنية. وكرّر شولتز، أن قضبان الوقود التي تحتاج إليها المعامل للإنتاج كافية فقط لنهاية العام، وأن الحصول عليها عملية تستغرق 14 شهراً على الأقل. هذا، وتعرّض شولتز لانتقادات كثيرة بسبب تلك التصريحات ولتجاهله فكرة إبقاء المعامل النووية مشغلة بُعيد بدء الحرب في أوكرانيا. وقال منتقدوه، إن الحكومة لو بدأت البحث عن أسواق لتأمين قضبان الوقود في فبراير الماضي، لما كان الانتظار سيكون طويلاً.
> وزير الاقتصاد «الأخضر»
وحول هذا الأمر، بعدما ظل شولتس يستبعد العمل بهذه المصانع الثلاث، عاد وزير الاقتصاد روبرت هابيك - المنتمي إلى حزب «الخضر» البيئي - إلى الإعلان قبل يومين بأن اثنين من هذه المعامل الثلاثة سيبقيان بـ«حالة جهوزية» بعد نهاية العام لاستخدامهما في حالة الطوارئ، من دون أن يعطي تفاصيل حول العوائق التقنية التي كان تذرّع بها المستشار. ويعني قرار هابيك هذا أن صيانة معملين من هذه المعامل الثلاثة ستستمر، وسيكون المعملان جاهزين للعمل ولكن من دون أن ينتجا كهرباء؛ ما تسبب بموجة انتقادات واسعة من قبل المعارضة وخبراء في الطاقة النووية.
وحول هذا الجانب، نقلت صحيفة «راينشيه بوست» عن الخبيرة في الطاقة كلاوديا كمفرت قولها، إن هذا القرار «باهظ الكلفة ويستغرق الكثير من الجهد بشكل لا يوازي المنافع». ونقلت صحيفة «بيلد» عن الخبيرة النووية أنا فيرونيكا فاندلاند قولها، إن كلفة صيانة معمل واحد يومياً تناهز الـ250 ألف يورو، أي أن إبقاء المعملين في حالة جهوزية من دون استخدامها لإنتاج الطاقة يكلف يوميا قرابة الـ500 ألف يورو تصرفها الحكومة من أموال دافعي الضرائب. ورأت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم في لقاء مع «القناة الألمانية الثانية»، أن قرار إبقاء المعامل النووية في حالة تأهب من دون استخدامها لإنتاج الكهرباء «هو أسوأ الحلول الممكنة».
أما على الصعيد السياسي، فقد انتقد زعيم المعارضة فريدريك ميرتز - الذي خلف ميركل في رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - قرار الوزير هابيك ووصفه بـ«الجنون»، متهماً الحكومة بالقيام بالقليل للمساعدة في احتواء ارتفاع الأسعار وغياب أمن الطاقة. ويدعو ميرتز منذ أشهر إلى تمديد العمل بالمعامل النووية والتخلي عن الالتزام بمهلة نهاية العام لإغلاقها، لكن المستشار شولتس رد متهما ميركل باتخاذ قرار «إغلاق المعامل النووية ومعامل الفحم من دون إيجاد بدائل».
جدير بالذكر، أن وزير الاقتصاد هابيك اتخذ القرار «الوسطي» هذا، أمام تزايد الضغوط السياسية عليه من المعارضة ومن داخل الحكومة. فهذا الوزير «الأخضر» الملتزم بحماية البيئة يعارض الطاقة النووية من منطلق آيديولوجي، بينما يروّج الحزب الديمقراطي الحر - الصديق لمجتمع الأعمال، والشريك الثالث في الحكومة مع الاشتراكيين و«الخضر» - منذ بداية الحرب في أوكرانيا إلى الإبقاء على المعامل النووية واستمرار إنتاج الكهرباء منها للتعويض عن كميات الكهرباء التي كانت تنتج من الغاز.
وحقاً، تتكرر دعوات وزير المالية كريستيان ليندنر، المنتمي إلى الديمقراطيين الأحرار، للإبقاء على المعامل النووية الثالثة، ولكن ليس في حالة تأهب فقط، بل في حالة نشاط كامل. ولقد قال ليندنر لصحيفة «تسودويتشه تسايتونغ» قبل يومين، إن الإبقاء على المعامل الثلاثة «يؤمّن استقراراً في الشبكة... ولا يجوز أن نكون انتقائيين كثيراً، بل علينا القبول بما يسهل حياتنا فعلياً واقتصادياً».
وعليه، بانتظار مرور أشهر الشتاء الصعبة، بدأت منذ الآن ألمانيا إعادة تقييم كامل لعهد أنجيلا ميركل، المستشارة التي أيقظت ضمير الأمة بفتحها الباب أمام اللاجئين السوريين، لكنها تواجه اليوم اتهامات بأنها أوصلت ألمانيا إلى مكان تحولت فيه فعلاً إلى «أسيرة لروسيا» كما وصفها دونالد ترمب عام 2018.
> سباق بين الأحزاب الألمانية على البدائل والأولويات
عدا عن الجدل الثائر في ألمانيا حول الطاقة النووية، عاد الجدل أيضاً حول استخدام الفحم الحجري الذي كانت ألمانيا قد تعهدت بوقف استخدامه لإنتاج الطاقة بحلول العام 2030؛ بهدف الوفاء بالتزاماتها البيئية.
بيد أن الحكومة أولاف شولتس الائتلافية أقرّت تمديد العمل ببعض معامل الفحم الحجري الأحفوري التي كان من المفترض أن تتوقف عن العمل قريباً، رغم أضرارها البيئية الكبيرة. ومع ذلك تصرّ الحكومة بأنها ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها البيئية.
وزراء الحزب الديمقراطي الحر داخل الحكومة الائتلافية الحالية يدعون إلى أكثر من ذلك بعد، ويريد «عميدهم» وزير المالية كريستيان ليندنر أن تناقش ألمانيا بشكل جدّي مسألة التنقيب عن الغاز بهدف تغيير القوانين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، والتي تمنع ما يعرف بـ«تكسير» الصخر للوصول إلى الغاز، بسبب مخاطر بيئية. ويقول الديمقراطيون الأحرار استناداً إلى تقارير من متخصصين بيئيين، إن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تكسير الصخر للوصول إلى مخزون الغاز يمكن السيطرة عليها. ومن هذه المخاطر تلويث المياه الجوفية والتسبب بهزات أرضية.
في المقابل، يرفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم وحزب «الخضر» مجرّد الخوض في هذا النقاش. لكن الديمقراطيين الأحرار يلقون في هذا الأمر تأييداً من الديمقراطيين المسيحيين، مع أن زعيمة الديمقراطيين المسيحيين السابقة والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل هي التي مرّرت قانون منع التنقيب عن الغاز. هذا، ويقدر خبراء أن مخزون الغاز في ألمانيا يمكن أن يكفي حاجاتها لـ5 أو 10 سنوات مقبلة، حسب نوعيته. وهذا تحديداً ما يدفع معارضي التنقيب لرفض النقاش في الفكرة. وهؤلاء يقولون، إن نوعية وجودة هذا الغاز غير معروفتين، والاختبارات التي ستجرى عليه ستستغرق سنوات وقد تتوصل إلى أنه غير صالح للاستخدام بسبب جودته المتدنية.
> حزمة مساعدات حكومية للتخفيف من المعاناة المرتقبة
مع احتدام الجدل حول سبل تعويض النقض في الغاز الروسي، والبحث عن بدائل بأسعار معقولة، تستمر الفواتير بالنسبة للمستهلكين الألمان بالارتفاع. ووفق التقارير المتداولة، أصبح العديد من الأعمال والمحال الصغيرة مهددا بالإفلاس بسبب العجز عن دفع الفواتير التي ارتفعت معدلاتها 3 أضعاف على الأقل خلال الأشهر الماضية، وتواصل ارتفاعها.
وفعلاً أقرّت الحكومة الاتحادية الألمانية حزمتَي مساعدات حتى الآن لمحاولة تخفيف العبء على المواطنين وأصحاب الأعمال، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة - في الوقت نفسه الذي يرتفع فيها التضخم ووصل إلى 8 في المائة الشهر الماضي - يعني أن هذه المساعدات لا تحدث فارقاً كبيراً. وحتى الآن لا يبدو أن الحكومة تخطط لمساعدات يمكنها تنتشل شركات مهددة بالإفلاس.