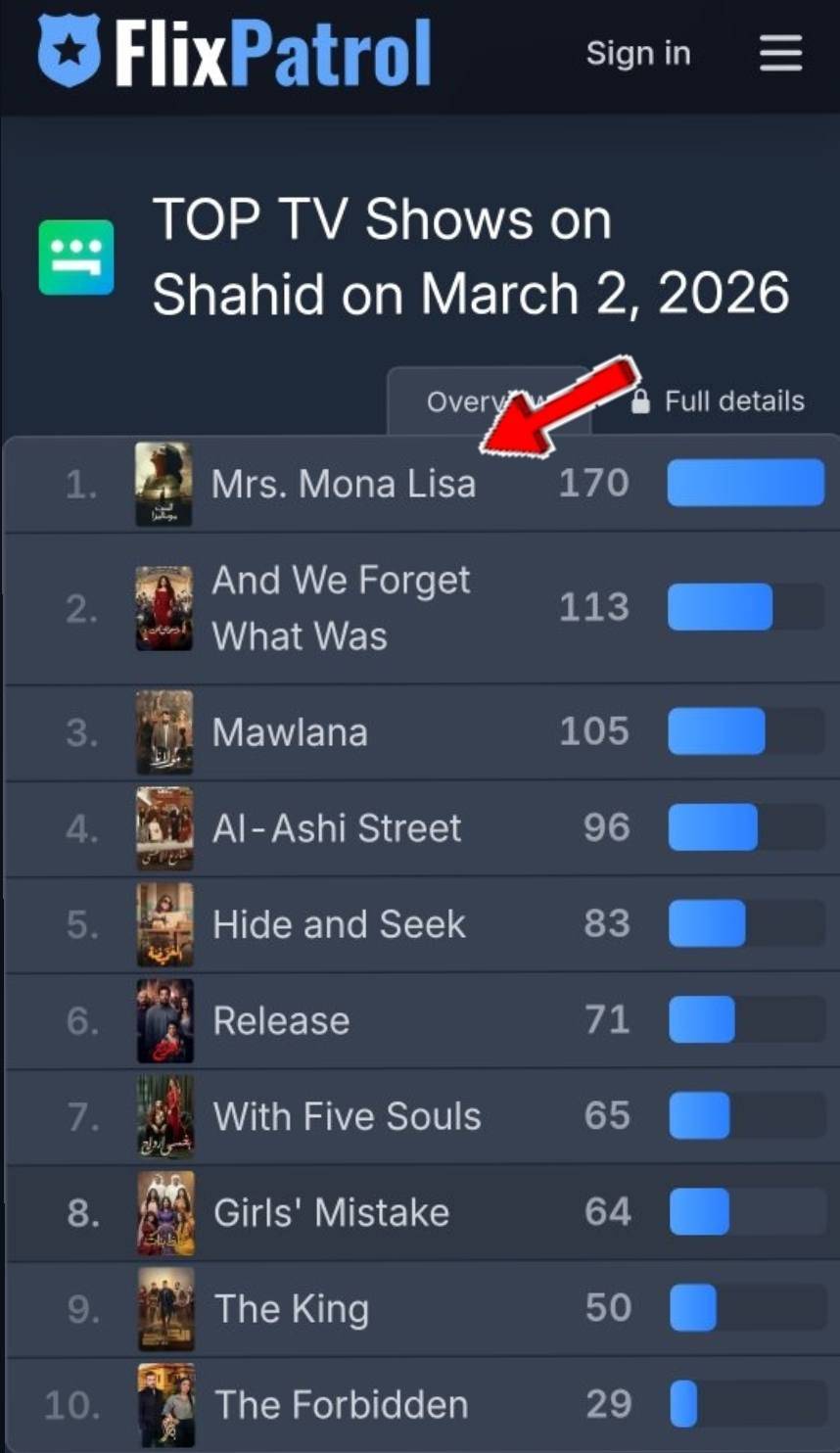اتَحضر الكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور إلى ذهن الكثيرين، وأنا أحدهم، بوصفها روائية تجلّت أهميتها في أعمال مهمة مثل «ثلاثية غرناطة» و«الطنطورية» وغيرهما. لكن على الرغم من ذلك الحضور الروائي المهم والمنتشر، فإن البعض يدرك أنها كانت إلى جانب ذلك ناقدة وأستاذة أدب إنجليزي لها إسهاماتها في مجال النقد والبحث أيضاً.
ومع أني كنت ممن أدركوا ذلك الجانب النقدي لدى عاشور إلى جانب معرفتي وإعجابي الشديد بإبداعها الروائي، فقد فوجئت قبل أشهر بأن لرضوى كتاباً بدا لي رائداً في مجالٍ نقديٍّ تَطوَّر في الغرب ويبدو أن أحداً لم ينتبه إلى أن عاشور، تلك الطاقة الإبداعية الكبيرة، كانت في ذلك الكتاب سباقة إلى ذلك المجال النقدي والبحثي الذي تنامى منذ ثمانينات القرن الماضي على يد نقاد آخرين جلهم يعودون إلى أصول آسيوية أو غير غربية عامة. أقصد الدراسات ما بعد الكولونيالية. في كتاب بعنوان «التابع ينهض: الرواية في غرب أفريقيا» نُشر عام 1980 وأعادت «دار الشروق» نشره عام 2016، تتناول عاشور الرواية الأفريقية موظِّفةً منذ العنوان عبارةً لطالما التصقت في الأذهان بالناقدة والمفكرة الهندية تشاكرافورتي غاياتري سبيفاك: «هل يستطيع التابع أن يتكلم؟» (Can the Subaltern Speak?). ذلك هو العنوان الشهير الذي جاء مع مقالة لسبيفاك التي هاجرت منذ الستينات للدراسة والاستقرار في الولايات المتحدة حيث تشغل الآن منصباً أكاديمياً رفيعاً في جامعة كولومبيا. نشرت سبيفاك مقالتها عام 1988، أي بعد كتاب عاشور بثمانية أعوام. لكن بين المقالة والكتاب فروق مهمة يجب ألا تُغفل.
أول تلك الفروق أن عاشور في كتابها ليست معنية بالتنظير النقدي، على الأقل بالقدر الذي تفردت به سبيفاك وغيرها من نقاد ما بعد الكولونيالية. كتاب عاشور يتركز على النقد الروائي الذي تقدم منه نماذج مميزة دون شك، لكن دون تأطير نظري كافٍ يحلها في موقع الريادة لمجالٍ تَطوَّر في ذلك الحين وبسرعة هائلة.
ثاني تلك الفروق يتصل بأن مقالة سبيفاك الشهيرة تتركز، إلى جانب التنظير، على النقد النسوي الذي أضافت إليه بعداً ما بعد كولونيالي أو ما بعد استعماري من الزاوية النسوية بصفة خاصة لم يكن مطروحاً بقوة في تسعينات القرن الماضي. ليست عاشور معنية بالنقد النسوي في كتابها لا من حيث المرأة بوصفها كاتبة ولا من حيث هي موضوع للكتابة.
هذان فرقان مهمّان لكنهما لا يقللان بحال من أهمية كتاب الناقدة العربية المصرية. هو كتاب مهم ومشكلته الوحيدة أنه لم يُترجَم إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو يُكتَب بأيٍّ من تلكما اللغتين –اللتين تتقن عاشور منهما الإنجليزية على الأقل كونها أستاذة أدب إنجليزي. وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى ما أدى إليه في حال أعمال أدبية ونقدية وفكرية عربية كثيرة لم تتسع لها دائرة التلقي. وكان يمكن لكتاب عاشور أن تكون له أصداء أوسع ويكون لمؤلفته دور ريادي أو شراكة على الأقل في ريادة حقل كان من رواده ناقد عربي آخر، إن لم يكن أهم رواده، هو إدوارد سعيد الذي كتب بالإنجليزية وحقق شهرة واسعة ليس في الغرب وحده وإنما في العالم. ولا أدري إن كان سعيد قد اطّلع على كتاب رضوى عند نشره، ومن المؤكد أنه لو اطلع عليه لذكره وأشاد به.
غير أن كتاب «التابع ينهض» لا يخلو مع ذلك من رؤى نقدية لافتة ضمّتها مقدمتان إحداهما ذات بعد نظري عام والأخرى تتصل بموضوع الكتاب. في الأولى تشير المؤلفة إلى الرواية الأفريقية وما أحاط بها من سوء الفهم أو سوء التناول سواء من النقاد الغربيين أو من الكتاب الأفارقة أنفسهم. فهناك تحيز غربي حدَّ من تلقي تلك الرواية بالصورة الصحيحة، كما أن هناك انحيازاً أفريقياً لدى بعض الكتاب الأفارقة توخى إرضاء الذائقة والفهم الغربيين. فالغرب، من ناحية وباستثناءات محدودة، تجاهل الرواية الأفريقية بصفة عامة أو نظر إليها نظرة دونية باستثناء تلك التي أرضت فرضياته القبلية حول القارة السوداء، والأفارقة، من ناحية أخرى، كما في رواية الكاتب المالي يامبو أولوجوم «واجب العنف» (1968) استجابوا لتوقعات المتلقي الغربي بتصوير أفريقيا تصويراً مشوهاً يجعلها مسرحاً تأصل فيه العنف والفحش، حسب عاشور. وكان فوز الرواية بجائزة أدبية فرنسية، كما تشير الناقدة المصرية، دليلاً على تحيز غربي تجاه أفريقيا، وتشير في ذلك السياق إلى مفهوم «العالمية» الذي تراه مسؤولاً إلى حد بعيد عن أحكام نقدية تأبى أن تتعامل «مع أدب سياسي إلا على أنه (أدب دعائي)، بسبب التمسك ببعض المفاهيم الأدبية الشائعة كمفهوم العالمية الذي يقصد به الناقد دائماً ما هو مشترك بين أبناء العالم الأوروبي الأميركي...». ثم تضيف سبباً آخر يتصل بالبعد «الشديد عن الواقع التاريخي الذي أنتج هذا الأدب وعدم بذل الناقد ما يكفي من جهد لفهمه».
هذه الآراء تصب في ذات السياق الذي سار فيه النقد ما بعد الكولونيالي سواء عند إدوارد سعيد أو سبيفاك أو هومي بابا أو غيرهم من أساطين ذلك النقد. الأقرب إلى عاشور، والذي أيضاً لم ينل نصيبه من التقدير في تطوير النظرية ما بعد الكولونيالية، هو الروائي والناقد الأفريقي نغوغي واثيونغو الذي أكد حتى في نصوصه النقدية المكتوبة بالإنجليزية، التي أُتيح لي أن أترجم أحدها، أنه سبق إلى الكثير من أطروحات النقد الما بعد كولونيالي لكنّ ذلك لم يُلتفت إليه. يشترك واثيونغو مع الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي وكتاب أفارقة آخرين إلى جانب رضوى عاشور في مساءلة مفاهيم قارَّةٍ في الثقافات الغربية –وغير الغربية- لا سيما النقد الأدبي المؤسَّس عليها مثل العالمية وقيمة أدب العالم الثالث، وأثر الاستعمار أو الإمبريالية على الثقافة. وليس هؤلاء متفقين على وجهات نظر في كل تلك المسائل. فأتشيبي مثلاً يختلف مع واثيونغو في أهمية اللغة الأوروبية الموروثة من عهود الاستعمار: يرى الكاتب النيجيري أن الإنجليزية صارت إرثاً للمستعمر (بفتح الميم) ولم تعد حكراً على من جلبها إلى البلاد التي وقع عليها الاستعمار وأن من حقه نتيجة لذلك أن يكتب بها. ويرى واثيونغو غير ذلك. لذا أصر الأول على الاستمرار في الكتابة بالإنجليزية والثاني على كتابة رواياته باللغة المحلية (ليترجمها لاحقاً إلى الإنجليزية). ولعل ذلك يذكّرنا بما يراه بعض الكتاب العرب الفرانكوفونيين حول الكتابة بالفرنسية.
ليست عاشور معنية بهذه القضايا، ربما لأنها غير مطروحة بقوة في الثقافة العربية، فباستثناء الأدب الفرانكوفوني والأنغلوفوني اللذين يمثلان حضوراً لافتاً فإن قضية اللغة ليست قضية أساسية أو رئيسية لدى الكتاب العرب عامةً كما هو الحال في الآداب الأفريقية. لغة الأدب العربي لغة عربية وليس الأمر موضوعاً للنقاش.
أمر آخر يلفت النظر في عنوان كتاب عاشور: أنها معنية بالنهوض وليس بالكلام. ففي حين تُعنى سبيفاك بمسألة تعبير التابع، أو المستعمَر، عن ذاته وقدرته على الاحتجاج، ما يهم عاشور هو النهوض، وهو قضية كبرى تشغل بال مثقفي العالم غير الغربي، أي نهوض بلادهم، القضية التي تراها عاشور مركزية في الرواية الأفريقية بصفة خاصة. ومع أن مسألتَي القدرة على التعبير والنهوض متلازمتان فإن مما لا يخلو من الأهمية إبراز إحداهما دون الأخرى. سبيفاك المعنية بالمرأة تشير إلى إشكالية جندرية في حين أن عاشور المعنية بالوضع الحضاري العام، بالنهوض، تبرز ما تراه أكثر حيوية وأهمية. ولكن الناقدة المصرية استطاعت على أي حال أن تبادر إلى ما كان حالة كامنة تنتظر الظهور.