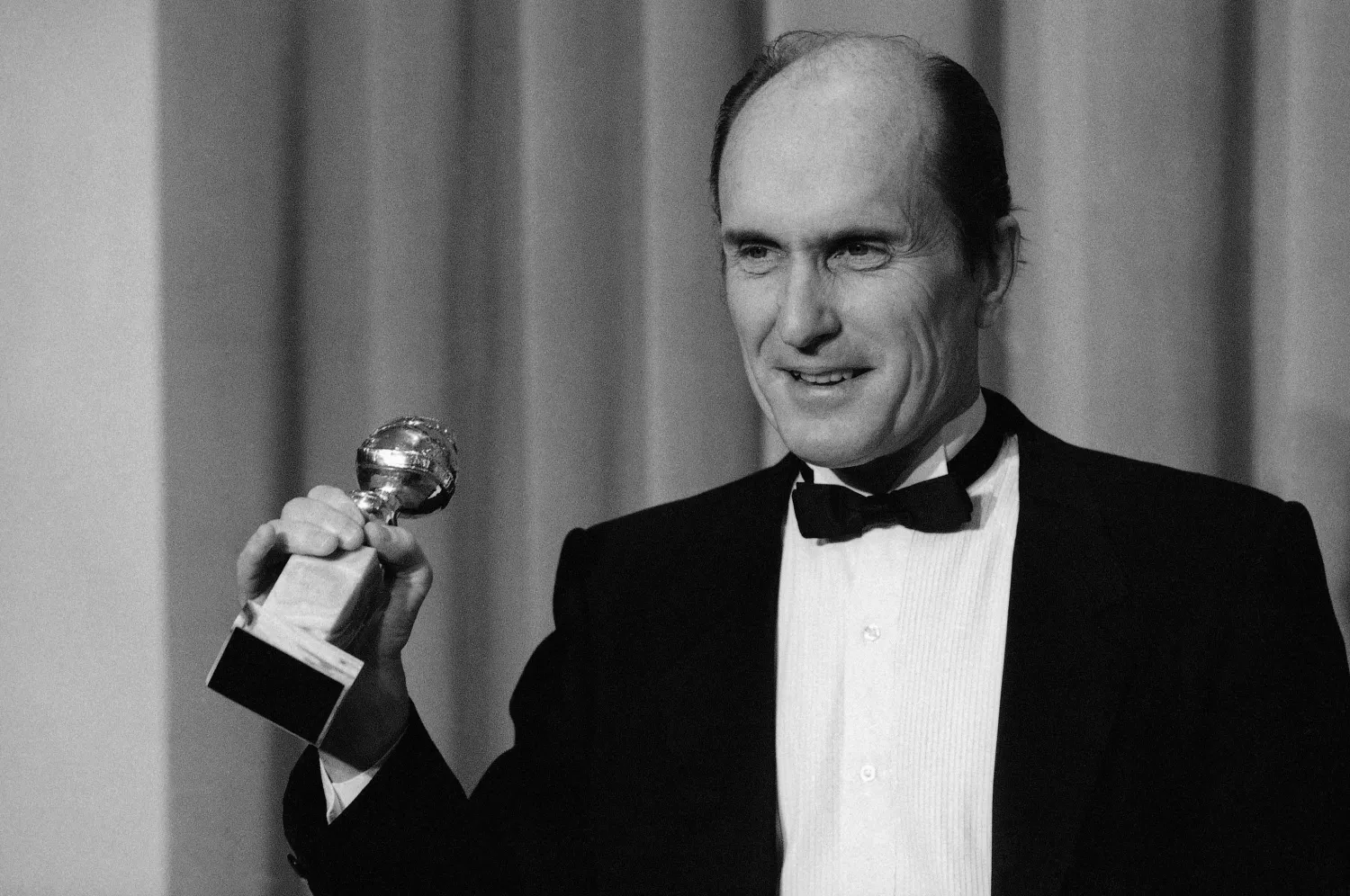في ستينات القرن الماضي، كانت الطرق التي تربط مدينة أميركية بأخرى تبدو، من نظرة علوية، كما لو كانت افتتحت بالخطأ. قليلة هي السيارات التي تمر فوقها. قليلة هي البلدات التي تمر بها. قليلة هي الحياة التي تمر عبرها.
هذا الوضع كان أكثر ظهوراً ودلالات في الولايات الوسطى والغربية مما كانت عليه في الشرق الأميركي. لكن في الواقع، خذ سيارتك النيو فييستا ST وانتقل من تشاندلر، غير البعيدة عن محيط مدينة فينكس (ولاية أريزونا) وقدها لنحو ساعة وعشر دقائق صوب البلدة الصغيرة كوليدج لتجد نفسك وحيداً على الطريق لمسافات بعيدة.
ليلاً؟ أنت بالتأكيد وحيد لمعظم هذه المسافة.
في عام 1960، عندما قام عبقري سينما التشويق ألفرد هيتشكوك بتحقيق «سايكو» وظّف هذه الحقيقة على نحو فريد. جانيت لي تقود سيارتها هاربة من فينكس بما خطفته من مال الشركة التي تعمل فيها. إنها بطلة الفيلم، وأن تكون مجرمة في فيلم يحققه هيتشكوك أمر لا نفع فيه بالنسبة له. لذلك نراها وقد أخدت تفكر في عاقبة ما قامت به (على الرغم من بعض الحوافز التي يمكن الاستناد إليها كمبررات). لكن تحقيق هذه الانعطافة لن يتحقق.
كانت قادت سيارتها نهاراً إلى أن وصلت إلى فندق منبسط من طابق واحد، يديره شاب (أنتوني بيركنز) ليلاً، فقررت المبيت فيه. تدخل حمام شقتها. تدخل عليها امرأة. لا نراها مطلقاً لكن هناك طيفاً شبحياً لها، وتنهال عليها طعناً بسكين طويلة.
تخرج المرأة. يدخل الشاب وينظر وراءه: «ما... لماذا فعلت ذلك؟». لاحقاً ما نعرف أن الشاب وأمه جسد واحد.
هذا هيتشكوك في واحدة من قممه ولديه أخرى، لكن بعض المختلف هنا كان شديداً: «سايكو» لم يشبه فيلم رعب آخر في التاريخ، لم يشبه أي فيلم آخر لهيتشكوك. سببان لذلك: قتله بطلة الفيلم (عادة ما تعيش المخاطر حتى لما بعد انتهاء الفيلم) وغياب المتهم - البريء.
كان هيتشكوك، المولود في منتصف سنة 1899. ما زال في الرابعة عشر من عمره عندما كتب والده الكاثوليكي المتزمت رسالة إلى صديقه رئيس البوليس في إحدى ضواحي إيست لندن طالباً منه حبس ابنه في زنزانة، لخطأ لا يستدعي العقوبة.
لن ينسى هيتشكوك هذه الحادثة التي ارتُكِبت بحقّـه. الخوف الذي تعرّض إليه من دون فهم لحقيقة ما حدث ولماذا. لاحقاً تسببت في صياغة بعض موهبة هيتشكوك؛ فإذا به يدفع إلى الأمام في غالبية أعماله لما قبل «سايكو» بتيمة المتهم - البريء الذي لم يرتكب ذنباً، والذي يطارده البوليس باحثاً عنه.
بعد وفاة والده، ترك ألفرد الدراسة الكاثوليكية ودخل معهداً لدراسة الهندسة الميكانيكية التي كان أبدى شغفاً بها منذ صباه، ثم اتجه إلى العمل في شركة لأعمال الكايبل والتلغراف، اسمها «هانلي»، كما دخل مدرسة أخرى بعد الدوام حيث ألم بالرسم والهندسة، ما جعله يقترح على الشركة استخدامه في مجال تصميم الدعايات.
بعد عام على اندلاع الحرب العالمية الأولى، سنة 1914، طُـلب هيتشكوك للتجنيد، لكنه أُعفي بسبب بدانته. ذات يوم تعرضت ضاحية ليتونستون التي كان يعيش ألفرد فيها مع والدته لغارات الطيران الألماني. دمار شديد وإحدى القنابل لم تكن بعيدة عن بيته. هرع لتفقد والدته، فوجدها في حالة رعب شديدة. ضع هذه الصورة التي حفظها هيتشكوك طوال حياته في البال عندما تشاهد بطلاته الخائفات وهن يصرخن في حالة هلع طالبات النجدة. إنها علامة أخرى من علامات التأثر الذي صاحب المخرج وميز أفلامه، كما الحال مع حبكتي «المتهم البريء» وعقدة الذنب، اللتين نجدهما في مختلف أعماله مباشرة، أو تحت خط المباشرة، في إيحاء مثير.
إلى ذلك، نكتشف أن وجود العائلة في الفيلم ميّز أعمال هيتشكوك عن الأفلام البوليسية الأخرى، حيث البطل عادة ما يكون شخصاً وحيداً لا علاقات عائلية له حتى تتمكن القصّـة المروية من حصره في الموقف المطلوب بذاته، ومن دون روابط. لكن حتى في أفلام هيتشكوك التي حوت شخصية رئيسية لا عائلة بادية من حوله، كما الحال في «شمال، شمال غربي»، فإن سعيه للارتباط بعلاقة عاطفية جادة هو سعي لتكوين عائلة. بطله في ذلك لا يختلف عن معظمنا. هذا وضع أساسي في أفلام كثيرة، له منها «النافذة الخلفية» و«ربيكا» و«غرباء في القطار»، لجانب «شمال، شمال غربي».
ما يختلف فيه هيتشكوك عن آخرين عمدوا إلى سينما التشويق واللغز كثيراً. هو النموذج الأفضل للنوع بأسره، لكن من بين تفاصيل هذا الاختلاف حقيقة أنه كان دائماً يجهر بمن هو القاتل الفعلي، على عكس الأفلام التي تخفيه وتعامله لغزاً، من دون أن يفقد التشويق قيد أنملة من مفاجآته.
«سايكو» إذ جاء مختلفاً (كذلك «فرتيغو» 1958، و«الطيور» 1963، و«حبكة عائلية»، فيلمه الأخير سنة 1976) لم يلغ شوق هيتشكوك لتفعيلة المتهم البريء. بل هي في طي أحداث هذا الفيلم بكل تأكيد. فالمشاهد، الذي يوهمه هيتشكوك بأنه مجرد متفرّج في البداية يجد نفسه وقد تحوّل إلى «بصباص» مشارك. ما قام به المخرج في هذا الشأن هو أنه قدّم صورة الشاب الذي يتحدث لجانيت لي بكل عفوية وطيبة في البداية، ثم يصوّره وهو يهرع ليرى ما حدث لها مؤنباً تلك المرأة التي دخلت وخرجت بسكينها سريعاً. يناديها: «ماما، ماذا ارتكبت؟». إلى ذلك الحين (نحو نصف ساعة من الفيلم) هو بريء مما تم ارتكابه. لكن ما هي إلا مشاهد قليلة لاحقة ويكبر دوره في الجريمة التي ارتكبت كما لو كان شريكاً، ثم يقودنا الفيلم ببراعة صاحبه إلى اكتشاف الشاب ارتدى ملابس والدته ليرتكب ما ارتكب. هو القاتل لكن هذه المفاجأة ليست كل شيء. هيتشكوك لديه أكثر من ذلك ليعرضه.
«فرنزي» (فيلمه ما قبل الأخير، وحققه سنة 1972) حمل آخر عناقيد تفعيلة المتهم - البريء والقاتل - الذي نعرفه - ولا يعرفه هو. جون فينش هو العامل في سوق الخضار جنباً لجانب صديقه باري فوستر الذي يرتكب الجريمة وهيتشكوك يمنح المحقق العجوز أليس مككووَن مشاهد ساخرة خارج نطاق القضية. مشاهد لدراسة سلوكية تمنح المشاهد بعض البسمة المتوترة.
مشهد الجريمة خنقاً واستخدام سلالم المبنى اللولبية (السلالم عقدة أخرى من عقد المخرج في أفلامه نراها كذلك في «سايكو») كشريك في حالة نفسية متوترة من تلك التي تُدرس كنموذج لكيفية تصميم المشاهد وتوليفها. وإذا ما أضفت مشهد نقل الجثة في أحد أكياس البطاطا إلى شاحنة، بعدما اكتشف القاتل أن يد الضحية تقبض على دبوسه المميز، خرج المشاهد من ذلك الفيلم وهو يختم بالعشرة على سنوات من الخبرة التي لا مثيل لها ولن يكون.
هيتشكوك لم يكن صياغة صدفية تمّت عن طريق دراسته المتخصصة في أحد المعاهد الكبيرة التي يتخرج فيها اليوم المئات، بل كان - كباقي عباقرة الفن السابع - موهبة اكتملت بفهم كامل العلاقة بين الصورة والمتلقي، وكيف يمكن للمخرج توظيفها بحيث يوجه الثاني ليصعد معه في رحلة لا يدري وجهتها، لكنه سيجد نفسه في مقعد أمامي طوال الوقت.
9:11 دقيقه
تفكيك ألفرد هيتشكوك من جديد
https://aawsat.com/home/article/2119151/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF



تفكيك ألفرد هيتشكوك من جديد
أدوات اللعبة من صنع تاريخه

- بالم سبرينغز: محمد رُضا
- بالم سبرينغز: محمد رُضا

تفكيك ألفرد هيتشكوك من جديد

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة