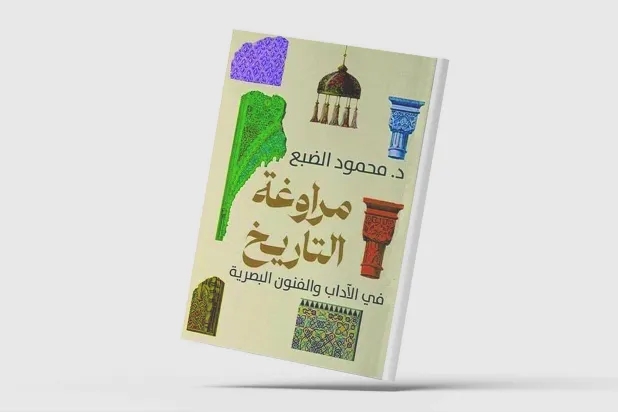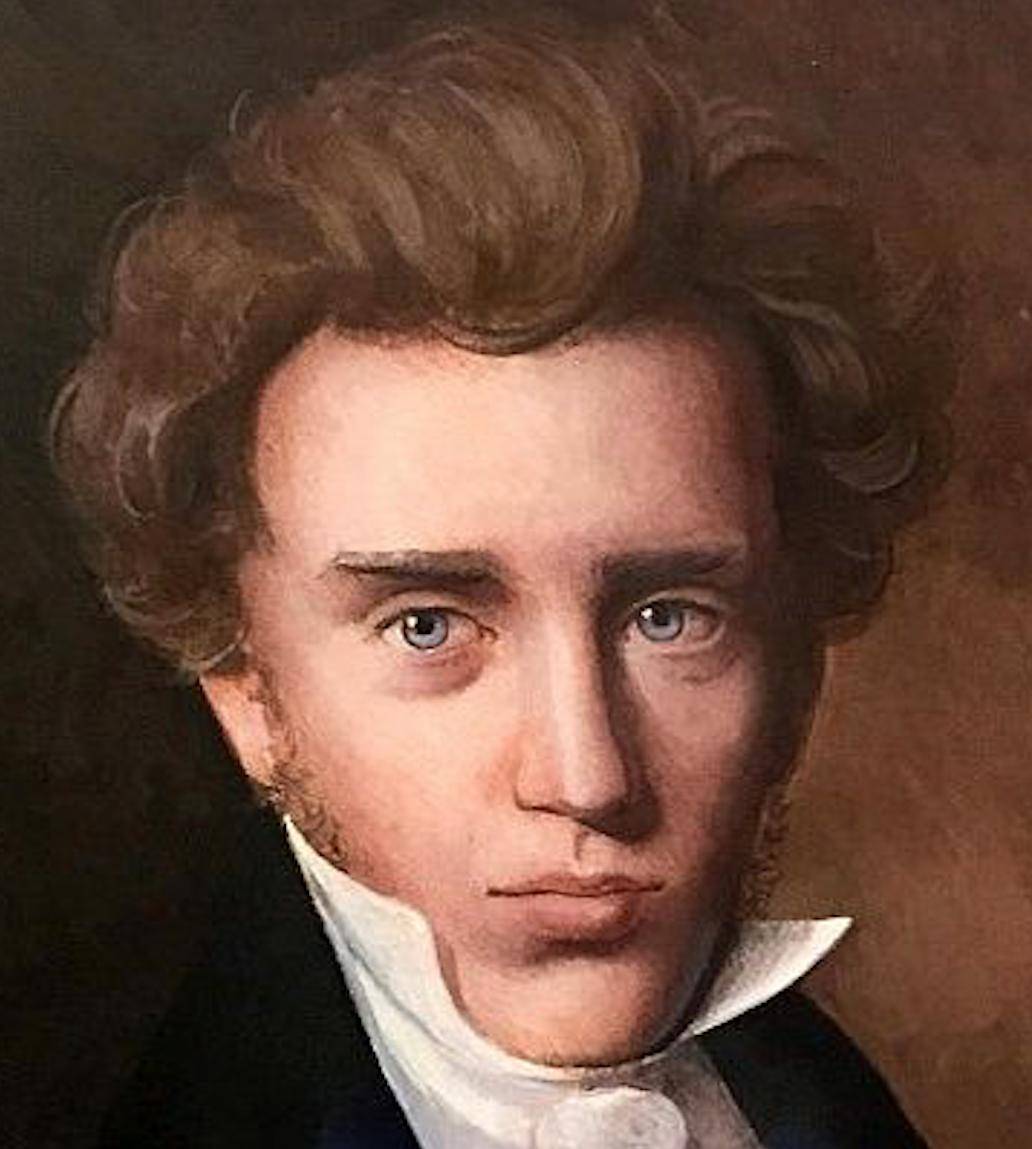صدر هذا العام كتاب بعنوان: «الطفل والفلسفة» عن دار أفريقيا الشرق، وهو من إعداد وتنسيق عبد الواحد أولاد الفقيهي. وهذا المؤلَف عبارة عن عمل جماعي قام به اثنا عشر من الباحثين وبمشارب تخصصية مختلفة، وهو ما أضفى عليه خصوبة؛ إذ تجد نفسك وكأنك تقرأ كتبا وليس كتابا واحدا. وما دام أن الكتاب متشعب فإننا سنقربه للقارئ في نقط محددة تعطي فكرة عامة عنه، وهنا بيان ذلك:
لقد اجتمع خبراء اليونيسكو في مارس (آذار) 1998 لمناقشة قضية الفلسفة والطفل، فتم تتويج ذلك بتقرير يحمل عنوان: «الفلسفة من أجل الأطفال»، وخلاصته أنه يمكن تعلم التفلسف منذ السنين الأولى لحياة الإنسان، بل تم إعلان أن الأمر مستحب لأسباب فلسفية وسياسية وأخلاقية وتربوية. فهل حقا يمكن ذلك؟ أم أن الفلسفة حكر على الكبار فقط؛ نظرا لطابعها «المجرد» و«المعقد» كما يلح البعض؟
لقد كثرت الإصدارات والدعوات والتجارب في الكثير من بقاع العالم تنادي بحق الطفل في الفلسفة، وبحقه في الدهشة والتأمل والشك والسؤال، فما مبررات التفكير في حاجة الطفل للفلسفة؟ أليس في ذلك إجهاض لبراءة الطفولة وتكسير للنمو النفسي والعقلي للطفل؟
إن الأمر يحتمل الوجهين، فهناك دعاة إمكانية إقحام الطفل في عالم الفلسفة؛ لأنه ذو خيال واسع، وهو بالفطرة فضولي وجريء ومغامر في أسئلته، وعلى العكس من ذلك، هناك من يرى أن الفلسفة ضد الطفولة، فهي تحتاج إلى النضج واستكمال القوى العقلية. فلننظر إذن في بعض من حجج كل فريق.
- الفلسفة لا تصلح للأطفال
يرى ديكارت أن الطفولة هي مرحلة بادئ الرأي، مرحلة السذاجة والاستقبال العفوي للمعارف، سواء باستخدام الحواس الخادعة أو بتلقي أجوبة المجتمع، فالطفل يكدس كمية هائلة من الأفكار التي هي في معظمها خاطئة وغير ذات أساس صلب؛ ولهذا فالفلسفة تأتي متأخرة، أي حينما يستكمل الفرد قواه العقلية التي تمكنه من التسلح بالمنهج الذي يمكنه من التخلص من كل زيف الطفولة.
إن الاعتراض الرئيسي لعدم القبول بممارسة الفلسفة من طرف الأطفال هو أن لهم نقصا معرفيا وذهنيا يحتاج إلى الوقت كي ينضج، فهم عاجزون على القيام باستدلالات منطقية صورية ومجردة يحتاج إليها التفكير الفلسفي بالضرورة. إضافة إلى أن الفلسفة تحتاج إلى ما يسمى «الأشكلة» وهو مستوى عال من التفكير يجعل المتفلسف يضع القضايا في مفارقات غير محسومة الحل، وهو أمر كما نعلم متعب جدا، ويجعل الحياة غير مريحة ومقلقة، وهو ما يتنافى والطفولة الباحثة عن الاطمئنان والسكينة، كما تحتاج أيضا إلى ما يسمى «المفهمة»، أي التعامل مع المفاهيم وبالمفاهيم، وهي كلمات مكثفة ومشحونة بدلالات عميقة لا يقدر الطفل على استيعابها بله تفكيكها، كما تحتاج الفلسفة أيضا إلى ما يسمى «المحاجة»، أي أن الأطروحات الفلسفية لا تقدم عارية دون إقناع منظم وبكل صنوفه: المنطقية والبلاغية والنقلية. وهو ما لا يقدر عليه طفل لا يزال قيد النمو.
إن دعاة عدم صلاحية الفلسفة للأطفال يؤكدون على مسألة أخرى، وهي أن تدريسها فيه خطر نفسي عليهم، فزج الطفل مبكرا في مشكلات الحياة الكبرى هو إجهاض لنموه الطبيعي، فهو له الفرصة حين ينضج لاكتشافها، فتعليم الفلسفة للطفل هو تكسير لبراءته، ودفعه إلى إدراك، سابق للأوان، لمأساوية الحياة. ناهيك على أن الفلسفة ببرودها وجفائها وصلابتها المنطقية، ستكبح خيال الطفل وتهدم له أحلامه، أو بكلمة واحدة ستسرق له طفولته. لكن، ورغم ذلك، فإننا نجد المدافعين عن إمكانية تدريس الفلسفة للأطفال يرون في التهديد النفسي للفلسفة على الطفل أمرا مردودا، فالطفولة ليس كما يروج عادة وبشكل أسطوري أنها عالم براءة بامتياز، فالإنسان منذ أن يرى النور وهو يلقى به في عالم كله تهديد بالموت، وسؤال الموت هو السؤال الفلسفي الأول، كما أن الكثير من الأطفال يعيشون منذ ولادتهم القسوة، حيث يتعرضون للمجاعة والعبودية والشغل وزنا المحارم والبغاء وسوء المعاملة، كما قد ترميهم الأقدار في مناطق تعج بالحروب والاقتتال... وحتى إن وجد الطفل في بلد آمن وتوفر لديه العيش الكريم، فهذا لا يمنع أن يعيش تمزقا أسريا أو عنفا بين الآباء، أو موت الأقرباء... وكلها أمور تجعل الطفل يتساءل رغم أنفه، وهو ما يفرض من وجهة نظرهم تدريس الفلسفة كي يتطبع مع المشهد الإنساني الدرامي، ويكتشف أنه ليس استثناءً. لكن كيف يمكن تدريس الفلسفة للأطفال؟
- الطفل فيلسوف بالقوة
يعد الانطباع العام حول تعليم الفلسفة للطفل صادما وغير مستساغ؛ لأنه في الغالب يتم تصور الفلسفة على أنها تمتاز بالتعقيد والغموض والتجريد وتحتاج إلى الجدية والحزم والصرامة، وتتطلب ملكات عقلية عالية، وهو ما يتنافى وعالم الطفولة الذي هو عالم اللهو والعبث والعفوية والتلقائية، عالم الخيال غير المنضبط، عالم البراءة بامتياز. فكيف نقحم الطفل في عالم غير عالمه؟ يتم الرد على ذلك بالذهاب نحو دهشة الطفل وجرأته في اقتحام المجهول، أليس هو ذلك الكائن الذي يطرح الأسئلة الوجودية الأزلية الأكثر إحراجا؟ (عن الله والأصل والمصير والموت والعدالة)، وهي كما نعلم الأسئلة الفلسفية الكبرى التي أضنت الفلاسفة عبر التاريخ، إلى درجة يمكن القول إن الفلسفة هي الطفولة الدائمة للفكر.
يقول الفيلسوف ياسبرز: «عادة ما يكون للأطفال نوع من العبقرية التي تضيع عندما يصبحون كبارا». فحقا يولد الطفل بذات إبداعية خارقة، وبعقل شجاع، قادر على الخوض في اللانهايات، لكن تأتي إليه التنشئة الاجتماعية لتقمع جرأته، وأحيانا تغتال أفقه وتسيجه بأجوبة جاهزة موروثة. فكل طفل هو بالأساس متحرر، ويتملك خيالا واسعا منفلتا من سطوة المألوف وقيوده، لكن وجراء الإكراه الاجتماعي للراشدين يتم إرغامه على ابتلاع نماذج من الأجوبة القادمة من عمق التاريخ، سواء عن طريق الترغيب أو الترهيب، فيبدأ الاستلاب عند الطفل فيتوقف الإبداع. باختصار نقول: إن الطفل أوسع إبداعا وإمكانا مما تقدمه التنشئة الاجتماعية التي تعمل على خفضه إلى مستواها وهو ما يهدر طاقته الهائلة التي من المفروض أن تستغل في فتح آفاق أكثر رحابة. أما الحل، فيكمن في إعادة النظر في الطرق والبرامج التربوية، سواء في الأسرة أو المدرسة أو الإعلام كي تتوافق وأسئلة الطفل، أو بعبارة أخرى ينبغي العمل على عكس الآية، فعوضا عن أن تسير التنشئة نحو تعليب الأطفال في قوالب جاهزة، ينبغي تكييفها كي تتلاءم والطفل وإمكاناته الهائلة، وهذا لن يتم إلا إذا تم الإيمان بأن الأفق الاجتماعي مجرد إمكان محدود يتجاوزه عقل الطفل بشكل لافت، وكذلك يجب تجاوز منطق القمع والقهر في التربية ومنطق الحقيقة اليقينية، نحو الحوار والإمكانات اللامحدودة، والاقتناع بأن الإمكان البشري أوسع مما جاءنا من التاريخ.
بالطبع، لا يقترح الباحثون زج الطفل في دروس فلسفية منظمة كما في الجامعات، أي دراسة نصوص فلسفية وتلقي محاضرات في القضايا الفلسفية، بل الأمر لا ينبغي أن يتجاوز فتح حوار جماعي مع التلاميذ الصغار حول موضوعات يتعلم من خلالها الطفل الكثير، فأولا سيفهم أنه ليس الوحيد الذي يطرح الأسئلة الكبرى، فهو في ذلك يتشارك مع الآخرين وضعهم المتميز كإنسان، باعتباره كائنا مفكرا، ناهيك عن أن الحوار الجماعي يبرز للطفل نسبية الأجوبة وتعددها وهو ما يراه البعض ضرورة لخلق جو من الديمقراطية، الذي يؤهل الأطفال إلى العمل السياسي حينما يصبحون راشدين.
- الطفل والفلسفة
إعداد وتنسيق عبد الواحد أولاد الفقيهي.
دار النشر: أفريقيا الشرق - 2017.