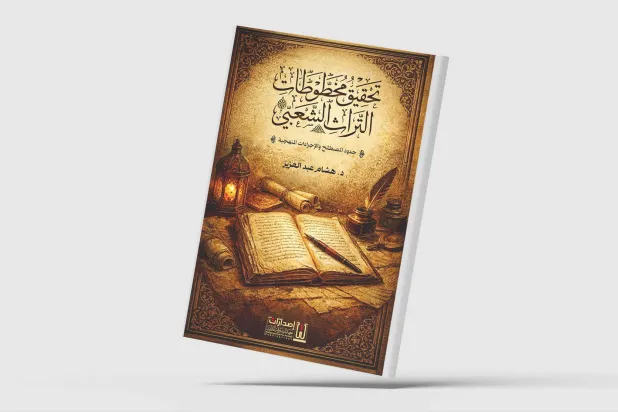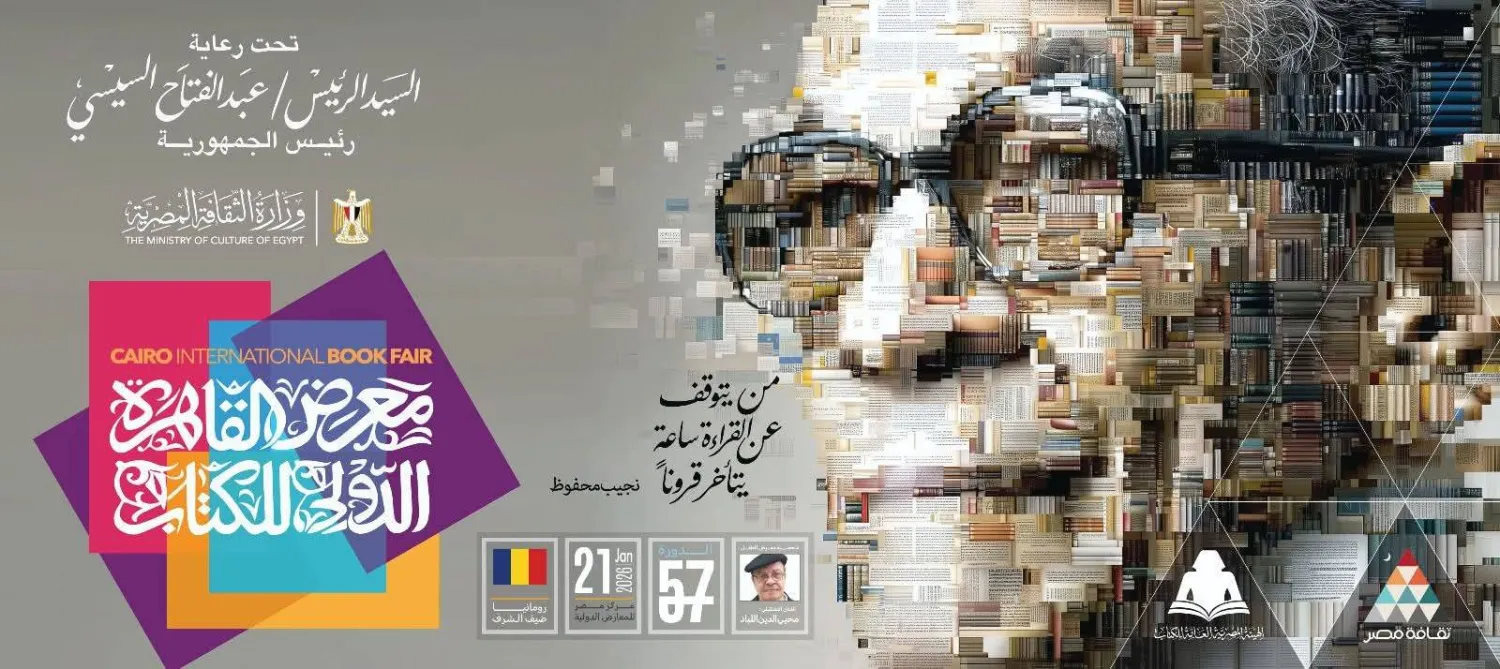تشير كلمة «المشربية» إلى بروز خشبي في المنازل القاهرية القديمة، لا سيما في العصر المملوكي، يتيح لمن داخل الغرفة أن يرى من بالخارج في الطرقات دون أن يراه الآخرون، وكانت تتميز بالمهارة والإبداع في الصنع. تشكل تلك الخلفية التاريخية مفتاحاً لفهم كتاب «إنها مشربية حياتي - وأنا العاشق والمعشوق» الصادر عن دار «الشروق» بالقاهرة للكاتب المصري من أصل أرمني توماس جورجسيان.
ينتمي الكتاب إلى «أدب السيرة الذاتية»، ويتسم بالحميمية في السرد والعفوية في استدعاء حكايات الماضي عبر لغة بسيطة وقريبة من المتلقي، وكأن المؤلف يجلس إلى مقهى شعبي ويقص على المحيطين به خبراً من طرف القاهرة في النصف الثاني من القرن العشرين. يعد الكتاب بمثابة رصد لفصل من فصول حياة الأرمن بمصر وأدوارهم البارزة والعميقة كأحد صناع التاريخ المصري الحديث في الأماكن والتجمعات التي أضاءوا شموع البهجة فيها، فضلاً عن مكانتهم الرائدة في العديد من المهن، على رأسها التصوير الفوتوغرافي وفن التمثيل.
يستعيد المؤلف ذكرياته بحي شبرا الشهير، الذي كان له طابع «كوزموبوليتاني» من حيث تعدد الأعراق والثقافات والجاليات الأجنبية، فكان يحتوي على «حضانة أرمينية»، وشهد خطواته الأولى من 1935 حتى 1963 على درب التعلم واكتشاف الذات والبشر، ثم جاءت سنوات الابتدائية والإعدادية بمدرسة «كالوسديان» في شارع «الجلاء» بجوار مصنع الثلج الشهير، وهي مدرسة بمبانيها وملاعبها مارست دورها التعليمي والتربوي لدى أجيال متعاقبة منذ عام 1907.

بين جدران «كالوسديان»، كانت سنوات النشاة والترعرع والانطلاق والخيال المجنح باللغة الأرمينية ولغة الضاد معاً، حيث تشكلت في فترة الستينات والسبعينات هذه الأجواء الأرمينية المصرية المحيطة به، وبدأ معها عشق اللغات وأبجديتها والإبداع الأدبي والفني، وكذلك محاولاته الأولى للخروج من صمته وتأمله ليتحرر من شخصيته الانطوائية.
اشتهر الحي باستديوهات التصوير التي امتلكها الأرمن مثل استديو «فوبيس» لالتقاط صور عائلية، غالباً سنوية، ترسلها والدته إلى الأقارب للسؤال عنهم وطمأنتهم، وكذلك محل «بطانيان» للزراير ومستلزمات الخياطة والتفصيل والتريكو ودكان جده «توماس»، والد والده، لإصلاح الأحذية وبيع الصنادل.
ويتوقف المؤلف عند والده طويلاً، فهو من مواليد 1911 وكان شاهد عيان على «المذبحة الأرمنية» ورحلة الشتات وهو لا يزال في الرابعة من عمره حيث فقد والدته وأخته، ليصبح هذا الأب ضمن من عُرفوا ووُصفوا فيما بعد في الذاكرة الأرمنية بـ«جيل الطفولة»، جيل لم يعش طفولته ولم يعرف أيامها بما فيها من أمان وعناق ولعب وخيال.
كان الوالد واحداً من هؤلاء، حتى أنه عندما كبر ظل في أغلب الأوقات صامتاً لا يتكلم، أو كان قليل الكلام، ولذلك كلما تكررت من ابنه توماس محاولات متعاقبة على مدى سنوات طويلة لمعرفة المزيد عن تلك الأيام السوداء، كان يجيب بالصمت التام، وقد تأتي أيضاً النظرة الثاقبة وغالباً الدموع التي تطل عبر العينين الحزينتين. وفي يوم لن ينساه توماس أبداً، تساءل الأب مستنكراً: «هل تريد مني أن أتذكر ما حاولت أن أنساه على مدار سنوات عمري؟ هل تريد مني أن أسترجع لحظات أنا لا أريد لها أن تأتي أو تعود لا إليّ أنا ولا إليك أنت من جديد؟». وفي يوم آخر نبهه والده لكثرة خوض ابنه في هذا الموضوع وإصراره على بوح أبيه علناً بكل ما في قلبه. قال الابن مازحاً: «أعمل إيه؟ أستعمل حقي أنا وحقك أنت في الكلام!»، فابتسم الوالد للحظة ولم ينطق بحرف.
والأرمني المصري لمن يتابع حياته وحضوره له طلته ولمسته وهمسته وغنوته ورقصته وأكلاته، وبالتأكيد سمعته، وطبعاً وميض الكاميرا الفوتوغرافية، فكم من مصور أرمني التقط صوراً لطفل بنظراته الحالمة أو لطفلة بشقاوة عيونها، إضافة إلى مصوري الرؤساء والملوك والمشاهير أمثال أرشاك وفان ليو وألبان وإنترو وجارو. وكم من أرمني علَّم الأجيال الجديدة الموسيقى أو الرسم أو النحت أو ضبط أوتار البيانو أو أصلح محرك سيارة جاره أو صاغ خاتم خطوبة أو أسورة زواج.
ويتساءل المؤلف: وماذا عن أغاني شارل أزنافور أو موسيقى آرام خاتشادوريان، أو كتابات ويليام سارويان، أو أفلام أتوم إيجويان؟ مشيراً إلى أن الأخير هو المخرج العالمي الكندي والأرمني الأصل الذي ولد بالقاهرة عام 1960، ثم هاجرت أسرته إلى كندا وحين كان طفلاً يلعب في مدرسته وصفه زملاؤه الصغار بـ«المصري» وهو الذي أخرج فيلم «أرارات» الشهير عن مذبحة الأرمن وأفلاماً أخرى تتناول تعدد الأعراق وتقبل الآخر.
يُعدُّ الكتاب بمثابة رصد لفصلٍ من فصول حياة الأرمن بمصر وأدوارهم البارزة والعميقة كأحد صناع التاريخ المصري الحديث في الأماكن والتجمعات
ويتذكر يوسف أفندي، المصري الأرمني الأصل، أحد المبعوثين إلى أوروبا من جانب محمد علي باشا حاكم مصر في بداية القرن التاسع عشر، وقد رجع يوسف أفندي ومعه الفاكهة الجديدة ليزرعها في مصر وتسمى باسمه ويطلق المصريون عليها «اليوسفي» نسبة إليه.
ويتوقف توماس جورجسيان عن والدته، فيشير إلى أن اسمها «روزيت ديكران مرزيان»، الأم وربة البيت ومعلمة أفراد الأسرة وكل شيء في حياتهم، هي الملكة في مملكتها القائمة في حي شبرا، في تلك الشقة في الطابق الثالث من عمارة رقمها 35 شارع الترعة البولاقية، التي شهدت دفء الأسرة وحنان الأم. كانت نموذجاً للمرأة العظيمة، تلك التي لم تتح لها الظروف أن تكمل تعليمها بعد الابتدائية إلا أنها أرادت واستطاعت أن تعلم نفسها بأكثر من لغة، وأن تقرأ بنهم وبرغبة في المعرفة، وأن تعمل كل ما في وسعها لكي تمكن أولادها من أن يتعلموا ويذهبوا إلى الجامعات. كان يراها دائماً تبتسم برضا وفرح شاكرة الرب الكريم لأنها استطاعت أن تحقق من خلال أولادها ما حلمت به، وتمنت أن تحققه في يوم من الأيام لنفسها. كانت «الملكة والشغالة» في خلية الأسرة، تتسوق احتياجات البيت وتدير شؤون 7 أفراد، هي والأب وثلاث بنات وولدين، ثم تطبخ الأكل وتنظف البيت وتغسل وتكوي الملابس وتستمع إلى مسلسل الراديو في الخامسة والربع مساء، وتتابع مذاكرة وواجباتهم المدرسية، وتصنع الحلويات وأنواع المربى، وتمضي الساعات منكبة على ماكينة الخياطة وأيضاً ترحب بقدوم الأقارب وتتعامل مع زياراتهم المفاجئة.