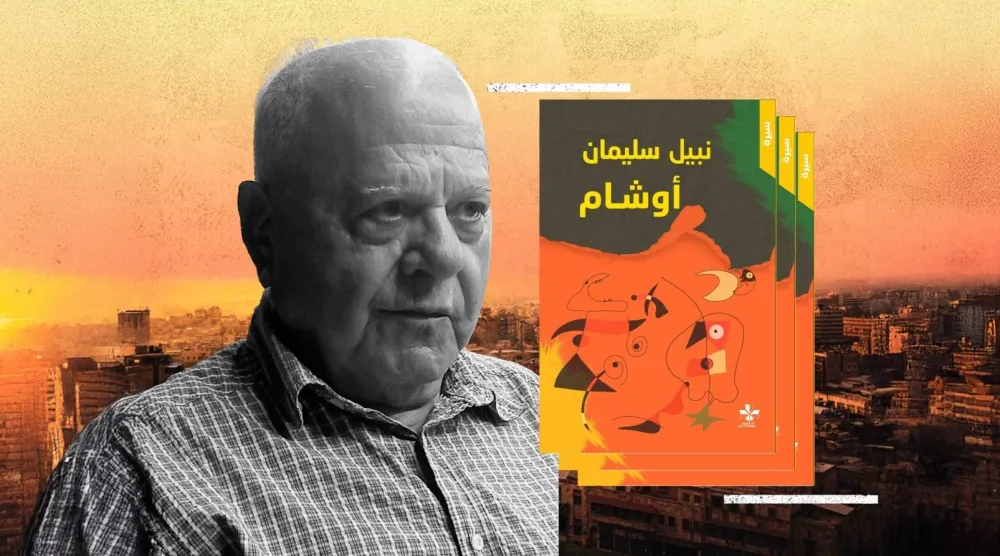أثارت نتائج مسح دولي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمهارات القراءة والكتابة والحساب وحل المشكلات، في 31 دولة واقتصاداً مختلفاً، جدلاً واسعاً في الصحافة والأوساط الثقافيّة والتعليميّة الغربيّة بعد أن أظهرت تراجعاً ملحوظاً من المستويات التي كانت عليها في عقد سابق. كتب وتحدث كثيرون حول وصول الدماغ البشري إلى منتهاه بعدما بلغت قدرة الإنسان العادي على التفكير وحل المشكلات الجديدة ذروتها في أوائل عام 2010 لتتراجع بشكل مطرد منذ ذلك الحين، في حين أنذر آخرون من عواقب سيطرة التكنولوجيا التي تزداد ذكاءً بمرور اللحظات بينما يفقد البشر أهم القدرات التي مكّنت لازدهار وجود نوعهم على هذا الكوكب.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها المنظمة عن عينة شملت 160 ألفاً من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاماً، فإن كفاءة القراءة والكتابة تحسنت في بلدين فقط – فنلندا والدنمارك -، في حين انخفضت بشكل كبير في 13 بلداً وبشكل حاد في كوريا الجنوبيّة ونيوزيلندا وليتوانيا، وتراجعت في جميع البلدان تقريباً لمجموعة البالغين الحاصلين على تعليم دون المستوى الثانوي. وقادت الولايات المتحدة وسنغافورة التباين بين الحاصلين على تعليم عالٍ مقارنة بالحاصلين على تعليم دون المستوى الثانوي؛ إذ إن واحداً من كل ثلاثة أميركيين مثلاً يقرأ بمستوى تتوقعه من طفل يبلغ العاشرة من العمر.

وتقاطعت نتائج هذا المسح مع اتجاهات مقلقة عن القراءة في الولايات المتحدة، حيث انخفضت نسبة الأميركيين الذين قرأوا كتاباً العام الماضي إلى أقل من خمسين في المائة، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أشار استطلاع أجرته هيئة حكوميّة إلى أن خمس البريطانيين لم يقرأوا كتاباً واحداً في العام الماضي، ووجد الصندوق الوطني البريطاني لمحو الأمية أن 35 في المائة فقط من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً كانوا على استعداد للقول إنهم يستمتعون بالقراءة - وهو أدنى مستوى منذ بدء الاستطلاع قبل 19 عاماً -، بينما اعترف خريجو جامعات نخبوية بأنهم حصلوا على شهاداتهم دون أن يقرأوا كتاباً واحداً من الغلاف إلى الغلاف في وقت تراجعت مبيعات الكتب المطبوعة الجادة في معظم دول العالم وفق أرقام كُشف عنها خلال الدورة الأحدث لمعرض لندن للكتاب - وإن كان ذلك يتم تعويضه بالنسبة للناشرين من خلال نمو الطلب على الروايات الرومانسيّة، وأدب الجريمة، والخيال العلمي.
واللافت، أنه في غضون ذلك أصبح البودكاست أكثر شيوعاً من أي وقت مضى؛ إذ يستمع إلى بودكاست واحد على الأقل في الأسبوع ثلث البريطانيين، في حين استمع نصف الأميركيين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً إلى بودكاست واحد على الأقل خلال الشهر الماضي، ويقضي هؤلاء ما معدله خمس ساعات ونصف الساعة تقريباً في الاستماع.
إن كل ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأننا أصبحنا وبشكل مطرد «مجتمعات ما بعد القراءة والكتابة»، حيث تفقد الكلمة المكتوبة تدريجياً مكانتها التقليديّة المركزيّة في تشكيل ثقافة الشعوب وتفكيرها وسياساتها لمصلحة الكليشيهات والصور النمطيّة المتداولة ومقاطع الفيديو القصيرة، ويحل الصخب والاستعراض الفردي والآراء المسلوقة والتعبير عن المشاعر العابرة والشتائم مكان التحليل الدقيق، والتفكير المعمق، في حين يميل صانعو المحتوى الشفوي إلى عدم تصحيح أنفسهم، حيث يبدو تقييم تناقضات الماضي مرتبطاً حصراً بالنصوص المكتوبة. ويفسّر البعض هذه الاتجاهات بعوامل جزئيّة متعلقة ببعض المجتمعات، مثل ارتفاع نسب شيخوخة السكان وتزايد مستويات هجرة الشباب، لكن التفسير الأكثر وضوحاً والأكثر قابلية للتعميم وراء هذا التحوّل يرتبط بتفشي استعمال الهواتف الذكيّة خلال الفترة الزمنية ذاتها، والتي نشأت من حولها صناعة هائلة تستند تحديداً إلى تعميم عدم القراءة والتغوّل على الوقت الذي قد يخصص لها. فهناك الآن ملايين البشر الذين يعملون على مدار الساعة لإنتاج محتوى - سطحي في غالبه – لملء كل لحظة فراغ قد تتوفر لدى مستخدمي تلك الهواتف والشاشات الذكيّة، وهو محتوى قريب جذاب يسهل استهلاكه والإدمان عليه في كل الأوقات مقابل نشاط القراءة – والكتابة – الذي يستدعي شيئاً من العزلة وتركيزاً وهدوءاً.
لقد غيّرت التكنولوجيا وخلال أقل من عقدين الطريقة التي يحصل بها الكثير من البشر على المعلومات، فأخذتهم بعيداً عن الأشكال الأكثر تعقيداً من الكتابة، مثل الكتب والمقالات المطولة، إلى فضاء المنشورات القصيرة ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي والملخصات والمقالات القصيرة جداً على الإنترنت، حيث الاستهلاك السلبي والتبديل المستمر للسياق. وهذا أمر يتسبب بكارثة معرفيّة للأجيال الجديدة من المتلقين بحكم بنية منصات التواصل التي تجعل من المرجح أن يطلّع المرء على أشياء تؤكد وجهة نظره؛ ما يضعف القدرات على التمييز بين الآراء المرسلة والحقائق، والبحث وراء الظاهر، والتعامل مع التعقيد، وهي قدرات لازمة للعبور إلى مستويات أعلى من التعليم وتبنى تدريجياً من خلال التعرّض لوجهات نظر متنوعة ومتناقضة والتعامل معها نقديّاً.
بالطبع لن يمكن يوماً إعادة تصميم الكتب بحيث تكون أكثر جاذبيّة من الهواتف الذكيّة – أقله بالنسبة للأعمار الأصغر سناً –، ولن يكون متاحاً في أي وقت إيجاد طريقة لاختصار الوقت الذي يحتاج إليه الدّماغ البشري كي يتعمق في الأفكار من خلال القراءة، فهل «مجتمعات ما بعد القراءة والكتابة» عادت لتبقى، وهل هذه الاتجاهات السلبية الحالية قدر البشرية المحتّم؟
تتباين آراء الخبراء في ذلك رغم غلبة التصورات المتشائمة. إذ يقول بعضهم إن تجربة فنلندا مثلاً تشير إلى أهميّة التعليم عالي الجودة والأعراف الاجتماعية القوية للحفاظ على مهارات القراءة والكتابة لدى أكثرية السكان؛ إذ إن التكنولوجيا المتقدمة في ذلك البلد الإسكندنافي عززت من كفاءة معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، ويشير آخرون إلى فرص الانفتاح التي تتيحها منصات الثقافة الشفوية للعبور نحو أفق أوسع لفهم النص المكتوب بأبعد من مطلق النص، بحيث يتاح للمتلقي الآن قراءة نص ما والاستماع إلى نقاش مطول بشأنه على بودكاست مثلاً، أو مشاهدة فيلم وثائقي عن مضمونه أو حلقة نقاشية مع مؤلفه؛ ما يضاعف من فرص تعميق فهمنا للأفكار المطروحة، كما أن هنالك إشارات أولية عن إمكانات هائلة تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحسن نوعي في إنتاجيّة العمالة المعتمدة على المعلومات والمعرفة لإنجاز مهماتها.
على أن كل تلك الإيجابيات المحتملة ستظل دائماً رهن تأسيس قاعدة متينة من مهارات القراءة والكتابة في سن مبكرة؛ لأن من يفتقدون تلك المهارات سينتهون دائماً إلى مجرّد مستهلكين ساذجين للمحتوى الجاهز، سواء بصرياً أو شفهيّاً أو حتى من «إبداعات» الذكاء الاصطناعي. إن تلك المهارات - التي يحتاج تعميمها إلى جهد مجتمعي منظم لضمان جودة التعليم وتعزيز سلوكيات اكتساب المعرفة اجتماعياً - وحدها ستفصل في صفحة تاريخ البشرية التالية بين من سيوظّفون التكنولوجيا، وأولئك الذين سيكونون خاضعين لها.