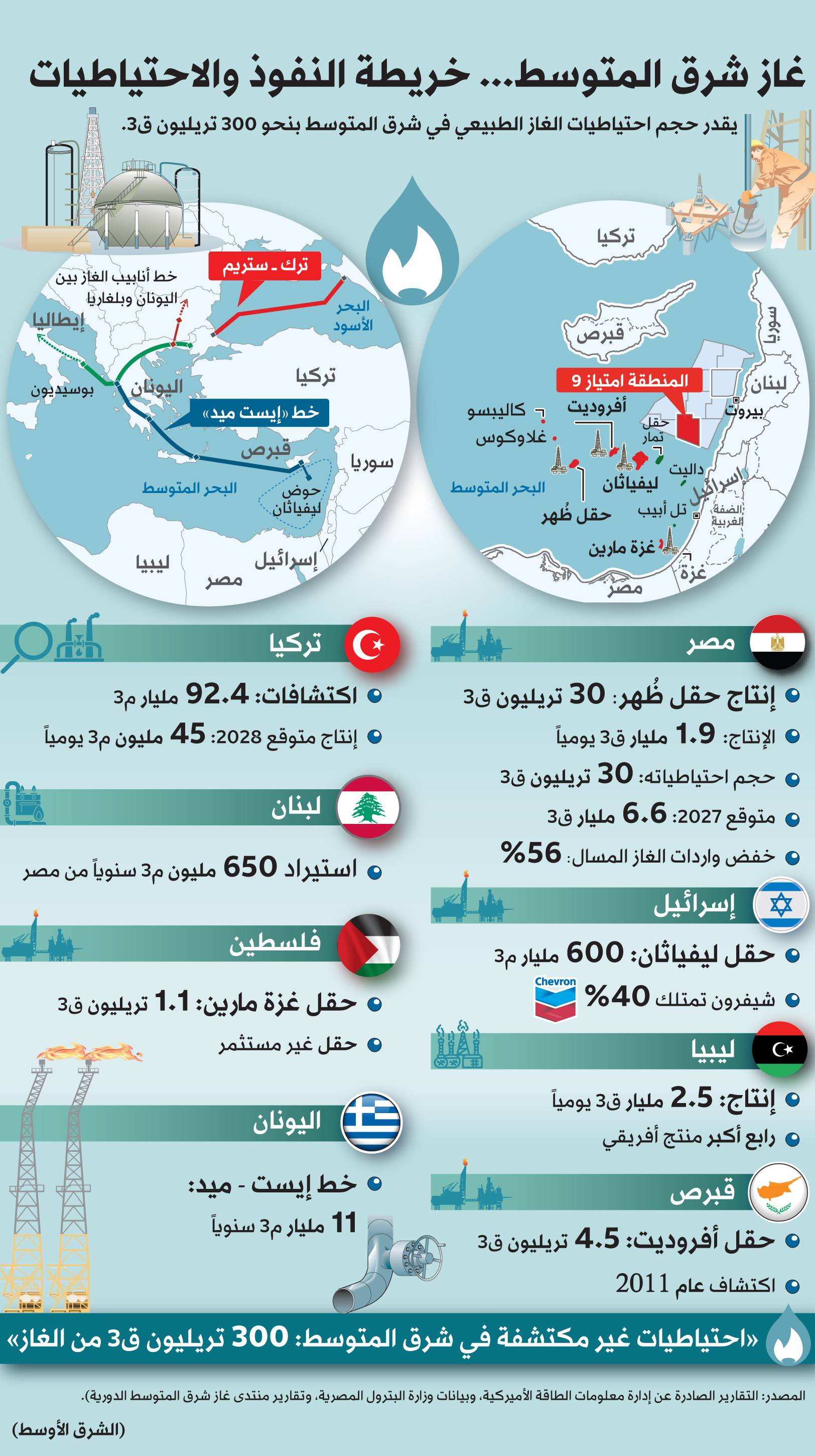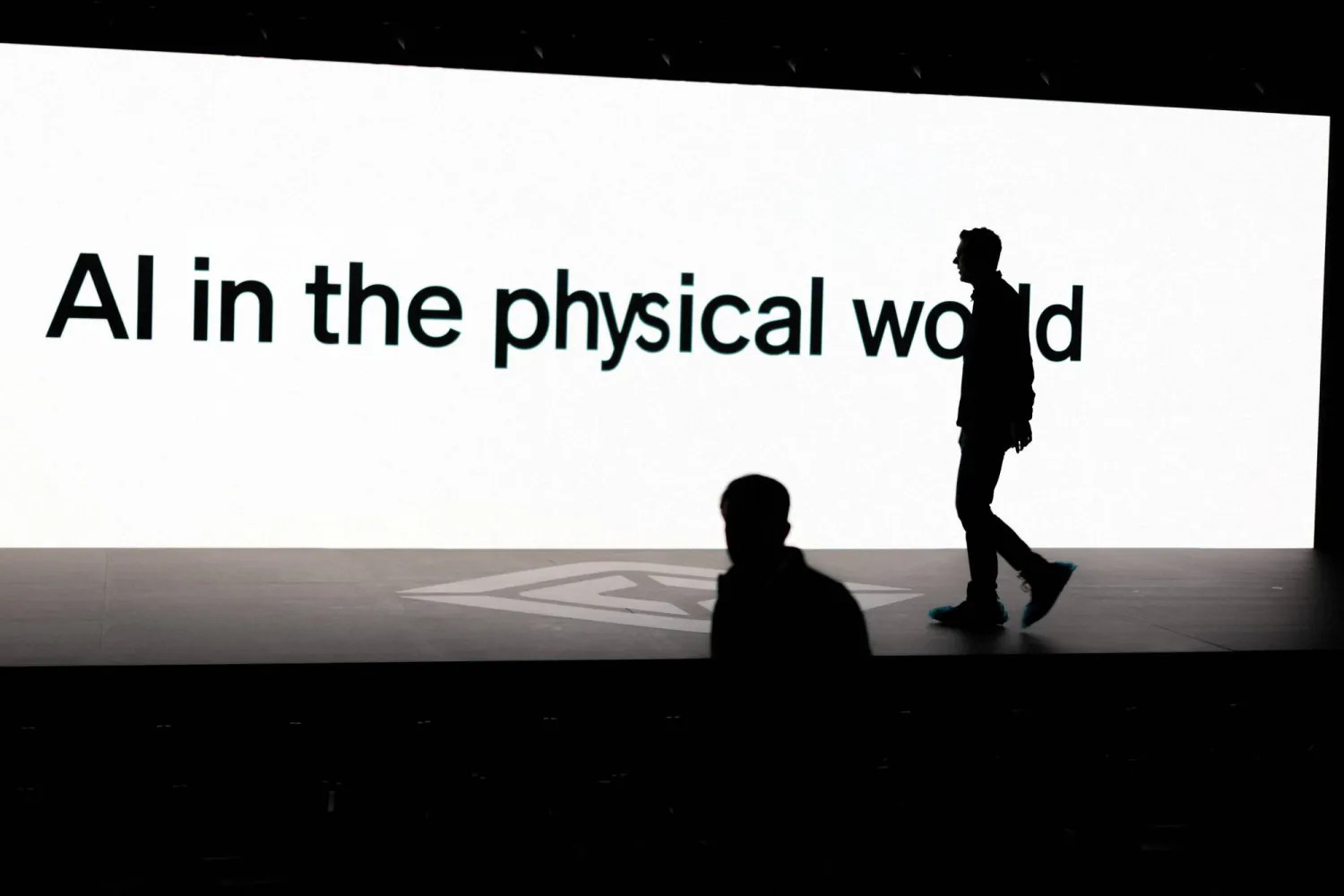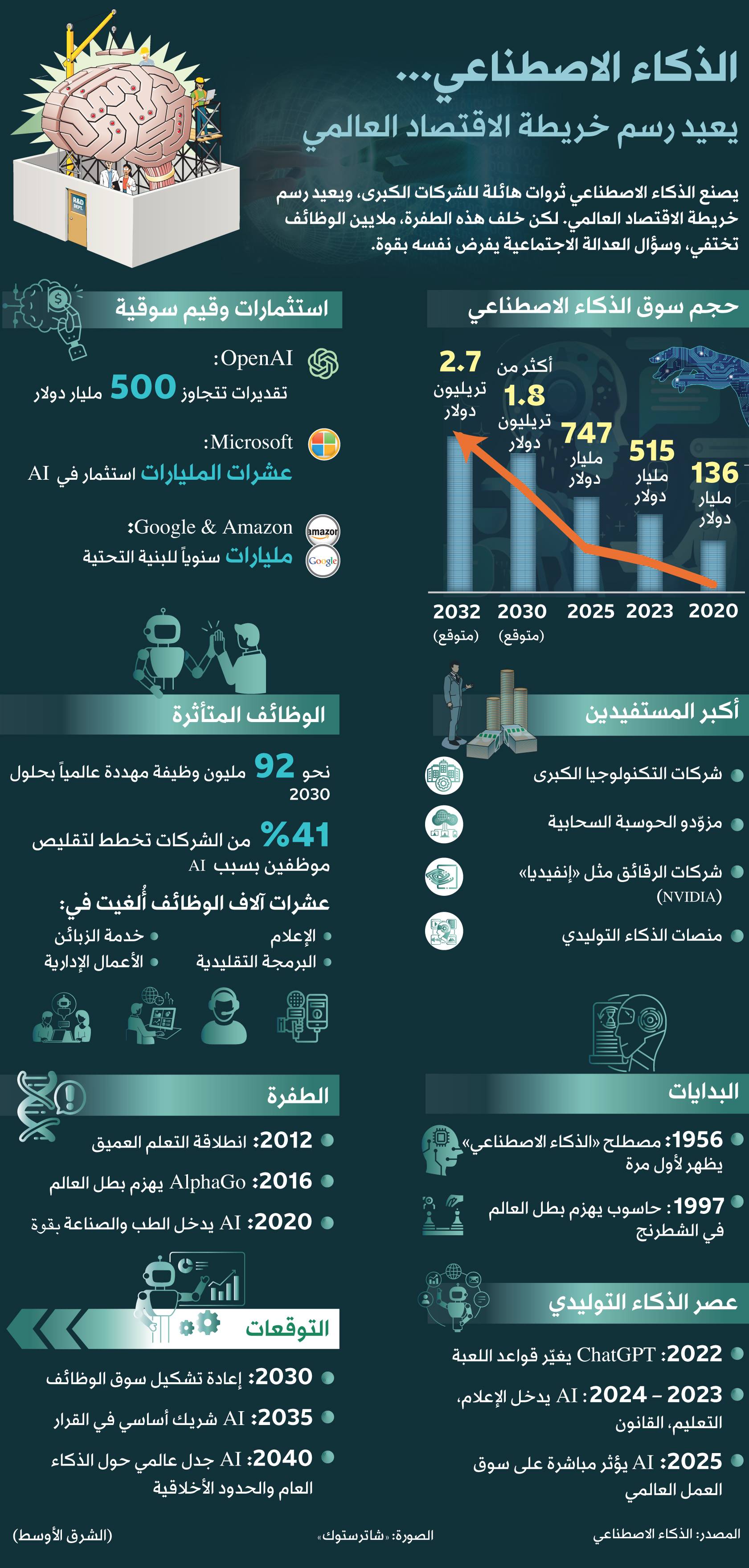ما إن تم الإعلان عن توقف الحرب العسكرية والعمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حتى بات السكان يواجهون حروباً أصعب وبأوجه مختلفة، أشد صعوبةً وأكثر قسوةً أحياناً من آلة الحرب ذاتها.
وتنعكس الخروق الإسرائيلية المستمرة، والواقع السياسي وإمكانية تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما يشوبها من بعض العقبات، على ظروف الحروب المصغرة التي يعيشها سكان القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
حرب بأوجه كثيرة
ويرى الكثير من الغزيين ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن الظروف الحياتية والاقتصادية اليومية في قطاع غزة، أصعب من الحرب العسكرية التي كانت دائرة على مدار عامين. ويقول المواطن ناجي المسحال (42 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن «حياة الطوابير باتت تلازمنا، من طوابير المياه، إلى طوابير التكيات، إلى طوابير المساعدات، كل هذه المشاهد ما زالت تلازم كل غزي».
ويشير المسحال، إلى أن أزمات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي ما زالت كما هي من دون تغيير حقيقي؛ الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الواقع البيئي والصحي ويتسبب بظهور الكثير من الأمراض، مثل الطفح الجلدي وغيره، كما حصل مع أحد أحفاده واثنين من أبنائه.

ويضيف: «منذ وقف إطلاق النار، كنا نعتقد أن ظروفنا ستتغير، لكننا ما زلنا تحت تأثير الحرب كما وأنها لم تتوقف... نعاني نقص المياه والطعام، وازدياد الأمراض وانتشارها، وعدم توافر خيام يمكن أن تحمينا من فصل الشتاء على الأبواب، وكل ذلك بسبب عدم التزام إسرائيل بأي من بنود الاتفاق المعلن».
وتتلاحق الأزمات الحياتية من المياه، إلى الأسواق والبضائع التي باتت تتوافر حديثاً، لكن أسعارها باهظة لا يقوى عليها المواطن رباح كتكت من سكان مدينة رفح والنازح إلى مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، حاله، حال مئات الآلاف من سكان القطاع.
ويقول كتكت: «الدواجن واللحوم المجمدة والخضراوات والفاكهة وحتى الشوكولاتة وغيرها مما بات يُسمح بإدخاله لا يستطيع المواطن البسيط شراءه سوى بصعوبة بالغة بعد حرمان استمر عامين». وأشار كتكت إلى أن تلك السلع مخصصة لأصحاب الأموال الفائضة الذين يمكن وصفهم بأصحاب رؤوس الأموال من تجار ومسؤولين وغيرهم، لكن المواطنين البسطاء أو حتى الموظفين الحكوميين فبالكاد يستطيعون توفير بعض الخضراوات لعوائلهم.
ويؤكد كتكت أنه «لم يتغير شيء على حياة سكان قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار»، في ظل غلاء الأسعار وعدم توافر البضائع باستمرار. ويقول: «لدي أسرة مكونة من 9 أفراد، لا يستطيع أي منا شراء دجاجة واحدة أو نصف كيلو لحم مجمد حتى نتناوله مثل البشر؛ لأن الأسعار باهظة».
ويتراوح ثمن كيلو الدواجن أو اللحوم من المجمدات التي يسمح بدخولها ما بين 60 و90 شيقلاً، أي ما يعادل 18 إلى 27 دولاراً، بينما كان كيلو الدواجن الطازجة قبيل الحرب يبلغ نحو دولارين، في حين كيلو اللحم الطازج 12 دولاراً، والمجمد 6 دولارات.
ويضيف كتكت: «قبل الحرب، كان لدينا أشغال وأعمال ونستطيع جمع الأموال، لكن حالياً الموظف وغير الموظف سواء، لا أحد منهما يستطيع شراء ما يلزمه وتلبية حاجات أسرته بالحد الأدنى قبل أن يبحث عن اللحوم أو الدواجن».
«حماس» تفرض الضرائب
يرى الشاب أحمد. غ، الذي فضَّل عدم كشف هويته، أن بقاء «حماس» في حكم غزة يعني بقاء القطاع تحت طائلة الأزمات، مشيراً إلى أن حكومتها «عادت لفرض بعض الضرائب على بعض السلع»؛ الأمر الذي دفع التجار إلى رفع أسعارها. وقال: «كان يجب على حكومة (حماس)، أن تشكرنا كمواطنين عايشنا أصعب الحروب في العالم على مدار عامين، وأن تقدّم لنا العون، لا أن تساعد على رفع الأسعار من خلال الإجراءات التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية»، في إشارة إلى الضرائب التي تم فرضها على بعض السلع الاستهلاكية.
وفي حين ينفي المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه فرض أي ضرائب على أي من السلع، أكّد التجار أنه فُرضت ضرائب على بعض البضائع والسلع التي تم إدخالها إلى القطاع ومن بينها الدخان والمجمدات؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وعلى سبيل المثال، كان سعر علبة الدخان قبل الحرب يتراوح حسب النوع، بين 8 و20 شيقلاً (أي بين 2 و6 دولارات)، بينما تضاعف خلال الحرب من دون ضرائب وإنما بسبب تهريبها بطرق مختلفة من قِبل التجار. أما بعد وقف إطلاق النار فانخفضت أسعارها، ثم عادت وارتفعت بشكل قياسي لتبلغ 40 شيقلاً أو أكثر بعد فرض الضرائب عليها.
ويقول أحد تجار الدخان لـ«الشرق الأوسط»، إنه خلال فترات الحرب كانت هناك طرق عدة للتهريب ولم تكن حكومة «حماس» قادرة على فرض الضرائب، لكن حالياً عادت لتفرضها؛ ما قلل قدرة المواطنين على الشراء، فعمد بعضهم إلى شراء سيجارة واحدة في اليوم فقط بدلاً من علبة كاملة.
«أونروا» والقطاعات الحيوية
لا تزال قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات البيئية والمياه تديرها بلديات وجهات حكومية تابعة لحركة «حماس»، في وقت تعاني غزة انقطاعاً مستمراً للكهرباء في ظل رفض إسرائيل إدخال الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، بما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار حسب الحركة.

وتتلقى الجهات الصحية والتعليمية والبلديات، دعماً مستمراً من جهات ومؤسسات دولية بهدف دعم القطاع المدني، والمساهمة في محاولة تقديم أقصى خدمة ممكنة من توفير الدواء والعلاج المناسب للمرضى والجرحى وغيرهم، إلى جانب محاولات إحياء التعليم من خلال فتح مدارس مؤقتة بعد تعطل استمر عامين. ذلك بالإضافة إلى دعم البلديات بالوقود لتشغيل آبار المياه التي دُمّرت معظمها، وتشغيل آليات هندسية مثل الجرافات لفتح الطرق العامّة المغلقة بفعل الدمار الكبير وردم المنازل، وسط رقابة شديدة من تلك المؤسسات لمنع وصول المساعدات إلى «حماس».
وتشرف المؤسسات الأممية على نقل المساعدات ومقوّمات الدعم من وقود وأدوية وكتب دراسية وخيام وغيرها عبر فرق تابعة لها تقوم بإيصالها للجهات المنفذة على الأرض، من دون نقل أموال؛ حتى لا تستحوذ عليها حركة «حماس» أو أي من المسؤولين الحكوميين أو الإداريين فيها.
ورغم المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء أي مهام داخل قطاع غزة، ومنعها من إدخال المساعدات، رغم أن لديها مخزوناً كبيراً منه يكفي لسد احتياجات السكان لأشهر عدة، لكن المؤسسات التابعة للمنظمة الأممية تحاول بشكل دائم تقديم خدماتها وإنْ بالحد الأدنى، من خلال ما ينقل إليها عبر مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة تزود «أونروا» ببعض المساعدات والدعم اللوجيستي من وقود وغيرها لتشغيل مركباتها وآلاتها الهندسية حسبما يسمح بدخوله من كميات وقود أو مساعدات طبية أو عينية.

وكان المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، قال في مقالة له نشرت في صحيفة «الغارديان»، إن الأمم المتحدة، بما في ذلك «أونروا»، تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بفاعلية وعلى نطاق واسع، لكن يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية واستقلالية، دون قيود تعسفية وغير معقولة على دخول وحركة الإمدادات والأفراد.
ورصدت «الشرق الأوسط»، أن «أونروا» استأنفت أخيراً تقديم الخدمات الصحية عبر عياداتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما استأنفت تقديم بعض المساعدات المحدودة غير المؤثرة مثل حفاضات الأطفال، في حين غابت عن دورها المركزي في توزيع المساعدات الغذائية الأساسية الأخرى مثل الطحين، وهو الأمر الذي كان يعتمد عليه السكان كثيراً خلال الحرب ومنذ عقود طويلة سابقة.
وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والإعلامية في «أونروا»، خلال تصريحات صحافية، إن «أونروا» لم تتوقف عن العمل في غزة طوال فترة الحرب، وواصلت فرقها الطبية تقديم الخدمات بشكل مباشر وعن بعد، كما استمر مهندسوها في معالجة المياه والصرف الصحي، ونقل مياه الشرب النظيفة إلى الملاجئ.
وأضافت: «مع وجود 12000 موظف وموظفة على الأرض، تواصل (أونروا) إدارة الملاجئ والعيادات وتقديم الخدمات الأساسية، حتى في ظل إدارة الموظفين الدوليين للعمليات عن بعد بسبب الحظر الإسرائيلي».
الإعمار... أولى الأولويات
في ظل كل هذه التحديات، يبرز تحدي إعادة إعمار قطاع غزة، وهو أحد أهم أولويات السكان الفلسطينيين في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه بعد تدمير أكثر من 80 في المائة من منازل القطاع وبناياته.

المواطنة ريهام أبو شاربين من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تواجه تحدياً خطيراً مع قدوم فصل الشتاء، بعد أن دمرت طائرات حربية إسرائيلية منزلها.
تشتكي أبو شاربين من نقص الخيام والشوادر والمواد الإغاثية التي قد تسهم في إنقاذها خلال فصل الشتاء، كما هو حال أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني فقدوا أي مأوى لهم.
وتقول أبو شاربين إنها كانت تتوقع أن تدخل الخيام الجيدة التي يمكن أن تحميها وأسرتها من فصل شتاء قاسٍ يتوقع أن يبدأ في الأيام المقبلة، معربةً عن خشيتها بغرق الخيمة المؤقتة التي تعيش فيها وهي من «القماش» الذي بالكاد يستطيع حمايتهم من أشعة الشمس. وتضيف: «التفكير يقتلنا يومياً كيف سنقضي الشتاء، كما يقتلنا يومياً كيف سنبقى في هذه الحياة والظروف الصعبة التي لا يتحملها بشر؟».

وتربط إسرائيل، إعادة إعمار القطاع، بنزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتخليها عن حكم القطاع بشكل كامل، في حين تحاول الإدارة الأميركية السعي لبدء إعادة الإعمار في المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل أساسي وليس في المناطق التي ما زالت تحكمها «حماس» وتمثل نحو 50 في المائة من مساحة القطاع، وهو ما رفضه غالبية وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، في الأيام الأخيرة خلال جلسة بُحثت فيها هذه القضية بعد أن طرحها رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو.
المواطن أحمد كلاب (57 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ، دُمّر منزله مرتين خلال عقد من الزمن. المرة الأولى في حرب 2014، ثم عادت القوات الإسرائيلية ودمّرته في الحرب الأخيرة قبل أكثر من عام، وهو أحد المتضررين من الرؤية الإسرائيلية – الأميركية لعملية إعادة الإعمار، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».

ويرى كلاب، أنه في حال طُبق ما نشر في وسائل الإعلام عن نية إعادة البناء فقط في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، فذلك يعني فقدان الأمل بإعادة بناء منازلنا والتي عانينا كثيراً حتى أعدنا بناءها بعد حرب 2014.
وقال: «كان من الواضح منذ البداية أن هناك حالة ابتزاز مستمرة للفلسطينيين، وكل شيء مرتبط برحيل (حماس) وتسليم سلاحها، ولكن يبدو أن الحركة ترفض ذلك، ومن يدفع الثمن نحن المدنيين الذين لا علاقة لنا بكل الوضع الذي نحن فيه، سوى أننا مجرد خسائر تكتيكية كما يراها البعض». في انتقاد واضح لتصريحات رئيس حركة «حماس» في الخارج، وعضو مكتبها السياسي خالد مشعل، في خطاب له ألقاه في شهر أكتوبر 2024.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، عن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر في محادثات داخلية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وكشف عنها مساء الثلاثاء الماضي أن إعادة إعمار القطاع في الجانب الغربي للخط الأصفر لن تبدأ قبل أن يتم تفكيك «حماس» من سلاحها كلياً.
تحديات الأمن والأمان
يأتي هذا الواقع الصعب، مع استمرار التحديات الأمنية المتلاحقة التي لا تنتهي، سواء بفعل الخروق الإسرائيلية، أو مع تردي الوضع الأمني الداخلي في بعض المناطق، ومواصلة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «حماس» في محاولة إعادة ترتيب صفوفها.

وتؤكد مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اجتماعات تُعقد باستمرار لمحاولة ضبط الوضع الأمني من خلال تعيينات وإصدار تعليمات أمنية مشددة لضبط الوضع، مشيرةً إلى أن التركيز هو على «ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل»، بينما تجري محاولات موازية لضبط الأسواق والأسعار وتحسين الخدمات الحكومية المختلفة.
وهناك من يرى أن «حماس» غير قادرة على التعامل مع بعض القضايا الجنائية مثل عمليات القتل العشوائي والسرقات، وغيرها من الثغرات الأمنية اليومية. واشتكت مواطنة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، من أنها لم تجد معيناً يقف معها بعدما سرق أحد أقاربها مصاغها من الذهب. وعلى رغم معرفتها بالسارق وتقديم شكوى ضده، فإن الشرطة التابعة لـ«حماس» لم تقدم لها العون في اعتقاله أو التحقيق معه؛ ما تركها فريسةً لحالة الفلتان الأمني.

وقُتلت قبل أيام سيدة في وضح النهار بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء تجولها في السوق المركزية للمدينة، وعلى بعد عشرات الأمتار من انتشار عناصر شرطة «حماس»، ليتبين أن قاتلها هو ابن زوجها، من سيدة أخرى، في حين فر من المكان دون أن تقوم الشرطة باعتقاله.
ومن الأمثلة الصارخة عن حالة الفلتان الأمني، قيام عناصر مسلحة بإيقاف مركبة تابعة للهلال الأحمر التركي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسرقة المركبة وهواتف وأموال كانت بحوزة العناصر في المركبة قبل الاعتداء عليهم.
وبينما كانت غالبية سكان قطاع غزة تأمل رؤية جهة جديدة تحكم القطاع في أعقاب الحرب، اصطدموا ببقاء الواقع السابق على حاله؛ الأمر الذي زاد من مخاوفهم بعدم الشعور بالأمن والأمان. وقالت الشابة نيرمين الفار (28 عاماً) من سكان مدينة غزة، نحن نريد جهة فلسطينية تحكمنا لتحقق لنا معيشة جيدة تتناسب مع آدمية أي إنسان في هذا الكوكب، وليس بقاء جهات حكمتنا لسنوات وحولت حكمها لخدمة مصالحها الحزبية السياسية من دون التفات لمعاناة السكان.

ويخشى معارضو «حماس» من عودة الاعتقالات في أوساطهم والتعرض لهم بسبب الانتقادات التي وجهوها للحركة خلال الحرب؛ الأمر الذي انعكس بوضوح في حالة مقتل الأسير المحرر هشام الصفطاوي، من نشطاء حركة «فتح»، على يد عناصر من «حماس» اقتحموا منزله في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قالت عائلته. وذلك إلى جانب حالات قتل أخرى لأشخاص اتُهموا بأنهم يعملون لصالح إسرائيل، من دون أن يخضعوا لمحاكمات قانونية.
وقال المواطن (م.أ) من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، إن عودة عمليات القتل وإطلاق النار وسرقة المساعدات من قِبل مجهولين، تشير بشكل واضح إلى أن «حماس» ليست قادرة على ضبط الأمن بشكل كامل كما كان الوضع سابقاً قبل الحرب، مشيراً إلى أن بعض المواطنين قُتلوا بسبب معارضتهم الحرب على أيدي مسلحين والاتهامات كانت توجه للحركة، بينما قُتل آخرون في ظروف مختلفة.
«أبو شباب» وآخرون
ما زالت قوى أمن حكومة «حماس» تحافظ على وجودها النسبي وانتشارها في الكثير من المناطق، وبدأت بمعالجة بعض القضايا الجنائية، في حين أنها لا تسيطر على بعض المناطق التي ما زالت موجودة فيها القوات الإسرائيلية، أو وضعتها الأخيرة في عهدة بعض المجموعات المسلحة التي تصفها «حماس» بـ«عصابات» تخدم إسرائيل، مثل مجموعات «ياسر أبو شباب» شرق رفح، أو حسام الأسطل جنوب خان يونس، أو رامي حلس شرق مدينة غزة، وغيرها من الأسماء التي برزت في الفترة الأخيرة.

وسعت هذه المجموعات إلى أن تشكل تحدياً لحركة «حماس» وحكمها في قطاع غزة، لكنها فشلت في تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، رغم أنها في بعض الفترات حاولت استغلال وجودها وحمايتها من قِبل إسرائيل لتنفيذ عمليات ضد نشطاء من «حماس» أو مراكز حكومية مثل المستشفيات أو غيرها، لتظهر وجودها وقوتها، فإنها في كل مرة كانت تصطدم بمقاومة من مسلحين يتبعون للحركة، كما أنهم تعرَّضوا لكمائن وقُتل الكثير من أفرادها.
وتوقف نشاط تلك المجموعات المسلحة بشكل كبير داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها حركة «حماس»، واكتفت بتمركزها داخل المناطق التي توجد فيها، حيث تعرضت لثلاث هجمات من قِبل عناصر الحركة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة بعضهم في حين تمت السيطرة على أسلحة ومركبات تابعة لهم.
ولا يعرف كيف سيتم التعامل مع قضية نزع سلاح «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهي مهمة ستكون صعبة في ظل الخلافات بشأنها، في وقت يأمل الغزيون أن يتم الاتفاق بشأنها من دون أي خلافات قد تعيد الأوضاع للمربع الذي كانت عليه، وتستخدم إسرائيل ذلك ذريعة للعودة الحرب.
آفاق القوة الدولية
يأتي ذلك في وقت ما زالت تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة مشروع أمام مجلس الأمن يسمح بتشكيل قوة دولية للعمل في قطاع غزة، وسط خلافات واضحة على المستويين العربي والإسلامي بشأن إمكانية المشاركة في هذه القوة من عدمه، خاصةً وأن مهامها ومسماها غير واضح، فيما إذا كانت قوة إنفاذ ستطبق خطة ترمب بالقوة، أم أنها خطة لمراقبة وقف إطلاق النار؟
وتسعى «حماس» والفصائل الفلسطينية، عبر الوسطاء للضغط على الولايات المتحدة، لتحديد واضح لمهام هذه القوة، كما تؤكد مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط».
ويخشى السكان في قطاع غزة من أن تكون مهام هذه القوة أكبر بكثير مما هو معلن، وأن تسمح لبقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع، واحتلال أجزاء منه، أو أن يكون لها مهام خفية تتعلق بالبقاء في غزة لسنوات طويلة لنزعها من أن تكون تحكم حكم فلسطيني في المستقبل القريب ونزعها من هويتها الحقيقية. ويقول المواطن فادي البكري (45 عاماً) من سكان مدينة غزة، إن وجود مثل هذه القوة داخل القطاع، قد يكون له آثار سلبية على حياة المواطنين، ولا يحقق لهم حقهم في الأمن والأمان، وهذا قد يؤدي إلى وقوع أحداث أمنية خطيرة نتيجة تشابك عناصر المقاومة ونشطائها مع تلك القوات في حال كان من مهامها نزع سلاح المقاومة.
في حين يقول الشاب مجد ياسين (31 عاماً) من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، إن أي قوة دولية لا تريد ضمان تطبيق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وإعادة الأمن، وتوفير حياة ملائمة للسكان من خلال مساعدة جهة فلسطينية تحكم القطاع، فإنه غير مرحب بها، ووجودها سيكون بمثابة خطر كبير على كل مواطن.
الأمل في حكومة موحدة
يأمل السكان في أن تكون هناك حكومة فلسطينية موحدة تدير شؤونهم وتهتم بقضاياهم، خاصةً ملف الإعمار وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والحفاظ على أمنهم بعد وقف إطلاق النار، من دون أن يسمح لمجموعات مسلحة بالسيطرة على حياتهم.

ويكرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه محمد مصطفى، التصريحات التي تؤكد على استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة.
ويقول الغزي عاصم الغزالي (39 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، إن السكان يرغبون في عودة السلطة الفلسطينية لكي تعينهم على تخطي أزمات الحرب التي عاشوها على مدار عامين، وأن يكون هناك قانون واحد يساوي بينهم ويحكمهم.
وأضاف: «نحن نعيش بعد وقف إطلاق النار، حرباً أقسى من الحرب العسكرية، وآن الأوان لأن يتغير الحال للأفضل».
ويقول الشاب عمر البحيصي (24 عاماً) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، إن الظروف التي عاشها كشاب بلا أي مستقبل، يريد ويطمح لأن يكون هناك جهة تحكم الجميع وتحقق الأمن والأمان، وتعيد بناء ما دمر، وأن تبني مستقبلاً للجيل الشاب، وكذلك للأطفال الذين أضاعت الحرب مستقبلهم التعليمي، وهم أشد الفئات التي في حاجة إلى الدعم النفسي والمجتمعي بعد هذه الحرب القاسية.
في حين يرى صديقه الشاب حسن أبو عيشة، أن مستقبله كخريج هندسة، يكمن في الهجرة خارج قطاع غزة، من أجل بناء مستقبله، والبحث عن عمل مناسب، يساعده على النجاة وتأسيس عائلة.

ويقول أبو عيشة: «عشنا حياة صعبة وشديدة طوال عامين من الحرب، وحان الوقت لأن تتاح لنا فرصة البحث عن مستقبل جديد لنا»، مشيراً إلى أنه يفضل الهجرة حلاً فردياً وليس بكونها قراراً مفروضاً من إسرائيل وأميركا لنقل سكان القطاع إلى دول ثالثة بهدف التخلص منهم.