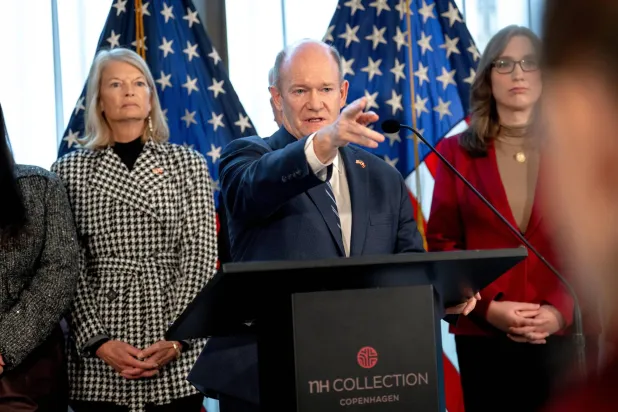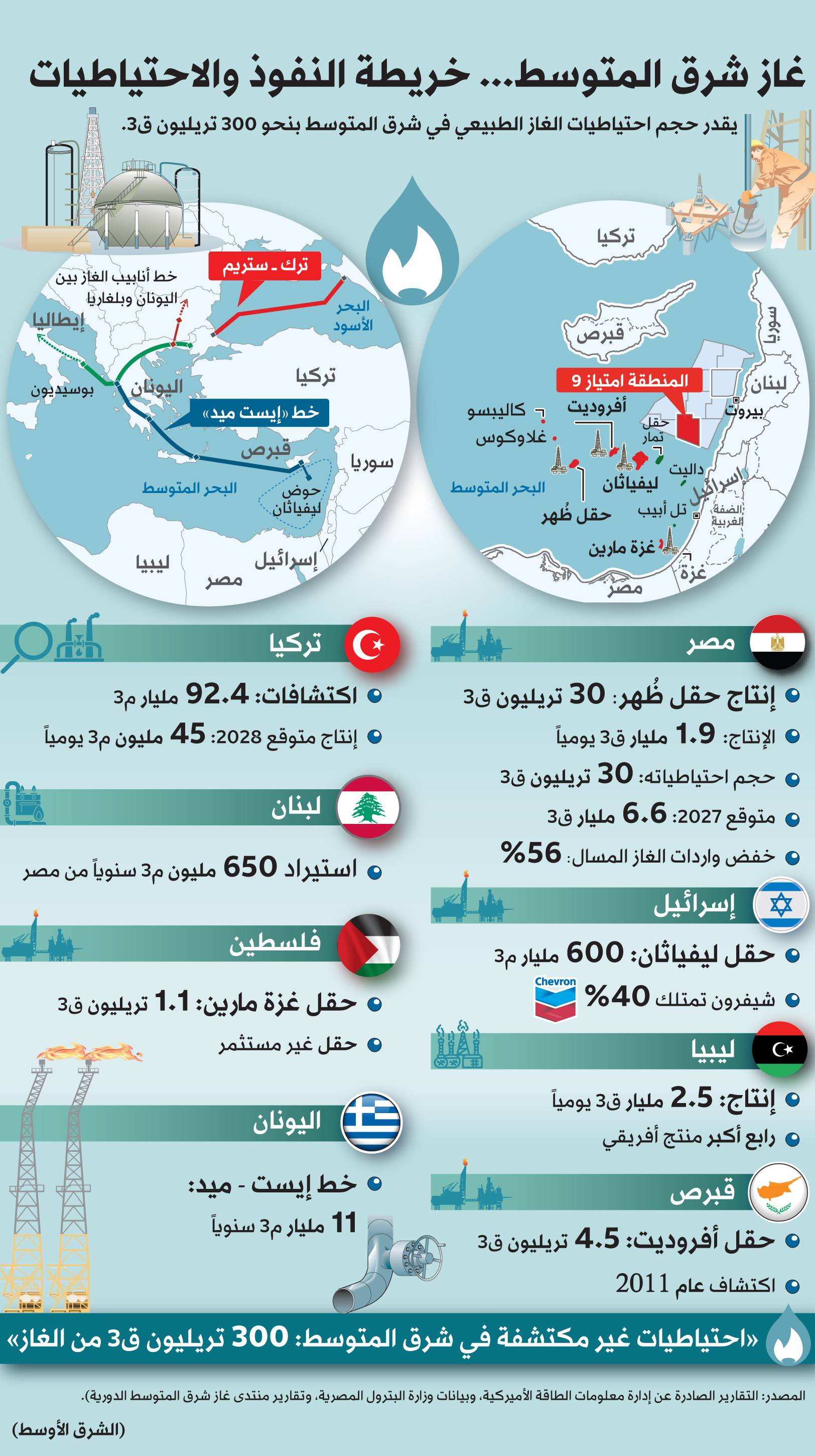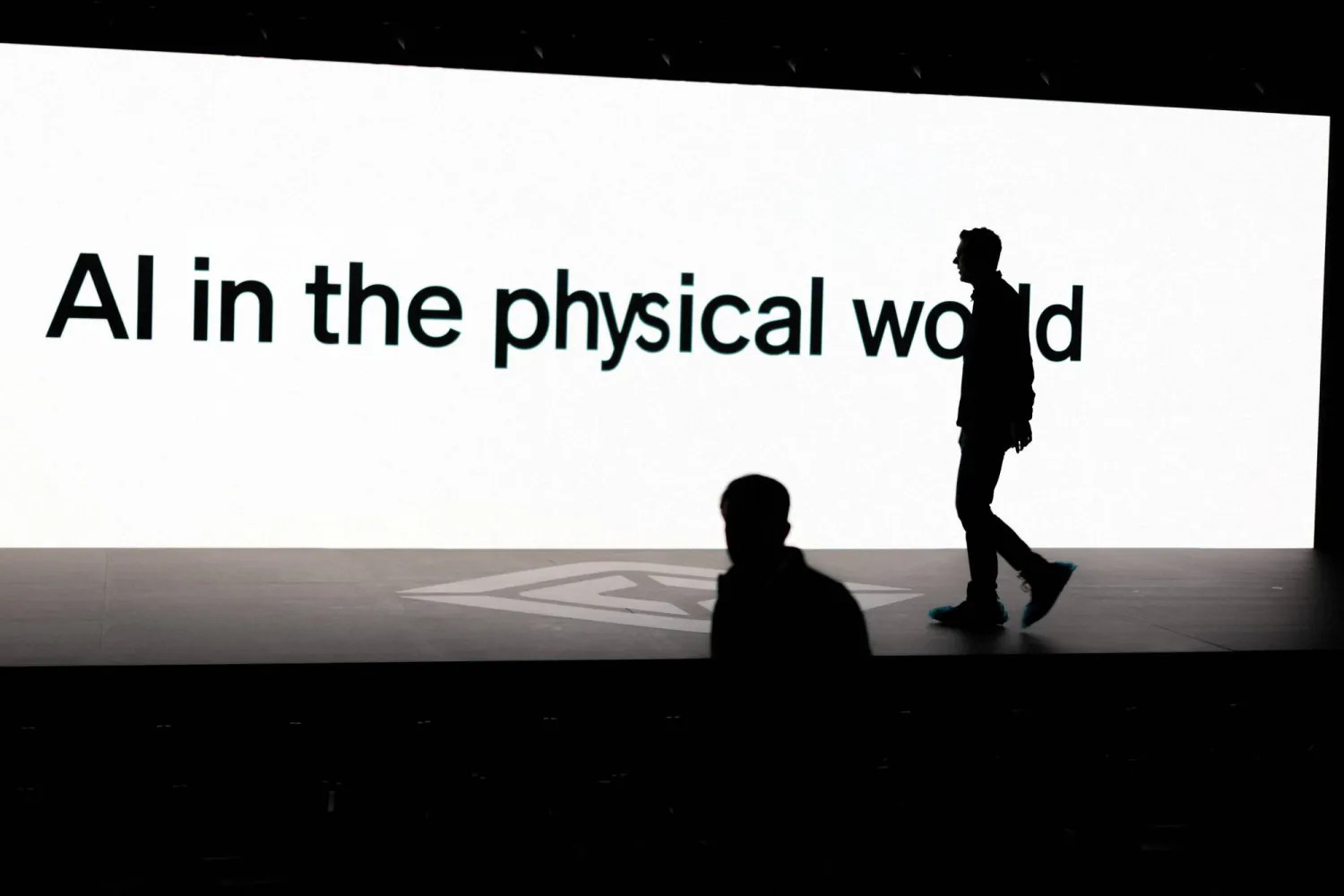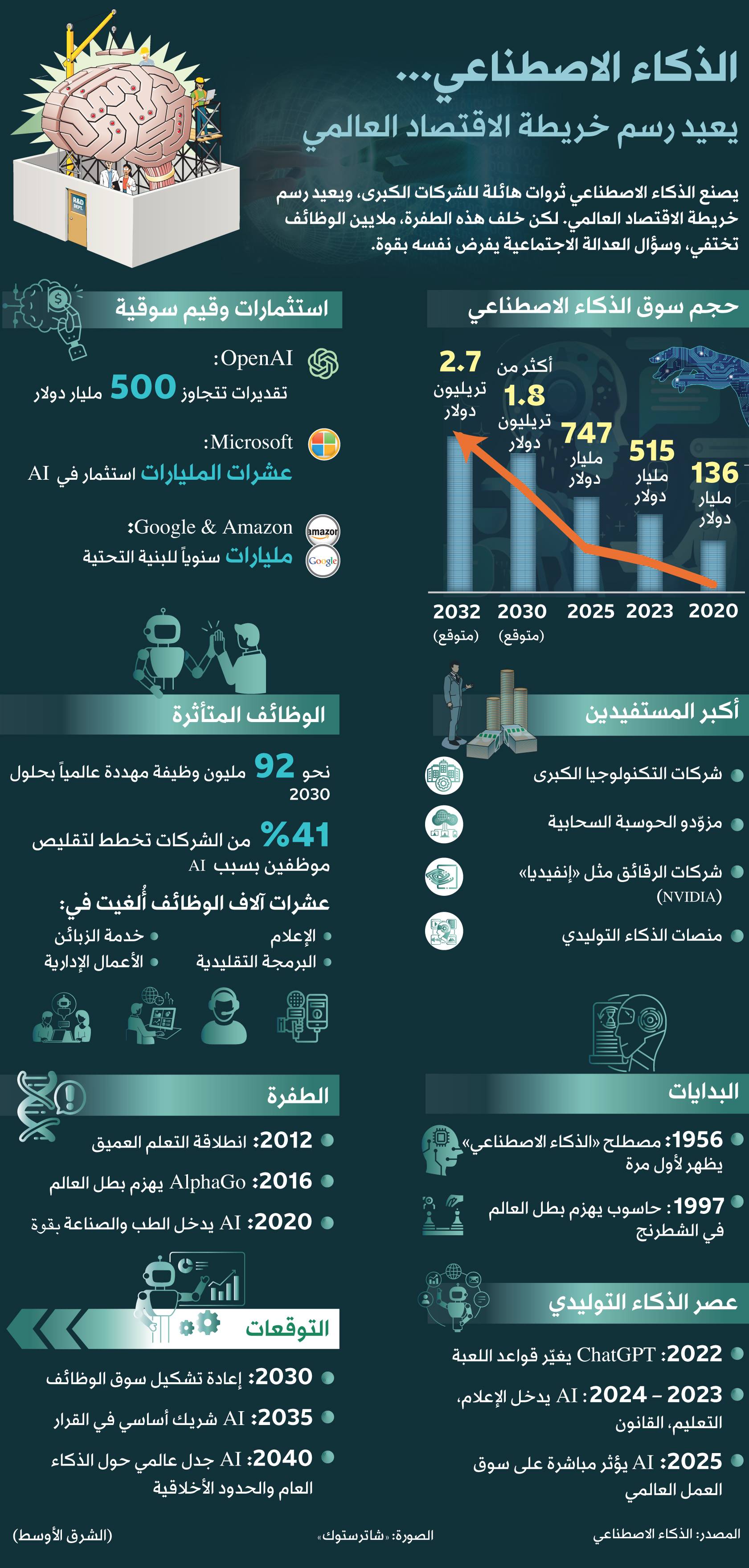حين نشأ لبنان في 1920 وحين استقلّ في 1943، لم تكن فكرة العداوة والعدوّ من شِيمَه، ولا كانت على لسانه. فلحسن الحظّ لم يكن لدينا «مليون شهيد» نتباهى بهم، بل لم يكن لدينا أيّ شهيد أصلاً. وقد خلا تاريخنا الاستقلاليّ من معارك، كمعركة ميسلون في سوريّا. فـ«الآباء المؤسّسون»، إذا صحّت الاستعارة الأميركيّة، اهتمّوا بالصداقة وبناء الجسور، فوصفوا بلدهم بأنّه «جسر بين الشرق والغرب»، ترصّعه المدارس والجامعات والمستشفيات والمصارف والرساميل والفنادق.
وكان من مصادر التكريم الذي أُسبغ على فينيقيا، وعلى الاستمراريّة التي قيل إنّها تضمّنا إليها، أنّ الفينيقيّين تجّار يعبرون المحيطات ويقصّرون المسافات. وكان في وسع الفينيقيّين أولئك أن يعيشوا في جوار عرب مسالمين أيضاً، فضلاً عن كونهم يأتوننا سيّاحاً ومصطافين ومستثمرين. وإذا كان لا بدّ من أعداء، لأنّ الأساطير المؤسِّسة للأوطان تتطلّب الأعداء، اختار أولئك الآباء أعداء اندثروا ولم تعد لهم ذريّة. هكذا أعلنوا عتبهم على الإسكندر المقدونيّ الذي حاصر صور قبل زمن المسيح، وعلى الملك الفارسيّ أرتحششتا الذي حاصر صيدا في زمن مُقارب. فكأنّما أريدَ القول إنّ لبنان لم يولد من رحم العداوة، وحين كانت العداوة تقصده كان يقاومها مضطرّاً، وهي في الأحوال كافّة، مرّت مروراً سريعاً ولم تعمّر.
صحيح أنّ الرواية التاريخيّة المعتمَدة لم تستطع تجاهل العثمانيّين. فهم قتلوا فخر الدين المعنيّ، الذي رفعته السرديّة الرسميّة جَدّاً أوّل للوطن، كما نفوا جدّه الثاني، بشير الشهابيّ. لكنّ العثمانيّة هي أيضاً صارت تاريخاً بلا وريث منذ ألغى أتاتورك سلطنتها وخلافتها. وبالمعنى هذا أصبحت الإحالات الكثيرة إلى الأربعمائة سنة عثمانيّة لا تدلّ إلى أحد، إذ قبل رجب طيّب إردوغان لم يكن في تركيّا حاكمٌ يتعصّب لها أو يُغضبه هجاؤها.

أمّا الامتحان الأصعب الذي عبره لبنان فكان موضوعه جمال باشا عام 1916. هكذا أُطلقت استدراكات ثلاثة لتطويق تلك العداوة: فأوّلاً، بولغَ في التوكيد على أنّ الرجل سفّاح، وهذا ما امتصّ مضمون العداوة السياسيّ وردّها إلى ساديّة مَرَضيّة أصيلة فيه. وثانياً، كُرّم الشهداء بأن جُعل لهم عيد، فكأنّ المقصود أنّ هذا احتفال أو تنصيب يحصل مرّة واحدة، مثلما الحال حين يُحتفل بعيد قدّيس معيّن. وثالثاً، وبما أنّ جمال أعدم مسيحيّين ومسلمين، جُعل الإعدام جسراً آخر يؤدّي إلى الوحدة الوطنيّة ويمتّنها. آخرُ الأحزان جعلناه، إذاً، أوّل الأفراح.
وكان من أسباب البساطة هذه أنّ الأوضاع نفسها بسيطة لا تحوِج إلى تعقيد. أمّا الحرّيّة فأكثر من كافية لجعل بلد قليل العداوات وكثير الصداقات شيئاً قابلاً للحياة. وفي وقت لاحق، نطقَ رجل، لم تصدر عنه إلا الكليشيهات المضجرة، بعبارة مبدعة هي أنّ «قوّة لبنان في ضعفه»، بمعنى أنّ الجسور مدافع اللبنانيّين وسلاحهم الثقيل.
وظلّ تعبير «العدوّ» غير مُستساغ في القاموس اللبنانيّ السائد، شأنه شأن باقي التعابير التي تلازمه عادةً، كـ«الاستعمار» و«الرجعيّة» و«الصهيونيّة». ولكثيرين بدا الشيوعيّون الذين يشهّرون بـ«الحلف الأطلسيّ»، والعروبيّون الذين يتباهون بمعارك اليرموك والقادسيّة، أشخاصاً غريبين يتحدّثون لغة عجيبة. ولئن تسرّع البعض حين خوّنوا إميل إدّه، إبّان الاستقلال، بقي المعترضون على فكرة التخوين، والمشمئزّون من جوّها التشهيريّ، كثيرين. وبالطبع لم تنشأ محاكمات ولم تحصل إعدامات من النوع الذي يلازم تهمة الخيانة. هكذا رفض اللبنانيّون، مرّة أخرى، أن يكون الدم أحد آبائهم. وبعد ثلاث سنوات على الاستقلال، حوّل إميل إدّه مؤيّديه إلى حزب سياسيّ شرعيّ، وحين توفّي، بعد ثلاث سنوات أخرى، أقيم له مأتم شعبيّ حاشد.

تفادي ذيول النكبة
وحتّى عندما نشبت حرب فلسطين في 1948، تراءى أنّ إطفاء نارها أمر ممكن. وبالفعل وقّعتْ على هدنة رودُس، بعد عام واحد، مصر وسوريّا والأردن، ما حالَ دون ظهور لبنان كأنّه متفرّد، أي كأنّه مسيحيّ في عالم الإسلام. والحلّ هذا لم يكن سهلاً فحسب، بل كان مُربحاً أيضاً، إذ أعفى اللبنانيّين من احتمالات الحرب كما أعفاهم من مغبّة التنافس مع مرفأ حيفا الصاعد في دولة إسرائيل ذات الوجه الغربيّ. وبهذا تمكّن الشاطر اللبنانيّ من أن يؤكّد شطارته التي لا يُمارى فيها. وبعد سنوات، تجرّأ لبنانيّون على أن يقدّموا نموذجهم الذي سمّوه «عيشاً مشتركاً»، بديلاً عن النموذج الصهيونيّ لإسرائيل.
يومذاك كان التأمّل ممكناً ونقاش التأمّلات ممكناً أيضاً، تماماً كما كانت الشطارة. وبرغم النكبة، ثمّ الانقلابات العسكريّة التي راحت منذ 1949 تضرب الجوار السوريّ، ومحاولة انقلاب فولكلوريّة نفّذها أنطون سعادة، «زعيم» القوميّين السوريّين، وأُعدم بنتيجتها، لم يعرف لبنان، في 1952، أكثر من «ثورة بيضاء» أطاحت ببشارة الخوري وعهده. وهذه كانت أشبه بمشاجرة قرويّة أو مباراة زجليّة، اندرجت في تاريخ من العراضات التي كانت تنتهي بتبويس اللحى، وباكتشاف أنّنا أخوة متحابّون.
وظلّ ممكناً، حتّى أواسط الخمسينات، الحفاظ على طريقة الحياة هذه. وكان ما يسهّل الأمر أنّ الأنظمة العربيّة، ما قبل الانقلابات، شابهت نظام لبنان. فهي أيضاً حرصت على علاقة جيّدة مع الدول الغربيّة، وأبقت على الإدارة والتعليم كما أنشأهما الاستعمار الغربيّ، كما أقدمت على محاولات تجريبٍ في البرلمانيّة شابتْها، كما كلّ المحاولات الأولى، شوائب ونواقص.
ولأنّهم رأوا البلد رائقاً ومُطَمْئناً، التحم به المسيحيّون الذين أسّسوه التحاماً صوفيّاً. فهو عندهم ليس وطناً فحسب، بل هو البيت والجبل والبحر، وهو عصارة الكون و«أرز الربّ» الذي لا يكون الشاعر شاعراً إن لم يكتب نصف شعره عنه، ولا يكون المغنّي مغنّياً إن لم يُغنّ له. هكذا رُفعت الوطنيّة إلى ديانة متعالية ومطلقة تطالب بالموافقة على كلّ حرف فيها. أمّا الذي يشكّك بهذه الفهم للوطنيّة فجرى التشكيك بلبنانيّته نفسها. وفي المقابل، حافظ المسلمون على مسافتهم الهادئة التي تفضّل أن يكون الوطن جواز سفر وفرصة عمل وعلاقة جوار ولا تستسيغ رومنطيقيّة الريف وهذا الاحتفال الدائم بالنفس. والمسافة تلك كان يمكنها، لو اختلفت الظروف، أن تعقلن الوطنيّة اللبنانيّة وتثبّتها على سكّة أكثر دستوريّة وديمقراطيّة، بيد أنّ أواسط الخمسينات راحت تدفع في اتّجاهات أخرى.
فمع تمكين جمال عبد الناصر قبضته في مصر، نشأ قاموس سياسيّ جديد في المنطقة مفرداته الثورة والتحرير ومكافحة الاستعمار وتخوين «أعوان الاستعمار» والتحريض على إسقاطهم، وهذا فضلاً عن تعطيل الأحزاب السياسيّة وتأميم الصحافة وتدجين النقابات وهروب الرساميل. لقد استقرّت الرئاسة والزعامة في يد ضابط، وفي 1956 تحديداً، مع «حرب السويس» أو «العدوان الثلاثيّ»، انهالت على ذاك الضابط أوصاف هي غالباً ممّا يُمنح للأنبياء والرسل.

هكذا راح يتبدّى كأنّ الحياة اللبنانيّة، كما رسمها القاموس السائد، هي في أحسن أحوالها نعيم مضجر لا يطاق، وفي أسوأها هروب جبان من صناعة الأقدار والمصائر الملحميّة. فالمنطقة باتت تنتج العداوات وتستهلكها بنهم وشراهة، فتطرد أفكار التوافق والتسوية، فيما هي تغلق البرلمانات تباعاً، ولا ترى طريقاً إلى المستقبل غير نكء جراح الماضي. وبات لبنان مطالَباً بأن يكون له موقف: فبدعوة من رئيس الجمهوريّة كميل شمعون، عُقدت في بيروت قمّة للتضامن مع مصر، وأكّد بيان القمّة الختاميّ على «مناصرة مصر ضدّ العدوان الثلاثيّ (...) واعتبار سيادة مصر أساس حلّ قضيّة السويس، وتأييد نضال الشعب الجزائريّ من أجل الاستقلال». لكنّ عبد الناصر أراد أكثر كثيراً، فطلب من الحكومة اللبنانيّة قطع العلاقات مع فرنسا وبريطانيا. وكان طبيعيّاً أن يرفض شمعون طلباً كهذا. فهو، من جهة، يقطع بعض الشرايين الأساسيّة لبلد ناشئ يرى أنّ علاقته بالغرب شرط شارط لازدهاره ولتعليمه. وهو، من جهة أخرى، يغيّر معنى لبنان كما رسمه «الآباء المؤسّسون». وعلى عكس ما أشيع، لم يكن في ذلك شيء من «الانعزال عن العرب»، إذ الأكثريّة الساحقة من الحكّام العرب كانت ترى ما رآه شمعون، وتتخوّف من «المارد الأسمر» مثلما تخوّف.
لكنّ الأمر لم يقتصر على حاكم مصر العسكريّ. فيومها كان الاتّحاد السوفياتيّ ما بعد الستالينيّ، والضالع في حرب باردة مع الغرب، يتقدّم من الشرق الأوسط، وكانت سوريّا، التي تحدّ لبنان من الشمال والشرق، تخضع لحكم ضبّاط يختبئون خلف واجهة مدنيّة. وكان هؤلاء الضبّاط، من ذوي الميول القوميّة العربيّة والبعثيّة، قد سحقوا خصومهم من «حزب الشعب» والقوميّين السوريّين وشرعوا يدفعون بلدهم نحو وحدة اندماجيّة مع مصر الناصريّة. وفي المعمعة هذه بدأت إعادة تأسيس القضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة لا تُعالَج بالهدنة والسياسة والوساطات الدوليّة، بل بتحريرٍ يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 1948. هكذا ارتسمت العداوة، التي حرص لبنان على تجنّبها، قدراً لا سبيل إلى تجنّبه، ولا تستطيع الشطارة تذليله.
عودة المكبوت
وكانت قضيّة فلسطين بالطريقة التي صارت تُطرح فيها أشبه بعودة المكبوت وهو جريح مُدمّى. فالفلسطينيّون الذين طُردوا من أرضهم وبيوتهم، وفي عدادهم مائة ألف نزحوا من الجليل إلى لبنان، وجدوا في عبد الناصر وإذاعة «صوت العرب» ما يغريهم بالعودة والتحرير، ويقنعهم بانسداد طرق السياسة والتسويات. وفي لبنان استيقظ مكبوت آخر هو تاريخ البلد نفسه، إذ صار إنشاء «لبنان الكبير» في 1920 قابلاً لإعادة النظر. فهو ضمّ، في الأطراف، أكثريّات إسلاميّة مشدودة اقتصاديّاً وقرابيّاً وعاطفيّاً إلى سوريّا وفلسطين، لكنّ الأطراف هذه وُحّدت مع ما كان متصرفيّة جبل لبنان ذات اللون المسيحيّ الطاغي. وفي ظلّ توازنات القوى الجديدة، من تحوّلات الديموغرافيا اللبنانيّة إلى الصعود الناصريّ، لم يعد مقبولاً ما بدا مقبولاً على مضض صامت في زمن أسبق. فالسياسة الموصوفة بممالأة الغرب وبمناوأة عبد الناصر، والنظام الرئاسيّ، خصوصاً وقد زوّر انتخابات 1957 وأسقط معظم القادة المسلمين لتعاطفهم مع الزعيم المصريّ، باتا عبئاً على استمرار النظام. وفي 1958، وبعد شهرين على قيام الوحدة المصريّة السوريّة، انفجرت حرب أهليّة طائفيّة كانت تمريناً أوّليّاً على حروب أشدّ شراسة سوف تلي. هكذا بدا أنّ يقظة القديم المسكوت عنه لا تأتي إلاّ على شكل حرب.

وفي تسوية أميركيّة - مصريّة، جيء بفؤاد شهاب رئيساً موصوفاً بالقدرة على توحيد لبنان. فهو، وإن كان مارونيّاً لا يرقى الشكّ إلى مارونيّته، لم يزجّ الجيش، بوصفه قائداً له، في مواجهة 1958. لكنّ نجاح تجربة الإصلاح الشهابيّ استدعت ربط السياسة الخارجيّة للبنان بالقاهرة، وأُحكمت السيطرة على الإعلام اللبنانيّ. كذلك زُوّرت انتخابات 1964 مثلما زُوّرت انتخابات 1957 إنّما على نحو معكوس، فأُسقط كميل شمعون وريمون إدّه، ومُنح جهاز «الشعبة الثانية» صلاحيّات يصعب تبريرها في نظام برلمانيّ. وما كادت تنتهي التجربة الشهابيّة، في النصف الثاني من عهد شارل حلو، حتّى انشقّ اللبنانيّون من حول المقاومة الفلسطينيّة الناشئة للتوّ، ووجدنا أنفسنا على أبواب حرب لن تلبث أن تندلع.
في تلك الغضون حاول الرحابنة وفيروز إقناعنا بأنّ مشاكلنا بسيطة، ناجمة عن سوء فهم وقابلةٌ لأن تُحلّ بالتفهّم والمحبّة، على غرار ما يحصل في القرى برعاية الشاويش والمختار. إلا أنّ الأعرف بيننا شرعت تُضحكهم تلك النهايات السعيدة. ذاك أنّ قاموسين مكتملين ارتسما في الأفق يتجاوزان الانقسام الحاصل ما بين تأييد الجيش وتأييد الفدائيّين الفلسطينيّين. فالقاموس الأوّل تعامل مع لبنان بوصفه بلداً ناجزاً، لا ينقصه إلاّ بعض الإصلاح، وكان أصحاب هذا القاموس يستوحون بلدان أوروبا المستقرّة نموذجاً لهم. أمّا القاموس الثاني فاعتبره بلداً فادح النقص ينبغي أن يعاد تأسيسه من صفر، وأصحابُ هذا القاموس كانوا يجدون نماذجهم في بلدان «العالم الثالث» المندرجة حينذاك في مكافحة الاستعمار. والقاموس الأوّل ظلّ، رغم كلّ شيء، يرسمه بلداً رائعاً أنجز تحرّره ولم يعد بحاجة لأن يحارب ويقاتل لأنّ تاريخ الآلام بات وراءه، فيما كان القاموس الثاني يرسمه بلداً شنيعاً وكريهاً لا يزال عليه أن يجتاز شوط التحرّر الطويل. أمّا الحروب والعذابات فإنّما تبدأ للتوّ، وهي ستكون هذه المرّة أكبر من أيّ وقت سابق. والأسوأ أنّ ما ظنّه أهل القاموس الأوّل أدوات تحرّر، كالجامعة والمصرف، كان بالضبط ما ظنّه أهل القاموس الثاني أدوات استعبادٍ تُعزّز ربطنا بـ«الإمبرياليّة والاستعمار والرجعيّة العربيّة». وهم اقترحوا علينا، بعد أن نطلّق هؤلاء كلّهم، نماذج بديلة كسوريّا والعراق البعثيّين واليمن الجنوبيّ المتمركس والبلدان الشيوعيّة في أوروبا الشرقيّة. وعلى العموم، أصبحنا مثل رجل مصاب بمرضين، واحدٍ يُعالَج بالإكثار من تناول المسكّنات والآخر يُعالَج بالامتناع عن تناولها.
وفي أواسط السبعينات شرعنا نتحرّر، فإذا بها حرب أهليّة متمادية وضروس، صبغتْها المجازر وتطهير المناطق أو تطهّرها من المختلفين، وهذا ناهيك عن تعطيل الدولة وشيوع الميليشيات ممّا راح يتعاظم مذّاك. وفي آخر المطاف تأدّى عن ذلك اجتياح 1982 الإسرائيليّ، فلم يتحرّر اللبنانيّون ولا انتصر الفلسطينيّون.

أمّا دعاة الحلّ عبر انتصار كاسح يحتمي بالغزو الإسرائيليّ فرأوا أنّ رئاسة بشير الجميّل تطوي صفحة الماضي. هكذا رُفض كميل شمعون أو بيار الجميّل كمرشّحين للرئاسة، وهما مَن هما في التصلّب المسيحيّ، ولم يعد مقبولاً في موقع الرئاسة إلاّ رمز التحدّي وقائد الميليشيا بشير الجميّل. فالردّ على ما اعتبره أغلب المسيحيّين خيانة المسلمين بانحيازهم إلى المقاومة الفلسطينيّة واعتبارها جيشهم لا يكون إلا ببشير. لكنّ الأخير اغتيل قبل وصوله إلى قصره، ثمّ كانت حرب الجبل وحرب المخيّمات وحرب الإلغاء وحرب التحرير، وراحت الكراهية، في وداع متعدّد الفصول للبنان القديم، تشقّ طريقها من الأجسام الاجتماعيّة الأكبر إلى الأجسام النواتيّة الأصغر.
والحال أنّ لبنان القديم لم يكن سيّئاً، وهو قطعاً كان أفضل الموجود في الشرق الأوسط. صحيح أنّ القصور والخطأ لازماه لكنّ النجاحات التي لازمته كانت أكبر. فهنا، وبفعل الحرّيّة المتاحة، كان التاريخ يتحوّل ويفتح باباً للاحتمال، وخلال سنوات قليلة من عمر الاستقلال تمدّدت الرأسماليّة من المركز إلى الأطراف، واشتدّ عود الطبقة الوسطى، وحصل اللبنانيّون على تعليم جيّد جعلهم شعباً مؤهّلاً لكثير من الأدوار والوظائف في داخل بلدهم وفي خارجه، كما اتّسع نطاق العمل الحزبيّ والنقابيّ مثلما اتّسعت رقعة الإعلام وما يمارسه من نفوذ. وهذا جميعاً لم يترافق مع ظهور ديكتاتور أو آيديولوجيا رسميّة تقول للسكّان: هكذا كونوا ولا تكونوا هكذا.
عبادة الأسد ونصر الله
لكنْ إبّان الحرب المديدة التي كسرت لبنان القديم جدّ عاملان شدّانا من شَعرنا إلى الانحطاط وكان لهما دور بارز في تأسيس الجمهوريّة الثانية. فقبل الغزو الإسرائيليّ وبعده، فرض نظام الوصاية، وعلى نحو غير مسبوق في لبنان، آيديولوجيا رسميّة على لبنانيّين كانوا قبلذاك أحراراً. هكذا لم يعد مقبولاً أن نفكّر ونناقش ونستنتج في ما يخصّ «عروبة لبنان» أو «قداسة المقاومة». وكان من نتائج التحوّل هذا انكماش الفضاء العامّ وازدهار التلقين والتخوين والتشهير في التعامل مع الرأي الآخر، تماماً كما هي الحال في الأنظمة الديكتاتوريّة والتوتاليتاريّة المؤسّسة على العداء والكراهية.
ومنذ ذلك الحين راحت تتزايد المقدّسات في حياتنا كما تتزايد المدنّسات. وكانت ثنائيّة المقدّس والمدنّس، وهي دوماً طريق إلى العنف والعداوة، تمهيداً لعبادة أولياء صالحين كان أبرزهم حافظ الأسد ومن بعده حسن نصر الله. وراح يتبدّى بجلاء، وعلى عكس الحكمة الشائعة، أنّ الجمع مستحيل بين أن تكون مقاوماً وأن تكون حرّاً يقتل نفسه فدى لحذاء زعيم. وهذا، بطبيعة الحال، جاء مصحوباً بفقر أكبر وتعليم أسوأ وهجرات شبابيّة إلى سائر أرجاء المعمورة.
أمّا العامل الآخر فكان الثورة الإيرانيّة، أعظم الكوارث التي شهدتها منطقتنا في تاريخها الحديث. فمعها لم تعد العداوة والعنف يستهدفان طرفاً في حاضرنا، بل باتا يدفعاننا عميقاً في الماضي إلى يزيد بن معاوية والحسين بن عليّ. فكأنّما العداوة أصل أصيل في البشر ما إن يبرأوا منه حتّى يبرأوا من بشريّتهم. وبعدما كان عيب الثورات إصرارها على فرض التنوير دونما اكتراث بالواقع، بات عيب هذه الثورة إصرارها على رفض التنوير من أساسه.

وعن الرعايتين السوريّة والإيرانيّة، وفي ظلّ تردّي الجسد اللبنانيّ المنهك بحروبه، انتهت السياسة، فرمزَ إلى نهايتها الطاقم الذي تولّى الحكم متوّجاً بالرئيس إميل لحّود، الموظّف المطواع لدى المتحكّمين في دمشق وطهران. أمّا الثمرة الأكبر التي نجمت عن زواج الرعايتين هاتين فكان «حزب الله» الذي استثني من حلّ الميليشيات، كما قضى به اتّفاق الطائف، بذريعة الاحتلال الإسرائيليّ ومقاومته.
لكنّ زوال الاحتلال في 2000 لم يُنه السلاح الذي ازداد افتتاناً بذاته، وفي حرب 2006 أضاف العرب إلى افتتانه بنفسه افتتانهم به، إذ، كما قيل، صمد وقاتل وهزم إسرائيل. وما لبث هذا الحزب، بعد عامين فحسب، أن وضع يده على بيروت بعدما غزاها وأذلّها. وعلى مدى تلك المرحلة التي جعلت لبنان ملحقاً بـ«حزب الله»، راح يهطل علينا القتل والقتال والشهادة والشهداء بوصفهم الصناعة الحصريّة للبنان، وانقسم المواطنون إلى واحد يحمي وآخر يُحمى، وهما كانا ينقلبان، حين تستدعي الظروف، إلى واحد يهدِّد وبيده السلاح، وآخر منزوع السلاح يُهدَّد وليس له إلا الله. والحقّ أنّ الصناعة الإيرانيّة - السوريّة، وبالاستفادة من التصدّع اللبنانيّ لما بعد الحرب، نجحت في جعل الوحش أكبر من الغرفة التي يقيم فيها، بحيث غدا تهديم الغرفة شرطاً لقتل الوحش.
وإذ أصبح اكتساب الأصدقاء وبناء الجسور تهمة، غدت أعمال التفجير والاغتيال والخطف رياضة يوميّة. وحتّى لو وضعنا جانباً تلك الارتكابات التي طالت لبنانيّين وأجانب، وكانت بمثابة حرب تطهيرٍ للبنانيّة المعروفة، بقي اغتيال رفيق الحريري في 2005 والاغتيالات اللاحقة لسياسيّين وصحافيّين شهادةً على أنّ الوطن الواحد صار مهمّة صعبة، إذ انشطر السكّان إلى قاتل وقتيل.
وفيما توطّد نظام تقسيم العمل بين المقاومة والفساد، شاعت لدى بعض اللبنانيّين لغة ورواية للتاريخ مزعومتان لا تنطويان إلاّ على الضدّيّة وتمجيد العنف. فنحن منذ كنّا، وبغضّ النظر عمّا نفعل، مُستهدَفون بالأطماع، وليس متاحاً لنا إلاّ القتال حتّى نهاية العالم، وأمّا الكرامة فلا تُكتسب بالعلم أو التقدّم أو الإنجاز، بل هي تعريف أن نقاتل إسرائيل. وهذا، في عمومه، كان برنامجاً لتصغير العقل وشفط المعرفة وتلغيز العالم.
وبدوره جاء صعود ميشال عون في الوسط المسيحيّ ليعلن تمكّن السمّ من المسيحيّين. فهم تصرّفوا كالعامل الذي يضطهده ربّ عمله فيفجّر غضبه انتقاماً من زوجته ومن أبنائه. هكذا حاولت العدوانيّة العونيّة، المغطّاة بكثير من الزجل، أن توهمنا بأنّ الالتحاق بـ«حزب الله» هو وحدة بين أنداد متساوين يخوضون معاً حرب الأقلّيّات. ولاحقاً، إبّان حرب «حزب الله» في سوريّا، حاول الطرفان إيهامنا بأنّنا ننتقل من سويّة التحرّر الذي أنجزناه إلى سويّة التحرير الذي ننخرط فيه. فبدل التوقّف لمراجعة الأكلاف الهائلة التي رتّبها علينا «التحرّر» منذ ابتدائه في 1975 حتّى تصاعده النوعيّ مع «حزب الله»، هربنا إلى «التحرير» عبر احتلال جزء من سوريّا وقتل السوريّين وتهجيرهم.

وأن تسيطر إيران، من خلال «حزب الله»، على قرارات البلد الأساسيّة فهذا متعدّد الأبعاد والمعاني، لكنّ المعنى الذي يهمّنا هنا هو أنّ العداوة والضدّيّة والعنف باتت عنواناً لحياتنا العامّة، حيث «الموت عادة» و«كلّ يوم كربلاء وكلّ أرض عاشوراء».
وإذ وفّرت حرب غزّة مسرحاً نموذجيّاً للعيش وفق القتال، بات واضحاً أنّ الخيارين اللبنانيّين وصلا إلى نقطة اللاعودة، وأنّه بات من المشكوك فيه أن يتصالح هذان التصوّران عن لبنان وعن العيش فيه حتّى لو هبّت رياح إقليميّة ودوليّة لغير صالح الحزب المسلّح.
صحيح أنّ هذا التناول لم يتوقّف عند أخطاء كثيرة ارتكبها الجميع، وارتكبتها الطوائف كلّها، والحكّام جميعاً، أكان في إدارة البلد أو في اقتصاده أو تعليمه أو غير ذلك. لكنّ هذه العوامل، على أهميّتها، لم تكن سبب تفجيره وجعله مستحيلاً. فأغلب الظنّ أنّ المشكلة الأمّ تكمن في السؤال: أيّ لبنان نريد؟ وهل نغلّب الصداقة أو نغلّب العداوة؟ فاللبنانيّون لم يتّفقوا في الأساسيّات، وكلُّ ما يلوح في الأفق يوحي أنّ عدم اتّفاقهم سيكبر ويتعاظم. وهذا ما يُلزمهم، أو يُفترض أن يلزمهم، بالتفكير في عدم اتّفاقهم وفي تحويله إلى نظام وإلى مؤسّسة يحلّان محلّ الفوضى المشبعة باحتمالات العنف الخصبة. والأسرع الأفضل، كي لا تنتهي بنا الحال إلى ما انتهت بـ«الحمار الفلسفيّ» الذي كتب عنه فيلسوف القرن الرابع عشر الفرنسيّ جون بوريدان. ذاك أنّ حماراً ضربه الجوع والعطش وجد نفسه في النقطة الوسطى بين كومة قشّ وسطل ماء، فراح يفكّر: هل أشرب أوّلاً أو آكل أوّلاً؟ وظلّ يطرح هذا السؤال على نفسه إلى أن مات جائعاً وعطشاناً معاً.
* ألقي هذا النصّ في ندوة استضافها «حزب الكتلة الوطنيّة» في لبنان.