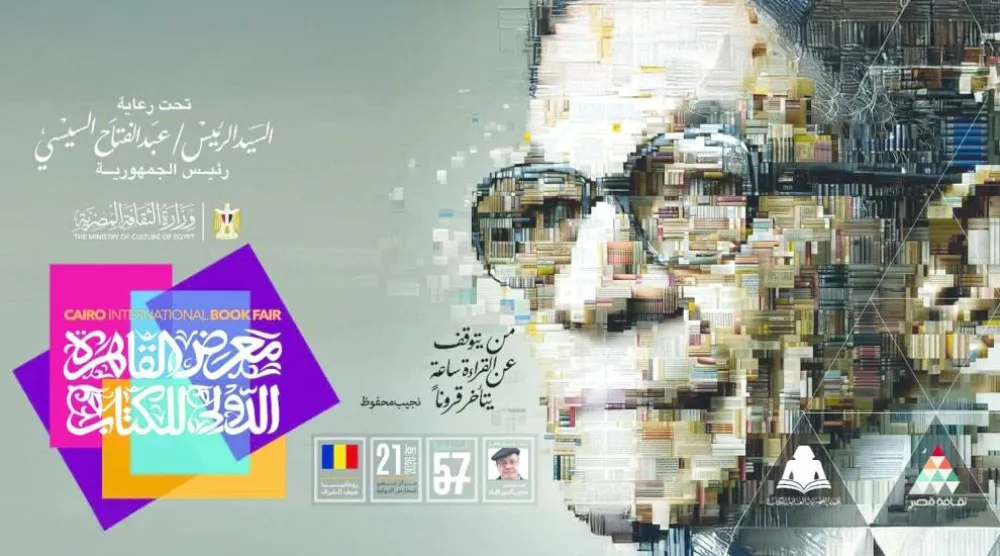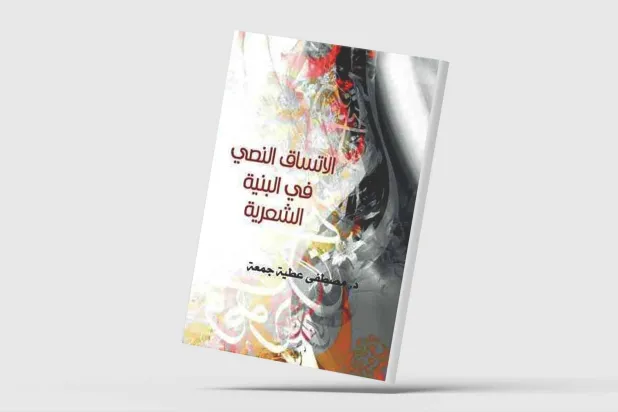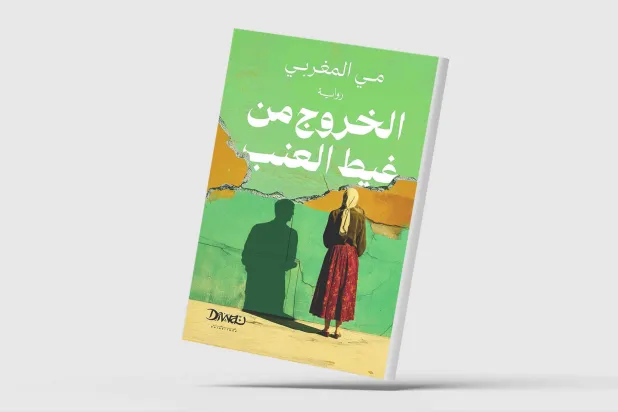يكشف الباحث والمؤرخ الدكتور خالد عزب في كتابه «القاهرة... الذاكرة الفوتوغرافية» - دار «ديوان» بالقاهرة - وعبر الكاميرا، عن سحر العاصمة المصرية في النصف الأول من القرن العشرين عبر طرزها المعمارية الفريدة وشكل الأحياء والشوارع والميادين في تلك الحقبة.
ابتداءً، يشير المؤلف إلى أنه في عام 1839 أعلن زعيم الحزب الجمهوري الفرنسي فرنسوا أرغو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عن اكتشاف «التصوير الشمسي» وشراء الحكومة الفرنسية هذا الاكتشاف وتقديمه للإنسانية. وكصورة من صور مسايرة مصر أحدث اكتشافات الغرب، التُقطت أول صورة فوتوغرافية في المنطقة العربية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1839 بحضور محمد علي باشا في مدينة الإسكندرية.

ومنذ التقاط الصورة الأولى في الإسكندرية. دخلت المنطقة العربية مرحلة جديدة من التوثيق البصري، وأخذ مئات المصورين في التدفق على مصر وسوريا، والتُقطت آلاف الصور للمعابد والهياكل القديمة للمدن والقرى، وصورت عدسات المصورين مختلف المناظر ومظاهر الحياة الاجتماعية. ولاقت تلك الصور رواجاً كبيراً في السوق الأوروبية، وخلال القرن التاسع عشر فقط نشط أكثر من ثلاثمائة مصور في مصر وبلاد الشام، وكان معظمهم من الفرنسيين والبريطانيين، وبعض الألمان والأميركيين.
وكان من الطبيعي أن تنال مدينة القاهرة الحظ الأوفر من اهتمام المصورين، حيث شهدت حالة من الازدهار المعماري خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، عكسته لنا مجموعة الصور الشمسية التي ضمَّها ألبوم لمجموعة من الصور كانت تحتفظ به مكتبة الملك فاروق الأول، تلك المجموعة التي تحكي مظاهر الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة منذ عام 1849 حتى أوائل القرن العشرين.
تحوي تلك المجموعة صوراً شمسيةً لمناظر شوارع القاهرة القديمة وميادينها، الشهيرة بتراثها المعماري العريق، كميدان محمد علي وميدان الأوبرا وميدان العتبة الخضراء وحي جاردن سيتي وشارع عماد الدين وشارع شبرا، بالإضافة إلى صور لعدد من السرايا والقصور التي اتخذتها أسرة محمد علي مقرّاً للحكم، كسراي عابدين وسراي القبة وقصر النيل.

عبر هذا الألبوم، تمكن متابعة التحول العمراني الذي أحدثه الزمن بعروس الشرق من خلال مجموعة صور لأعرق الفنادق بالقاهرة كفندقَي الكونتننتال وشبرد، بالإضافة إلى صور لدار الأوبرا القديمة والمتحف المصري وكوبري قصر النيل وكوبري أبي العلا، ومجموعة صور لحديقتَي الأزبكية وروستي، ومجموعة صور لأقدم مساجد القاهرة، والقناطر والبِرك التي أقيمت وحُفرت بالقاهرة آنذاك.
تعدّ تلك المجموعة من الصور الشمسية لمدينة القاهرة بمثابة كنز ينطق بما شهدته مدينة القاهرة من رقي معماري وتخطيطي، حيث التقط تلك الصور فنانون مرَّوا وأقاموا في مصر، ومنهم الفنان مكسيم دي كامب، الذي قام بنشر مؤلف زوَّده بمائة وخمسين صورة شمسية واهتم فيه بتسجيل مشاهداته عن الآثار المصرية التي بهرته، وذلك عبر رحلة قام بها إلى الشرق طاف خلالها في آسيا الصغرى، كما زار إيطاليا والجزائر. واستطاع دي كامب في عام 1848 وهو في السادسة والعشرين من عمره أن ينشر كتابه «ذكريات أدبية» الذي أهداه إلى زميله جوستاف فلوبير، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين، منهم فرنسيس فريث، وبيشار والفنان ليكيجيان.
ويؤكد الدكتور عزب أنه يمكن للمؤرخين كتابة التاريخ عبر الصور؛ لأنها توضح عناصر الحياة اليومية العارضة والعشوائية، دون فقدان أدق التفاصيل التي تبدو غير مهمة في وقت ما، لكنها تتحول مصدراً مهماً في المستقبل لإثبات شيء ما؛ لذا فتاريخ تطور مدينة القاهرة من القرن الـ19 إلى منتصف القرن العشرين يعتمد على التصوير الفوتوغرافي، خصوصاً في معرفة تغير وظائف بعض الأماكن. ويضرب المثل بعمارة «الإيموبيليا» في وسط القاهرة، فقد كان مكانها مدابغ القاهرة التي نُقلت في مرحلة لاحقة في القرن الـ19 إلى مكان جديد بين منطقتي «السيدة زينب» و«عين الصيرة»، ليصير مكانها السفارة الفرنسية، ثم عمارة «الإيموبيليا».
ويشير المؤلف إلى تجربته الشخصية في إنشاء مشروع «ذاكرة مصر» بمكتبة الإسكندرية، حيث سعى إلى تجميع آلاف الصور من مصادر متعددة، ليستطيع بناء أرشيف استثنائي يضم آلاف الصور النادرة التي تساعدنا على اكتشاف أحداث مختلفة في أوقات متباينة ونشر معلومات واضحة. ويوضح أن الربط بين مجموعة متناثرة من الصور لحدث معين كثورة 1919، على سبيل المثال، يعطينا تصورات جديدة حول بنية هذه الثورة ودور العمل السري في تنظيم المظاهرات وتوجيهها عبر اكتشاف الأشخاص المتكررين في الصور وطريقة حركتهم وأماكنهم في كل صورة، وكذلك تعيننا الصور على فهم وقراءة مواضع الأعلام والشعارات المرفوعة على لوحات مكتوبة، وكيفية حركة المجاميع داخل المكان، ليبقى السؤال المهم: هل خرجت هذه المظاهرات بصورة عشوائية تلقائية، أم بصورة منظمة ذات أهداف واضحة، أم أنها كانت تخرج عفوية ثم يجري توجيهها؟ تكشف الصور عن كل هذا؛ فقد خرجت عفوية تلقائية حين نراها تفتقد التنظيم المعتاد في بعض الصور، وخرج بعضها منظماً في بعض الأحيان، وبعضها خرج عفوياً ثم جرى توجيهه.