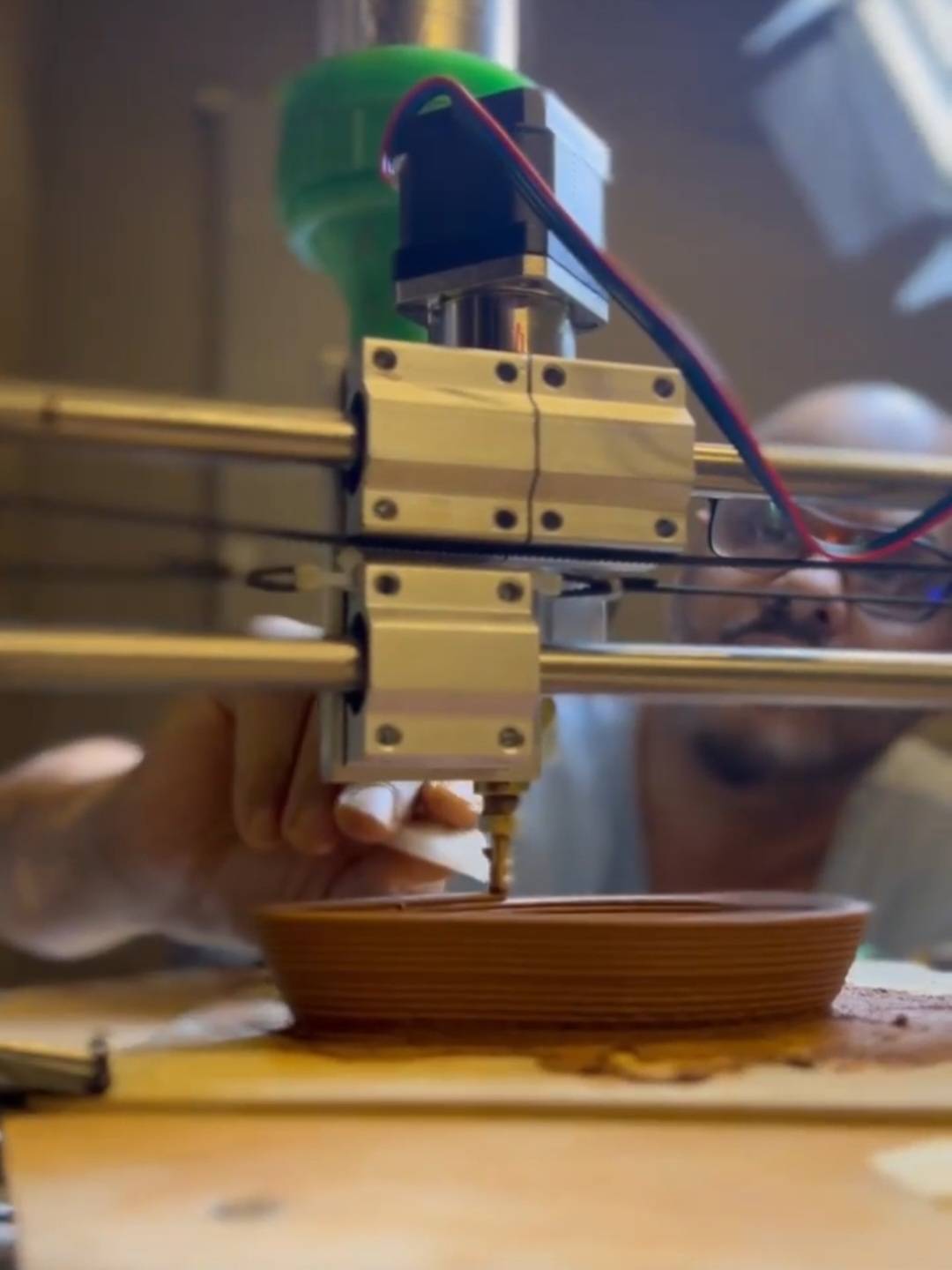على الرغم من أنه قضى عمراً طويلاً في التدريس والبحث العلمي الأكاديمي، فإنه فاجأ الجميع في 2015 بحصول روايته «الطلياني» على جائزة الرواية العربية «البوكر»، وهي الرواية الأولى لاسم لم يكن معروفاً في المشهد الروائي العربي. الناقد والأكاديمي والروائي التونسي شكري المبخوت الذي أصبح نجماً في عالم الرواية، ولد عام 1962، وهو عميد سابق لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، ويشغل الآن وظيفة رئيس جامعة منوبة. وحاصل على دكتوراه الدولة في الآداب، من كلية الآداب بمنوبة. صدر له عن دار «التنوير» ثلاث روايات، هي: «الطلياني» و«باغندا»، و«مرآة الخاسر»، كما صدر له: «السيد العميد في قلعته»، ورواية «السيرة العطرة للزعيم». جاءت روايته الأولى «الطلياني» وبعدها «مرآة الخاسر» وقبلهما مجموعة «السيّدة الرئيسة»، ضمن مشروعٍ روائي يسجل من خلاله تحولات المجتمع التونسي في قالب روائي.
لقيت «الطلياني» ترحيباً لدى عامة الجمهور الثقافي في العالم العربي؛ لأنها برأيه «قصة تونسية تعبّر عن المجتمع التونسي». الجانب الفني لـ«الطلياني» أنزلها هذه المنزلة في نفوس القرّاء، من ذلك بناء الشخصيّة المنكسرة التي لا تفقد تألّقها حتى في لحظة الانكسار؛ علاوة على الكتابة البصريّة التي تجعل القارئ يطالع الرواية كما لو أنه يشاهد شريطاً سينمائيّاً. هكذا يقول الدكتور شكري المبخوت لـ«الشرق الأوسط»، في الحوار التالي الذي أُجري معه بمناسبة الاحتفاء بتونس (ضيف شرف) في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022. وفيما يلي نص الحوار:
> كيف ترى الحضور الثقافي التونسي في معرض الرياض الدولي للكتاب؟
- أعتقد مبدئيّاً بأنّ هذا الحضور سيكون فرصة لمزيد من التعرّف على الحركيّة الثقافيّة التي تشهدها الثقافة التونسيّة؛ إذ لا شكّ في أنّ البرنامج الثقافي سيبرز جوانب منها. وأكبر ظنّي أن هذا الحضور حلقة مهمّة من سلسلة متواصلة للحضور التونسي في المملكة، وقد تجسّم تاريخيّاً في معرفة القرّاء السعوديين لكثير من الإنتاج الإبداعي والفكري التونسي من قبل، علاوة على تمثيل الأكاديميين التونسيين لهذه الثقافة في عدد من الجامعات السعودية؛ خصوصاً في مجال تدريس الأدب والنقد العربيين.
> لديك حضور بارز في المشهد الثقافي العربي، وأنت بالإضافة لعدد من الأسماء الأدبية التونسية سجلتم علامة فارقة في مشهد الإبداع الأدبي على المستوى العربي والعالمي. كيف ترى التفاعل بين الإبداع الأدبي في تونس وأرجاء العالم العربي؟
- كنتُ أشبّه دوماً الأدب في العالم العربي بالنهر الكبير ذي الروافد المتعدّدة، ومنه الرافد التونسيّ. ومن الطبيعي والحال تلك أن يحدث تفاعل ربما بصورة أكبر مما نتصوّر. فالقرّاء والمثقّفون في تونس كانوا دوماً منفتحين -ولا يزالون- على الإنتاج الإبداعي في العالم العربي، ولا يوجد كاتب عربي مهمّ لم يشارك في لقاء من اللقاءات الثقافيّة الكثيرة التي تُعقد في تونس. وبالمقابل يشكو الفاعلون الثقافيّون والمبدعون التونسيّون من قلّة احتفال العالم العربي بهم. ففكرة أن المشرق مركز والمغرب هامش تحكّمت لعقود في الثقافة العربيّة، وأثّرت في تمثّلات التونسيين منذ ثلاثينات القرن الماضي لموقع إبداعهم من المشهد الإبداعي العربي. ولنا في بعض رسائل الشابّي أدلّة واضحة على هذا الشعور. لكنني أعتقد بأنّ حال الثقافة العربيّة تغيّرت بفضل تعدّد المراكز؛ إذ خرجنا من هيمنة المركز المصري، وإلى حدّ ما المركز الشامي، إلى مراكز أخرى ظهرت منذ عقدين أو أكثر؛ سواء في المغرب الكبير أو الخليج، لأسباب يطول شرحها. وعلينا أن ننظر إلى هذا بإيجابيّة؛ لأن في ثراء الروافد ثراءً للنهر كلّه.
> أتيتَ لعالم السرد والرواية من ميدان الممارسة الأكاديمية والنقدية. كيف أثر ذلك في نجاحك بوصفك روائياً؟
- ذكّرني سؤالك بأخبار قديمة تُروى عن النحاة العرب. فقد كانوا بارعين لا محالة في علمهم باللغة؛ لكن هذه البراعة لم تمنعهم من اللحن عند الكلام. فالمعرفة النظريّة بالقواعد لا تعصم المتكلّم بالضرورة من الخطأ عند المخاطبة العاديّة. وقياساً عليه، فإنّ المعرفة بنقد الرواية لا تعني آليّاً إنتاج نصّ ناجح يلقى حظوة لدى القرّاء على الأقلّ. ولو كان الأمر كذلك لقدّم المحرّرون الأدبيّون في كبرى دور النشر العالميّة إلى القرّاء كلّ يوم آلافاً من الأعمال التي تلقى رواجاً كبيراً (مسألة البيست سيلر). ما أستطيع قوله وأنا مطمئنّ: إنّ المعرفة النقديّة الأكاديميّة في علاقتها بالسرد الروائي ينبغي أن ننظر إليها على أنها جزء فقط من خبرة الروائي باللغة والمجتمع والنفسيّات... إلخ، وليست محدّداً للنجاح الأدبي، مع لطف الإشارة إلى أن الرواية في عصرنا لم تعد حكياً لقصّة مشوّقة فحسب؛ بل أصبحت تحمل معرفة ما وتنتجها أيضاً.

- سرّ «الطلياني»!
> في عام 2014 صدرت لك رواية «الطلياني» التي شقت لك طريقاً نحو النجومية الثقافية. كثيرون اعتبروا هذه الرواية واحدة من أهم ما أنتجه السرد العربي. برأيك، ما السرّ في رواية «الطلياني»؟
- لو كنت أعرف الوصفة أو السرّ لقلت لك... بكل بساطة: ما فكّرت فيه عن وعي وأنا أكتب «الطلياني» هو أن أروي قصّة تونسيّة تعبّر عن مجتمعي التونسي بخصائصه التي أزعم أنني أعرفها. فالمشكلة أن صورة تونس في الأدب ضعيفة بسبب ضعف الإنتاج الروائي نفسه، قبل الفورة التي شهدتها الرواية العربيّة عموماً في العقدين الأخيرين. وأعتقد أنّ القرّاء الذين رأوا بعض القيمة في هذه الرواية، إنما أدركوا هذا الهدف الذي رسمته لها، ولاحظوا فيها وفي غيرها مما كتبت اشتغالاً على تحوّلات المجتمع التونسي وملامح الإنسان التونسي. طبعاً هذا إطار عام للمسألة؛ لأنه توجد مسائل فنيّة ربما جعلت لـ«الطلياني» هذه المنزلة في نفوس القرّاء. من ذلك بناء الشخصيّة المنكسرة التي لا تفقد تألّقها حتى في لحظة الانكسار، علاوة على الكتابة البصريّة التي تجعل القارئ يطالع الرواية كما لو أنه يشاهد شريطاً سينمائيّاً.
> كيف فتحت رواية «الطلياني» ما يمكن أن نسميه «أرشيف» الألم الإنساني؟ تقول بطلتها «زينة»: «وجعي –يا عبد الناصر– في الجسد، ولكن لا دواء له... خرقتُ الصمت معك أنت، أنت الوحيد الذي فتحت له أرشيف وجعي».
- كل الروايات الجادّة هي بحث في أرشيف الوجع الإنساني بالنسبة إليّ. هكذا أفهم الرواية. فحين نكتب نتأمّل من حيث ندري أو لا ندري حركة الإنسان، بحثاً عن شيء ما ينقصه، فيصارع وينكسر فيصرّ ويعيد البحث، فتخيب آماله وتتعاظم أوجاعه. فهذا الكائن الهشّ أمام حركة الزمان وفي الأمكنة التي لم يخترها في العادة عنيد عناداً يصنع إنسانيّته، بتردّداتها وتناقضاتها وأخطائها وعظمتها والقلق الذي يلفّها. من هنا، فإنّ الرواية إذ تتتبّع هذا البحث الإشكالي تفتح أرشيفات الأوجاع والآلام.
> في «الطلياني»، تقول على لسان بطلتها «زينة»: «المثقف عندي هو الذي يطلق النار على كل ما يتحرك... هو من يخلخل السائد». هل ترى فعلاً أن هذا هو دور المثقف؟
- هو تصوّر من التصوّرات الموجودة عن دور المثقّف، وليس من ابتداعي إلا في طريقة التعبير عنه. العبارة المحايدة أكثر هي «المثقّف النقديّ». كان هذا اختيار «زينة» بثقافتها الواسعة والثوريّة في الرواية، ولا أرى اختياراً آخر يناسب شخصيّتها كما رسمتها في «الطلياني». ولكن عموماً أجد التعريف مناسباً لكلّ فكر ينشد التغيير، ويعمل على تجاوز المحنّط في المجتمع والقيم والأفكار. فللحقيقة وجوه، ودور المثقّف فلسفيّاً هو أساساً أن يكشف هذه الوجوه ويناقشها، ويجوّد النظر فيها انتصاراً لقيمة الحرّيّة.
> كأن ثورات «الربيع العربي» حفزتك لاستكمال رواية «الطلياني»، فجاءت رواية «مرآة الخاسر» (دار التنوير 2019)، لتكمل المشوار، وتضيف عناصر جديدة أثرت المشهد الروائي. هل هو مشروع لكتابة تاريخ تونس الحديث بقالب روائي؟
- ذكرتُ لك من قبل أنّ اشتغالي الأساسي روائياً كان على تحوّلات المجتمع التونسي، وتأمّل خصائص هذا البلد والإنسان فيه. لتعتبر ذلك ضرباً من البحث في الهوية التونسيّة وتحوّلاتها التي تبرز بالخصوص في فترة الأزمات. فهذه الأزمات مادّة خصبة روائيّاً للتفكير في المستمرّ الثابت وفي المتغيّر المتحوّل، يكشف في العمق تفاعل الإنسان التونسي مع الأحداث، ويبرز تصوّراته وردود فعله وهواجسه. من هذه الناحية تناولت «الطلياني» بعض التحوّلات في ثمانينات القرن المنصرم، وجاءت «مرآة الخاسر» لتعالج تحوّلات تونس في تسعينات القرن العشرين، وتوقّفت الرواية تقريباً في حدود سنة ألفين للميلاد. وفي أطول قصّة من مجموعة «السيّدة الرئيسة»، وقد منحت للمجموعة كلّها عنوانها، نجد اشتغالاً على بداية سنوات الألفين. هذا الترتيب يدلّ على أننا أمام مشروع روائي فعلاً مثلما قلت، وسمّيته كتابة تاريخ تونس، كما عشته وعايشته في صيغة روائيّة. وأصدقك القول إنه يمكن كتابة جزءين آخرين على الأقلّ، يواصل فيهما «عبد الناصر الطلياني» مساره المتعرّج الذي يروي من خلاله تعرّجات مسار البلاد والمجتمع. ولكنّ هذا يحتاج إلى جهد ومثابرة وتركيز كي تكون الحبكات مناسبة، فلا تسقط الشخصيّة في التكرار والنمطيّة. وما يحول دون ذلك هو الحاجة إلى التفرّغ؛ لأن الرهان كبير ولا مجال للخطأ فيه.
- بين الشعر والرواية
> الشعر كان ديوان العرب، واليوم هناك من يقول إن الرواية هي ديوان العرب؛ لأنها الأصدق في تمثيل أحوالهم. أنت تقول إنّ «الشِّعر تمرين بلاغي، بينما الرواية هي أم الحقيقة الإنسانية العميقة». كيف نجح الخطاب السردي في تمثيل أحوال المجتمعات العربية؟
- نعم. المسألة مهمّة جدّاً. فأنت تقرأ اليوم في الروايات العربيّة روحاً محلّيّة تمثّل تنوّع المجتمعات العربيّة في كل شيء؛ حتّى لغويّاً (لهجات عربيّة مختلفة ولغات أخرى غير العربيّة تُستعمل هنا وهناك). وقد سبق للرواية المصريّة أن قامت بهذا الدور، ولم يكن نجيب محفوظ إلا المثال الساطع على ذلك؛ لكنّ القرّاء العرب اكتشفوا منذ رواية الطيّب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال» أي في حدود سنة نشرها 1966 على الأقل، أن الرواية المصريّة تعبّر عن مصر وليس عن كل العالم العربي، وأنّ ثراء المجتمع السوداني مختلف عن ثراء المجتمع المصريّ. وعلى هذا القياس، ففي كل بلد عربي نجد خصائص ومميّزات تمثّل مادّة للروائيين يمتحون منها ما يمكن أن يعبّر عن هذه المجتمعات المتنوّعة فعلاً اجتماعيّاً وثقافيّاً. أصبحنا اليوم نعرف المجتمع العماني أو الليبي أو الإريتري، من خلال روايات نجحت لبشرى خلفان أو محمد النعّاس أو حجي جابر، مثلما عرفنا من قبل المجتمع العراقي أو السوري أو اللبناني من خلال كتابات مميّزة. عموماً أعتقد أن الرواية العربيّة قامت بالدور الذي من المفترض أن يقوم به علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا، ولكن بشكل آخر أقرب إلى نفوس القرّاء، علاوة على أدوارها الأخرى الجماليّة والثقافيّة.
> ماذا تمتلك الرواية لتصبح ديوان العرب؟
- تمتلك ما كنت أقوله لك. أقصد قدرتها على بيان أن وحدة الثقافة العربيّة بفضل اللغة العربيّة لا تعني مطلق التشابه والمماثلة. لذلك فهي قادرة على أن تتناول المحلّي والخصوصي والمميّز والمتنوّع والمختلف. صحيح أن رواياتنا حين تترجم إلى اللغات الأخرى -إذا تُرجمت- توضع في خانة الأدب الأجنبي، وتفريعاً في خانة الأدب العربي، ولكن هذه الخانة تخفي تنوّعاً مذهلاً بدأ يبرز أكثر فأكثر.
> لديك سجل مع الجوائز. ماذا يعني لك الفوز بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع اللغة العربية والأدب 2018، وقبلها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة 2012؟
- يظنّ كثيرون أنّ حصولي على بعض الجوائز هو من باب أنّ لي من اسمي نصيباً، إن لم تكن الكتابة عندي منذ البداية موجّهة للحصول على جوائز، كما يدّعي البعض (فكرة صيّاد جوائز). ولكن في حقيقة الأمر أرى هذه الجوائز ضرباً من الاعتراف بجهد متواضع في سياق محدّد، وليس تخطيطاً.
فجائزة أكاديميّة في قيمة جائزة الملك فيصل ليست بالأمر الهيّن، حتّى نخطّط له ونصل إلى مبتغانا، فالإعلان عنها والترشّح لها لا يفصل بينهما وقت يسمح بالارتجال، وإنما يكون ذلك بفضل تراكم معرفي وكتابات سابقة تتوّج بالترشّح، إضافة إلى التسابق مع أفضل العقول العربيّة وغير العربيّة. وقس عليها حصول «الطلياني» على «البوكر»، وهي الرواية الأولى لاسم غير معروف في المشهد الروائي العربي. والحق أنني بقدر ما أفخر بـ«البوكر» التي وسّعت من قاعدة قرّائي في الأدب، فإنّني أفخر كذلك فخراً كبيراً بجائزة الملك فيصل؛ لأنها جائزة أكاديميّة توّجت جزءاً من عملي الأكاديمي طيلة ثلاثين عاماً تقريباً.
> واسيني الأعرج قال بعد منحك جائزة الرواية العربية، إن «جائزة (البوكر) لم تخلق أديباً؛ ولكنها كشفت عن أديب»، ولكنك قلت بعد أن فاز واسيني بجائزة «كتارا»: «إن الجوائز تزيد النجم سطوعاً». فكيف ترى أثر الجوائز الأدبية؟
- سأروي لك شيئاً. كنتُ قد قرأت لواسيني منذ سنوات، ولكن أوّل مرّة ألتقيه فيها كانت سنة 2015 في القاهرة، في مؤتمر للرواية. ومما أذهلني وأبهجني في الآن نفسه رغبة القرّاء في التحدّث إلى واسيني والتقاط صور معه، وكان يتعامل مع الطلبات الكثيرة والمزعجة أحياناً بنبل وأريحيّة وابتسامات تليق بالنجوم. يومها عرفت أن للأدب نجومه، ومنهم واسيني. لذلك قلت إن الجوائز تزيد النجوم سطوعاً؛ لأنه فعلاً كان نجماً قبل حصوله على جائزة «كتارا». ربما لم يكن سياق التصريح يسمح بسرد ما ذكرته لك الآن، وها أنا أفعل. أما ما قصده الصديق واسيني من قوله، فمن الواضح أن الجوائز لا تصنع الأدباء؛ بل تتوّجهم وتعرّف بهم.