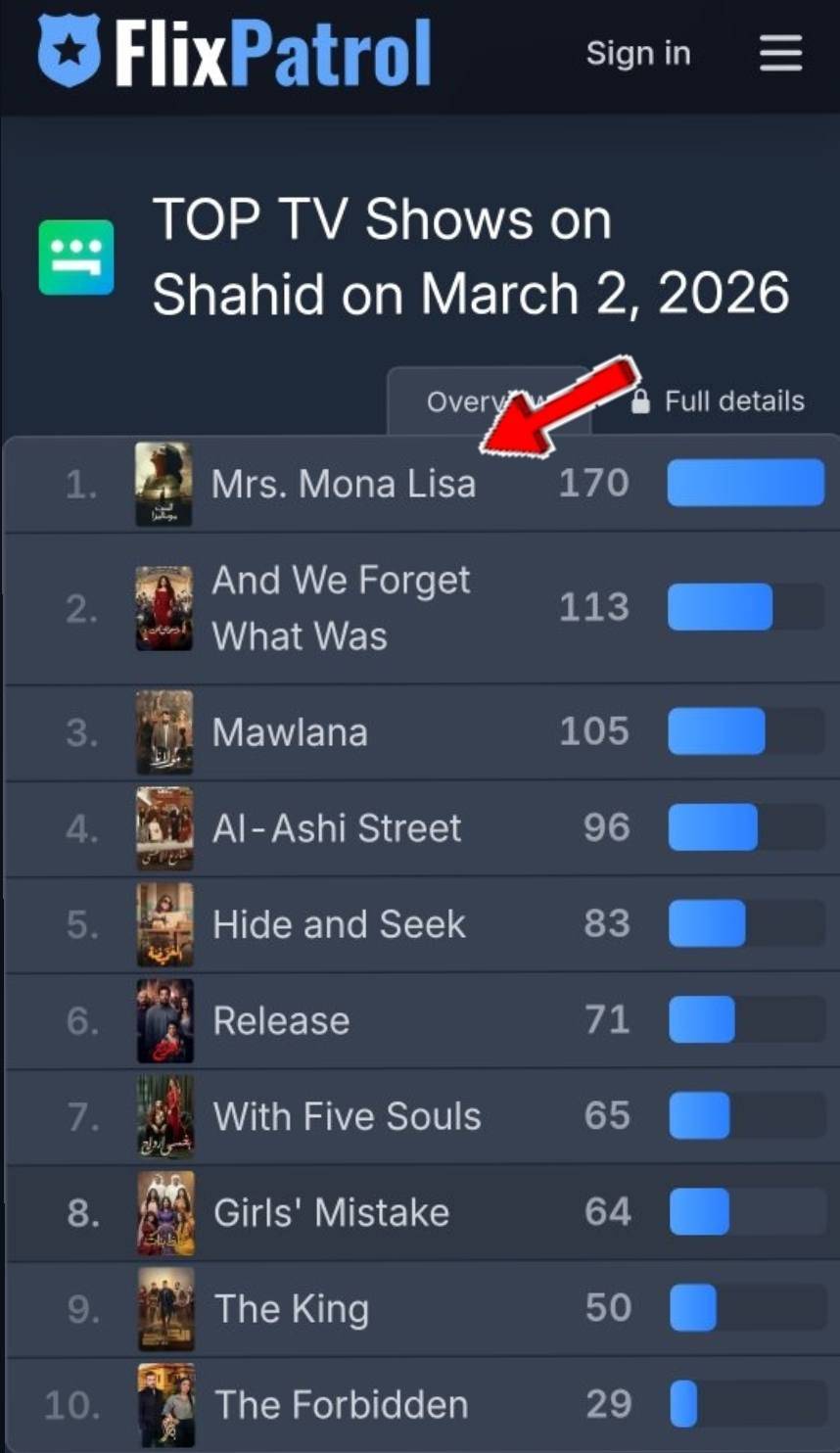لم تعد مسألة ازدهار فنون السرد في عالمنا المعاصر واحدة من المسائل الخلافية التي تستدعي الجدل الصاخب ونصب المتاريس المتقابلة، كما كانت الحال قبل عقود قليلة من الزمن. فأي نظرة متأنية إلى مبيعات الكتب، أو استطلاع للرأي حول الأعمال الأكثر رواجاً، لا بد من أن يفضيا إلى التأكيد من جديد على أن هذه الفنون بالذات هي الديوان الجديد للكوكب الأرضي، وقبلة أنظار المهتمين بالقراءة من سكانه. وإذا كانت ظاهرة الهبوط الجماعي الواسع من «سماء» الشعر نحو «أرض» الرواية، قد باتت من بديهيات الأمور في السنوات القليلة الماضية، فإن اللافت في هذا السياق هو الاهتمام المتزايد بفنون السيرة والبيوغرافيا والرسائل ومذكرات المبدعين والأعلام، التي تبدو من بعض وجوهها أشبه بالارتدادات المتأخرة للزلزال السردي الأصلي. وإذا كان اهتمام القراء المتزايد بالحياة الفعلية للكتاب والمبدعين، يبدو بمثابة رد ضمني على مقولة «موت المؤلف»، فإن ثمة فضولاً موازياً للوقوف على يوميات المشتغلين بالأدب والفكر والفن، وعلى ما يكتنفها من عادات ووقائع وطقوس.
في مقدمة كتابه «طقوس فنية... كيف يعمل المبدعون»، يعترف الكاتب ماسون كاري بأن الصدفة المجردة، مقرونة بعمله الشاق صحافياً محترفاً، هما اللذان يقفان وراء فكرة الكتاب، التي لمعت في رأسه إثر إدراكه المباغت أن كتابته مقالاته تقتصر على ساعات النهار الأولى، وتتحول إلى روتين دوري من الطقوس والممارسات، وأن ما تبقى من نهاره هو مجرد تزجية رتيبة للوقت وإلهاء للنفس بمشاغل وتفاصيل غير جوهرية. وإذ خطر للكاتب الشاب أن يبحث عبر الإنترنت عن جداول عمل زمنية لبعض الرموز المميزة في عالم الكتابة والفكر، فسرعان ما لمعت في رأسه فكرة الاستمرار في مهمته الاستقصائية، وصولاً إلى إصدار الغلة المعرفية التي حصل عليها في كتاب مستقل.
يتناول ماسون كاري في كتابه المثير للفضول، مائة وستين مبدعاً في سائر مجالات الثقافة والفكر والفن، توزعت حيواتهم على القرون الأربعة الماضية من التاريخ. واللافت في هذا السياق أن العودة إلى مؤلفات المبدعين وسيرهم ورسائلهم الشخصية، لم تكن سبيل المؤلف الرئيسي للحصول على ما يريده من المعلومات، بل اعتمد على محركات البحث العملاقة، وأرشيف الصحف والمجلات، والمقابلات، وصفحات النعي الإخبارية... وغيرها من المصادر.
والملاحظ أن كاري؛ الذي حاول العثور على «نسب» طقوسي يربطه بالسلالات الإبداعية المتعاقبة، لم يُلزم نفسه منهجاً صارماً لجمع المعلومات، ولا تقديم مقاربات متماثلة للرموز المختارة؛ بل شاء لكتابه، الذي قرر المترجم تعديله ليصبح «طقوس فنية»، أن يكون خليطاً غير متجانس من أنماط عيش الكتاب وعاداتهم اليومية وهواياتهم وعلاقاتهم بالآخرين وأمزجتهم المتقلبة، فضلاً عن المناخات والظروف الزمانية والمكانية والنفسية، التي تكفل لمشاريعهم الفنية والأدبية أسباب النجاح والتحقق الأمثل.
وقد تكون الأمثولة الأهم التي تقدمها لنا الصفحات الثلاثمائة لكتاب ماسون كاري، هي أن الفوارق بين المبدعين لا تقتصر على الأفكار والأساليب والنظرة إلى الوجود فحسب؛ بل تشمل في الوقت ذاته طقوس الإبداع وزمنه وآلياته، بحيث إن ما يعدّه البعض المناخ النموذجي لمزاولة نشاطهم الأدبي والفني، يرى فيه آخرون مثبطاً معرقلاً لانطلاقتهم ومثبطاً لعزيمتهم. واللافت أيضاً أن بعض الكتاب قد حرصوا على العمل في ظل برامج موقوتة وبالغة الانضباط على امتداد حياتهم الأدبية برمتها، كما هي حال الفيلسوف الفرنسي فولتير الذي اعتاد أن يعمل في سريره لمدة تقارب العشرين ساعة في اليوم، والذي عبر عن التزامه الصارم بروتين عمله الشاق من خلال قوله لأحدهم: «أنا أعشق زنزانتي». وإذ ينوه الكاتب ف. س. بريتش بالجدية الفائقة التي يعمل في ظلها المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون، يخلص من جهته إلى القول إن «كل الرجال العظام يتشابهون. فهم لا يتوقفون عن العمل مطلقاً، ولا يضيعون دقيقة من وقتهم. إنه لأمر مرهق حقاً».

أودن
ولم يكن الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط بمنأى عن مثل تلك الدقة؛ في كتابته كما في أسلوب حياته، وهو المنتظم في مواعيد النوم والاستيقاظ والكتابة وتناول الطعام واحتساء القهوة ورياضة المشي؛ الأمر الذي يصفه هاينريش هاينه بالقول: «جيران (كانط) أصبحوا يضبطون ساعاتهم على الثالثة والنصف عصراً، مع خروج الفيلسوف اليومي من منزله، وهو يرتدي معطفه الرمادي، ويمسك بيده عصاه الإسبانية». ومثله كان الشاعر البريطاني أودن، الذي لطالما اعتقد أن الحياة المفعمة بالانضباط العسكري هي الشرط الأساسي لإبداعه. وقد لاحظ بعض زواره أن كل ما يقوم به الشاعر، كالأكل والشرب والكتابة والتسوق، وحلّ الكلمات المتقاطعة... وغيرها، أمر محسوب بدقة، وملحقٌ بروتين جامع.
على أن هذا الأسلوب النمطي في العمل، وهذا الانضباط الدقيق في العلاقة مع الزمن، ليسا بالنسبة إلى مبدعين آخرين السبيل الوحيد للوصول إلى الأهداف. فالبعض لم يؤمنوا مطلقاً بالتعاطي مع شياطين الكتابة والفن وفقاً لقاعدة الدوام الوظيفي، أو النظام العسكري الصارم. ولأنهم رأوا في الحياة فرصتهم الثمينة والوحيدة للاستمتاع بمباهج العالم، فقد رفضوا الجلوس على مقاعد الصمت القاتل منتظرين فكرة أو صورة أو قبساً من سماء الإلهام؛ قد لا يجيء أبداً. ولأنهم عدّوا أن لحظة الإلهام هي ابنة الغفلة والمصادفة المحضة، فقد آثروا قذف أنفسهم في لجج المغامرة والفوضى وصخب المشاغل اليومية.
وقد يشعر المرء بكثير من الدهشة والاستغراب حين يعرف أن روائية بالغة الفرادة من وزن أغاثا كريستي، لم تكن تعدّ نفسها كاتبة بالمعنى العميق للكلمة، وأنها حين تُسأل عن مهنتها، كان أول ما يتبادر إلى ذهنها القول إنها ربة منزل. كما تكتب كريستي في مذكراتها أنها استمتعت مع زوجها بكل لحظة عاشتها، ولم تهب الكتابة سوى أوقات متباعدة ومستقطعة، بحيث لم يتوان بعض أصدقائها عن مصارحتها بالقول: «لا نعرف مطلقاً متى تؤلفين كتبك؛ لأننا لم نركِ قط تكتبين، ولا حتى منصرفة لأجل الكتابة».
ثمة من جهة أخرى تباين واسع بين الكتاب والفنانين، فيما يخص الزمان والمكان المواتيين لعملية الإبداع. وإذ يتوزع هؤلاء؛ على المستوى الزمني؛ بين الفترات المختلفة للنهار والليل، فإن ما يلفت القارئ هو أن المبدعين النهاريين يفوقون نظراءهم الليليين على المستوى العددي، وبحدود نحو الضعف. وهو ما يكسر الفكرة الرومانسية النمطية التي تجعل من الكتاب كائنات ليلية بامتياز. وليس من المستغرب تبعاً لذلك أن نعرف أن مبدعين من وزن بتهوفن وهيمنغواي وهنري ميللر وأودن وغونتر غراس وموراكامي، لم يكونوا يعملون إلا في ساعات النهار الأولى، حيث يكون الجسد والذهن في كامل حيويتهما، بينما يتركون الليل للراحة والسهرات الممتعة، أو الرد على رسائل القراء. وقد أعلن توماس مان في هذا الصدد: «كل ما لا يُكتب قبل الظهر، فعليه أن ينتظر إلى اليوم التالي». بينما في الشطر الليلي من العمل، نتعرف إلى فنانين وكتاب كبار من أمثال بيكاسو، الذي كان يجلس للرسم بين الثانية بعد منتصف الليل حتى شروق الشمس، فيما كانت فرناند؛ حبيبته لسبع سنوات، تدور وحيدة حول العمارة التي يقطنها.

ولعل أطرف ما في الكتاب، هو الجانب المتعلق بالطقوس والتقاليد التي حرص كثير من المبدعين على الاستعانة بها لتكون ظهيراً لهم في عملية الخلق الأدبي والفني. وإذا كان بعض هذه التقاليد مألوفاً تماماً، كالإلحاح على التدخين واحتساء القهوة كما كان يفعل كيركغارد وفرويد، أو على تناول الخمر والمخدرات على طريقة لوتريك وسارتر، فإن بعضها الآخر كان أقرب إلى الفانتازيا الغرائبية منه إلى أي شيء آخر، كما هي حال فريدريك شيلر الذي لم يكن يشرع في التأليف إلا بعد أن يشم رائحة الموز المتعفن، أو إديث ستويل التي كانت تؤثر قبل كتابة الشعر أن تتمدد في تابوت شبه مقفل، لكي تمنحها فكرة الموت القدرة على الذهاب إلى أقاصي اللغة، أو مارك توين الذي كان في لحظات التأليف ينفصل بالكامل عن محيطه الخارجي، إلى حد لجوء عائلته إلى النفخ في بوق كان يقتنيه، لإخراجه من غيبوبته.
على أن نجاح ماسون كاري في تحويل كتابه إلى عرض بانورامي مشوق لأنماط حياة العشرات من كتاب العالم وفلاسفته ومفكريه، لا يمنعنا من ملاحظة الطابع العشوائي للعمل، الذي بدا أشبه بكشكول فضفاض من المذكرات ووجوه العيش والنوادر، وقصاصات السيَر التي وفرتها للمؤلف شبكات الإنترنت وتقنيات البحث السريعة. كما أن اكتظاظ الكتاب بهذا الحشد الهائل من الكتاب، لم يترك لمؤلفه الفرصة الكافية لإيلاء كل منهم حقه من الاهتمام، وقد كان بإمكانه أن يكتفي بأربعين اسماً، بدلاً من المائة والستين. إضافة إلى الطابع الاستنسابي للمقاربات، بحيث اقتصر بعضها على بضعة أسطر، ولامس بعضها الآخر حدود الصفحات الثلاث.
وإذ أنوه أخيراً بوجاهة الملاحظات التي أبداها المترجم خالد أقلعي في مقدمة الكتاب، فلا يسعني مع ذلك سوى «استغراب» استغرابه الناجم عن خلو العمل من أي مبدع عربي. والأرجح أن ذلك لا يعود إلى مركزية الثقافة الغربية، ورؤية الغربيين المتشاوفة إلى الثقافات الأخرى فحسب؛ بل لأن كاري جاء إلى التأليف من موقع الصحافي الشغوف بموضوعه، لا من موقع المفكر المتعمق في شؤون الثقافات الإنسانية، كما هي حال بورخيس وتودوروف وأوكتافيو باث... وآخرين غيرهم، خصوصاً أن التغييب المشار إليه لم يقتصر على المبدعين العرب وحدهم؛ بل اتسعت دائرته لتشمل مبدعي العالم الثالث على نحو عام.