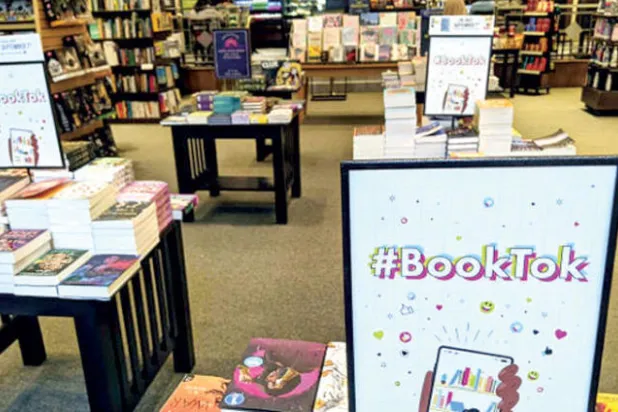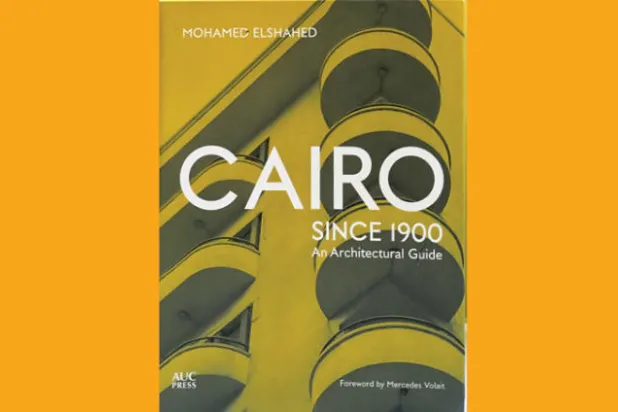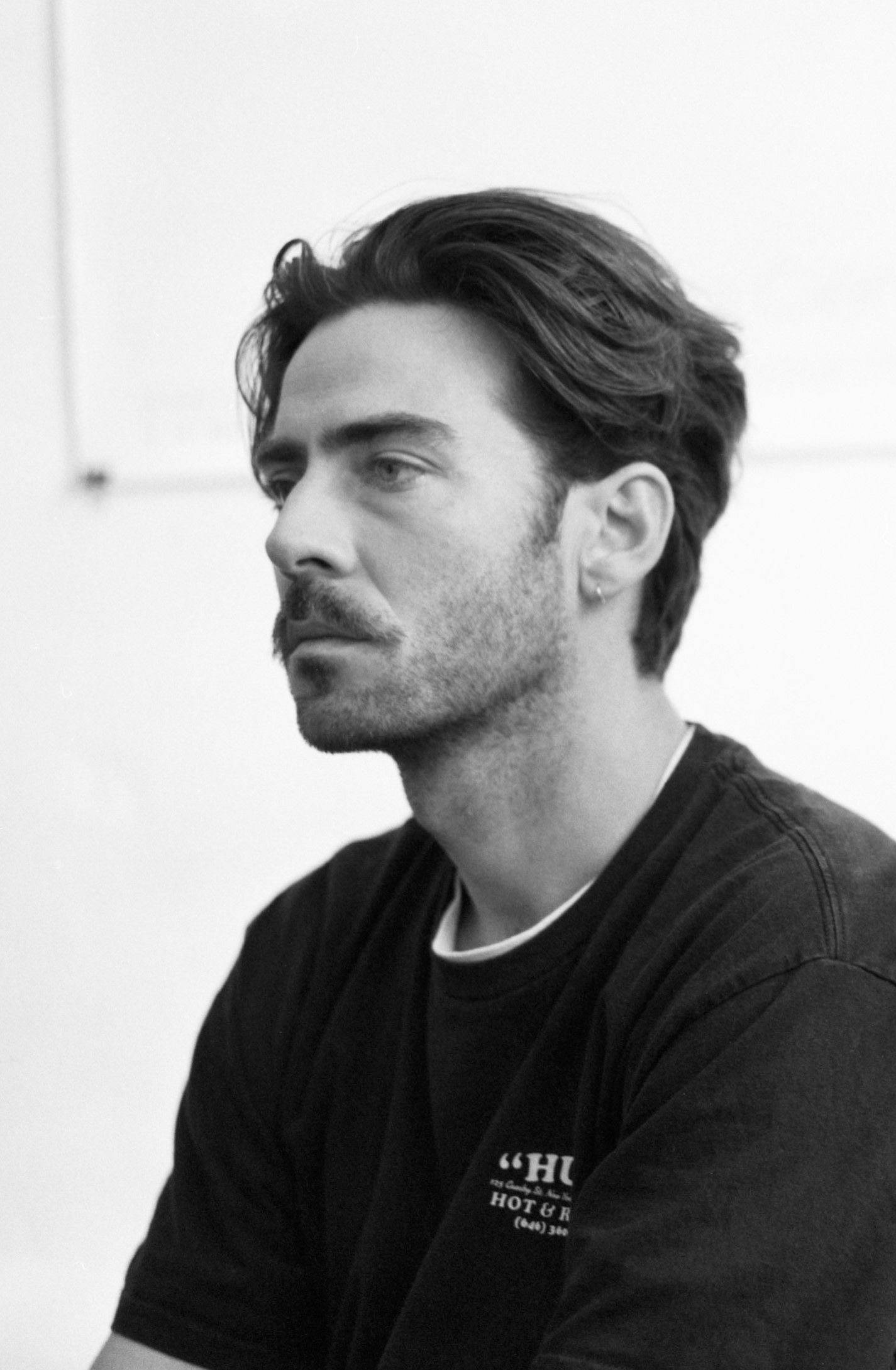يضم كتاب «قراءة الشعر» الصادر حديثاً عن «الهيئة المصرية للكتاب» للناقد الدكتور محمد عبد المطلب، عدداً من القراءات في قصائد مختارة لبعض الشعراء الكلاسيكيين، مثل أحمد شوقي، وإيليا أبي ماضي؛ لكنه يتوقف بشكل خاص ويفرد مساحة واسعة أمام واحدة من أهم التجارب الشعرية العربية في القرن العشرين، وهي تجربة نازك الملائكة، الشاعرة والأستاذة الأكاديمية العراقية التي نشأت في بيئة ثقافية بين أب يمارس نظم الزجل، وأم تنظم الشعر، وكانت ذات تأثير بالغ على المسيرة الإبداعية لابنتها.
تخرجت نازك في دار المعلمين، وبدأت رحلتها العلمية بالحصول على منحة لدراسة النقد الأدبي في أميركا، ثم سافرت إليها مرة أخرى 1954 لدراسة الأدب المقارن. صدر ديوانها الأول «عاشقة الليل» عام 1947، ويضم قصيدة «الكوليرا»، وهي من شعر التفعيلة الذي أطلقت عليه نازك «الشعر الحر»، ثم أصدرت ديوانها الثاني «شظايا ورماد» عام 1949، ويضم مجموعة من القصائد التي صاغتها على النسق العروضي الجديد، ثم أصدرت ديوانها الثالث «قرار الموجة» عام 1957. وقد تصدت لقضية الشعر الحر في كتابها «قضايا الشعر المعاصر» الصادر عام 1962.
يرى عبد المطلب أن الكلام عن قصيدة «الكوليرا» التي تحتل مكانة مركزية في تجربة الملائكة، لا بد من أن يسبقه الكلام حول مسألة شائكة بعض الشيء، هي مسألة «البدايات» التي تختلف حولها الآراء عادة. حدث هذا عند الكلام على بدايات الشعر العربي، وبدايات الرواية والمسرحية في الثقافة العربية؛ إذ اتجه البعض إلى التنقيب عن جذورهما في التراث، واتجه البعض الآخر إلى الوافد الغربي وأثره في بداية النشأة، ولهذا تحولت المسألة من البساطة إلى التعقيد، وتحولت إلى قضية انشغل بها المجتمع الأدبي، ولم يكن من الميسور الوصول إلى حكم فاصل فيها. وذكرت نازك الملائكة أن الشعر الحر ظهر على يدها في العراق، ومنه انتشر في أنحاء العالم العربي، وعندما ذكرت ذلك لم تكن على علم بأن هناك محاولات قد سبقتها لبعض المبدعين، أو تردد على سمعها أسماء مثل: علي أحمد باكثير، ومحمد فريد أبو حديد، ومحمود حسن إسماعيل، ولويس عوض. وذكر البعض الشاعر الأردني عرار.
ويلفت الناقد إلى أن الفارق الزمني بين رأيها الأول في قصيدتها «الكوليرا» باعتبارها بداية الشعر الحر، والرأي الآخر الذي ذكرت فيه أن هناك شعراء سبقوا إلى هذا النظم، هو الفارق بين عامي 1962 و1974 اللذين صدرت في أولهما الطبعة الأولى، وفي الثاني الطبعة الرابعة من كتابها «قضايا الشعر المعاصر».
وقد تعددت الآراء حول أسبقية النظم على نسق الشعر الحر، فالبعض يرجع هذه الظاهرة الإيقاعية إلى عام 1921 في العراق، والبعض يرجعها إلى 1932 في مصر، وهذا الاختلاف في الرأي دفع نازك إلى تحديد أربعة شروط لصحة القول ببدايات الشعر الحر، هي: أن يكون الشاعر الذي ينظم على هذا النحو واعياً بأنه يستحدث نسقاً إيقاعياً جديداً، وأن يثير هذا النسق الجديد انتباه الجمهور، وأن يقدم الشاعر تجديده مصحوباً بشرح تأسيسي لما أقدم عليه، وأن يدعو الشعراء إلى متابعته فيه، فضلاً عن أن يكون لدعوته صدى واضح لدى المبدعين والنقاد؛ سواء بالرفض أو بالقبول.
ويوضح عبد المطلب أن قصيدة «الكوليرا» مبنية على «السماع»؛ إذ كانت الإذاعة المسموعة تذيع أنباء انتشار الكوليرا في مصر، وكيف أن ضحايا الوباء يتكاثرون يوماً بعد يوم، ومع ازدياد أعداد الضحايا دخلت الشاعرة حالة مأساوية هيأتها للتعبير عنها شعرياً. يقول مطلع القصيدة:
«سكن الليل
أصغِ إلى وقع صدى الأنات
في عمق الظلمة، تحت الصمت، على الأموات
صرخات تعلو، تضطرب
حزن يتدفق، يلتهب
يتعثر فيه صدى الآهات».
وتقول في نهايات القصيدة:
«الصمت مرير
لا شيء سوى رجع التكبير
حتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير».
واللافت أن المفردتين المركزيتين شكلتا حقلاً صياغياً كئيباً، فمفردة «الليل» استحضرت الظلمة والسواد والكوخ الساكن، أما مفردة «الموت» فاستحضرت حقلها في تردد المفردة ذاتها ست مرات، فضلاً عن توابعها من الأنات والصراخ والحزن والآهات والبكاء. وهذه الخلفية المعتمة كانت فعالة في تعديل مسار الدلالة من الاتجاه الأفقي المتتابع إلى التصادم الدرامي على مستوى الصوت والحركة؛ إذ تبدأ الأسطر بما يوهم أن الحالة الشعرية مقبلة على لحظة رومانسية ناعمة في السطر الأول: «سكن الليل» وإذا بالدرامية تصنع أولى مفارقاتها في الصدام بين الصمت والصراخ.
ويخلص عبد المطلب قائلاً: يبدو أن الثقافة الشعرية المتجذرة في وعي نازك جعلت النهار امتداداً لليل، أي أن الخلاص خلاص وهمي، وهذا الوعي النفسي سبق إليه امرؤ القيس في معلقته عندما قال:
«وليلٌ كموج البحر أرخى سدوله
عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي»
فصباح امرئ القيس امتداد لليله الحزين، وهو ما سيطر على اللوحة الثانية في قصيدة «الكوليرا»؛ إذ كان الفجر امتداداً لمأساة الليل، هذا الليل الذي سيطر على اللوحة الأولى مع الموت، ثم أخلى سيطرته لتكون اللوحة الثانية تحت سطوة الفجر:
«طلع الفجر
أصغِ إلى وقع خطى الماشين
في صمت الفجر، أصِخ، انظر ركب الباكين».
8:27 دقيقه
«الكوليرا» تعيد نازك الملائكة للواجهة
https://aawsat.com/home/article/3829716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9



«الكوليرا» تعيد نازك الملائكة للواجهة
«قراءة الشعر» يسلط الضوء على تجربتها وريادتها للشعر الحر


«الكوليرا» تعيد نازك الملائكة للواجهة

مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة