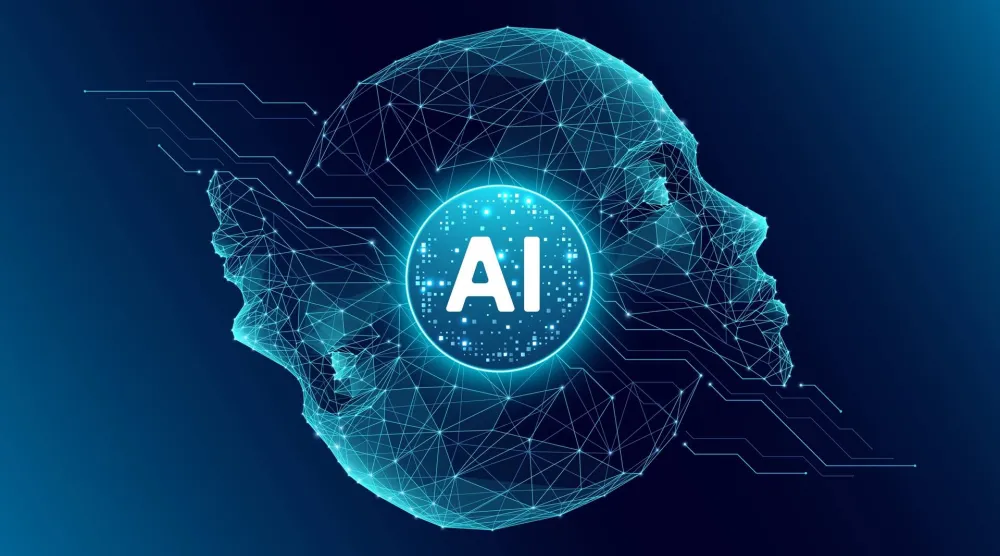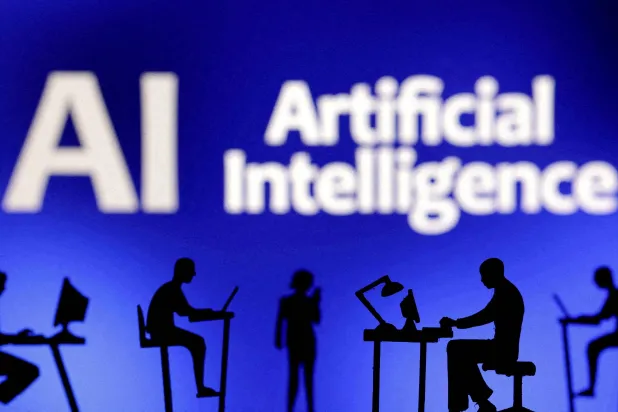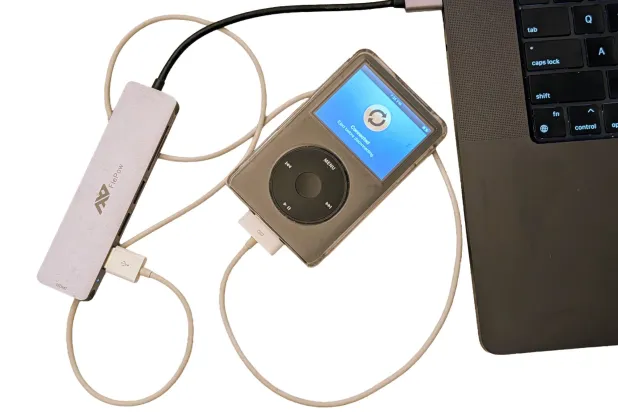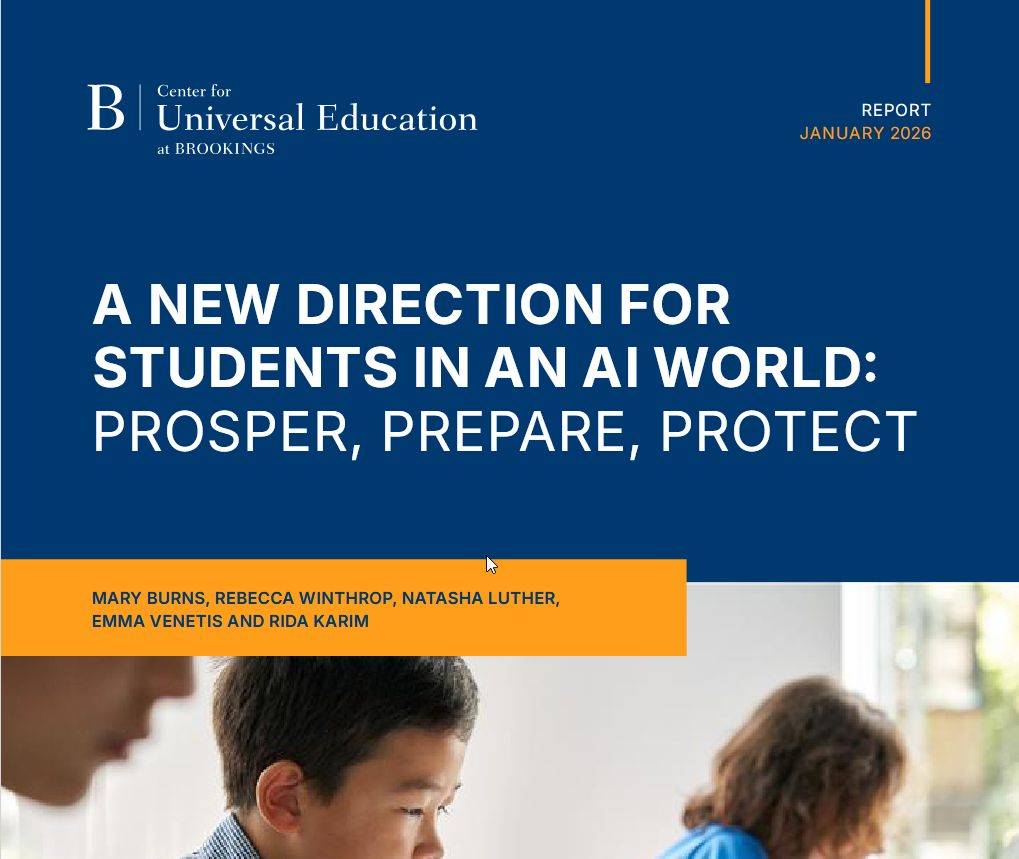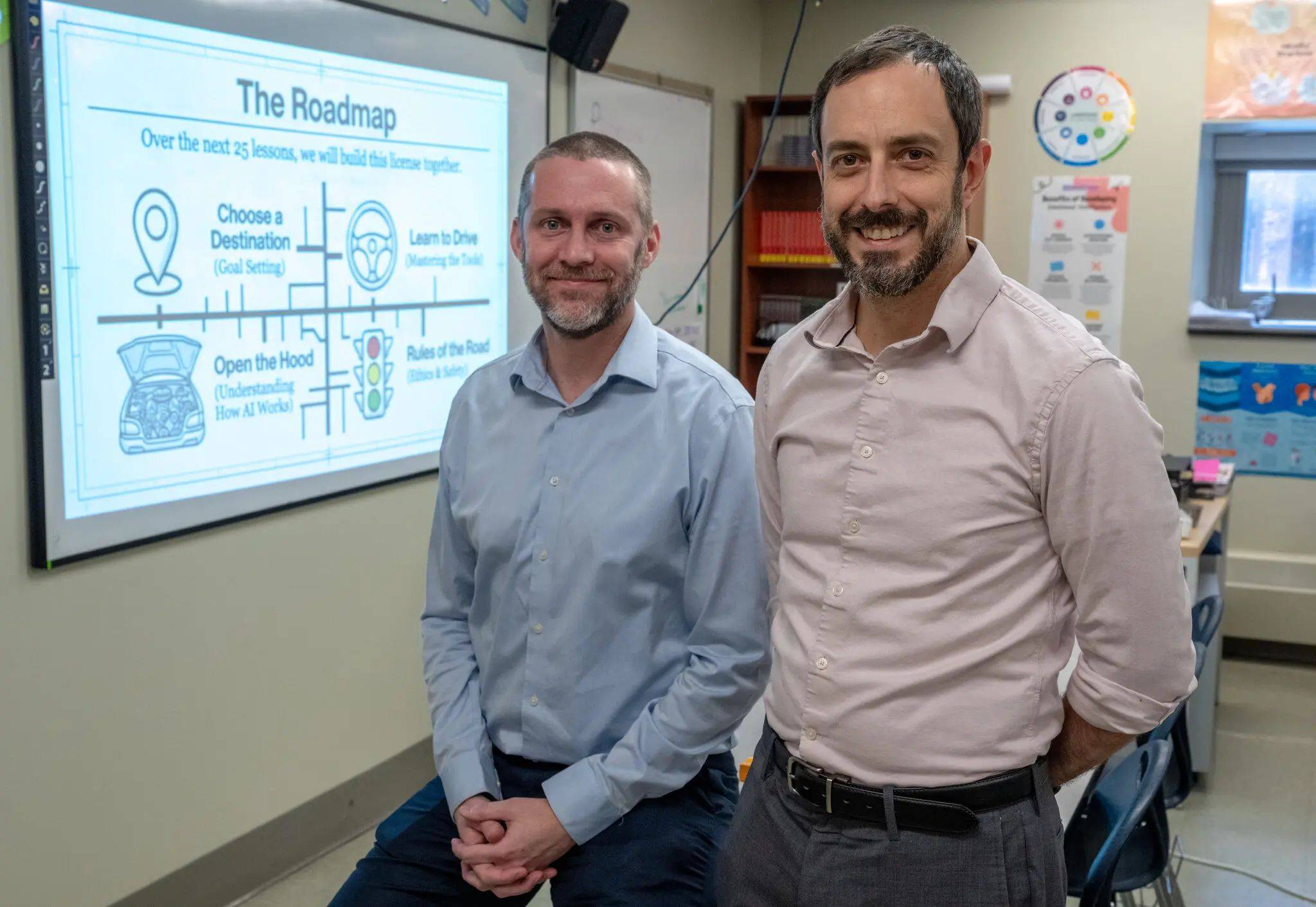عندما يفكر الباحثون بالفئات الخمس الأساسية للتذوق - الحلو، والمالح، والحامض، والمر، والأومامي - فإنهم يختلفون قليلاً حول الأكثر غموضاً بينها.
تشتهي المخلوقات الحية الحلويات للحصول على السكر والسعرات الحرارية، بينما تغذي شهوة الأومامي كثيراً من الحيوانات بالبروتينات. وينطوي الملح على أهمية كبيرة للأجسام للحفاظ على توازن السوائل ونشاط الخلايا العصبية، بينما تساعد الحساسية للمذاق المر في الحماية من حالات التسمم.
مذاق عريق القدم
ولكن ماذا عن المذاق الحامض؟ يعد الأخير إشارة غريبة غير مرتبطة لا بالتسمم ولا بالتغذية، بل بالمؤشر التقريبي للأس الهيدروجيني المنخفض (pH- درجة الحموضة) ووجود الأحماض - حمض الستريك في الليمون وحمض الأسيتيك في الخل وغيرها.
تعتبر آن ماري توريغروسا، الباحثة المتخصصة في المذاق بجامعة بوفالو، أننا «لا نحتاج المذاق الحامض لنعيش»، و«أنه لمن الغريب أن نحتاج لهذا المذاق». في المقابل، يرى روب دان، عالم البيئة في جامعة ولاية شمال كاليفورنيا، أن «الحامض مذاق ضائع»، وأنه «من رواسب المذاقات المنسية... لا أحد يعلم ما (المذاق الحامض) بالتحديد»، على حد وصف دان.
ولكن على الرغم من كل ما ذُكر، ما زلنا نشعر بقوة بالمذاق الحامض ولسنا وحدنا في ذلك. فبعد مبادرة دان وزملائه أخيراً إلى التحقيق في الجذور التطورية لهذه الحاسة، صرحوا بأنهم لم يجدوا نوعاً حياً واحداً من الفقريات خسر قدرته على تذوق الأطعمة الحامضة، لا الطيور ولا الثدييات ولا البرمائيات ولا الزواحف ولا حتى الأسماك. ويقر الجميع بأن السبب في هذا الأمر يعود لقلة أنواع الحيوانات التي درسها الباحثون - بضع عشرات منها فقط - ولكن تبقى الخلاصة الأهم أن المذاق الحامض نجح في إثبات نفسه.
وبينما خسرت القطط وثعالب الماء والضباع وغيرها من آكلات اللحوم القدرة على الشعور بالمذاق الحلو، وفيما يملك دب الباندا العملاق مناعة قوية ضد مذاق الأومامي، وخسرت الدلافين التي تبتلع فرائسها قطعة واحدة، حساسيتها للمذاقين الحلو والمر... فإن مذاق الحموضة كما يبدو حافظ على قوة فقدها أقرباؤه - من المذاقات - ما يرجح تمتعه بدورٍ قوي وتاريخي ربما.
لغز الطعم الحامض
ولكن هذا الدور أو الشيء الذي يقوم به لا يزال لغزاً ولعله يتفرع إلى أشياء مختلفة بحسب النوع الحي. يعتقد دان أن جزءاً من هذه القصة يبدأ مع الأسماك - النوع الفقري الأقدم وقدراته الخارقة في تذوق الحامض التي قيمها العلماء وأكدوا وجودها. تملك الأسماك براعم للتذوق في أفواهها، كما البشر، ولكنها تمتد لديها لتغطي كامل جسدها (يمكن تشبيهها بلسانٍ كبيرٍ). وتستطيع بعض مجسات استشعار الحمض لدسها، مساعدة هذه الأحياء على الأرجح في الملاحة داخل وخارج المياه التي تحتوي على نسب كبيرة أو منخفضة من ثاني أكسيد الكربون، للمحافظة على التوازن الكيميائي لسوائل أجسامها.
عندما بدأ أجداد الأنواع الحية التي تعيش اليوم على الأرض بالزحف البطيء إلى اليابسة، حافظت حاسة تذوق الحامض على استمراريتها لديها - وتوسعت بسرعة لتشمل التفرعات المختلفة من النوع نفسه. تتمتع الأطعمة الحمضية اليوم بشعبية متوسطة، أي أنها ليست مرغوبة كثيراً ولا مكروهة كثيراً.
ينجح كثير من الأنواع الحية عالية التطور (مثل القرود المتطورة)، وكذلك البشر، في رصد المذاق الحامض، وكذلك تفعل الجرذان والخنازير - حتى تركيزٍ معين على الأقل يُعرف بـ«نقطة الهناء»، أي الدرجة التي تسبق تحول الطعم إلى مقرف. يحذر دان مثلاً من «إعطاء حبة طماطم لخروف» ويؤكد ضرورة «عدم إعطائه حبة ليمون». (لم يجرب دان الأمر ولكنه وزملاءه اطلعوا على دراسة أجريت عام 1970، جاء في نتائجها أن الخرفان تجد في الأطعمة الحامضة مذاقاً سيئاً للغاية).
لم يتضح بعد سبب نفور بعض الأنواع الحية من المذاق الحامض، ولكن العلماء يطرحون أكثر من تخمين. لعل الحيوانات التي أُثبِت كرهها للطعم - كالأحصنة والخفافيش الماصة للدماء والأرانب وعفريت الماء وغيرها - تعده إشارةً على عدم نضوج طعامها، أو على فساده ما يجعله غير صالح للأكل. قد يؤدي الحمض عند تطرف مستواه في الجسم إلى قضم الأنسجة أو تآكل مينا الأسنان، وقد يعبث بكيمياء الجسم ويربك ميكروبات الأمعاء الهشة.
من جهتها، اعتبرت هانا فرانك، باحثة في مجال المحاصيل الزراعية وعلوم التربة بجامعة ولاية كارولينا الشمالية التي تعمل مع دان في بحثه لتفكيك الماضي التطوري للمذاق الحامض، أن «كثيراً من التفسيرات المرتبطة بالأحماض تركز على المساوئ، لكنها لا تزال غير مثبتة». أما دان، فقد اعتبر أن البحث عن سبب التطور وإثباته يشكل كابوساً علمياً، خصوصاً أن التاريخ ليس حافلاً بدراسات لحالة «الخروف الذي توفي لأنه أكثر من تناول الليمون».
ولكن على عكس الخراف، نُعد نحن البشر كنوع حي من أشد معجبي المذاق الحامض، والأمر نفسه ينطبق على أنواع عدة من الأحياء العليا في التطور - كالشمبانزي والأورانغوتان والغوريلا والمكاك والجبون... لأن الحمض يفعل شيئاً جيداً على ما يبدو.
فوائد غنية
يفتش الباحثون منذ سنوات عن سببٍ مقنع لهذا الأمر، ويعتقدون أن المذاق الحامض قد يكون مؤشراً على غنى الطعام بفيتامين سي، وهز العنصر الغذائي الذي خسر أجدادنا ميزة إنتاجه منذ نحو 60 أو 70 مليون عام. ومن هنا، يمكن القول إن الشهية المفتوحة على الأطعمة الحامضة قد تكون ساعدتنا في تجنب ويلات داء الإسقربوط.
تبقى علاقة الكائنات الحية مع الحمضية فوضوية حتى في أبسط الروايات. إذ يمكن للفواكه الحامضة، التي تعد أحياناً وجبة خفيفة ممتازة، أن تكون بعيدة جداً عن النضوج. تعتبر كايتي أماتو، عالمة الأنتروبولوجيا الحيوية من جامعة نورث وسترن المشاركة في بحث دان، أن الحل قد يكمن في شراكة المذاق الحامض مع بعض الحلاوة. تعطي الأطعمة شديدة الحموضة وشديدة الحلاوة مكسباً إضافياً يتمثل بمجموعة كبيرة من الميكروبات الحميدة التي تستوطن الأمعاء وتفكك الكربوهيدرات.
تُعرف هذه العملية باسم التخمير وتنتج مذاقاً حاداً، فضلاً عن أنها تبقي الميكروبات المضرة خارج الجسم وتسحق ألياف النباتات التي يعاني جسمنا من صعوبة في هضمها وحده. يميل البشر، أو بعض منهم، إلى تفضيل أنواع من الأطعمة عالية الحموضة كاللبن الزبادي. هنا، ترى أماتو في الحموضة مؤشراً على التأثير المذهل الذي يتمتع به التخمير، «الأمر الذي تجب مقابلته باختيار النوع الصحيح من الفواكه الناضجة».
ولكن لا بد من الاعتراف بأن دراسات تفضيل المذاق بين الأنواع الحية غير البشرية ليست مهمة سهلة أبداً، إذ تعتمد إحدى أبسط التجارب على تخيير الحيوان بين المياه العادية والمياه المنكهة - بطعم حلو، أو مالح، أو مر أو أومامي، أو حامض - لتحديد السائل الأكثر جذباً للمخلوق.
من جهته، أشار هيرو ماتسونامي، عالم أحياء في الكيمياء الحسية في جامعة ديوك، إلى عنصرٍ أكثر تعقيداً وهو أن الانتشار الواضح لرصد المذاق الحامض بين الفقريات قد لا يعود بالضرورة للطعم، لأن المستقبلات الكيميائية نفسها التي نستخدمها لتصفير الحموضة في أفواهنا تؤدي على ما يبدو مهام أخرى في الجسم قد تكون مهمة جداً، ما يرجح أن يكون هذا الضغط التطوري وحده السبب في استمرار تذوق الحامض طوال هذا الوقت.
* «ذا أتلانتك»
- خدمات «تريبيون ميديا»
8:27 دقيقه
الطعم الحامض مذاق «ضائع» من رواسب المذاقات المنسية
https://aawsat.com/home/article/3501421/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9



الطعم الحامض مذاق «ضائع» من رواسب المذاقات المنسية

- واشنطن: كاثرين جي وو
- واشنطن: كاثرين جي وو

الطعم الحامض مذاق «ضائع» من رواسب المذاقات المنسية

مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة