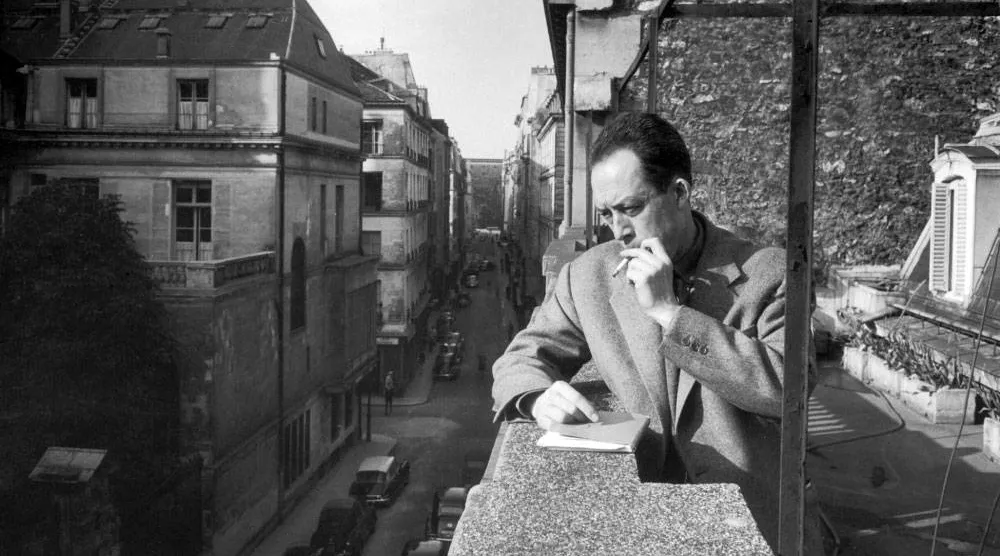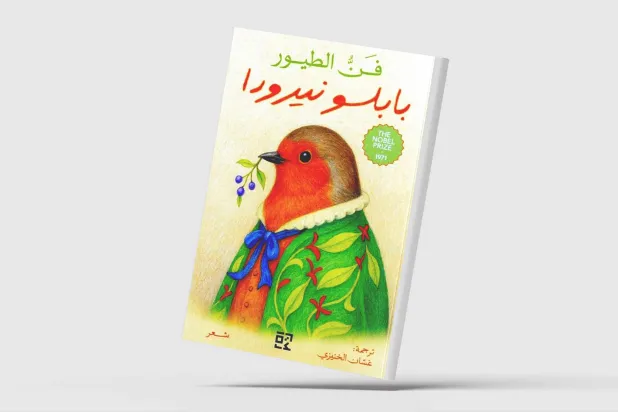«من يرغب بالعيش في طهران فهو مضطر للكذب، فلا مكان هناك للأخلاق، لأنها خارج إطار الحسابات»... هذا هو مضمون الرسالة التي خلصت إليها الكاتبة والصحافية الإيرانية البريطانية راميتا نافي «Ramita Navai» في كتابها السردي «العيش والكذب في طهران»، الصادر مؤخراً عن دار النشر الفرنسية «LITT. ETRANGERE».
تسعى الكاتبة عبر صفحات كتابها البالغة 384 صفحة من القطع المتوسط، إلى كشف أسرار مدينة طهران، لافتة إلى أنها مدينة مزدوجة النهج والحياة، ومن ثم فنحن أمام ازدواجية تنعكس على السكان أيضا؛ مثلما الحال في شارع «فالي عصر» وهو الشارع الرئيسي في طهران الممتد من الشمال للجنوب بطول 16.8 كلم؛ حيث يمثل نموذجا صارخا للازدواجية.
وبحسب الكتاب، يضم الشارع بين جنباته الدراويش والإرهابيين التائبين وتجار السلاح؛ مما يجعلنا أمام صورة بانورامية للحياة التقليدية اليومية في طهران، وهى صورة تعتمد أبعادها الرئيسية على أفراد يحيون حياة غير طبيعية في ظل واحد من أكثر النظم قمعاً في العالم، الأمر الذي يضفي على المدينة نوعا من الازدواجية في جوانبها كافة.
«العيش والكذب في طهران» رواية تضم قصصاً واقعية دون التطرق لهوية البطل الحقيقية خوفا عليه وعلى أقاربه من بطش النظام القمعي، وهو ما دفع المؤلفة لأن تلجأ إلى حيل كثيرة لتوصيل المعلومة والرسالة الأساسية عن طريق الشخصية بعيدا عن التطرق إلى هويته الأصلية، أو مجرد التلميح بها، وهى معادلة صعبة للغاية، إلا أنها نجحت في تحقيقها إلى حد كبير.
هناك ثماني قصص لثماني أحداث مختلفة، لكنها تتفق في عنصر المكان وهو شارع «فالي عصر»؛ ذلك الشريان الرئيسي والأهم الذي يخترق قلب العاصمة الإيرانية طهران ليشهد جميع الأحداث الرئيسية في العاصمة بين مظاهرات واحتفالات، هذا بالإضافة إلى لمساته الجميلة الرائعة ونسماته الطيبة لما يتمتع به الشارع من أشجار فريدة على جانبيه تحمي المارة من حرارة الشمس.
من القصص المثيرة في الكتاب، قصة الفتاة العلمانية «فريدة» التي تنتمي إلى الطبقة البورجوازية وتسعى للتعايش في ظل هذا النظام القمعي بسعادة على الرغم من معارضتها الشرسة له ورفضها مغادرة البلاد، ومن ثم فنحن أمام حالة استثنائية للغاية في مجتمع ديكتاتوري لتمثل بذلك قمة الازدواجية التي تمثل بدورها أحد الأمراض التي يعاني منها قاطنو المدينة.
يكتسب هذا العمل أهمية خاصة ليس فقط لأنه يجسد الواقع الداخلي لطهران، ولكن أيضا لأن الكاتبة تعرف المجتمع الإيراني جيدا ومعروفة بتقاريرها الميدانية الواقعية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتع بمهنية من طراز رفيع، فسبق أن عملت بالأمم المتحدة في إيران وباكستان والعراق، هذا بالإضافة إلى عملها مراسلة لصحيفة «التايمز» لدى طهران في الفترة من 2003 حتى 2006. لقد لعبت هذه الخبرة دورا مهما في تصوير المجتمع الإيراني، عن قرب ومن الداخل، مع تصوير الأحداث والشخوص، مستخدمة آلية الإسقاط الفني بمهارة لافتة، الأمر الذي أدى إلى حصول هذا العمل على عدد كبير من الجوائز الدولية؛ تأتي على رأسها جائزة «جيرود الملكية الأدبية».
تتنوع الشخصيات في الكتاب، وتبدو انعكاساً حياً لحياة العاصمة الإيرانية طهران وقاطنيها، كما تلتصق رمزية شارع «فالي عصر» بوصفه نموذجا صارخا للتناقضات داخل العاصمة الإيرانية والمجتمع الإيراني بشكل عام، برمزية الكذب، التي تمثل طبيعة الشخوص من الداخل.
فالكذب ضرورة؛ حسبما يوضح الكتاب، مؤكدا على أهمية التحلي بهذه الصفة لكي تحيا في طهران، في أمن وسلام وهدوء وتجنب أي إزعاج وتصادم مع النظام.. أي إننا أمام مجتمع تسوده الرقابة الصارمة في كل شيء، وهو أمر يتطلب الحذر الشديد والحيطة البالغة في كل التصرفات.
في ظلال هذه الصورة، يقدم الكتاب رسالة مهمة وقوية حول ثمن الحرية المستحيلة في طهران في ظل حياة معقدة للغاية، هذا بالإضافة إلى الخطر الدائم القائم هناك، وهو وضع جعل البشر من قاطني المدينة سجناء في فلك حياة ملؤها الكذب من أجل أن يعيشوا بعيدا عن بطش النظام وقمعه.
أيضا سعت الكاتبة من خلال هذا العمل إلى تشريح المجتمع داخل العاصمة الإيرانية طهران من خلال قصصها وأبطالها المختلفين في مصائرهم ونظرتهم المضطربة للحياة، واستخلاص بعض الصفات السائدة داخل المجتمع، بل على العكس نجحت إلى حد كبير في إحداث حالة من التوازن على الرغم من حساسيتها المفرطة في تناول الشخوص حفاظاً على سير الأبطال الحقيقيين وذويهم من بطش وقمع النظام.
كما قدمت الكاتبة على مدار عشرات الصفحات، صورة فريدة للشباب الإيراني الذي ينتهك جميع القواعد والقوانين الموضوعة، بالإضافة إلى التأكيد على حالة القمع السياسي التي يتعرض لها قاطنو المدينة، خصوصا الشباب.
وتوضح المؤلفة أن هناك أسبابا كثيرة دفعتها نحو تقديم هذا العمل، أهمها يكمن في رغبتها ومسعاها إلى تقديم صورة إيران الحقيقية للغرب، لتخلص إلى أن إيران بلد خطر للغاية لما به من مجانين يسعون لامتلاك سلاح نووي ويمارسون سياسات خطرة في محيطهم الإقليمي.
وفي الختام، يبقى تصوير المجتمع الإيراني من الداخل على الرغم من حالة الانغلاق التي يحياها، حالة من حالات الاختراق، تحسب للكاتبة، التي نجحت في توضيح الصورة الذهنية للمجتمع الإيراني المغلق لدى الغرب الذي لا يزال يعاني بدوره من فقر شديد في المعلومات حيال هذا المجتمع.
9:11 دقيقه
طهران... مدينة الازدواجية
https://aawsat.com/home/article/1263361/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9



طهران... مدينة الازدواجية
كتاب يخترق المجتمع الإيراني من الداخل

جانب من السوق القديم (بازار) في العاصمة الإيرانية
- القاهرة: أحمد صلاح
- القاهرة: أحمد صلاح

طهران... مدينة الازدواجية

جانب من السوق القديم (بازار) في العاصمة الإيرانية
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة