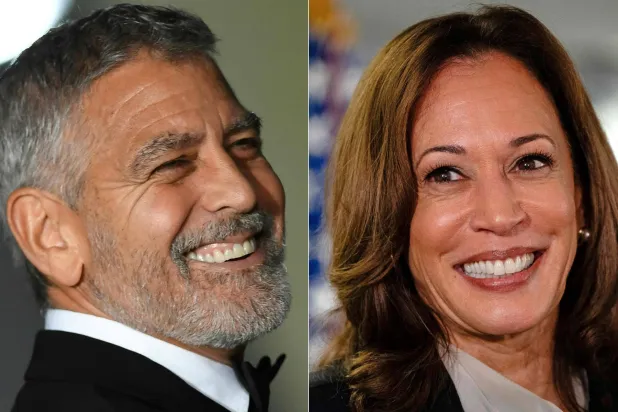إذا كان الإيفانجيليون البروتستانت الذين بنوا الولايات المتحدة الأميركية، هم أكبر كتلة سكانية (25 في المائة)، ويُعدّون القوة التصويتية الأكبر التي تدعم الحزب الجمهوري، لكونهم «ملتزمين أكثر دينياً»، فهل هذا يعني أن تأثيرهم على الحزب الديمقراطي انحسر لمصلحة كتلة أخرى، كالتيار اليساري على سبيل المثال؟ يجيب العديد من القراءات والدراسات بما فيها تلك الصادرة عن هيئات حكومية أميركية، بأن الدين، والإيفانجيليون على وجه الخصوص، لم يلعب فقط دوراً كبيراً في تشكل الحزبين، بل دوراً محورياً في تكوين، «هوية» أميركا و«رأسماليتها»... وحتى يسارها المنضوي الآن تحت عباءة الحزب الديمقراطي الحديث.

يقول كتاب التاريخ الرسمي الأميركي، في البداية، إنه لم يكن لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري دائماً المُثُل نفسها التي لديهما اليوم. بل ما حصل هو أن الحزبين غيّرا و«قلبا» آيديولوجياتهما على مدى عشرات العقود منذ تأسيسهما. وبينما يُعد الحزب الديمقراطي الذي أسّس عام 1828، أقدم حزب سياسي قائم على نظام الاقتراع في العالم، وأقدم حزب سياسي في أميركا، يعود تاريخ الحزب الجمهوري إلى عام 1854.
في سنواته الأولى، كان الحزب الجمهوري، الذي يعد حزب الرأسمالية الجديدة المسيطرة على الصناعات والبنوك في المدن... ليبراليا تماماً، وفي المقابل كان الديمقراطيون، المدافعون عن المزارعين وسكان الأرياف، معروفين بمحافظتهم القوية.
عند اندلاع الحرب الأهلية، سيطر الجمهوريون على غالبية الولايات الشمالية الأكثر تصنيعاً. وسعوا إلى توسيع الولايات المتحدة، وتشجيع الاستيطان في الغرب، وساعدوا في تمويل السكك الحديدية العابرة للولايات وتأسيس الجامعات الحكومية. وإضافة إلى ذلك، وبسبب الجدل المتوتر المتزايد حول العبودية، صار العديد من الجمهوريين - وعلى رأسهم زعيمهم إبراهام لنكولن - من معارضي العبودية (الرقّ) ودعاة إلغاء عقوبة الإعدام.
في المقابل، كان الديمقراطيون يتشاركون في الالتزام بقيم المجتمع الزراعي والريفي، وينظرون إلى الحكومة المركزية وقاعدتها المدينية على أنها معادية للحرية الفردية. ولأن معظم الديمقراطيين كانوا في الولايات الجنوبية الزراعية، فقد سعوا بعناد من أجل إبقاء العبودية قانونية.
دور الحرب الأهلية
ومع اقتراب الحرب من نهايتها، سيطر الحزب الجمهوري على الحكومة، واستخدم سلطته لحماية الأشخاص المستعبدين سابقاً وضمان حقوقهم المدنية. وشمل ذلك التعديلات بعد تسوية عام 1877 التي انتهت بإعادة الإعمار، التي أكسبت الجمهوريين ولاء السكان السود في أميركا وتصويتهم، وهو ما رفضه معظم الديمقراطيين.
لكن بعد الحرب الأهلية، بدأ التغيير البنيوي في الحزب الجمهوري، مع تعاظم ثروة الصناعيين الشماليين، ودخول العديد منهم ميدان السياسة؛ إذ لم يجد هؤلاء الساسة الأثرياء الجدد أي معنى في دعم حقوق الأميركيين السود، حين كان البيض هم الغالبية. وبحلول سبعينات القرن التاسع عشر، شعر الجمهوريون أنهم فعلوا ما يكفي للمواطنين السود، وأوقفوا كل الجهود «لإصلاح» الولايات الجنوبية، التي تُركت للديمقراطيين البيض وسياساتهم القمعية تجاه المواطنين السود. ومع انتهاء عملية إعادة الإعمار، صوّت «الجنوب الصلب» لصالح المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين للسنوات الـ44 التالية.
«الكساد الكبير» بداية التحول
بعد 52 سنة، أصبح «الكساد الكبير» الذي هز أميركا عام 1929، حافزاً لتغيير سياسي هائل. وفي حين ظل رجال الأعمال الأثرياء يهيمنون على الحزب الجمهوري، فضل هؤلاء سياسات اللا تدخل الحكومي دعماً للشركات الكبرى، التي كانت سياسة فعالة عندما كان الاقتصاد مزدهراً، لكنها أضحت كارثية مع الانهيار الاقتصادي الذي حصل.
وبالتالي، عندما تبنّى الرئيس الجمهوري هربرت هوفر سياسة اللا تدخل تعرّض لسخط الرأي العام الأميركي عليه وحزبه، وهذا بينما كان منافسه الديمقراطي فرانكلن روزفلت مؤمناً بالحاجة إلى التغيير. وبالفعل نظّم روزفلت حملته على التعهد بالتدخل الحكومي لإنقاذ الاقتصاد وتقديم المساعدة المالية والاهتمام برفاهية الناس. وبفضل هذه السياسة اكتسح روزفلت انتخابات عام 1932 بغالبية ساحقة. وكانت سياسات حملته - التي تبلورت يومذاك بما يعرف بـ«الصفقة الجديدة» - هي التي أدت إلى تحول كبير في آيديولوجيات الحزب الديمقراطي.
ولم يطل الوقت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عاد العرق والمساواة بالعودة إلى مركز السياسة في الخمسينات والستينات.
لم يكن العرق بالضرورة ضمن وجهة نظر الحزبين في هذه المرحلة، بل كان الأمر أقرب إلى قضية تخصّ الولايات، والجنوبية تحديداً؛ إذ عارض كل من الديمقراطيين والجمهوريين الجنوبيين «حركة الحقوق المدنية» المبكّرة، بينما بدأ الديمقراطيون والجمهوريون الشماليون في دعم التشريعات مع تزايد قوة الحركة.
وفي عام 1964، وقّع الرئيس الديمقراطي ليندون جونسون على قانون الحقوق المدنية. وفي انتخابات ذلك العام، عارض المرشح الجمهوري باري غولدووتر القانون الجديد علناً بحجة أنه وسّع سلطة الحكومة الفيدرالية إلى مستوى خطير.
كان ذلك هو ما أدى إلى التحوّل النهائي والحاسم؛ إذ بعدما كان الناخبون السود موالين للحزب الجمهوري بسبب «قانون الحقوق المدنية لعام 1866»، تحوّل هؤلاء بالفعل إلى الحزب الديمقراطي عندما رأوا أنه مناصر للمساواة والعدالة، في حين كان الجمهوريون مهتمين بالحفاظ على الوضع الراهن في أميركا.
وحقاً، مع مواصلة الديمقراطيين السير بالسياسات «الإصلاحية»؛ كالحق في الإجهاض في بداية السبعينات، وإلغاء تعليم الدين في المدارس الحكومية، أخذ الديمقراطيون الجنوبيون البيض - بخلفيتهم الريفية والدينية المحافظة - يتضايقون من مدى تدخل الحزب فيما يرونه حقوق الناس. وبحلول الثمانينات، أصبح الديمقراطيون الجنوبيون البيض جمهوريين، وغالبية الجنوب جمهوريين. والآن، نرى أن الحزب الجمهوري غدا الملاذ الحصين للمحافظين، مقابل تحول الحزب الديمقراطي إلى معقل لليبراليين والراديكاليين و«اليساريين».

هوية الحزب الديمقراطي
على الرغم من أن المجموعات التي تشكل ما يسمى بائتلاف التحالف الديمقراطي، خضعت لتحولات عدة، منذ حسم الحزب الديمقراطي استدارته السياسية، يتساءل كثيرون: هل تحول الحزب بالفعل إلى حزب يساري؟
وما موقع هذا التيار ضمن الائتلاف الديمقراطي؟
وما أفكاره؟ وما مدى تأثيره اجتماعياً وسياسياً؟
في الحقيقة، لم يكن الرئيس السابق دونالد ترمب، الجمهوري الأول الذي عد حركات الاحتجاج على ممارسات النظام الأميركي، حركات تنتمي إلى «الجماعات اليسارية» الأميركية. غير أن تزايد استخدام الجمهوريين لهذه المصطلحات بهدف «شيطنة» الاحتجاجات، وبصورة غير مسبوقة منذ حركة الحقوق المدنية في ستينات القرن الماضي، كشف عن عمق الانقسام السياسي والاستقطاب الذي تعيشه البلاد اليوم.
بحسب مركز «بيو» الأميركي المرموق، هناك أربع مجموعات تشكل التحالف الديمقراطي، هي: اليسار التقدمي، والليبراليون المؤسسيون، والديمقراطيون الأساسيون، واليسار الخارجي.
هذه المجموعات متوافقة إلى حد كبير على دعم الدور القوي الذي تلعبه الحكومة وشبكة الأمان الاقتصادية والاجتماعية القوية، فضلاً عن تشككها بقوة الشركات. ولكن، مع ذلك، ثمة اختلافات ملحوظة، إزاء قضايا كالقوة العسكرية الأميركية، وإلى حد ما، العدالة الجنائية وموضوع الهجرة. ثم إن الاختلافات في العديد من مجالات القضايا الرئيسة، بما فيها السياسة البيئية، والأسلحة، والإجهاض، والمساواة العرقية وغيرها، لا تتعلق بالقضية نفسها بقدر ما تتعلق بكثافة الدعم للمواقف والسياسات الليبرالية.
يمثل «اليسار التقدمي» حصة صغيرة نسبياً من الحزب، لا تتجاوز 12 في المائة من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، وغالبيتهم من جيل الشباب والطلاب الجامعيين. ومع ذلك، فإن هذه المجموعة هي الأنشط سياسياً.
في المقابل، يشكل «الليبراليون المؤسسيون» حصة أكبر بكثير، (24 في المائة)، ويصوّتون أيضاً بمعدلات عالية ويهتمون سياسياً للغاية. ومع أن لديهم آراء ليبرالية فهؤلاء يميلون إلى دعم التسويات السياسية أكثر من اليسار التقدمي واليسار الخارجي.
الفئة الثالثة، «الديمقراطيون الأساسيون»، هم أكبر مجموعة في الائتلاف الديمقراطي، (28 في المائة) ويطلقون على أنفسهم مسمى «المعتدلين سياسياً». ورغم احتفاظهم بمواقف ليبرالية بشأن الاقتصاد، فهم يختلفون بشأن قضايا الهجرة. فهؤلاء أقل ميلاً بكثير لدعم زيادة الهجرة القانونية وأكثر تقبلاً لتحديد الهجرة غير الشرعية بوصفها مشكلة في البلاد. كذلك فهؤلاء أكثر استثماراً في القوة العسكرية الأميركية. ويتركز الديمقراطيون السود بشكل خاص في هذه المجموعة (40 في المائة)، كما ينتمي إليها الأكبر سناً والاًقل احتمالاً للحصول على تعليم عالٍ.
وتبقى الفئة الرابعة، وهي «اليسار الخارجي»، وقوامها (16 في المائة)، لكن هؤلاء يعرّفون أنفسهم بأنهم مستقلون، وغالبيتهم من الشباب والتقدميين. ورغم أنهم ليسوا ليبراليين تماماً مثل «اليسار التقدمي»، فإن ليبراليتهم تظهر عندما يتعلق الأمر بالعرق والهجرة والقضايا البيئية. ولا يُعد هذا التيار موثوقاً به انتخابياً، ولكن عندما يواجه الاختيار بين مرشحين جمهوريين أو ديمقراطيين، يصوّت أفراده بغالبية ساحقة لصالح الديمقراطيين.
عندما تبنّى الرئيس الجمهوري هربرت هوفر سياسة اللا تدخل تعرّض لسخط الرأي العام الأميركي عليه وحزبه
تغير مصطلح «اليسار»
مع فشل «النماذج الاشتراكية» في دول أوروبا الشرقية، خضع مصطلح «اليسار»، الذي كان يشير في البداية إلى الفكر الاشتراكي، لتعديلات عدة في الغرب. ولقد بذلت في الماضي محاولات لجمع الاشتراكية الماركسية والرأسمالية الغربية، بهدف التوفيق بين رفض الاضطهاد والفقر والتفاوت الناجم عن السوق الحرة والرأسمالية، ورفض التأميم والاقتصادات المخططة مركزياً. وهو ما أدى إلى ولادة ما يسمى تيار «الديمقراطية الاجتماعية/الديمقراطية الاشتراكية» أو «تيار الاشتراكيين الجدد»، الذي ازدهر خصوصاً في بعض دول أميركا اللاتينية، ويمثله في الولايات المتحدة «اليسار التقدمي»... وجزئياً «اليسار الخارجي».
أيضاً، ظهر ما يسمى بتيار «الليبرالية الاجتماعية»، وهو فرع من الليبرالية، لكنه لا يدعو إلى حرية مطلقة للأفراد، بل لدور إيجابي للدولة في توفير حرية إيجابية. ويرفض هذا التيار كلاً من النماذج المتشددة من الرأسمالية والبُعد الثوري من الديمقراطية الاشتراكية. وبالتالي، فهو يؤمن بالأفكار الرأسمالية مع إدخال بعض الإصلاحات عليها، ويمثله في البلاد، «الديمقراطيون الأساسيون» و«الليبراليون المؤسسيون».
وأخيراً... لا آخراً، ظهر تيار اللاسلطوية أو «الفوضوية/الأناركية»، وهي ترجمة لمصطلح إنجليزي، ويُعد أقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية، الكاره لأي سلطة سواءً كانت دولة أو مجتمعاً أو حتى أسرة.

أميركا البروتستانتية... والمكارثية
عندما أسست الولايات المتحدة على أيدي البروتستانت البيض الذين فروا من أوروبا هرباً من الاضطهاد الكاثوليكي، بنى هؤلاء مجتمعاً قائماً على الرأسمالية والاقتصاد الحر. ومع تحوّل أميركا مركزاً للرأسمالية العالمية، أضفوا عليها مسحة بروتستانتية متدينة ميَّزتها عن الرأسمالية الأوروبية، الأمر الذي جعل من الصعب على اليسار الانتشار فيها.
وعلى الرغم من تأسيس الحزب الاشتراكي الأميركي عام 1905، وحزب العمال الأميركي بعده، نُبذ الحزبان وأمثالهما جماهيرياً. غير أن الفكر اليساري تغلغل في المجتمع الأميركي تدريجياً، معتمداً على عدة عوامل، أبرزها:
- أزمات الرأسمالية والانهيارات التي لازمتها، من أزمة 1929، مروراً بعقد الثلاثينات وبداية عقد الأربعينات، والأزمة المالية في عام 2008.
- التمييز العنصري ضد الأقليات عموماً، والسود خصوصاً.
- صعود اليمين المحافظ المتشدد، بتأثير من الإيفانجيليين البروتستانت.
هذه العوامل الثلاثة وعوامل أخرى دفعت كثيرين من المواطنين الأميركيين - ليس فقط من السود، ولكن أيضاً من البيض المستائين من تغوّل الرأسمالية والعنصرية وتصرفات اليمين المتشدد - للبحث عن أفكار أخرى يمكن أن تؤسس لأميركا جديدة، فكان الانتماء إلى الأفكار اليسارية طريقاً لهؤلاء.
مع هذا، حوّلت سيطرة الدين الشيوعية إلى «تهمة» يُتَّهَم بها كل صاحب فكر يساري في أميركا. وبالفعل، أُجريت المحاكمات إبان فترة الخمسينات من القرن الماضي لكل من يُتَّهَم أو يُشتَبَه في حمله لهذا الفكر. وهو ما عرف بـ«المكارثية السياسية»، نسبة إلى السيناتور اليميني المتشدد جوزيف مكارثي، الذي نظّر لقمع «الشيوعيين» في تلك الفترة.
في حينه، صارت تهمة الشيوعية ذريعة للإجهاز على المثقفين اليساريين والحركات النقابية والعمالية، التي أضعفت بنيوياً في أميركا، مقارنة بأوروبا. ويُذكر أنه اتُّهمت بـ«اليسارية» أيضاً «حركةُ الحقوق المدنية» في أميركا ضد التمييز العنصري خلال الستينات من القرن الماضي، التي قادها القس مارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس، مع أن الخطاب الشهير الذي ألقاه كينغ، «لديّ حلم»، استخدم فيه الكثير من مراجع الإنجيل.
تيارات اليسار الأميركي
هكذا، انتظم اليسار الأميركي في جماعات وتيارات، وكان له تأثير على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأميركية، وبعض هذه التيارات ارتبطت بقضايا معينة في وقـت معيَّن. إلا أنها عندما عجزت عن تحقيق أهدافها لم تلبث أن تلاشت أو ضعف تأثيرها، مثل حركة «احتلوا وول ستريت» التي انطلقت في سبتمبر (أيلول) 2011 من حي المال والأعمال في نيويورك، للتصدي لغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة فسادِ فاحشي الثراء، وإيقاف سيطرة الشركات الكبرى على الحكومات. وتبنَّت الحركة شعار «نحن نسبة الـ99 في المائة»، في إشارة إلى انعدام العدالة توزيع الثروة، واستمرت الاحتجاجات نحو ثلاثة أشهر، لكنها لم تنجح.
ومن رحم تيار «احتلوا وول ستريت» خرج تيار الاشتراكية الديمقراطية الأميركية بوصفه حركة مستقلة حاولت الدفع بأعضائها إلى الأحزاب الأميركية، وخصوصاً الحزب الديمقراطي، واستطاعت توفير الدعم المالي والإعلامي لهؤلاء المرشحين.
ووفق موقع «حركة الاشتراكيين الديمقراطيين» على شبكة الإنترنت، تعمل الحركة على تقنيات الحملات وحشد كل المؤمنين بالاشتراكية الديمقراطية. وتدّعي الحركة أيضاً أنها دعمت كثيراً من أعضائها للوصول إلى الكونغرس الفيدرالي والولايات. ومع أنها بدأت نشاطها السياسي الانتخابي فعام 2016 فقط، بلغ عدد أعضائها في عام 2018 نحو 50 ألف عضو فعال.
ويرجع الإقبال المتزايد على الانضمام إلى هذا التيار إلى طلاب الجامعات الحديثي التخرج بسبب إرهاقهم بالديون الدراسية، ونجاحها في استغلال المزاج الشعبي العام بعد انتخاب دونالد ترمب، وحالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها المجتمع الأميركي، واتجاه الإعلام الليبرالي لدعم اليسار بسبب خطاب ترمب اليميني. وحقاً، أعلنت الحركة عن جملة من الأهداف أهمها: إعادة توزيع الثروة عبر سياسات ضريبية جديدة، من خلال استراتيجية إعادة تشكيل المناخ السياسي في الولايات المتحدة عبر إصلاح الرأسمالية.
أما التيار اللاسلطوي أو «الأناركي»، فتمثله اليوم حركة «أنتيفا»، التي هاجمها ترمب وإدارته، قائلاً إنه سيصنِّفها منظمة إرهابية بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الرجل الأسود جورج فلويد. ومصطلح «أنتيفا» هذا اختصار لعبارة «مناهضة الفاشية». وكانت بدأت بتنظيم كوادرها ضد «النازيين الجدد» في الولايات المتحدة أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي، وخاصة في منطقة الغرب الأوسط. وبعدما تراجعت منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي، ظهرت مجدداً بعد انتخاب ترمب عام 2017.
وتقوم استراتيجية «أنتيفا» على رفض اللجوء إلى الشرطة أو الدولة لوقف زحف فكرة تفوُّق البيض. وبدلاً من ذلك يدعو أعضاؤها ومناصروها إلى المعارضة الشعبية للفاشية والحركات العنصرية والنازية، على الرغم من أن الفاشية في العموم، تنتمي فكرياً إلى الحركات اللاسلطوية أو «الأناركية». كذلك مع أن خطاب «أنتيفا» الرسمي يشدّد على مناهضة العنف، يقول أعضاء في الحركة إن العنف والأسلحة ضروريان للدفاع عن النفس.

«الحزب الديمقراطي» الأميركي... في المعايير اليسارية
> مع أن كثيرين يصنّفون الحزب الديمقراطي الأميركي بأنه حزب يساري، فإن هذا التصنيف مبسط جداً، لأن تركيبة الحزب بالغة التعقيد. فكثيرون من أعضاء الحزب يمكن تصنيفهم كيمينيين، ومنهم من يتبنى موقفاً وسطاً بين اليسار واليمين. وهذا الواقع برز في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية الترشيحية للرئاسة عام 2016، ثم عام 2020، حين فازت هيلاري كلينتون، ثم جو بايدن بالترشيح على حساب ممثل اليسار السيناتور بيرني ساندرز، الذي عد فشله مرتين فشلاً لتيار الاشتراكيين الديمقراطيين. وأيضاً، فإن سياسات الحزب الخارجية تتشابه في حالات عديدة مع سياسات الحزب الجمهوري، وهو ما نراه اليوم في موقف إدارة بايدن من الحرب الإسرائيلية على غزة. وفق مركز «بيو»، حصل بايدن في الانتخابات العامة ضد ترمب عام 2020 على الغالبية العظمى من أصوات المجموعات الأربع ذات التوجه الديمقراطي. إذ صوّت له 92 في المائة من «الليبراليين المؤسسيين»، و94 في المائة من «اليسار الخارجي»، و98 في المائة من «الديمقراطيين الأساسيين»، و«اليسار التقدمي». من جهة أخرى، في حين يفضّل الليبراليون العيش في المدن، يفضّل المحافظون المناطق الريفية، والبلدات الصغيرة. ومع التغيير الذي طرأ على بنية الاقتصاد الأميركي، وتراجع دور التصنيع التقليدي لمصلحة التقنيات الحديثة، والصناعات الجديدة، دُفعت القاعدة العمالية التي تعيش في ضواحي المدن نحو الجمهوريين. كذلك، يميل الليبراليون أكثر من المحافظين إلى القول بأن التنوع العرقي والإثني مهمّ في المجتمع. ورغم ذلك، يقول 49 في المائة من الأميركيين إنهم لن يكونوا سعداء إذا تزوّج أحد أفراد الأسرة من شخص لا يؤمن بالله.