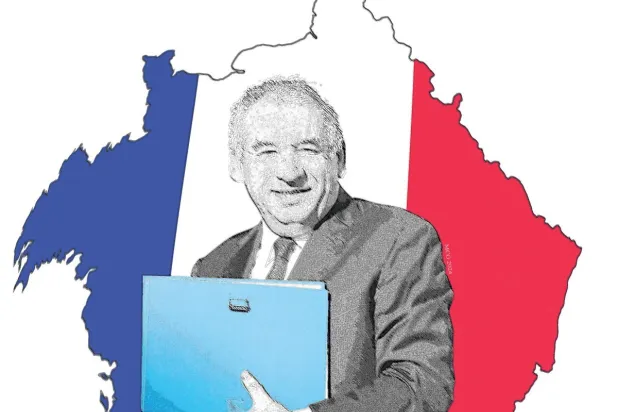مطلع العام الحالي، كان رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل، أنطونيو كوستا، يتناول طعام العشاء في عاصمة بلاده لشبونة، محفوفاً بالمستشار الألماني لأولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فيليبي غونزاليس، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للحزب الاشتراكي البرتغالي الذي كان قد أسّسه في المنفى الدكتور ماريو سواريش. ويومذاك أسس سواريش الحزب برفقة مجموعة من المنشقّين عن ديكتاتورية أنطونيو سالازار التي امتدت من ثلاثينات القرن الماضي حتى سقوطها في عام 1974 عندما قامت «ثورة القرنفل»، التي قادتها مجموعة من الضبّاط الذين خدموا في مستعمرات البرتغال الأفريقية. في ذلك العشاء الاحتفالي، قال رئيس «الحزب الاشتراكي الأوروبي» ستيفان لوفين، وهو رئيس وزراء السويد الأسبق، إن كوستا «منارة أمل» بالنسبة للاشتراكيين الأوروبيين، بينما وصفه نظيره الإسباني بيدرو سانتشيز بـ«الحصن الاشتراكي المنيع»، وسط التيار الليبرالي في أوروبا. لكن في مطلع الأسبوع الفائت، خسر الاشتراكيون رئيس الوزراء الاشتراكي الوحيد في أوروبا الذي كان يحكم بغالبية نيابية مطلقة، إلى جانب المالطي روبرت أبيلا، عندما توجه أنطونيو كوستا إلى مقرّ رئاسة الجمهورية ليقدّم استقالته بعد الكشف عن فضيحة فساد تطول عدداً من أقرب معاونيه.

مضى أسبوعان تقريباً على استقالة أنطونيو كوستا، وما زال البرتغاليون في دهشة أمام هذه النهاية الصادمة لحقبة فريدة في تاريخ البرتغال السياسي امتدت ثماني سنوات. وللعلم، كان كثيرون يرجّحون أن تنتهي هذه الحقبة بمنصب رفيع يتولاه كوستا في إحدى مؤسسات «الاتحاد الأوروبي» الذي كان قد استقبله بتحفظ شديد وشكوك عندما وصل للمرة الأولى إلى الحكم في عام 2015 متحالفاً مع كتلة اليسار و«الحزب الشيوعي البرتغالي».
وحقاً، لم يكن أحد يتوقع، بداية الأسبوع الماضي، أن البرتغال ستبدأ، في اليوم التالي، رحلة البحث عن رئيس جديد للحكومة وزعيم للحزب الاشتراكي خلفاً لكوستا، في أعقاب إعلان المحكمة العليا أنها ستفتح تحقيقاً حول دوره في الموافقة على مشروعات كبرى في مجال الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخراج الليثيوم. بيد أن كوستا عند مثوله أمام الصحافة ليعلن استقالته، قال نافياً أي ذنب: «أريد أن أقول للبرتغاليين وأنا أُحدّق في عيونهم: إن ضميري مرتاح من أي مخالفة أو تصرّف غير قانوني».
على أية حال، بعد استقالة كوستا، أصبح القرار بيد رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوسا، الذي يجيز له الدستور حل البرلمان، والدعوة لإجراء انتخابات مسبّقة أو مبكرة، أو تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة من «الحزب الاشتراكي» الذي يتمتع بغالبية واسعة في البرلمان. غير أنه بعد مشاورات مكثفة مع قيادات الكتل البرلمانية وأعضاء «مجلس الدولة»، قرّر رئيس الجمهورية إنهاء الولاية التشريعية التي كانت قد بدأت في ربيع العام الفائت بعد الانتخابات العامة، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة ستُجرى في مارس (آذار) المقبل.
فرصة فرناندو ميدينا
من بين الأسماء التي بدأت تتداولها الأوساط السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة قبل قرار دي سوسا حل البرلمان، وزير المال الحالي فرناندو ميدينا، المقرَّب من كوستا، والذي يحظى بتقدير واسع، حتى في بعض أوساط المعارضة التي فتحت هذه الأزمةُ المفاجئة نافذة غير متوقّعة أمامها للعودة إلى الحكم. إلا أن قرار الرئيس قطع عليه الطريق، على الرغم من إصرار «الحزب الاشتراكي» على استعداده لطرح اسم خليفة لسوسا، ما يفتح الآن أمامه باب زعامة الحزب التي أصرّ كوستا أيضاً على الاستقالة منها.
ولعلّ ما يزيد من حظوظ ميدينا الآن في تولّي قيادة «الحزب الاشتراكي» أن هذه الأزمة تتزامن مع مناقشة البرلمان الموازنة العامة التي تسجّل حدثاً غير مسبوق في تاريخ البرتغال الحديث. هذا الحدث هو انخفاض مستوى الدَّين العام إلى ما دون إجمالي الناتج المحلي، بحيث تصبح البرتغال، للمرة الأولى، خارج «نادي» الدول الأوروبية المثقلة بالديون. والواقع أن ثمة إجماعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، البرتغالية والأوروبية، على أن فرناندو ميدينا أحسن تطبيق سياسة «الحسابات الصحيحة» التي كان كوستا قد جعل منها العماد الأساسي لسياسة حكومته، وذلك منذ شكّل الحكومة، للمرة الأولى، في عام 2015، وتحوّلت، من ثم، إلى هاجسه الأساسي لمنع انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تعرّضت لها عام 2011.
في المقابل، كانت تلك السياسة التقشفية الصارمة التي جعل منها كوستا العنوان الرئيس لإدارته، قد حالت دون إجراء الإصلاحات والاستثمارات الكبرى التي تحتاج إليها البرتغال، إلى أن جاءت مساعدات «صندوق الإنعاش الأوروبي» للنهوض من تبِعات جائحة «كوفيد-19». وقد تقرّر تخصيص جزء مهم من هذه المساعدات لتمويل مشروعات في مجال الطاقة بهدف وقف انبعاثات الكربون في الاقتصادات الأوروبية.
وبالفعل، سارع كوستا حينذاك إلى تبنّي هذا التوجّه، ليجعل منه أساس «الثورة الخضراء»، التي أمل أن تكون إرثه السياسي بعد ثماني سنوات من الحكم، ولا سيما بعدما أصبحت البرتغال - في عهده - رابع أكبر منتج أوروبي للطاقة المتجددة خلف كل من النمسا والسويد والدنمارك. وفي هذا السباق المحموم نحو «تصفير» انبعاثات الكربون، اعتمدت الحكومة الاشتراكية تخفيف القيود والشروط البيئية على الشركات، لتمكينها من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها، وتحقيق هدف التصفير بحلول عام 2045. إلا أن تلك التسهيلات أدّت إلى منح تراخيص لمشروعات مثيرة للجدل، منها، مثلاً، منجم استخراج الليثيوم في منطقة كوفاس دو بارّوسو، المشهورة بمزاياها البيئية والزراعية الاستثنائية، التي استحقت معها أنْ أدرجتها «منظمة الأمم المتحدة» على قائمة «التراث الزراعي العالمي». وكان هذا أحد المشروعين الأبرز اللذين أثيرت حولهما الشبهات، إلى جانب مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر... ومن ثم تحركت النيابة العامة لفتح تحقيق حول ملابسات الترخيص له.

الإنجاز الأبرز الذي حققته حكومة أنطونيو كوستا كان خفض الدَّين العام ومستوى العجز في الموازنة، لكنها أظهرت عجزاً واضحاً عن فتح قنوات للحوار مع بقية القوى السياسية
تحقيقات النيابة العامة
ما يجدر ذكره هنا أن النيابة العامة البرتغالية كانت قد باشرت تحقيقاتها، في أواخر عام 2019، وأسفرت، في مرحلتها الأخيرة، خلال الأسبوعين الأخيرين، عن إلقاء القبض على اثنين من أفراد الدائرة الضيّقة المقرَّبة جداً من أنطونيو كوستا، هما مدير مكتبه فيتور أسكاريا، وصديقه رجل الأعمال البارز ديوغو لاسيردا ماتشادو، وهذا، فضلاً عن توجيه تهمة الاشتباه الرسمي إلى وزير البنى التحتية جواو غالامبا. وقد سبق لغالامبا أن أثار جدلاً واسعاً حول أسلوبه وإدارته التي تسببت أخيراً في تعكير صفاء العلاقة المتينة التي كانت تربط كوستا برئيس الجمهورية ريبيلو دي سوسا، وذلك بعدما أصرّ كوستا على إبقائه في الحكومة، رغم سلسلة الفضائح التي شهدتها وزارته. هذا، وكان قد ورد، في بيان النيابة العامة، أن إلقاء القبض على أسكاريا وماتشادو جاء لقطع الطريق على احتمال فرارهما من وجه العدالة، ومواصلة الأفعال الجنائية والتحقيقات القضائية الجارية، لكشف جميع الملابسات، والتأكد من وقوع الفساد وسوء التصرف بالأموال العامة.
وإلى جانب ما تقدّم، كانت الشرطة القضائية البرتغالية قد نفّذت ما يزيد عن 40 عملية مداهمة، بما فيها مداهمات مقرّات رئاسة الحكومة ووزارات البني التحتية والبيئة، وعدد من المنازل الخاصة والمكاتب القانونية.
من جانبه، قال كوستا، لدى مثوله أمام وسائل الإعلام في القصر الحكومي: «كرامة المنصب تتعارض مع فتح التحقيقات من جانب المحكمة العليا... وأنا من واجبي أن أحافظ على كرامة المؤسسات الديمقراطية». ثم أكّد أنه ما كان على علم بالأفعال التي حرّكت شبهات النيابة العامة، لكن مجرّد الإعلان عن إخضاعه للتحقيق يمنع استمراره في منصب رئيس الحكومة. ثم أضاف: «أنا لستُ فوق القانون، وإذا كانت هناك شبهات فلا بد من التحقيق فيها». وحقاً، جاء في تسريبات نشرتها مجلة «إكسبريسو»، الواسعة الاطلاع، أن النيابة العامة كانت قد أخضعت مكالمات وزير البيئة السابق للتنصّت، بعد الاشتباه بضلوعه في أفعال جنائية. وقد تبيّن أنه تواصل مع رئيس الحكومة في أربع مناسبات، بحثا خلالها اجتذاب استثمارات أوروبية ودولية ضخمة لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة في البرتغال.
غير أن المبادرة الجريئة، التي صدرت عن كوستا بتقديمه استقالته، فور إعلان المحكمة العليا إخضاعه للتحقيق - والتي كانت موضع تقدير وثناء في الأوساط السياسية والشعبية - لا تحجب الحالات الكثيرة التي تعرّض فيها عدد من وزرائه لشبهة الفساد في السابق، وانتهت بخروجهم من الحكومة؛ ليس بضغط من رئيس الحكومة، بل بفعل التحقيقات القضائية وتبِعاتها.
استحقاقان صعبان للاشتراكيين
على صعيد آخر، يرجّح المطّلعون أن السبب الرئيس الذي حدا برئيس الجمهورية البرتغالي إلى رفض التجاوب مع الدعوات لتكليف شخصية من الغالبية البرلمانية الاشتراكية لتشكيل حكومة جديدة، أنه في أعقاب انتخابات العام الفائت التي نال فيها «الحزب الاشتراكي» الغالبية المطلقة، أبلغ كوستا صراحةً بأن الغالبية هي، في المقام الأول، له شخصياً. وهو ما يعني أن رحيله لتولي منصب أوروبي رفيع - كما كان متداولاً - يعني نهاية الولاية التشريعية للبرلمان المنتخب.
مهما يكن من أمر، فإن الإنجاز الأبرز الذي حققته حكومة أنطونيو كوستا كان خفض الدين العام ومستوى العجز في الموازنة، لكنها في المقابل أظهرت عجزاً واضحاً عن فتح قنوات للحوار مع بقية القوى السياسية الممثلة في البرلمان والنقابات العمالية. واليوم، يواجه الاشتراكيون استحقاقاً صعباً على جبهتين:
الأولى هي التوافق على زعيم جديد للحزب الذي يعاني انقسامات داخلية كان كوستا قادراً على تهدئتها.
والثانية تجاوز الإرث الصعب الذي تركته فضائح الفساد التي دفعت كوستا إلى الاستقالة، وخصوصاً أن الرئيس المستقيل كان قد خصّص قسطاً كبيراً من جهوده لتطهير الحزب من أدران الفساد الذي كان قد نخره على عهد رئيس الوزراء الأسبق، خوسيه سوقراطيس، الذي حُكم عليه بالسجن عام 2014 بسبب ضلوعه في فضيحة فساد مالي.
وضع معسكر اليمين
على الجانب اليميني، «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» اليميني وحده قادر على تغيير المعادلة البرلمانية الراهنة، وخصوصاً إذا أُجريت الانتخابات المسبّقة، بعدما يكون القضاء قد أصدر أحكام الإدانة في قضايا الفساد التي هزّت أركان الحزب الاشتراكي.
والحقيقة أن الاجتماعيين الديمقراطيين يرون في الأزمة الراهنة فرصة ذهبية للعودة إلى الحكم، غير أن حزبهم سيحتاج إلى التحالف مع أحزاب أخرى، وخصوصاً مع «حزب المبادرة الليبرالية»، والحزب اليميني المتطرف «شيغا» الذي حقق صعوداً لافتاً في الانتخابات الأخيرة. ووفق المراقبين والمحللين، تبدو حظوظ «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» في التحالف مع القوى اليمينية أوفر بكثير من حظوظ الاشتراكيين في التحالف مع أحزاب اليسار الذي قطع معهم خطوط التواصل في الفترة الأخيرة بسبب من السياسة الوسطية واليمينية التي انتهجتها حكومة كوستا.
وهنا، يقول المراقبون في الأوساط السياسية البرتغالية إن الدرس الذي أعطاه أنطونيو كوستا في الأخلاقيات السياسية، يوم الثلاثاء الفائت، عندما هرع إلى رئيس الجمهورية لتقديم استقالته فور الإعلان عن إخضاعه للتحقيق، وقوله إنه لا يعرف بالضبط التهم الموجهة إليه، لا يعفيه من مسؤولية تطبيق معاييره للنزاهة على أقرب معاونيه، ولا سيما أن كثيرين كانوا قد حذّروه من عواقب «الصداقة المتينة» التي تربطه برجل الأعمال المثير للجدل، ديوغو لاسيردا ماتشادو.
وللعلم، تعود الصداقة بين الرجلين إلى أيام الدراسة الجامعية في كلية الحقوق بجامعة لشبونة، وظلت تتوطّد إلى أن طلب كوستا من صديقه أن يكون إشبينه (مرافقه المقرَّب) يوم زفافه، كما أصرّ على أن يبقى قريباً منه منذ أن تولّى رئاسة الحكومة. وبعدها، كانت أول مهمة كلّف كوستا صديقه بتوليها هي تأميم شركة الطيران الوطنية «تاب»، بعدما كانت الحكومة السابقة قد وضعتها في يد القطاع الخاص، ليتولّى ماتشادو بعد ذلك رئاسة مجلس إدارتها.
بعد ذلك عاد كوستا وكلّف ماتشادو بإدارة الأزمة مع المتضرّرين من أزمة انهيار مصرف «سبيريتو سانتو»؛ أحد أكبر المصارف البرتغالية وأعرقها، ثم كلّفة بتسوية النزاع بين مصرف «كايشا» وابنة الرئيس الأنغولي الأسبق جوزيه إدواردو دو سانتوس؛ الملاحَقة دولياً في عدد من قضايا الفساد واختلاس المال العام. وقد تمّ ذلك التكليف دون أن يُخضع لرقابة الإدارة العامة، ما تسبَّب في عاصفة من الانتقادات والجدل دفعت كوستا إلى اتخاذ قرار بالتعاقد مع صديقه براتب رمزي قدره 2000 يورو شهرياً. وهنا أيضاً تجدر الإشارة إلى أن ماتشادو، الذي تدور حوله معظم الشبهات في هذه الفضائح التي أدت إلى استقالة كوستا، لا ينتمي أصلاً إلى «الحزب الاشتراكي»، بل كان فقط مستشاراً لكوستا عندما تولّى هذا الأخير حقيبة العدل في الحكومة التي ترأسها الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ولعلّ ما يستحق الإشارة في هذا السياق أن صداقة وطيدة تربط غوتيريش برئيس الوزراء المستقيل كوستا.
وإلى جانب كل ذلك، كان مدير مكتب كوستا، فيتور أسكاريا الذي أُلقي القبض عليه أيضاً، قد اضطر للاستقالة عام 2017 من منصبه بصفته مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء بسبب فضيحة قبوله هدايا ودعوات لرحلات سياحية مع أسرته لحضور نهائيات «كأس الأمم الأوروبية» في فرنسا عام 2016.

خلافة كوستا بين خياري الاستمرارية والتوجه يساراً
> تحولت البرتغال، خلال السنوات الماضية، بفضل قيادة أنطونيو كوستا ومهارته في فتح قنوات الحوار مع الخصوم السياسيين والتوافق على القضايا الكبرى، إلى قدوة في الاستقرار السياسي الديمقراطي والعمل الطبيعي للمؤسسات العامة في محيط أوروبي دائم التأرجح على شفا الأزمات والاهتزازات السياسية. ورغم خطورة الفضائح التي أدَّت إلى استقالة كوستا، ينبغي التوقف عند ظاهرتين: الأولى موقف كوستا الذي، رغم الغالبية الواسعة التي تؤيده في البرلمان، قرر الاستقالة، لإدراكه مدى الضرر الذي يلحقه بقاؤه في المنصب، خلال الإجراءات القضائية، بالمؤسسات العامة. والثانية تأكيد استقلالية القضاء البرتغالي الذي يؤدي عمله دون أن يتأثر بمستوى المسؤولية العامة التي يتولاها الأشخاص الذين يخضعون لملاحقة الأجهزة وتحقيقاتها. ولا شك في أن قرار رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوسا بإجراء الانتخابات المسبقة على أعتاب الربيع المقبل، هو لإفساح المجال الكافي أمام «الحزب الاشتراكي» كي يعيد تنظيم صفوفه وانتخاب زعيم جديد في الأشهر المقبلة. ووفق المعطيات الراهنة، بين الأسماء الأخرى التي ينتظر أن تنافس فرناندو ميدينا على زعامة الحزب، الوزير السابق للبنى التحتية بيدرو نونو سانتوس. وكان هذا الأخير قد استقال من حكومة كوستا في عام 2021، بعد تفاقم الخلاف بينهما حول سياسة التحالفات البرلمانية لتعزيز الغالبية التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان. هذا، ويقود نونو سانتوس التيار الذي يدعو إلى الانفتاح على الأحزاب اليسارية، ومنها «الحزب الشيوعي»، والعودة إلى اتباع سياسة يسارية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في حين كان كوستا مؤيداً للانفتاح على الأحزاب الوسطية، واتباع سياسة اقتصادية أقرب إلى البرنامج الليبرالي، مع تخفيض الخدمات الاجتماعية للطبقة العاملة وموظفي القطاع العام.