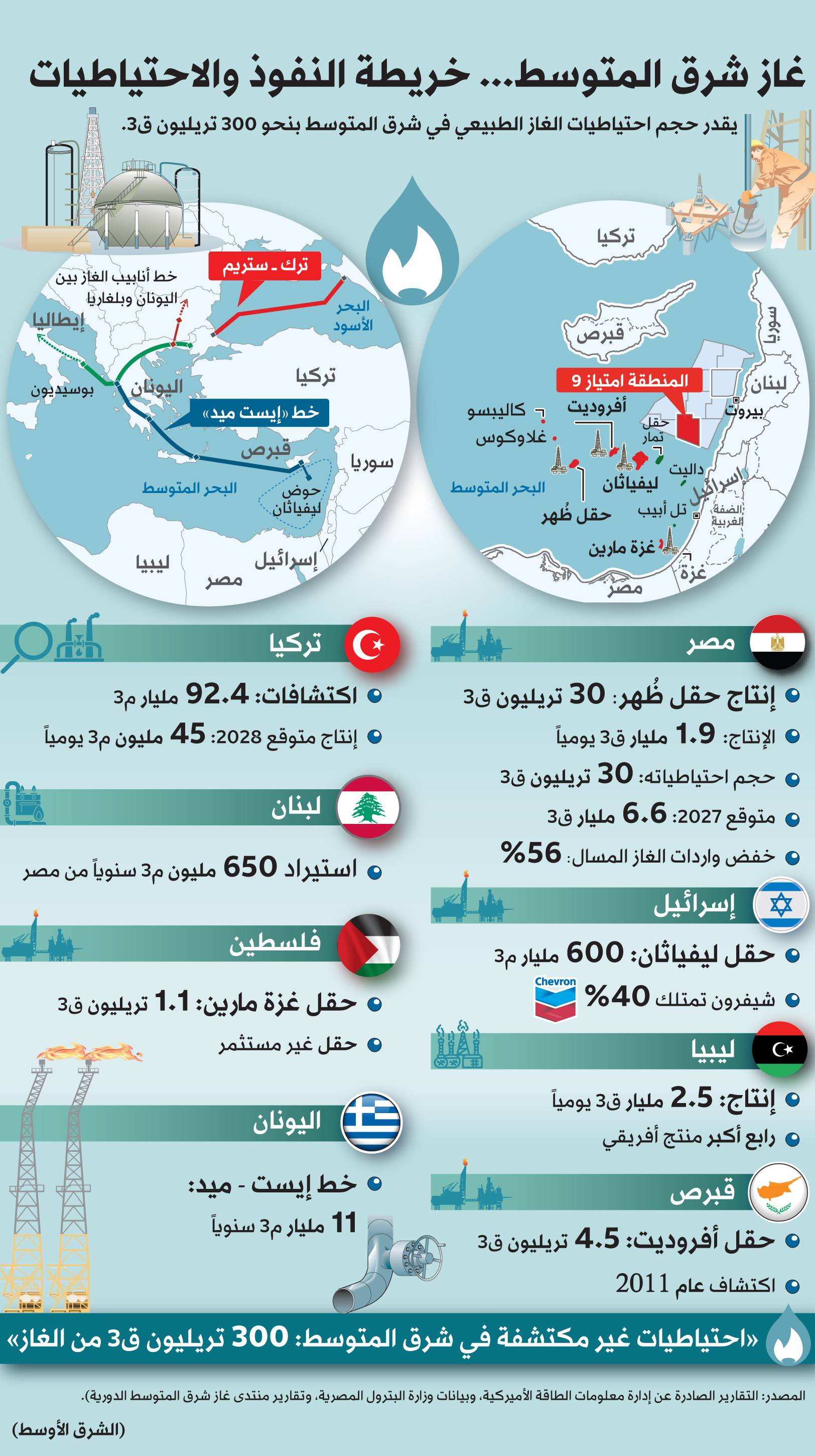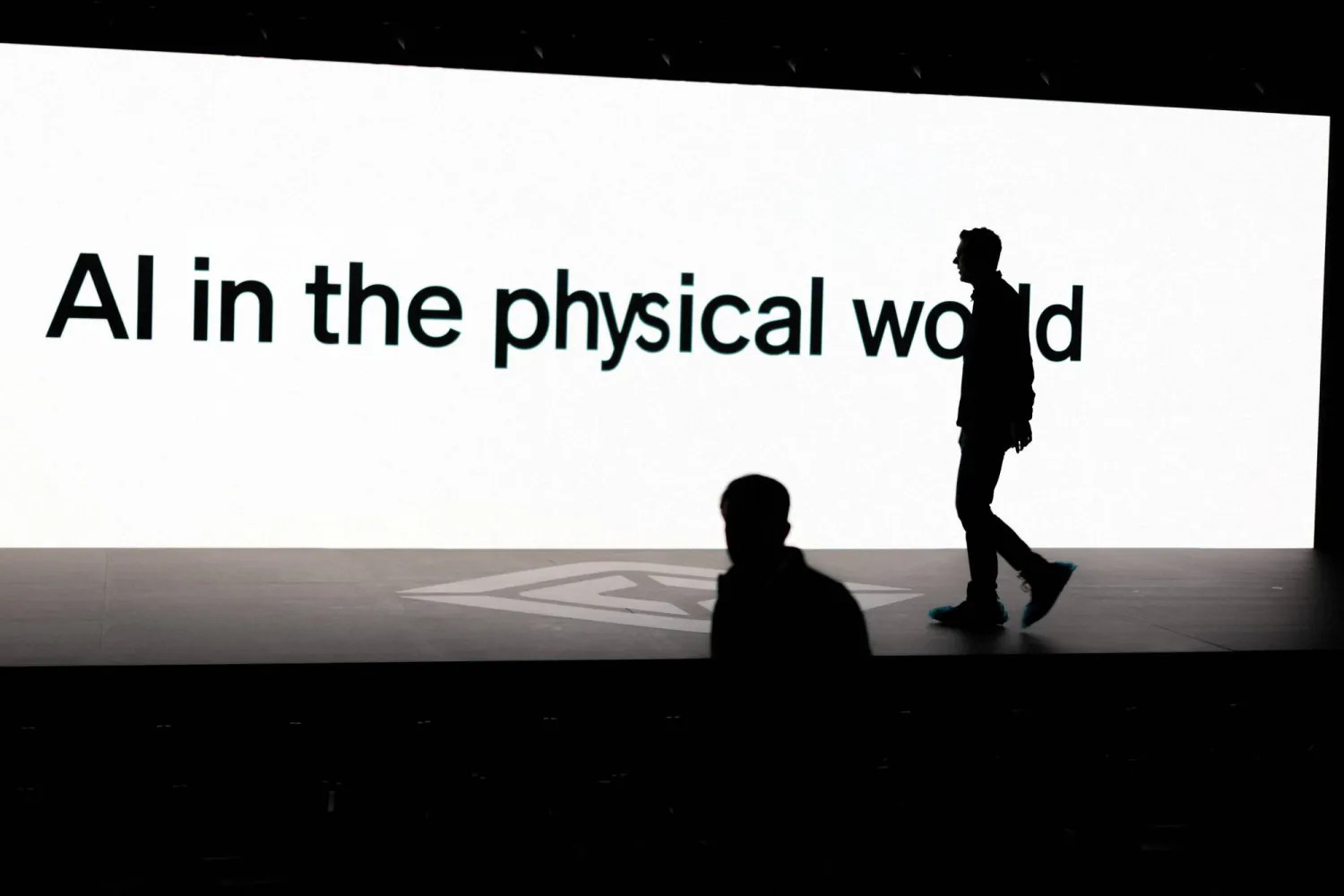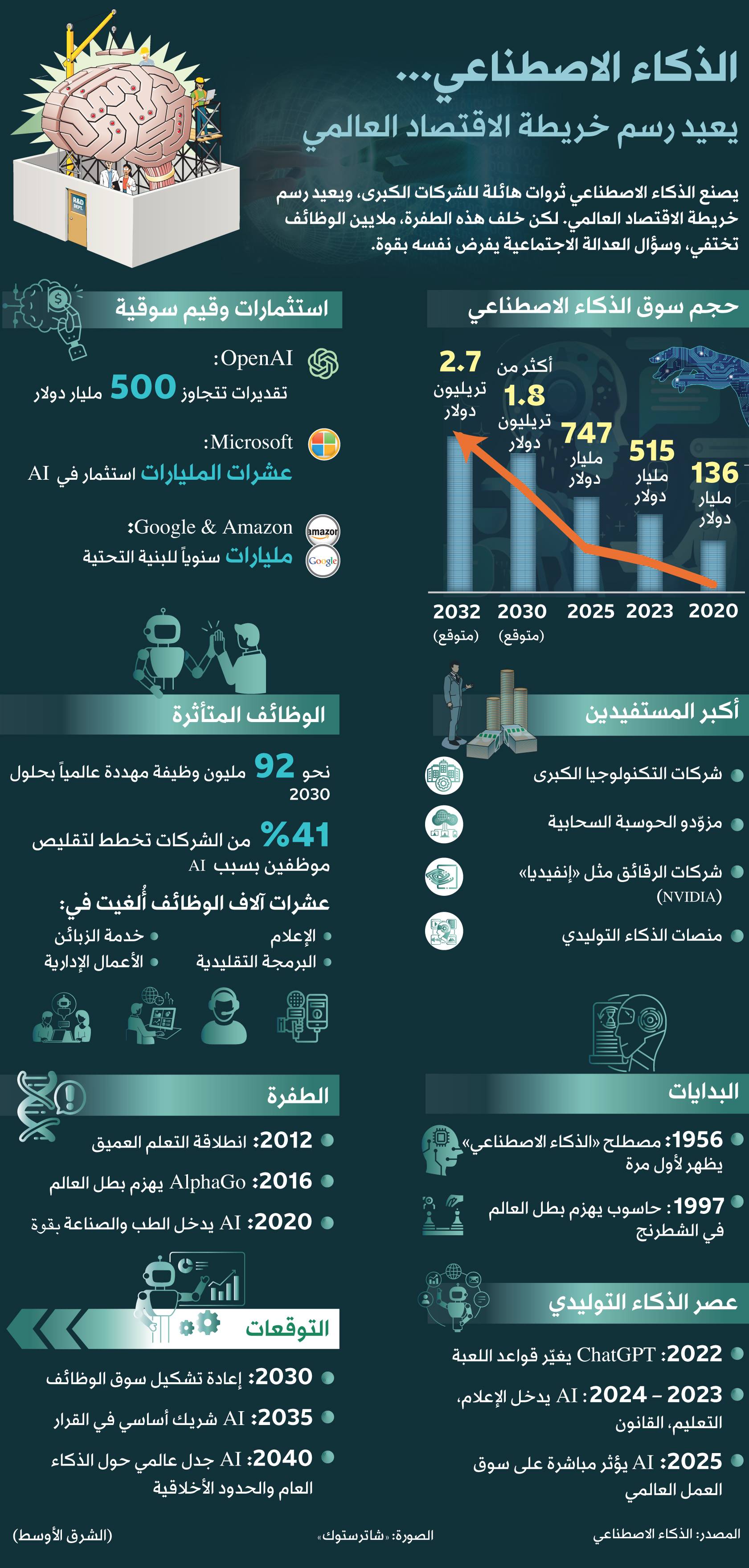منذ عقود والعالم ينظر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي كواحة رخاء وأمان واستقرار، وكمصدر لفرص عمل كريمة وبناء مستقبل افضل في منأى عن الحروب والاضطرابات والأزمات المتوطنة التي أغرقت مواطني غالبية الدول النامية في حال من اليأس وانسداد الأفق؛ ما دفع بكثيرين منهم إلى ركوب كل المخاطر للوصول إلى الأرض الأوروبية الموعودة. لكن منذ سنوات، ثمة عواصف تعتمل في سماء المشهد الأوروبي وتعكّر صفاء البحيرة التي بدأت تتقاطع في مياهها تيارات الغضب والقلق التي ولّدها تعاقب الأزمات الاقتصادية والتغييرات الهيكلية التي باتت تهدد نظام الرفاه الذي يشكّل إحدى الركائز الأساسية للمشروع الأوروبي. بعد شتاء حافل بالاحتجاجات الحاشدة في المملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا والجمهورية التشيكية، شهدت أوروبا ربيعاً غاضباً، خاصة فرنسا التي ترفض القبول بأن ساعة «نهاية البحبوحة» قد أزفت، حسب تعبير إيمانويل ماكرون، في حين تشعر غالبية الأوروبيين بأن ركائز دولة الرفاه تتقوّض بسرعة، وتتدهور خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم الرسمي، في الوقت الذي أصبح المسكن ترفاً، والطبقة الوسطى على شفا الانهيار. كل ذلك تسبب في إضرابات عامة لم تشهدها أوروبا منذ سنوات كثيرة، كتلك التي عاشتها المملكة المتحدة أو الإضراب الذي شلّ قطاع النقل في ألمانيا مطلع الربيع الفائت، أو الاحتجاجات الحاشدة في عدد من المدن البرتغالية ضد ارتفاع تكاليف الإسكان، وعشرات المظاهرات ضد التضخم الجامح في معظم الدول الأوروبية.
ساحات حرب
مطلع الربيع الفائت تحولت شوارع باريس إلى ساحات حرب متنقلة بين قوات الأمن والمتظاهرين احتجاجاً على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد الذي يشكّل أحد أعمدة دولة الرفاه بالنسبة للفرنسيين. وترافد في تلك الاحتجاجات أنصار الأحزاب المعارضة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تعبيراً أيضاً عن السخط المتفشي في أوساط المجتمع الفرنسي الذي تتراكم عليه الازمات منذ سنوات، وانضمّت إليهم عناصر احترفت ركوب هذه الفرص لممارسة العنف ضد الممتلكات العامة ورموز الدولة.
إنه السخط المتنامي نفسه الذي أضرم نار الإضرابات في المملكة المتحدة والبرتغال وألمانيا واليونان. تختلف الشرارات التي تطلقه باختلاف البلدان، لكن سببه الأساسي واحد، هو السأم من حياة ترتفع تكاليفها وتزداد تعقيداً.
تكلفة المعيشة هي اليوم الهاجس الرئيسي الذي يقضّ مضاجع غالبية الأوروبيين الذين يراقبون بعجز وإحباط منذ سنوات كيف تتضاءل قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع المطرد في الأسعار بسبب تداعيات الثورة الرقمية والتحوّل نحو الاقتصاد البيئي وازدياد عدد المسنين، ومؤخراً الحرب الدائرة في أوكرانيا وما نجم عنها من مضاعفات في سوق الطاقة والسلع الغذائية. في هذا السياق، كان لا بد من التساؤل: هل إن ما شهدته فرنسا، ولا تزال، هو نذير لما ينتظر البلدان الأوروبية الأخرى؟
محركات الموسم الاحتجاجي
الموسم الاحتجاجي الذي يجتاح أوروبا منذ أشهر وتتصاعد وتيرة العنف الذي يرافقه، ليست محركاته مقصورة على الأزمات الاقتصادية وما تولّده من صعوبة العيش لنسبة متزايدة من السكان، بل هو أيضاً نتيجة حتمية لسنوات من الاستياء المتراكم والاغتراب الذاتي، خاصة عند الشباب المتحدرين من أصول غير أوروبية كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا، حيث أخفقت سياسات الاندماج في معالجة أزمة الانتماء والهوية التي يعانون منها. يضاف إلى ذلك، أن الغضب الشعبي الذي يعبر الحدود الآيديولوجية هو فرصة ذهبية لا تفوّتها الأحزاب المتطرفة، على يمين المشهد السياسي ويساره، لتوسيع دائرة نفوذها، ولا النقابات التي انحسرت قواعد مؤيديها في العقود المنصرمة.

إلى جانب كل ذلك، يتميّز جيل القرن الواحد والعشرين بنزعة انفرادية حادة، تجعله ينأى عن الانخراط في الجمعيات والتنظيمات الحزبية والنقابية حيث يتم اتخاذ القرارات بالتوافق، ويجنح بالتالي إلى عدّ كل نزاع أزمة هوية تستهدفه شخصياً ولا يتردد في الانفجار من غير مراعاة لتباين الأدوار والمهام في المجتمع، ويرفض استيعاب فكرة أنه من المستحيل أن يعيش مثلما عاش جيل آبائه.
الغضب الشعبي يتراكم على امتداد القارة الأوروبية، وهو إلى ازدياد على وقع الأوضاع الاقتصادية المتردية، وينتظر من يستغلّه عند أول شرارة احتجاجية. وفرنسا هي اليوم المرآة التي تنعكس على صفحتها الأزمة الاجتماعية المتنامية في أوروبا. أزمة الصراع بين التكنوقراط والذين خسروا معركة العولمة ويطالبون بعالم لم يعد موجوداً، ويقعون في قبضة الأحزاب الشعبوية المتطرفة.
فرنسا... «بلد الاحتجاجات»
ولا ننسى أنه إذا كانت فرنسا «بلد الاحتجاجات» بامتياز، فهي أيضاً نموذج سياسي بالنسبة للكثير من الأوروبيين، ومشكلاتها هي نفسها التي تعانيها اليوم معظم الدول الأوروبية التي يترقّب مواطنوها أدنى شرارة للاندفاع في مسيرات الغضب والاحتجاج التي يكثر الذين يصطادون في مياهها. ومن نافل القول تأكيد أن الحراك الاجتماعي حصل دوماً بغض النظر عن الجهة الحاكمة في فرنسا أكانت من اليمين أم اليسار؛ ما يعني أن الداء لا لون سياسياً له، بل هو كامن ومتجذر.
ويقول فرنسوا دوبيه، أستاذ العلوم السوسيولوجية في جامعة بوردو (جنوب غرب فرنسا): إنه منذ أحداث الشغب في ضواحي مدينة ليون «شهدنا عشرات عدة» من أنواع الحراك كافة. والخيط الجامع بينها «أن ساكني الضواحي والأحياء الشعبية يشعرون بالتهميش إن بسبب أصولهم أو ثقافاتهم أو دياناتهم». والثابت أيضاً، أن الجمعيات والحركات الاجتماعية المنبثقة عنهم وكذلك الأحزاب «لم تنجح في ترجمة النقمة والغضب إلى مطالب واضحة أو أن تفضي إلى مسار سياسي» بحيث إن الشعور العام هو الفراغ. وحدها أحداث «غينغيت» أفضت إلى شيء سياسي هو «المسيرة من أجل المساواة ورفض العنصرية» التي انطلقت من لوين ووصلت إلى باريس وكان لها وقع كبير على المجتمع.
ويلحظ الباحث الأكاديمي وجود «نمطية» محددة في تسلسل الأحداث التي تنطلق بعد سقوط جريح أو قتيل من هذه الضواحي أو الأحياء على أيدي رجال الأمن ما يثير حنقاً وحالة هياج تترجم فورياً بأعمال عنف تستهدف الإنشاءات العامة والمدارس والبلدية والمراكز الاجتماعية، ويتطور العنف إلى اشتباكات مع رجال الأمن وعمليات كرّ وفرّ، ثم يعقبها استهداف المحال التجارية وبعض السرقات. وينتج منها توقيف المئات من المتظاهرين ومن المشاغبين وتتبعها المحاكمات... وهكذا دواليك. أما ردود الفعل العامة فتنقسم تقليدياً، وفق الباحث، بين التنديد بعنف رجال الأمن وأجواء العنصرية المسيطرة بما فيها التعامل التمييزي مع شباب الضواحي الذين يقوى لديهم الشعور بالاستهداف معطوفاً على الفقر والبطالة والشعور بالتهميش. وبالمقابل، ثمة من يدين تكاثر الحضور الأجنبي والهجرات والتهديد الذي يلحق بتركيبة المجتمع وثقافته وعدم التلاؤم بين ثقافة المنشأ والثقافة الفرنسية وصعوبة الاندماج بما يحمله من تغيير في البنية المجتمعية وتهديد للهوية الفرنسية والسير نحو «أسلمة» البلاد وتحقق نظرية «الإحلال»، أي أن تأخذ موجات الهجرات القادمة من أفريقيا ومن بلدان المغرب مكان الفرنسيين. ويذهب كثيرون لإدانة تصرفات سكان الضواحي والأحياء الفقيرة المتسمة بـ«التوحش»، لا، بل إن الرئيس ماكرون لم يتردد سابقاً في التنديد بما سماه «الانفصالية الإسلاموية»، أي تبني ثقافات وتصرفات منقطعة عما هو فرنسي الطابع، في حين يتحدث آخرون عن مساحات خارجة عن الدولة الفرنسية، حيث لا تدخلها القوى الأمنية وتخضع عملياً لمهربي وتجار المخدرات. وما بين الطرفين، تجد الحكومات المتعاقبة نفسها عاجزة أكانت من اليمين أم اليسار.
أخطاء سنوات البحبوحة
حقيقة الأمر، كما يرى كثير من الباحثين، أن ما يحصل من «ثورات» اجتماعية منذ عقود عدة ليس سوى نتيجة تراكمات وأخطاء ارتكبت سابقاً. ومن بين الأخطاء، أن سنوات البحبوحة دفعت الشركات الفرنسية والأوروبية بشكل عام إلى استجلاب اليد العاملة رخيصة التكلفة وبأعداد كبيرة للعمل في المصانع والمزارع وملء فراغات المهن الصعبة أو التي يرفضها الفرنسي، وذلك زمن القفزة الاقتصادية ووضعتها في مجمعات في ضواحي المدن. وقد تحولت لاحقاً إلى «غيتوات» بطابع أجنبي يغلب عليها الفقر والجهل والبطالة وتجارة المخدرات والعنف والتهميش. وتبين الإحصائيات الحالية، أن نسبة البطالة في الضواحي والأحياء الشعبية تصل إلى 18 في المائة بينما معدلها العام لا يزيد على 7 في المائة.
حقائق
18% نسبة البطالة
في الأحياء الفقيرة في فرنسا
ويبلغ عدد هذه الأحياء التي تصنفها الحكومة بأن لها «الأولوية» في عملية الإنماء 1514 حياً. ومن الناحية السكانية، ثمة 22 في المائة من سكانها من الأجانب. واللافت، أن نسبة البطالة فيها للشباب دون سن الثلاثين تصل إلى 30.4 في المائة. ومن الناحية الجغرافية، تتوزع الضواحي الساخنة على جوار المدن الكبرى (باريس، وليون، ومرسيليا، وليل غرونوبل). والثابت، أنه إذا كانت سنوات البحبوحة لم تعرف «حراكاً» مطلبياً من هذه الضواحي فلأن المهاجرين الذين جيء بهم من الخارج كانوا في غالبيتهم من الأميين وهمّهم الوحيد كسب لقمة العيش ليس إلا وكانوا إما لا يشعرون بالمعاملة التمييزية أو أنهم كانوا يقبلونها. لذا؛ فإن الحراك بدأ مع الجيل الثاني وتوسع مع الجيل الثالث وكلاهما أكثر إحساساً بالتهميش والمعاملة التمييزية من آبائهم.
وخلال الأيام الماضية، كثرت الشهادات التي تبين أن العنصرية متفشية لدى الكثير من أفراد الشرطة الفرنسية. ويعيد الباحث إيمانويل بلانشار ذلك إلى التاريخ الاستعماري لفرنسا والرؤية الدونية لمن كانوا مستعمرين، ودليله على ذلك ما حصل مع الجزائريين والقمع الذي تعرّضوا له وعلى سبيل المثال ما حصل للمتظاهرين منهم يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961، حيث تعرّضوا للقمع الشديد وسقط منهم الكثير من القتلى. ومما هو معروف أن كثيرين فضّلوا أن يرموا أنفسهم في نهر السين بدلاً من أن يقعوا بأيدي الشرطة. ودلّت تصريحات وبيانات صادرة عن نقابات الشرطة في الأيام الأخيرة على عنصرية كامنة، عادّة أن أفرادها في «حالة حرب مع مفسدين».
ليس من العدل بمكان رمي المسؤولية على جهة واحدة أكانت الدولة أم أجهزتها وتناسي مسؤولية الطرف الآخر. ورغم ما سبق، يمكن تأكيد أن أفضل حماية للمواطن أو للمهاجر في فرنسا أو في غيرها من الديمقراطيات عنوانها احترام القوانين، ومنها قوانين السير. وليس سراً أن نسبة الأجانب في السجون الفرنسية مرتفعة قياساً لنسبتهم السكانية داخل المجتمع الفرنسي. وتبين إحصائيات وزارة العدل لشهر أكتوبر عام 2021، أن 17198 أجنبياً كانوا في السجون، ما نسبته 24.5 في المائة من إجمالي السجناء، بينما نسبة الأجانب في فرنسا لا تتعدى 7 في المائة. وواضح أيضاً أنه يتعين على الأجانب التأقلم مع المجتمع الفرنسي وليس العكس، وأن الأعمال المخلّة بالأمن على أنواعها تسيء بالدرجة الأولى إلى سكان الضواحي والأحياء الفقيرة التي يتزايد تهميشها فيما الحرائق التي أضرمت أصابت بداية هذه المناطق والأحياء.
بريطانيا... فوضى غير مسبوقة
وقد تكون بريطانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية المنزلقة في منحدر شديد زادت حدته منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك؛ فإن أزمات المملكة المتحدة أقدم من «بريكست»، رغم أن الخبراء الاقتصاديين يتفقون على أنه من دون شك سرّع في انحدارها هذا.

وربما الأشهر الماضية كانت دليلاً على مدى تردي حالة البلاد وإشارة إلى مدى تراجع الكثير من الخدمات الأساسية فيها. فعلى وقع أزمة تضخم هي الأقسى منذ 40 عاماً، لفت الإضرابات بريطانيا وخرجت خدمات أساسية في قطاعات التنقل والتعليم والاستشفاء، عن الخدمة لأيام متتالية، لم تنته بعد وتحذر بالعودة في الأسابيع المقبلة. هؤلاء المضربون جميعهم، من أساتذة وأطباء وعمال سكك الحديد والبريد والمطارات وغيرهم، كلهم يطالبون برفع أجورهم لكي تتماشى مع نسبة التخضم التي ترتفع بشكل صاروخي.
ويقول ماريانو آغيرّي، الباحث في مركز «تشاتهام هاوس»: «إن حزب المحافظين البريطاني يدفع البلاد نحو الانهيار، في حين تكبّد بريطانيا سياسات (رئيس الوزراء السابق) بوريس جونسون والخروج من الاتحاد الأوروبي خسائر فادحة، والاقتصاد أشبه بسفينة توشك على الغرق في بحر اجتماعي شديد الهيجان».
وعشيّة مرور مائة يوم على وصول ريشي سوناك إلى داونينغ ستريت، أعلن عمال السكك الحديدية وموظفو قطاع التعليم، بما فيه الجامعات، أكبر إضراب في بريطانيا منذ 12 عاماً للمطالبة برفع الأجور وإلغاء التشريعات التي تلزم بتأمين الحد الأدنى من الخدمات. وفي أبريل (نيسان) الفائت، أضرب موظفو الأمن في المطارات عشرة أيام متتالية؛ مما تسبب في حال من الفوضى غير المسبوقة خلال عطلة عيد الفصح، في الوقت الذي هددت فيه قطاعات أخرى بموجة من الإضرابات إذا لم تحصل على ما يعوّض التضخم الذي زاد عن 11 في المائة منذ بداية هذا العام.
حقائق
330 ألف عامل
خسرتهم بريطانيا نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي
وكان لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي أثراً مباشراً على العمالة، وأدى بحسب دراسة «معهد الإصلاحات الأوروبية» صدرت مطلع العام الحالي، إلى خسارة بريطانيا لقرابة 330 ألف عامل، معظمهم في قطاعات لا تتطلب مهارات عالية، مثل قطاعات البيع والنقل والخدمات في المطاعم والفنادق. وتحركت الحكومة في المقابل لتسهيل العمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة من الهند، لملء الوظائف الشاغرة، ولكن في قطاعات تحتاج إلى مهارات عالية مثل النظام الحصي والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.
ألمانيا... أشهر حبلى
ورغم أن «بريكست» أبرز أزمة نقص العمالة في بريطانيا وفاقمها، فإن ألمانيا تعاني مثلها نقصاً كبيراً في العمالة يهدد كذلك سير الخدمات الرئيسية، خاصة في القطاع الصحي والتعليم. والسبب الرئيسي في نقص العمالة زيادة أعداد المتقاعدين مقابل عدم تدريب مختصين بشكل كافٍ في المهن التي تعاني من النقص.
ففي ألمانيا تعاقبت إضرابات قطاعات أساسية، مثل السكك الحديدية والنقل الجوي والمواصلات العامة، دائماً لطلب زيادة في الأجور تعوّض التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، رغم أن الحكومة تطبق تدابير للتخفيف من آثار أزمة الطاقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا. لكن إذا كانت ألمانيا لم تشهد حتى الآن نفس الفوضى التي عرفتها فرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال؛ لأن المجتمع الألماني أكثر تنظيماً وقدرة على التكيّف مع الصعاب، ولأن التعاضد بين النقابات الألمانية الموزعة حسب القطاعات أقلّ منه بين الفرنسية الأكثر تطرفاً، فإن الأشهر المقبلة قد تكون حبلى بسلسلة من الإضرابات والاحتجاجات ما لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتصحيح الأجور بعد أن اقتربت نسبة التضخم من 8 في المائة.
فنقص الأطباء، مثلاً، بات يشكل قلقاً كبيراً للحكومة الحالية دفعت بوزير الصحة كارل لاوترباخ إلى الدعوة لخلق 5 آلاف مقعد إضافي في الجامعات لتعليم وتدريب أطباء في وقت تشير توقعات معهد روبرت بوش إلى أن 11 ألف وظيفة طبيب عائلة ستكون شاغرة بحلول عام 2035، خاصة في المناطق النائية البعيدة عن المدن الكبيرة. وبشكل عام، فإن واحدة من كل 6 مهن تعاني نقصاً في المهارات، ويشكو العاملون فيها من عدم قدرتهم على توظيف المهارات التي يبحثون عنها. وبحسب دراسة لوزارة العمل الفيدرالية، فإن 200 مهنة من أصل 1200 تعاني نقصاً في المهارات، وهو رقم ارتفع عن العام الذي سبق حين كان عدد المهن التي تنقصها مهارات 148. وأشارت الوزارة أيضاً إلى إمكانية انضمام 157 مهنة إضافية إلى لائحة المهن التي تعاني نقصاً في العثور على مهارات لملء الوظائف الشاغرة. ومن بين هذه المهن التمريض والتعليم والبناء وتكنولوجيا السيارات والمهندسين والصيادلة والمختصون بتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى سائقي الشاحنات والباصات والعاملين في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والمطاعم والصناعات المعدنية.
اقرأ أيضاً
وتحاول الحكومة التي يقودها الاشتراكيون ملء هذه الثغرات بجذب مهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ يشير متخصصون إلى أن ألمانيا بحاجة لـ٤٠٠ ألف مهاجر ماهر سنوياً للتعويض عن المجتمع الهرِم والعمالة الناقصة. وجال المستشار الألماني أولاف شولتز على الهند وغانا مطلع العام للإعلان عن نية حكومته تسهيل دخول العاملين الماهرين من الدولتين خاصة العاملين في مجال تكونولوجيا المعلومات، في حين يبحث وزير العمل في البرازيل عن مهارات لملء آلاف الوظائف الشاغرة في مجال التمريض ورعاية المسنين.
وقبل أسبوعين مررت ألمانيا قانون هجرة حديثاً وغير مسبوق يسهّل إجراءات الدخول للكفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي ويخفض متطلبات اللغة الألمانية المطلوبة كشرط مسبق للحصول على التأشيرة. ويسمح القانون الجديد كذلك للباحثين عن العمل بالدخول إلى ألمانيا والمكوث لغاية عام بحثاً عن عمل، بشرط أن يكونوا من حملة شهادة جامعية أو خضعوا لتدريب في مهنة من المهن التي تعاني نقصاً في الموظفين في ألمانيا. ولا يشترط القانون الجديد معرفة اللغة الألمانية، بل يخير المتقدم بالألمانية او الإنجليزية، إضافة إلى شروط أخرى. وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا، استفاد مرة جديدة من أزمة اللاجئين الأوكران ومن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم ومهاجمة الحكومة، خاصة لجهة خططها المتعلقة بالطاقة. ومررت الحكومة باقتراح من حزب الخضر المشارك فيها، قانوناً يمنع على مالكي الأبنية شراء سخانات تعمل فقط على الغاز، وإجبارهم بدءاً من عام 2024 على أن تكون السخانات الجديدة التي يتم تركيبها، تعمل بنسبة 60 في المائة بالطاقة المتجددة. وأثار القانون سخطاً كبيراً للتكلفة العالية التي تواجه أصحاب البيوت من دون تعويضات واضحة من الحكومة. واستفاد «البديل لألمانيا» من السخط ليهاجم الحكومة ويكسب أصواتاً إضافية. ورغم أن وصول «البديل لألمانيا» إلى السلطة على المستوى الفيدرالي مستبعدة لرفض كل الأحزاب الكبيرة العمل معه، فهو بدأ يحقق نجاحات تاريخية في بلديات صغيرة بشرق ألمانيا. والأسبوع الماضي انتخبت أول بلدة ألمانية في ولاية ساكوميا أنهالت رئيس بلدية من «البديل لألمانيا». وتستعد الولايات الثلاث الشرقية العام المقبل لإجراء انتخابات محلية تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب المتطرف سيفوز بها.
قد تكون ألمانيا بدأت تتقبل أنها باتت مجتمع لاجئين من الناحية القانونية، ولكن الكثيرين يقولون بأنه من دون تغيير العقلية تجاه المهاجرين والغرباء والألمان من أصول مهاجرة، فإن القوانين المحدثة لن تنفع بجلب المهارات التي تحتاج إليها البلاد إلى دولة لا ترحب بهم وتميز ضدهم ولا تعدّهم متساوين.
الفقر والتهميش وشرارة أخطاء الشرطة

ليست المرة الأولى التي تعيش فيها فرنسا حالة من الاضطرابات الاجتماعية - الاقتصادية التي تفضي إلى أعمال عنف واسعة واشتباكات وسرقة ونهب وانقسامات آيديولوجية وسياسية حادة، في حين تجد السلطات نفسها عاجزة عن إطفائها إلا عن طريق اللجوء إلى القوى الأمنية، وأحياناً إلى فرض حالة الطوارئ ومنع التجول. وإذا كان الفقر والتهميش والمعاملات التمييزية تشكل الوقود الذي يغذي الاحتجاجات، فإن اخطاء الشرطة تشكل عادة الشرارة التي تشعله.
كذلك، ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الشباب في ضواحي المدن والأحياء الشعبية لمواجهة رجال الشرطة بعد حادث كالذي أفضى إلى موت الشاب القاصر نائل مرزوق صبيحة يوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران) الماضي، على يد شرطي دراج أطلق النار عليه من مسافة قريبة بعد ملاحقة خطرة في شوارع مدينة نانتير الواقعة على مدخل باريس الغربي. الشرطي البالغ من العمر 38 عاماً والقابع حالياً في الحبس الاحتياطي، عدّ أن تصرف سائق السيارة المسروقة يشكل تهديداً له ما يعطيه الحق بإطلاق النار عليه، وهو ما فعله. السيناريو ليس جديداً، لا، بل هو مكتوب سلفاً وعشرات الأحداث المشابهة حصلت في العقود الأربعة الأخيرة. لكن الجديد فيها هذه المرة أن رواية الشرطي وزميله دحضهما تسجيل فيديو أظهر أن لا الشرطي ولا زميله كانا مهددين، وأن روايتهما الأصلية كانت مفبركة؛ ما ضاعف من غضب الشارع. وتفيد أرقام وزارة الداخلية، بأن 15 شخصاً قُتلوا منذ عام 2022 على أيدي الشرطة في حوادث تدقيق مروري شبيهة بما حصل مع نائل مرزوق. والسبب الرئيسي أن قانوناً صدر في عام 2017 وسّع دائرة الظروف التي تتيح لرجل الشرطة إطلاق النار.
يطول سرد وتفصيل تسلسل الأحداث التي عرفتها فرنسا في العقود الأربعة الماضية. والمتعارف عليه أن نقطة الانطلاق يمكن ردّها إلى نهاية السبعينات، وتحديداً لعام 1979، حيث شهدت ضاحية فول - فولين، اللصيقة لمدينة ليون (وسط فرنسا) أول أحداث أمنية عندما عمدت الشرطة إلى توقيف مراهق عمره 17 عاماً، اسمه حكيم، جزائري الأصل، بتهمة سرقة سيارة. وعندما شعر الأخير أن الشرطة على وشك القبض عليه، لم يتردد في جزّ أحد شرايين ذراعه ما لم يمنع الشرطة من سوقه مكبلاً؛ الأمر الذي أثار غضب سكان الحي الذين هاجموها بما توفر.
الغلطة الكبرى
هذا كان أول الغيث وتبعته في المنطقة نفسها أحداث مشابهة صيف عام 1981 في الحي المعروف باسم «غينغيت». أسابيع من الاشتباكات التي تمددت إلى مدينتي فينيسيو وفيلوربان القريبتين من ليون مع الشرطة بما يصاحبها من سيارات محروقة ومتاجر وممتلكات. والجديد فيها أنها الأولى من نوعها التي تلقى تغطية إعلامية واسعة من كافة الوسائل الإعلامية بما فيها التلفزة التي لعبت وقتها الدور الذي تلعبه حاليا وسائل التواصل الاجتماعي ما زاد من وقعها على المجتمع ولفت الأنظار لأوضاع الضواحي والأحياء الشعبية التي تحتضن نسبة مرتفعة من الأجانب المهاجرين.
إذا كانت الحكومات المتعاقبة منذ أربعين عاماً قد فضلت التعامل الأمني مع الأحداث، إلا أنها في الوقت نفسه سعت لتحسين أوضاع الضواحي من خلال خطط متنوعة منها عمليات تجديد الإنشاءات العامة والعمل لتوفير الخدمات وزيادة المدارس والمراكز الرياضية والمكتبات... إلا أن القبضة البوليسية لم تتراخ واستمر سكان الضواحي، خصوصاً الشباب منهم، في الشكوى من تعاطي الشرطة معهم ومن تعرّضهم للمتاعب والملاحقات التي ينسبونها لكونهم أجانب أو أفارقة أو مغاربة... بالطبع، لم تعرف موجات العنف السابقة بما فيها ما حصل في عام 2005 المدى الذي وصلت إليه الموجة الأخيرة التي طالت 500 مدينة على مجمل التراب الفرنسي. إلا أن عناصر الشبه بينها كثيرة وعميقة، وبالتالي انكب كثيرون من علماء الاجتماع على دراسة جذورها مسبباتها وكشف دقائقها وطرح خطط للتخلص منها. ومن جانبها، لم تبق الحكومات المتعاقبة يميناً ويساراً مكتوفة الأيدي. وثمة من ينتقد في فرنسا «السخاء الزائد» للدولة مع هذه الضواحي والأحياء. ولكن في أي حال، فإن النتائج لم تكن بمستوى الآمال، والدليل على ذلك ما حصل في الأيام الأخيرة. وهناك من يرى أن «الغلطة الكبرى جاءت في التركيز على البنيان المادي من دون السعي لتغيير الذهنيات والعقليات وهدم الصور النمطية»، بمعنى أن السياسات المتبعة «لم تنجح في خفض الرؤى والمعاملات التمييزية على أسس إثنية أو دينية أو اجتماعية» ولم تنجح في إعادة خلط السكان بحيث بقيت الأحياء الصعبة فقيرة وأكثر هشاشة وبقيت مراكز اجتذاب للمهاجرين.