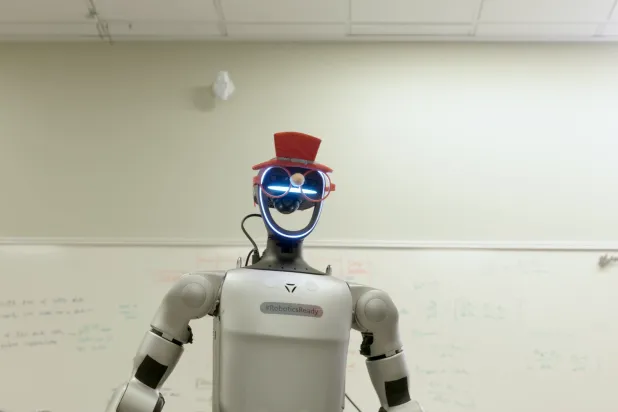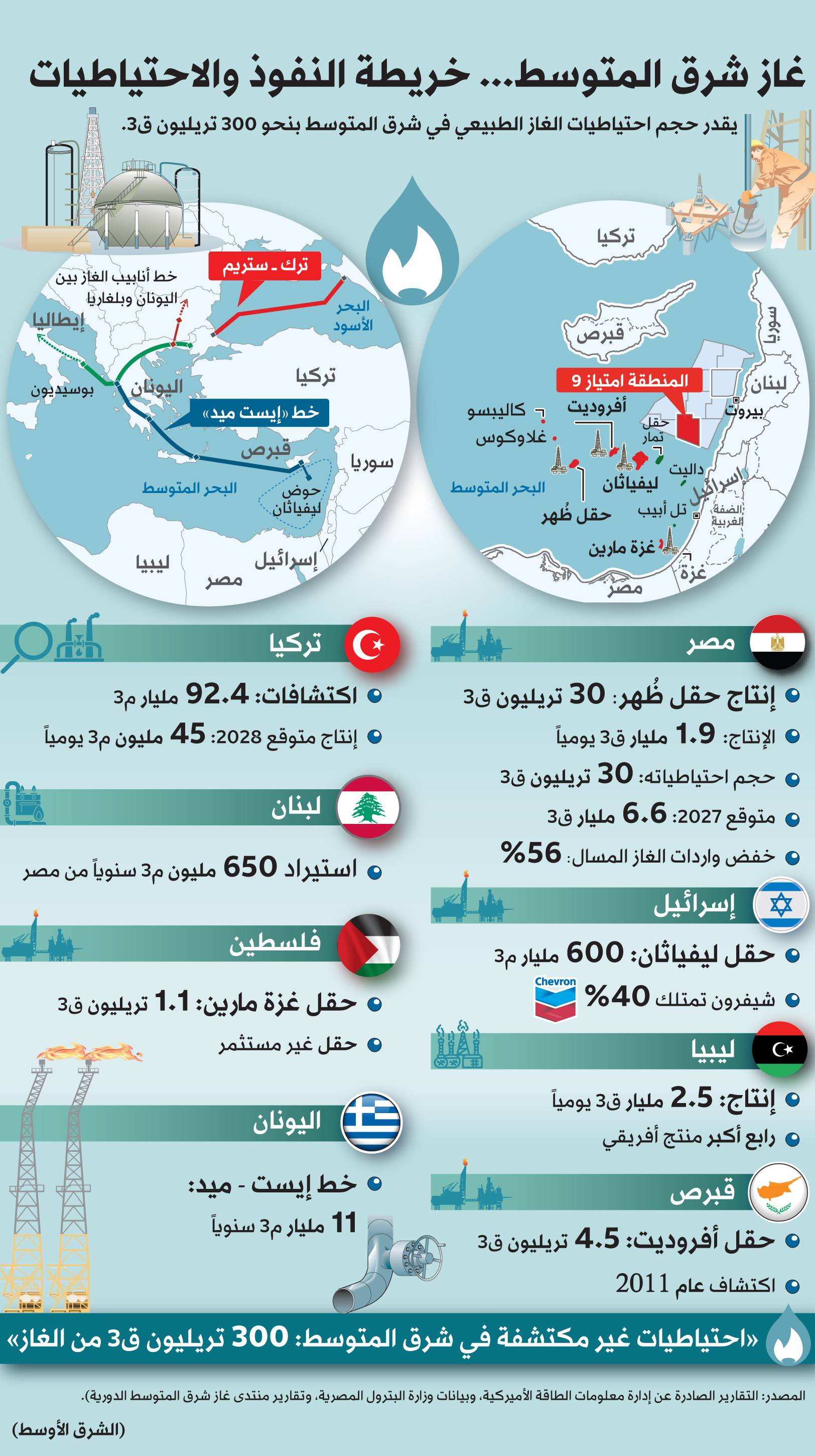بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي بالانتشار، وسمعنا عن الكثير من الشركات التي تضيف هذه التقنية إلى خدماتها وتقدم عناصر جديدة كان من الصعب تخيلها قبل بضع سنوات. ولكن ما الذكاء الاصطناعي؟ وما نظمه وما أحدث التطويرات في الأجهزة والبرامج الذكية؟
ماذا يعني الذكاء الاصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي هو عملية محاكاة نظم الكومبيوترات لعمليات الذكاء البشري بهدف تحقيق أمر ما. وكثيراً ما تروّج الشركات لخدماتها على أنها ذكاء صناعي، ولكن حقيقة الأمر أن الكثير من تلك الخدمات تستخدم عنصراً من التقنية، مثل «تعلم الآلة». ويتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي أساساً متقدماً من العتاد الصلب Hardware المتخصص، والبرمجيات المطورة خصيصاً لهذا الغرض. ولا توجد لغة برمجة متخصصة بهذه التقنية حتى الآن، ولكنّ عدداً من اللغات يقدم أدوات مفيدة لهذا الغرض، مثل Python وJava وR و«سي بلس بلس».
وتحتاج هذه النظم إلى تحليل كميات كبيرة جداً من بيانات التدريب وإيجاد روابط بين تلك البيانات واستخدامها لتوقع أمور مقبلة، مثل تحليل ملايين الصور لفهم ما الذي يميز الإنسان عن النبات عن الحيوان عن الجماد، وما الطبيعة؟ وما العائلة؟ وكيف يمكن تمييز الليل عن النهار والخيال عن الحقيقة؟ وأسلوب رسم فنان ما مقارنةً بآخر، وهكذا. وينطبق الأمر نفسه عند تحليل النصوص والموسيقى وعروض الفيديو، وغيرها، ليتكون لدينا نظم ذكاء صناعي مختلفة متخصصة في مجالات كثيرة، وفقاً للبيانات التي تم تحليلها.
مهارات برمجة الذكاء الاصطناعي
ويتم التركيز في برمجة الذكاء الاصطناعي على 4 مهارات، هي: التعلم والإدراك والتصحيح الذاتي والابتكار.
يركز جانب التعلم على الحصول على البيانات وإيجاد القوانين والروابط بينها وتحويلها إلى بيانات مفيدة. ويتم تقديم قوانين مختلفة على شكل خوارزميات Algorithm كثيرة (الخوارزمية هي نهج عمل برنامج ما لتحقيق الهدف المرغوب) حول كيفية إكمال مهمة محددة، مثل التعرف على وجود إنسان في صورة (يجب تحديد ما يصف شكل معظم البشر: العينان والفم والأنف والحاجبان والرقبة، وهكذا).
وبالنسبة إلى مهارة الإدراك، فإنها تركز على اختيار الخوارزمية الصحيحة بقوانينها المرتبطة لتحقيق الهدف المرغوب. أما التصحيح الذاتي، فتركز هذه المهارة على تعديل الخوارزميات وقوانينها بناءً على صحة المخرجات لإيجاد قوانين أكثر دقة من السابق، الأمر الذي ستنجم عنه نتائج صحيحة بنسبة أعلى في المرات المقبلة التي يعمل فيها ذلك النظام.
وتبقى المهارة الرابعة وهي الابتكار، التي تستخدم الشبكات العصبونية Neural Networks الرقمية والنظم المبنية على القوانين والبيانات الإحصائية وتقنيات أخرى بهدف إيجاد صور ونصوص وموسيقى وأفكار جديدة.
ولعلكم قد سمعتم عن بعض المفردات التقنية المتقاربة، مثل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وتعلم الآلة Machine Learning، والتعلم العميق Deep Learning.
تحتاج هذه النظم إلى تحليل كميات كبيرة جداً من بيانات التدريب وإيجاد روابط بين تلك البيانات واستخدامها لتوقع أمور مقبلة، مثل تحليل ملايين الصور لفهم ما الذي يميز الإنسان عن النبات عن الحيوان عن الجماد، وما الطبيعة؟ وما العائلة؟ وكيف يمكن تمييز الليل عن النهار والخيال عن الحقيقة؟
وبينما يعرَّف الذكاء الاصطناعي بأنه محاكاة الآلات للذكاء البشري لتحقيق هدف ما، فإن تعلم الآلة يعرَّف بأنه رفع دقة البرامج والتطبيقات في توقع النتائج بناءً على البيانات السابقة من دون برمجتها بشكل مباشر على كيفية القيام بذلك، حيث تتم هذه العملية من دون تدخل المبرمجين، ذلك أن النظام سيتعرف على الروابط بين البيانات ويستخدمها في التوقع. أما التعلم العميق، فهو جزء متخصص من تعلم الآلة مبنيٌّ على فهمنا لتركيبة الدماغ البشري. وبسبب استخدام التعلم العميق لبنية الشبكات العصبونية الرقمية أخيراً، تم إيجاد تقنيات حديثة مفيدة جداً للبشر، مثل القيادة الذاتية للسيارات وChatGPT.
أنواع الذكاء الاصطناعي
ويمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى فئتين: الضعيف والقوي، بحيث يُعرّف الذكاء الاصطناعي الضعيف Weak AI، أو الذكاء الاصطناعي ضيق النطاق Narrow AI، على أنه نظام يتم تدريبه لإكمال مهمة محددة، كالروبوتات الاصطناعية والمساعدات الذكية الشخصية، مثل «سيري» من «أبل». أما الفئة الثانية فهي أكثر شمولاً ويطلق عليها مصطلح الذكاء العام الاصطناعي Artificial General Intelligence AGI، وهي عبارة عن نظام يستطيع محاكاة القدرات الإدراكية للدماغ البشري. ويستطيع هذا النظام تحليل البيانات الموجودة أمامه في مهمة جديدة كلياً عليه لم يسبق برمجته على كيفية إكمالها، وتطبيق معرفته السابقة في مجال ما على آخر لإيجاد حل صحيح ومن دون أي تدخل خارجي.
استخدامات الذكاء الاصطناعي
ولكن ما أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا؟ في الواقع، استفدنا سابقاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في الكثير من جوانب الحياة؛ من نظم الكشف عن التحايل المالي والضريبي، وأتمتة العمليات اليومية البسيطة، وفي مراكز خدمة العملاء، وزيادة المبيعات وضبط جودة المنتجات. وتستطيع هذه التقنيات في بعض المجالات التفوق على الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور المتكررة أو التي تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، مثل تحليل كميات كبيرة من أوراق النماذج Form والتأكد من وجود بيانات صحيحة في حقول محددة.
ونظراً للقدرات الممتدة في إيجاد روابط بين البيانات الضخمة في أوقات قليلة، تستطيع هذه النظم تقديم معلومات غنية جداً لمديري الشركات لم يكن من الممكن لأي بشري إكمالها وإيجاد روابط بين الملايين من البيانات.

كما يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تطوير عملية التعليم والتسويق وتصميم المنتجات. وأصبحت هذه التقنية محوراً لتقدم الكثير من شركات التقنية الضخمة اليوم، مثل «ألفابيت Alphabet» المالكة لـ«غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، وغيرها.
ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات بهدف زيادة كمية وأنواع المهام المنوطة به، وتحليل الصور الطبية للمساعدة في التعرف على الأمراض المختلفة وفقاً لتاريخ مرضى سابقين وتطور مراحلهم، إلى جانب الاستخدامات العسكرية في المعارك الميدانية وتحليل نزعات تحرك المشاة والآليات وفقاً لعوامل البيئة والطقس والأعداد والوقت. كما يمكن استخدامه في برامج مكافحة الجرائم الرقمية والتعرف على الرسائل التصيّدية بناءً على نص الرسالة وعنوانها وعنوان الجهة المرسلة، أو ترجمة النصوص وتفريغ المحادثات الصوتية وتحويلها إلى نصوص، والتعرف على مشاعر الطرف الثاني في الرسائل الإلكترونية. ويتم استخدام هذه التقنيات حالياً في المجالات الاصطناعية ولتحريك عناصر ثقيلة جداً في مهمات المركبات الفضائية التي تستكشف الكواكب المختلفة، أو في المركبات ذاتية القيادة للتعرف على العقبات الموجودة أمام المركبة وتجاوزها من دون المخاطرة بحياة الركاب أو المشاة من حولها.
وأخيراً شهدنا انطلاق خدمات إيجاد المحتوى متعدد الوسائط بجودة عالية «الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI»، مثل النصوص والصور والفيديوهات والموسيقى بشكل غير محدود وبقدرات إبداعية غير مسبوقة، وبتكلفة منخفضة جداً. ويمكن إيجاد نصوص مسرحية وصور واقعية وكتابة عدد كبير من رسائل بريد إلكتروني من دون ملاحظة الطرف الآخر أن المرسل ليس من البشر، والكثير غيرها من الخدمات الأخرى.
كما يمكن استخدام هذه التقنيات في القطاع المصرفي لتحليل ما إذا كان يمكن للبنك تقديم قرض لشخص ما أو تحديد السقف المالي لبطاقة ائتمانية أو الفرص الاستثمارية، أو للمساعدة في تداول الأسهم. وتستطيع هذه التقنيات المساهمة في التنبؤ بحدوث تأخير في الرحلات الدولية حسب الحالة الجوية، أو زيادة أمن الشحن البحري حسب حالة الطقس والتيارات المائية، والتنبؤ بنزعات الشراء والطلب بناءً على عوامل كثيرة جداً، إلى جانب تقديم المحامين للمشورة القانونية وفقاً لقضايا سابقة بعد تحليل تفاصيل ونتائج أحكام الكثير من القضايا والملفات السابقة.
تطويرات وآفاق واعدة
وتطورت استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وتسارع ذلك التقدم بشكل ملحوظ. ويمكن العودة بالابتكارات النوعية لهذه التقنيات إلى عام 2012 خصوصاً شبكة «AlexNet» العصبونية التي رفعت من مستويات الأداء بشكل كبير بسبب اعتمادها على وحدات معالجة الرسومات فائقة الأداء لتحليل البيانات مقارنةً بالاعتماد على المعالجات التقليدية، وقدرة وحدات معالجة الرسومات على معالجة البيانات بالتوازي بكميات ضخمة وبسرعات كبيرة جداً.
وشكّل التعاون بين شركات البرمجة العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أوبين إيه آي OpenAI» من جهة، وشركات صناعة عتاد الكومبيوترات، مثل «إنفيديا Nvidia» المتخصصة في وحدات معالجة الرسومات فائقة الأداء، ومعالجات «إنتل» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، من جهة أخرى نواة لتشكيل قفزات متسارعة في خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي كان من آخرها «تشات جي بي تي ChatGPT». ومن أحدث الابتكارات في أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي تطوير «غوغل» ما تُعرف بـ«المحولات Transformers»، وهي آلية فائقة الأداء ترفع من سرعة تحليل البيانات الضخمة باستخدام مجموعات كبيرة من الكومبيوترات العادية التي تحتوي على وحدات معالجة الرسومات، الأمر الذي خفض من تكاليف تأسيس تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بشكل كبير.
وطوّرت شركة «إنفيديا» كفاءة معالجة البيانات بالتوازي Parallel Processing عبر نوى وحدات معالجة الرسومات GPU الخاصة بها بشكل كبير على مستوى الدارات الإلكترونية والبرمجيات في آن واحد، مما شكّل قفزة كبيرة سرّعت من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب سهولة تكامل تلك التطويرات في مراكز البيانات، والعمل مع مراكز الحوسبة السحابية لتقديم الأجهزة المتقدمة كخدمة لمن يريد، دون الحاجة لبناء مراكز متخصصة لكل شركة، وهو أمر من شأنه خفض تكاليف تبني هذه التقنية بشكل غير مسبوق.
واستطاعت هذه الشركات تطوير «محولات» توليدية مسبقة التدريب Generative Pre - trained Transformers GPT ومشاركتها مع الشركات الأخرى التي ترغب في تخصيص تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتدريب الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات وما يصاحب ذلك من وقت وتكاليف كبيرة. وتستطيع الشركات المتوسطة أو الصغيرة استخدام تلك النماذج العامة وتخصيصها حسب الحاجة لقاء بضع آلاف من الدولارات، مقارنةً بـ5 إلى 10 ملايين دولار للتدريب من نقطة الصفر. ويشكّل هذا الأمر قفزة كبيرة للشركات المتخصصة نحو مباشرة العمل وتقديم خدمات ثورية بسرعات كبيرة ومخاطر منخفضة.
ومن الأمثلة على خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي AWS AI Services وGoogle Cloud AI وMicrosoft Azure AI Platform وOracle Cloud Infrastructure AI Services، والتي تزيل عبء بناء مركز بيانات متخصص بالذكاء الاصطناعي، وتقدمه كخدمة لقاء اشتراك شهري أو سنوي منخفض التكلفة. هذا، وتقدم OpenAI وNVidia خدمات متخصصة لمستخدميها، مثل نماذج ذكاء صناعي متخصصة بالصور والدردشة النصية والطب وحتى البرمجة.
وتقدم OpenAI نظام ChatGPT للمحادثة أو الدردشة الذي انتشرت شعبيته بشكل كبير بين المستخدمين في آخر بضعة أشهر، وهي الشركة نفسها التي استثمرت بها «مايكروسوفت» بقيمة 10 مليارات دولار، والتي ستضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى متصفح «إيدج Edge» ومجموعة برامج «أوفيس» المكتبية وحتى نظام التشغيل «ويندوز» لتطوير تجربة الاستخدام بشكل مبهر جداً.
من جهتها كشفت «غوغل» عن نظام الذكاء الاصطناعي «بارد Bard» للدردشة المبنيّ على عائلة LaMDA للغات التطوير، والذي من المتوقع أن يساعد في أعمال ترجمة النصوص بين اللغات بدقة عالية جداً وكتابة المحتوى المبتكر والإجابة عن الأسئلة وكتابة النصوص البرمجية عبر أكثر من 20 لغة برمجة، وحتى إيجاد معادلات لجداول الحسابات لتحقيق هدف حسابي ما يريده المستخدم.
هذا، وكشفت «إنفيديا» عن نظام ذكاء صناعي يستطيع إيجاد فيديوهات واقعية للغاية بمجرد كتابة وصف لها، ليقوم النظام بتوليد تلك الفيديوهات بسرعة. ومن الممكن استخدام هذا النظام في شركات صناعة الفيديوهات أو حتى في استوديوهات المسلسلات والأفلام لإضافة العناصر الرقمية إلى المشاهد المختلفة، أو حتى استبدالها بأخرى بمجرد كتابة ذلك نصياً (مثل استبدال سيارة بأخرى أو وجه ممثل بآخر، وبسرعة ودقة كبيرتين).

أخلاقيات الاستخدام
مثلها مثل أي أداة في حياتنا، يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمنفعة أو لإلحاق الأذى، وينبغي إيجاد ضوابط لاستخدامها بشكل يعود بالخير على الجميع. وكما ذكرنا سابقاً، تعتمد هذه النظم على تحليل البيانات السابقة، أي إن نتائجها مرتبطة بتلك البيانات، الأمر الذي يعني أنه سيوجد تحيز إن كانت البيانات غير شاملة لجميع العوامل المرتبطة بالمسألة التي يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحلها، وتجب مراقبة جودة تلك البيانات التأسيسية لضمان وجود مخرجات صحيحة ومفيدة. يضاف إلى ذلك أن هذه النظم تقدم النتيجة دون ذكر كيفية الوصول إليها، ذلك أنها توجِد ترابطاً بين أعداد كبيرة من العوامل المختلفة للبيانات التي تقوم بتحليلها.
هذا الأمر قد لا يكون مفيداً في الكثير من الاستخدامات اليومية، مثل عدم القدرة على توضيح أسباب اتهام شخص بتجاوز قانوني ما، إذ لا يكفي القول إن النظام قد توصل لتلك النتيجة دون ذكر أسباب مقنعة لذلك، أو رفض مصرف طلب حصول عميل ما على بطاقة ائتمانية، مثلاً. وشهدنا نظماً تستطيع إيجاد صور وفيديوهات ملفقة باستخدام أوجه وأصوات أشخاص حقيقيين DeepFake، الأمر الذي سيصعّب على المستخدمين التأكد من صحة تلك الصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات، وقد يوقِع الضحايا في مشكلات كبيرة.
ويوجد الكثير من القوانين التي تحدّ من نوعية البيانات التي يمكن للشركات استخدامها، مثل القانون العام لحماية البيانات General Data Protection Regulation (GDPR)، (لائحة الاتحاد الأوروبي التي تنص على كيفية التعامل مع البيانات الشخصية)، الأمر الذي سيشكل عقبة أمام القدرة على استخدام البيانات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد يشكّل في النهاية، إلى جانب قوانين دولية أخرى، عقبة أمام تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإيجاد بيانات تأسيسية شمولية وأكثر دقة للحصول على نتائج صحيحة. كما ستشكل مسائل حقوق الملكية الفكرية عقبة كبيرة أمام تقدم هذه التقنيات، حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي محاكاة أسلوب رسم أو كتابة شخص ما، أو يمكن إيجاد موسيقى مشابهة جداً لأسلوب فرقة أو مغنٍّ ما وبيع تلك النتائج وجني المال.
أمر آخر لافت للانتباه هو الاستخدامات الخبيثة لهذه التقنية، حيث يمكن لمجموعة من القراصنة استخدامها للتعرف على الثغرات الموجودة في موقع حكومي أو تابع لشركة ما واختراق ذلك الموقع والدخول إلى الأجهزة الخادمة وسرقة البيانات أو جعلها رهينة لقاء فدية مالية.

نظرة «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي: نقلة نوعية... بضوابط
تحدثت «الشرق الأوسط» مع فريق عمل «مايكروسوفت» الذي أكد أن للذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في حل التحديات الاقتصادية المعقدة، وإحداث نقلة نوعية للكثير من الأعمال، وتحسين أداء المؤسسات وتجربة العملاء، وتطوير إمكانات التنبؤ والتخطيط، وذلك للمساعدة في تحسين وتعزيز حياة فئات المجتمع كافة.
وأسهم الذكاء الاصطناعي في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات على إيجاد حلول للتحديات الملحّة وابتكار طرق جديدة لتحسين سير أعمالها، ومنها الطاقة، حيث يرسم الذكاء الصناعي مستقبل هذا القطاع. وتسعى وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية إلى توظيف الذكاء الصناعي في إدارة استهلاك الطاقة والتنبؤ بها، لتلبية طلبات الاستهلاك، وكذلك لتحديد أنماط جمع مزيج الطاقة وإدارتها وتشغيلها بما يسهم في جعلها أكثر كفاءة وأماناً.وعقدت «مايكروسوفت» في عام 2019 شراكة مع «أوبين إيه آي OpenAI»، وهو مختبر الأبحاث الذي يقف خلف برامج الدردشة «تشات بوت» و«تشات جي بي تي ChatGPT»، وكذلك مُنشئ الصور «دال - إي 2 Dall - E2» الذي يُحول النصوص الوصفية إلى صور جديدة.
ونتج عن هذه الشراكة خدمة «أزور أوبن إيه آي سيرفيس Azure OpenAI Service» الجديدة التي توفر عدداً من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل إصدارات مطورة من متصفح «إيدج» ونظام البحث «بينغ» اللذين يعملان معاً مساعدين شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. وتجاوز عدد المستخدمين لهذه التقنية 100 مليون مستخدم نشط يومياً على «بينغ» بحلول أوائل شهر مارس (آذار) الماضي. ونذكر كذلك أداة «بينغ إميج كرييتور Bing Image Creator» الجديدة التي تسمح لمستخدمي بحث «بينغ» الجديد المزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي «Bing Chat» أو متصفح «إيدج» بإنشاء صور مبتكرة بمختلف أنواعها من خلال نصوص وصفية.وأطلقت الشركة المرشد المساعد «مايكروسوفت 365 كوبايلوت Microsoft 365 Copilot» الذكي لمستخدمي تطبيقات «مايكروسوفت 365» المكتبية بهدف مساعدة المستخدمين في إنتاج المحتوى، سواء كان رسائل بريد إلكتروني أم إنشاء الوثائق أم العروض التقديمية أم تلخيص المحتوى والرسائل وتحليل البيانات وجداول الحسابات، وغيرها. يضاف إلى ذلك «المرشد المساعد للنصوص البرمجية GitHub Copilot» الذي يتيح إمكانية كتابة النص البرمجي مباشرةً من خلال الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لوحة المفاتيح.
وأشار الفريق أيضاً إلى استفادة قطاع آخر من هذه التقنية هو الرعاية الصحية، حيث يمكن تشخيص الأمراض وفحص أعداد كبيرة من المرضى في وقت قصير بفضل الذكاء الاصطناعي. وأسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى التشخيص المبكر واكتشاف الأمراض في أولى مراحلها، وربما قبل حدوثها أو انتشارها. ونذكر كذلك الخدمات المالية، حيث أحدث الذكاء الاصطناعي موجات تغيير واسعة في قطاع الخدمات المالية وتم استخدام روبوتات الدردشة «Chatbots» لخدمة العملاء.
كما أسهم الذكاء الاصطناعي في مساعدة المعلمين والمحاضرين من خلال تحريرهم من الأعمال المكتبية وتمكينهم من أتمتة العمليات اليدوية، مثل تصحيح الامتحانات وتقييم الواجبات. كما يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى التعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في أي وقت وفي أي مكان، ودون تكبد المزيد من النفقات.ويرى الفريق أن الحقبة التالية من الذكاء الاصطناعي (نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة) ستساعد في مهام كثيرة، مثل تلخيص المحتوى وإدارة المستندات وتبسيط تدفقات المبيعات، ويمكن أن تمتد إلى مجالات كثيرة مثل تصميم جزيئات جديدة للأدوية أو إنشاء نصوص أو صور أو موسيقى أو محادثات أو رموز أو فيديوهات تحاكي إنتاج البشر. وتستخدم اليوم أكثر من 85% من شركات قائمة «Fortune 100» أدوات «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي.
وترى «مايكروسوفت» أنه من المهم جداً أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة. ولذلك، فقد تم تصميم سياسات ولوائح «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي بطريقة تراعي وتتماشى مع الأطر التنظيمية للاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
نظرة «غوغل» للذكاء الاصطناعي
يرى فريق «غوغل» أن مستقبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات اليومية كبير، لأنها تجعلها أكثر فائدة حول العالم، سواء كانت لمساعدة الأطباء في التعرف على الأمراض بشكل أسرع أو السماح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات بلغاتهم الأم لإطلاق العنان لإبداعاتهم، وفتح فرص جديدة من شأنها تغيير حياة الملايين.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع فريق «غوغل»، أشار إلى أن هذه التقنية ستعالج التحديات المجتمعية التي تشمل الأزمة المناخية والتنبيه إلى الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات) والمساهمة في الوصول إلى اكتشافات علمية جديدة، وحتى رفع المستويات الصحية للمستخدمين.
ومن الأمثلة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجات «غوغل» القدرة على البحث عن المعلومة باستخدام الصور أو صوت المستخدم، حيث تقوم النظم بتحليل الصوت والبحث عن أغنية مشابهة للحن الذي سجله المستخدم، أو تحليل صورة ما لإيجاد عناصر مشابهة لها. كما يمكن استخدام هذه الآليات إلى جانب كتابة النصوص إليها للبحث من خلال تطبيق «غوغل»، مثل كتابة «ملابس» وتصوير ورق الجدران أمام المستخدم، ليعثر محرك البحث على ملابس تحتوي على نمط مشابه لذلك الموجود في ورق الجدران الذي تم تصويره. كما تحلل تقنيات الذكاء الاصطناعي بيانات الخرائط وتقدم معلومات مفيدة للمستخدمين حول حالة الازدحام وساعات عمل المتاجر والسرعات المسموحة في الطرق المختلفة، وبشكل آلي. هذا، وتستطيع نظم الذكاء الاصطناعي تحليل محتوى الصور الموجودة في جهازه والسماح للمستخدم كتابة عبارة تصف عنصراً ما، لتعرض جميع الصور، التي تحتوي على ذلك العنصر.
إلا أن الفريق أشار إلى ضرورة استكشاف القدرات الكامنة لهذه التقنية ونتائجها الإيجابية والسلبية التي تتقاطع مع التجارب البشرية. ويجب التركيز على العوامل الأخلاقية للاستخدام، الأمر الذي كشفت عنه «غوغل» في مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والاستخدامات المفصلة حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، والعمليات الحكومية لتطبيقها، وهي جميعاً عوامل تُوَجِّه جهود «غوغل» في الذكاء الاصطناعي.
الجدير ذكره أن «غوغل» أطلقت نظام «بارد» Bard للذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI بشكل تجريبي للسماح للمستخدمين البحث عن المعلومات بطرق مبتكرة وغير تقليدية مقارنة بالبحث التقليدي. وترى الشركة أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية أساسية وتحويلية ستقدم مزايا مساعدة عديدة للأفراد والمجتمعات من خلال قدرتها على تمكينهم وإلهامهم في جميع المجالات، ولديها القدرة في المساهمة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه البشرية. وتؤمن «غوغل» أنه يجب تقديم حلول صحيحة من خلال التعاون جماعياً بين الحكومات والباحثين والمطورين والأفراد والشركات والمنظمات والجهات المشرعة بهدف الحصول على ثقة العموم.