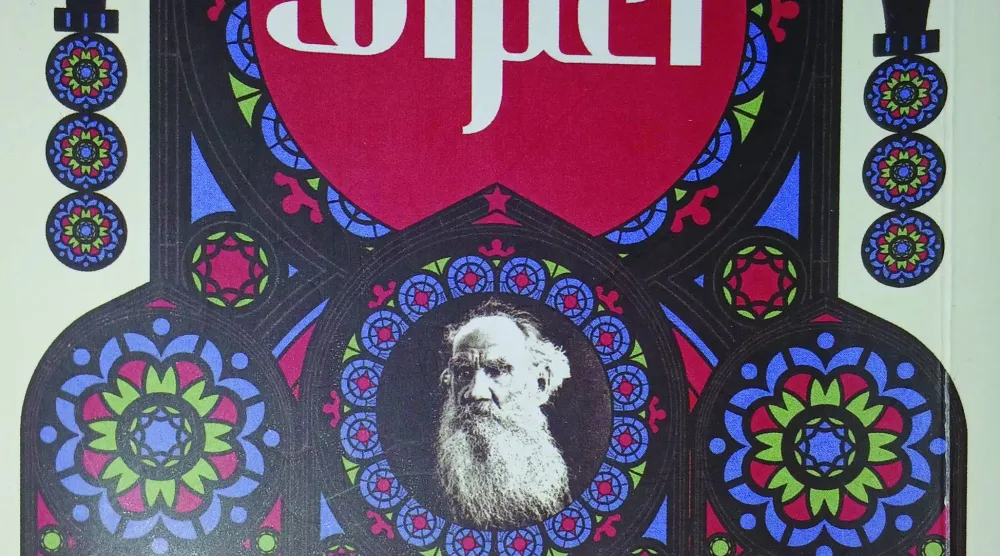لأم كلثوم أغنية من تأليف أحمد رامي وتلحين محمد القصبجي عنوانها «سكت والدمع تكلّم على هواه»، تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، فهي ليست إذن مما طربَ عليه أبناء جيلي، وعندما سمعتها لم تصمد معي أكثر من دقيقة، بسبب إيقاعها البطيء والرتيب، لكني قرأتُ عنها وأكاد أقول حفظتُ كلماتها في قصّة قصيرة لفؤاد التكرلي هي «الأغنية الأخرى»، ضمن مجموعته القصصيّة «حديث الأشجار»:
«سكت والدمع تكلّم على هواه/ والقلب ياما بيتألّم/ تنزل دموعي على خدودي/ وأقول لها دموعي شهودي... ما تصدّق...».
في «لسان العرب» البكاء ربما كان بصوت أو من دونه، فإذا كان بصوت فهو نحيب، والنشيج مثل النحيب، وقيل هو أشدّه، وشهقت الفتاة إذا ردّدت البكاء في صدرها، فإذا صار صوت النحيب أو النشيج صياحاً فهو عويل، وأجهشت فلانة: تهيّأت للبكاء، وتهمّعت: بكت أو تباكت.
في قصّة فؤاد التكرلي تُقرّر الدموع الصامتة مصيرَ بطلة القصّة، عندما ترفض الزواج من شابّ ثري تقدّم لخطبتها، وتُفضّل عليه حبيبها رغم أنه فقير أو معدم، لكنها تحبّه، وهي المسألة الأهمّ. ندعو في العراق الدموع الصامتة أو الساكتة: «بكاء الشموع»، نوع من بلاغة سامية يلجأ إليها الإنسان في حالات القهر الشديد، وجاءت الاستعارة من أغنية «يبنادم» (يا بني آدم) للمغنّي حسين نعمة: «بجي (بكاء) الشموع الروح/ بس (فقط) دمع ما مش (من دون) صوت/ رَبطَة جِنِحْ مكسور/ قلبي يرفّ بَسْكوتْ (أي من غير صوت)».

دموع الفتاة في القصة هي كلامها، وقد صارت شمعة تذوب من فرط الألم والحزن، وكانت تحاول أن تستحضر حبيبها الغائب في جلسة الخطوبة، بواسطة همس يقع في آخر درجات الصمت، كي يراه أهلها وخطيبها ويتركون الاثنين في حالهما. يقول الشاعر الألماني شليغل: «الكلمات! ما هي؟/ دمعة واحدة ستقول أكثر منها جميعاً»، وبالفعل أدّت دموع الفتاة ما يعادل أطناناً من الكلام، لأن الخطوبة فشلت، وعادت الحبيبة إلى حبيبها.
بالنسبة إلى صموئيل بيكيت، يجري الأمر بالعكس بقدر مماثل، فهو يقول: «كلماتي هي دموعي»، أما نيتشه فهو يرى أنه «لا يستطيع التفريق بين الدموع والموسيقى»، رغم أن ليست هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأيي، بين الاثنين. اقتبسَ فكرة نيتشه الملتبسة الشاعر سيوران، وكتب قائلاً: «الدموع هي الموسيقى في شكل ماديّ».
في الأساطير الكنعانيّة والرافدينيّة والمصريّة تكوّن الدموع مفصلاً مهمّاً من العقيدة الدينيّة، فالبكاء والنشيج والعويل واجب على الجميع، لأنّه سوف يؤدي إلى بعث الإله الميّت. تبكي عشتار تموز في سبيل إعادته إلى الحياة، وتبكي عنات أخاها بعل، ومثلها تفعل الإلهة إيزيس مع أخيها أوزوريس، وربما كان لمراسيم عاشوراء لدى الشيعة علاقة بهذه الطقوس، فهم يبكون الحسين بن علي بن أبي طالب إحياءً لذكراه في كلّ عام.
عندما تسأل القاموس عن مرادف لكلمة دمعة ودموع يأتيك الجواب فراغاً على الورقة أو على شاشة الحاسوب. ليست هناك كلمة قريبة غير العَبْرة، وهي الدمعة قبل أن تفيض، والرقراق هو الدمع الذي يغمر العين ولا يسيل. لا شبيه للدموع لأن أصلها واحد رغم أن معانيها متعدّدة. يقول الشاعر الإنجليزي وليم بليك: «فرط الحزن يُضحك، وفرط الفرح يُبكي»، والاثنان تصاحبهما العَبرات أو الدموع، لكن بكاء الشموع، أيْ كلامها البليغ والمعبّر والصامت، اختُصّت به المرأة عندما يأكل قلبها اليأس، لعلّه ينقذها ويعالج قلبها المكلوم من الألم والحزن.
يتألف «نصب الحريّة» للنحّات جواد سليم الذي يتوسّط ساحة التحرير في بغداد من أربع عشرة منحوتة من البرونز، تتوزّع على جداريّة طولها خمسون متراً وترتفع عن الأرض ثمانية أمتار، فهو إذن من أكبر النصب في العالم. إحدى وحداته اسمها «الشهيد»، وفيها رجل ساقط كأنما من شاهق، ذراعاه ووجهه يتجّه إلى الأرض، أُمّه تحضن صدره بقوّة وتَعول، وتجلس قربها فتاتان إحداهما ترتدي عباءة سوداء هي الأخت أو الزوجة، تبكي بصمت رمادي ويداها على الوجنتين لصدّ سيل الدموع الجارية. هو بكاء الشموع إذن أو كلامها باللسان العراقي المبين. في المشهد تجسيد للوخز القلبي الذي يطبع حالة الحزن، وقد أعطاه النحّات موقع المركز في النصب. ثمّة ما يُثير بعض الاضطراب في حركة الساقين المعلّقتين في الهواء باتجاه السماء، كما أن هناك قوة روحيّة عميقة في ثبات يدَي الفتاة على الوجنتين، ومبتكرتها هي المرأة العراقيّة. في ظروف فجائيّة ووحي مصادف عبّرت هكذا عن يقظتها الأوليّة وخوفها من الألم والموت، ونقل الفنان عنها هذه اليقظة. إن مهمّته تتلخّص في حمل الخوف من داخلنا إلى الخارج، حيث الضوء، من أجل خلاصنا، وقد نجح جواد سليم في أدائه هذه المهمّة بصورة باهرة. أمام أحد وجوه النساء وبكائها الصامت ينقل النحّات في دفتر مذكراته هذا البيت الشعري لإيليوت:
«ما هذا الوجه/ أشدّ وضوحا وأقلّ وضوحا...».
الشعر مدوّن بالإنجليزيّة، ونقله إلى العربيّة محرّر المذكرات وناشرها، وهو جبرا إبراهيم جبرا في كتابه «جواد سليم ونصب الحريّة». الدموع الصامتة عندما تبلّل الخدّ المسفوع تُزيدُ من وضوح ملامحه، حين تشوّهها أو تطمسها. وجوهنا ليست ذاتها في كلّ وقت، وهي لمسة الفنّ التي ترسم انعكاسات السماء عليها فتظهر على حقيقتها. وفق القاعدة الفنية التي أتانا بها الشاعر محمود البريكان: «الفقدان يكون أجمل حين تُصاغ المراثي»، فإن مشهد اليدين على وجنتي الأخت الباكية غدا أغنية رقيقة بموسيقى هادئة تشدو المرأة فيها بحزنها، وبهذه الطريقة ضَمِن جواد سليم أنْ لا أحد يملّ من تأمّل نصب الحريّة، لأن قصّة الشهيد تتوسّطه فهي مركز الثقل الإبداعي للنصب، أو ما يُدعى مصدر اللذّة الإبداعيّة. ويُلاحظُ المتتبّعُ للتخطيطات «الاسكتشات» في المذكرات أن الفنّان أعاد هذا المشهد في صفحات عديدة، كأنه صار بصمة أو إشارة جوهريّة لا يمكن الاستغناء عنها في التعبير عن المرأة البغداديّة. هل كانت نبوءة أن شدائدَ قادمة وكوارث سوف تقع في البلاد في العقود القادمة؟
أكان يجب أن يطول هذا العذاب إلى ما لا نهاية... أعني أن يتحوّل العراق إلى غرفة فارغة لا شيء فيها سوى الحزن؟
شهد أبناء جيلي حفلات إعدام السجناء السياسيين في الساحات من سلطة حزب البعث الذي حكم العراق بين 1968 و2003، وكانت قوات الشرطة تشترط على الأهالي عدم إقامة مراسم العزاء، وإلا تعرّضوا للسجن أو الترحيل ومصادرة الأملاك. لنا أن نتخيّل صورة بيت الفقيد من الداخل، والنساء فيه يذبن مثل الشموع من فرط الحزن. كما أن فصيلة من المخبرين ينتشرون في كلّ مكان، ويدوّنون (التقارير)، أي ملاحظاتهم المكتوبة يرفعونها إلى السلطات، فلا يحقّ للأم والأخت والزوجة النحيب أو النشيج والعويل، والمسموح هو «بجي (بالجيم المعطّشة أو المثلثة) الشموع الروح/ بس دمع ما مش صوت».
الحزن الذي يصاحب البكاء الصامت يكون أكثر قوّة، وبالتالي أذى، وهو السبب الذي يدفع الجلّاد في طلبه، لكي يُنزل بالضحيّة عذاباً أكبر. علي عيدان عبد الله شاعرٌ مغمور، رغم أنه أوّل من كتب قصيدة النثر في العراق. في إحدى قصائده تصوير لحالات الإعدام الجماعي رمياً بالرصاص، وكانت تتمّ في الساحات وأمام جمهور من الناس، من بينهم أقارب الضحايا. أنقل لكم قصيدة الشاعر كاملة لأنها تختصر كلّ ما قلته. عنوانها «آباء لا يموتون»:
«لم يكتفِ قادة الحملة بتقييد الرجال في صفّ واحد فحسب، ولكنهم حشّدوا أطفالهم ليجبروهم على التصفيق مع كلّ رشّة رصاص تطيح بآبائهم الموقوفين أمامهم مكتوفي الأيدي،
لكننا حين كبرنا
وأدركنا حقيقة ما جرى
قرّرنا أن نكون آباءً
لآبائنا الأجلّاء
أولئك الذين لا يموتون
والذين نكرّمهم كآلهة في أرضنا».
لم نعثر خلال دراستنا فيما يُدعى «علم اجتماع الدموع» على ذِكر للبكاء الصامت في تاريخ العراق القديم والوسيط، أي إنه خاصٌّ بعصرنا الحديث. حين تبكي العيون مثل الشموع التي يركض فيها الصمت لكي تذوب، تتمنّى صاحبة القلب الضعيف الممرور الشفاء ولو عن طريق الموت. أكان يجب أن يطول هذا العذاب إلى ما لا نهاية، أعني أن يتحوّل العراق إلى غرفة فارغة لا شيء فيها سوى الحزن؟
عندما يتوقف الحاكم عن التمسّك بأدنى حالات الإنسانيّة يُصاب بحالة انفعال شديدة تشبه الخبال، تؤدي به إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. هل كان بقاء حزب البعث في السلطة في العراق نحو أربعة عقود دليلاً على سخط الربّ علينا وعقوبته لأننا اعتقدنا في أحد الأزمان أن الخير في بلادنا لا ينتهي؟ سورة النحل، آية 112: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَة كَانَتْ آمِنَة مُّطْمَئِنَّة يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ).