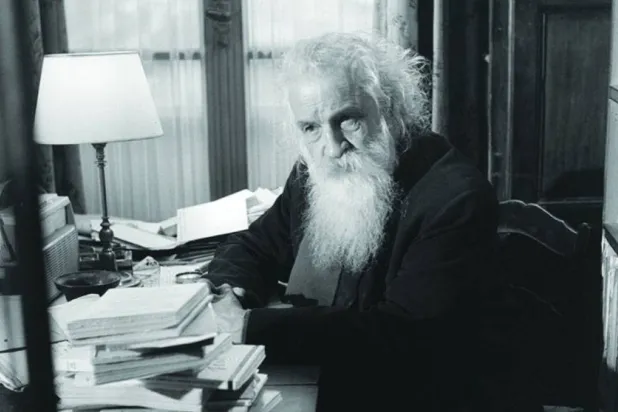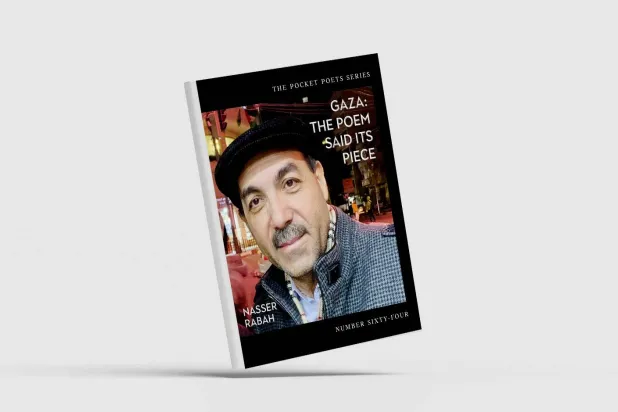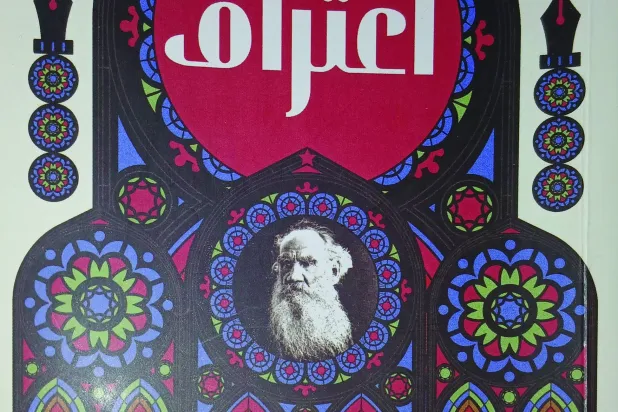أربعة أيام في محبة الشعر، شارك فيها نحو 40 شاعراً ومجموعة من النقاد والباحثين، في الدورة التاسعة لمهرجان الشعر العربي، الذي يقيمه بيت الشعر بالأقصر، تحت رعاية الشيح سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، وبالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ودائرة الثقافة بالشارقة، وبحضور رئيسها الشاعر عبد الله العويس، ومحمد القصير مدير إدارة الشئون الثقافية بالدائرة.
نجح المؤتمر في أن يصنع فضاء شعرياً متنوعاً وحميمياً، على طاولته التقت أشكال وأصوات شعرية مختلفة، فكان لافتاً أن يتجاور في الأمسيات الشعرية الشعر العمودي التقليدي مع شعر التفعيلة وقصيدة النثر وشعر العامية، وأن يتبارى الجميع بصيغ جمالية عدة، وتنويع تدفقها وطرائق تشكلها على مستويي الشكل والمضمون؛ إعلاء من قيمة الشعر بوصفه فن الحياة الأول وحارس ذاكرتها وروحها.
لقد ارتفع الشعر فوق التضاد، وحفظ لكل شكلٍ ما يميزه ويخصه، فتآلف المتلقي مع الإيقاع الصاخب والنبرة الخطابية المباشرة التي سادت أغلب قصائد الشعر العمودي، وفي الوقت نفسه كان ثمة تآلف مع حالة التوتر والقلق الوجودي التي سادت أيضاً أغلب قصائد شعر التفعيلة والنثر، وهو قلق مفتوح على الذات الشعرية، والتي تبدو بمثابة مرآة تنعكس عليها مشاعرها وانفعالاتها بالأشياء، ورؤيتها للعالم والواقع المعيش.
وحرص المهرجان على تقديم مجموعة من الشاعرات والشعراء الشباب، وأعطاهم مساحة رحبة في الحضور والمشاركة بجوار الشعراء المخضرمين، وكشف معظمهم عن موهبة مبشّرة وهمٍّ حقيقي بالشعر. وهو الهدف الذي أشار إليه رئيس المهرجان ومدير بيت الشعر بالأقصر، الشاعر حسين القباحي، في حفل الافتتاح، مؤكداً أن اكتشاف هؤلاء الشعراء يمثل أملاً وحلماً جميلاً، يأتي في صدارة استراتيجية بيت الشعر، وأن تقديمهم في المهرجان بمثابة تتويج لهذا الاكتشاف.
واستعرض القباحي حصاد الدورات الثماني السابقة للمهرجان، ما حققته وما واجهها من عثرات، وتحدّث عن الموقع الإلكتروني الجديد للبيت، مشيراً إلى أن الموقع جرى تحديثه وتطويره بشكل عملي، وأصبح من السهولة مطالعة كثير من الفعاليات والأنشطة المستمرة على مدار العام، مؤكداً أن الموقع في طرحه الحديث يُسهّل على المستخدمين الحصول على المعلومة المراد البحث عنها، ولا سيما فيما يتعلق بالأمسيات والنصوص الشعرية. وناشد القباحي الشعراء المشاركين في المهرجان بضرورة إرسال نصوصهم لتحميلها على الموقع، مشدداً على أن حضورهم سيثري الموقع ويشكل عتبة مهمة للحوار البنّاء.
وتحت عنوان «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة»، جاءت الجلسة النقدية المصاحبة للمهرجان بمثابة مباراة شيقة في الدرس المنهجي للشعر والإطلالة عليه من زوايا ورؤى جمالية وفكرية متنوعة، بمشاركة أربعة من النقاد الأكاديميين هم: الدكتور حسين حمودة، والدكتورة كاميليا عبد الفتاح، والدكتور محمد سليم شوشة، والدكتورة نانسي إبراهيم، وأدارها الدكتور محمد النوبي. شهدت الجلسة تفاعلاً حياً من الحضور، برز في بعض التعليقات حول فكرة التلاقي نفسها، وشكل العلاقة التي تنتجها، وهل هي علاقة طارئة عابرة أم حوار ممتد، يلعب على جدلية (الاتصال / الانفصال) بمعناها الأدبي؛ اتصال السرد والمسرح والدراما وارتباطها بالشعر من جانب، كذلك الفن التشكيلي والسينما وإيقاع المشهد واللقطة، والموسيقي، وخاصة مع كثرة وسائط التعبير والمستجدّات المعاصرة التي طرأت على الكتابة الشعرية، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والذي أصبح يعزز قوة الذكاء الاصطناعي، ويهدد ذاتية الإبداع الأدبي والشعري من جانب آخر.
وأشارت الدكتورة نانسي إبراهيم إلى أن الدراما الشعرية تتعدى فكرة الحكاية التقليدية البسيطة، وأصبحت تتجه نحو الدراما المسرحية بكل عناصرها المستحدثة لتخاطب القارئ على مستويين بمزج جنسين أدبيين الشعر والمسرح، حيث تتخطى فكرة «المكان» بوصفه خلفية للأحداث، ليصبح جزءاً من الفعل الشعري، مضيفاً بُعداً وظيفياً ديناميكياً للنص الشعري.
وطرح الدكتور محمد شوشة، من خلال التفاعل مع نص للشاعر صلاح اللقاني، تصوراً حول الدوافع والمنابع الأولى لامتزاج الفنون الأدبية وتداخلها، محاولاً مقاربة سؤال مركزي عن تشكّل هذه الظاهرة ودوافعها ومحركاتها العميقة، مؤكداً أنها ترتبط بمراحل اللاوعي الأدبي، والعقل الباطن أكثر من كونها اختياراً أو قصداً لأسلوب فني، وحاول، من خلال الورقة التي أَعدَّها، مقاربة هذه الظاهرة في أبعادها النفسية وجذورها الذهنية، في إطار طرح المدرسة الإدراكية في النقد الأدبي، وتصوراتها عن جذور اللغة عند الإنسان وطريقة عمل الذهن، كما حاول الباحث أن يقدم استبصاراً أعمق بما يحدث في عملية الإبداع الشعري وما وراءها من إجراءات كامنة في الذهن البشري.
وركز الدكتور حسين حمودة، في مداخلته، على التمثيل بتجربة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، ومن خلال هذا التمثيل، في قصائد درويش رأى أنها تعبّر عن ثلاثة أطوار مرّ بها شعره، مشيراً إلى أن ظاهرة «الأنواع الأدبية في الشعر» يمكن أن تتنوع على مستوى درجة حضورها، وعلى مستوى ملامحها الجمالية، عند شاعر واحد، عبر مراحل المسيرة التي قطعها، موضحاً: «مما يعني، ضِمناً، أن هذه الظاهرة قابلة لأن تتنوع وتتباين معالمها من شاعر لآخر، وربما من قصيدة لأخرى».
ورصدت الدكتورة كاميليا عبد الفتاح فكرة تلاقي الأجناس الأدبية تاريخياً، وأشارت، من خلال الاستعانة بسِجلّ تاريخ الأدب العربي، إلى أن حدوث ظاهرة التداخل بين الشعر وجنس القصة وقع منذ العصر الجاهلي، بما تشهد به المعلقات التي تميزت بثرائها الأسلوبي «في مجال السردية الشعرية». ولفتت إلى أن هذا التداخل طال القصيدة العربية المعاصرة في اتجاهيها الواقعي والحداثي، مبررة ذلك «بأن الشعراء وجدوا في البنية القصصية المساحة الكافية لاستيعاب خبراتهم الإنسانية». واستندت الدكتورة كاميليا، في مجال التطبيق، إلى إحدى قصائد الشاعر أمل دنقل، القائمة على تعدد الأصوات بين الذات الشعرية والجوقة، ما يشي بسردية الحكاية في بناء الحدث وتناميه شعرياً على مستويي المكان والزمان.
شهد المهرجان حفل توقيع ستة دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة للشعراء: أحمد عايد، ومصطفى جوهر، وشمس المولى، ومصطفى أبو هلال، وطارق محمود، ومحمد طايل، ولعب تنوع أمكنة انعقاد الندوات الشعرية دوراً مهماً في جذب الجمهور للشعر وإكسابه أرضاً جديدة، فعُقدت الندوات بكلية الفنون الجميلة في الأقصر، مصاحبة لافتتاح معرض تشكيلي حاشد بعنوان «خيوط الظل»، شارك فيه خمسون طالباً وطالبة. وكشف المعرض عن مواهب واعدة لكثيرين منهم، وكان لافتاً أيضاً اسم «الأصبوحة الشعرية» الذي أطلقه المهرجان على الندوات الشعرية التي تقام في الفترة الصباحية، ومنها ندوة بمزرعة ريفية شديدة البساطة والجمال، وجاءت أمسية حفل ختام المهرجان في أحضان معبد الأقصر وحضارة الأجداد، والتي امتزج فيها الشعر بالأغنيات الوطنية الراسخة، أداها بعذوبة وحماس كوكبة من المطربين والمطربات الشباب؛ تتويجاً لعرس شعري امتزجت فيه، على مدار أربعة أيام، محبة الشعر بمحبة الحياة.