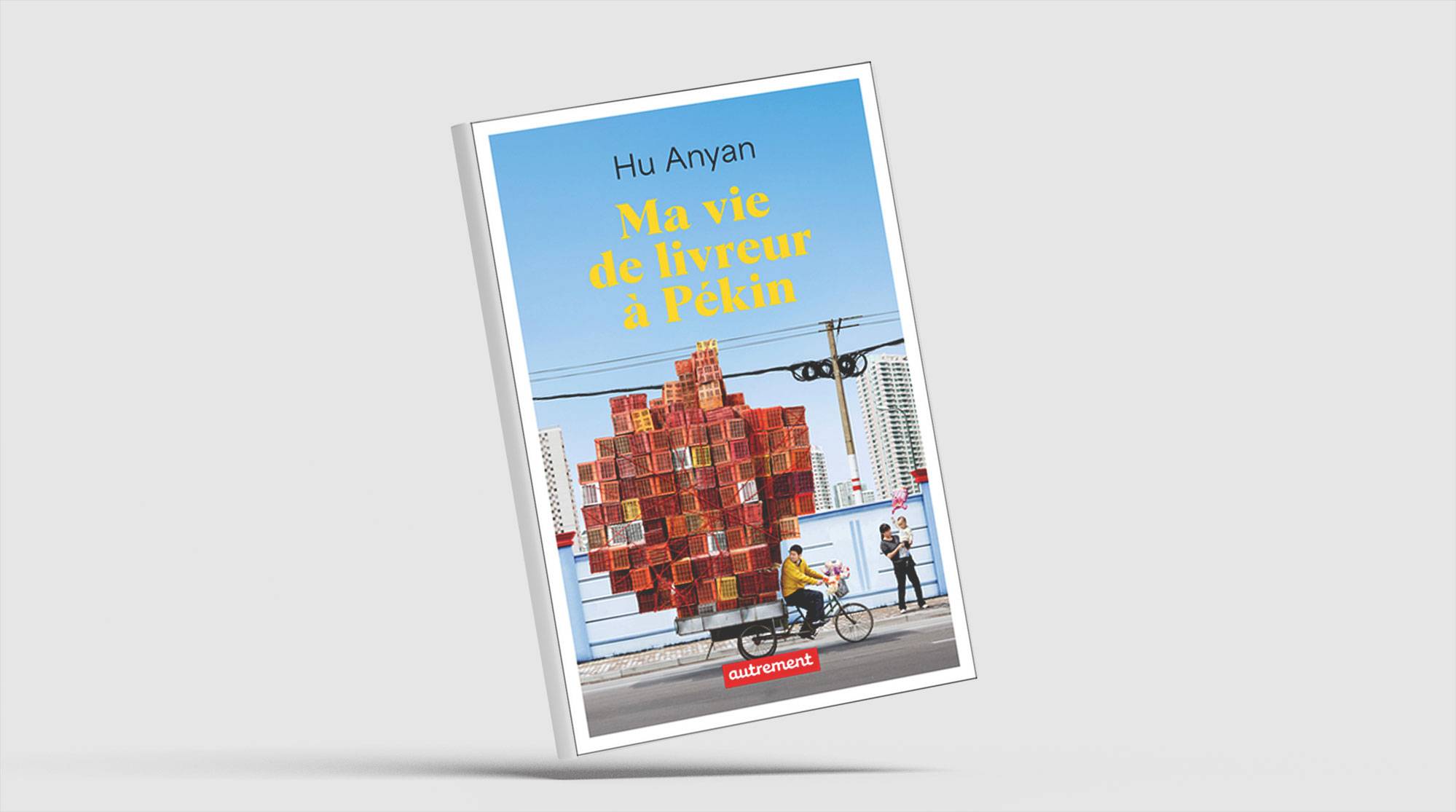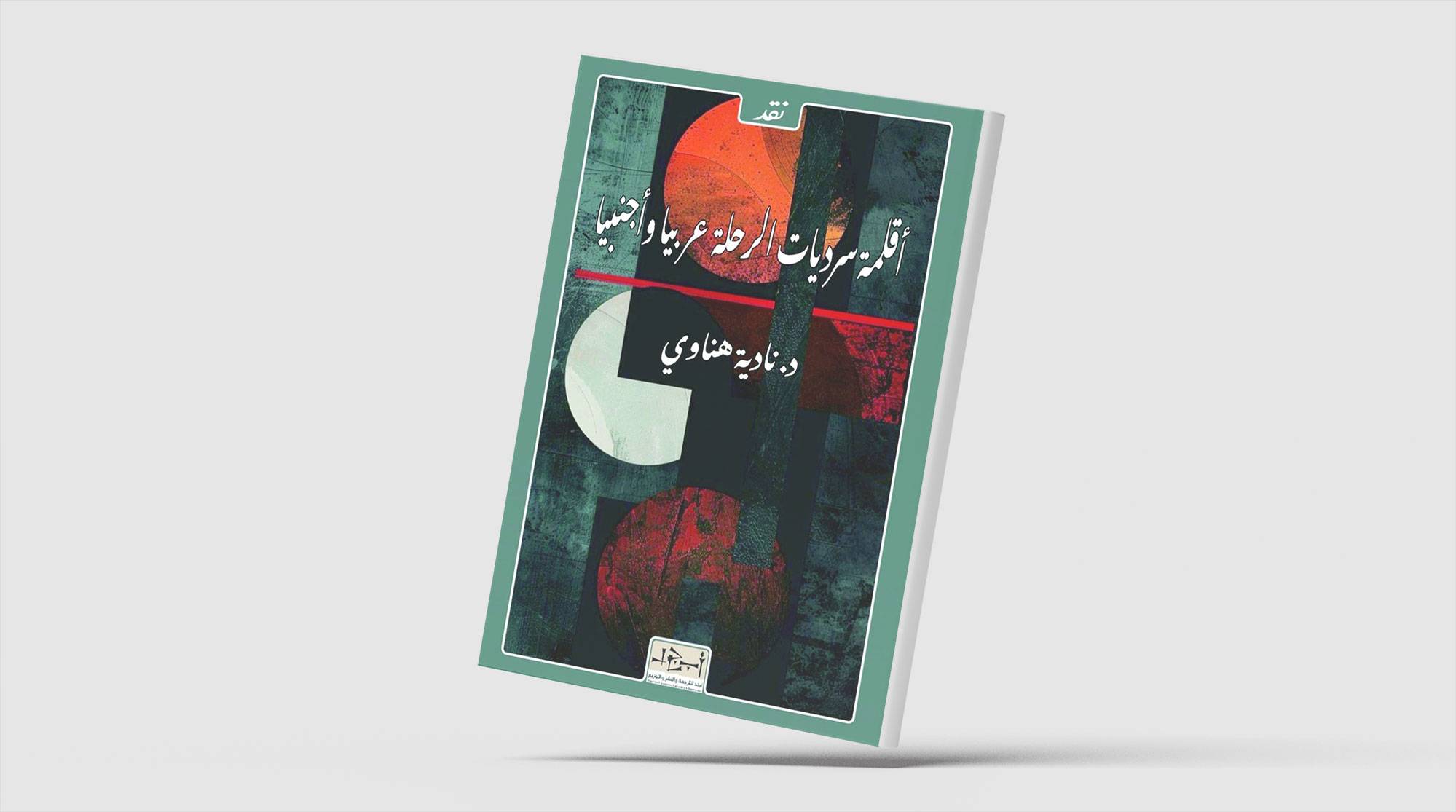تتضاعف مسؤوليات العاملين في قطاع النشر أمام مخاطر مرحلة عنوانها السرعة والتغيّرات والذكاء الاصطناعي. وفي هذا الحوار، يتحدث رئيس مجلس إدارة «جمعية الناشرين الإماراتيين» عبد الله الكعبي عن رؤيته لكيفية التكيف مع التغيرات، ومواجهة التحديات التي يطرحها حاضر القطاع ومستقبله، وضرورة تزامُن النوع مع الكم، فلا تعمّ الركاكة على واقع هذه الصناعة:
• ما الخطوات المُتَّبعة من الجمعية لتعزيز قطاع النشر الإماراتي واستقطاب الناشرين؟
- تُولي الإمارات قطاع النشر اهتماماً خاصاً، فتمهّد الطريق أمام دُور تشكّل حجر الأساس في هذه الصناعة، وتتبنّى استراتيجية فعّالة لنشر ثقافة القراءة لدى المواطنين والمقيمين، وبناء أجيال واعية بأهمية الكتاب واقتنائه وقراءته.
ازدهرت هذه الصناعة في الإمارات خلال السنوات الماضية، وتطوّرت بشكل متسارع، فأقبل الشباب على الاستثمار فيها، وسط دعم المؤسّسات والهيئات الثقافية؛ مثل «جمعية الناشرين الإماراتيين»، و«مدينة الشارقة للنشر»، و«دائرة الثقافة والسياحة»، فضلاً عن مبادرات ريادية للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي. ويتجلّى تطوّر القطاع في نمو عدد دور النشر في الدولة، فقبل سنوات كان عددها 166 داراً، فارتفع حالياً إلى 300، بإدارة رواد ورائدات أعمال. كما تطوّرت آليات الطباعة لتنافس أرقى دور النشر في العالم لجهتَي الجودة والإبداع. إلى ذلك، نجحت الدولة في استقطاب الناشرين من دول العالم عبر معارض الكتب والجوائز الأدبية، ما حفّز تطوير منظومة العمل في القطاع وتنويع الإصدارات.
• ما هي خطوات المحافظة على نوعية هذه الإصدارات، في وقت نرى فيه السوق قد أغرقت بكثير من النتاجات الهابطة؟
- مهم تغذية السوق بعدد وافر من الإصدارات، لكنّ الأهم يكمن في نوعية المحتوى والرسائل الثقافية الثرية الواجب أن تحملها، ومدى تلبيتها لذائقة القرّاء لجهتَي تنوّع المواضيع وجودة المضمون. أحدث قطاع النشر في الإمارات نقلة نوعية على مدار الأعوام الأخيرة تتعلّق بإصدارات الكتب كمّاً ونوعاً. دور نشر عدّة ركّزت على المحتوى المتخصِّص، منه الموجَّه للأطفال الذي يزدهر في الدولة رغم النقص في أنواع معيّنة من العناوين؛ مثل: قصص الخيال والتشويق والحركة والخيال العلمي. ونحن في «جمعية الناشرين الإماراتيين» نعمل على توحيد جهود الكتّاب والمترجمين والناشرين والموزّعين في منظومة ثقافية فعّالة تساعد على إثراء المحتوى وإنتاج كتب تتناول قضايا تشهد إقبالاً ونجاحاً في الأسواق العالمية؛ مثل: العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الشخصية، والفنون والآداب، وقضايا العصر، والمواضيع القطاعية المتخصّصة الأخرى.
من جهودنا في هذا الإطار، توقيع مذكرة تفاهم بين «جمعية الناشرين الإماراتيين» و«اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات» خلال معرض الشارقة للكتاب 2023 بهدف زيادة فرص التواصل والتبادل المعرفي بين الناشرين والكتّاب والأدباء، ضمّ كل ما يُعنى بالتأليف والكتابة والنشر في الدولة تحت سقف واحد، ما يُسهم في دفع حركة التأليف والنشر قُدماً. كما وقّعت الجمعية مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات» بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم قطاعَي النشر والمكتبات، وأُطلقت منحة موجَّهة إلى أعضاء «جمعية الناشرين الإماراتيين» لنشر كتب جديدة متخصّصة في مجال المكتبات.
• هل ترى أن الذكاء الاصطناعي يهدد عالمَ النشر، خاصة فيما يخص الملكية الفكرية؟
- يشهد قطاع النشر عالمياً نمواً متزايداً اعتماداً على الابتكارات والذكاء الاصطناعي وتزايد استخدام التطوّر التقني والمعرفي. يمكن لهذا الذكاء تحقيق نقلة نوعيّة في عالم النشر لجهة توفير بيانات ضخمة تدعم هذه العملية برمّتها، وإتاحة الفرص لربط دور النشر بالموزّعين والمكتبات والكتّاب، فضلاً عن تأمين الدراسات الخاصة بسلوكيات القرّاء وحاجاتهم، وتحليل البيانات والتسويق والشراء، وفتح آفاق واسعة أمام القطاع للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. في الوقت عينه، أثيرت مخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية والأثر السلبي المحتمل للذكاء الاصطناعي على المحتوى وأصالته، إلا أننا نؤمن بأنه ليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الإطار، ما دام بقي العنصر البشري جوهر الأدب والفكر والإبداع، وما دام ثمة قوانين تحكم التداول وتحمي حقوق الملكية الفكرية.
• ماذا عن أهمية التجديد في القطاع في هذا العصر الذي نشهد فيه تطوراً تكنولوجياً هائلاً؟ وما الذي تخططون له لمواكبة جيل الشباب؟
- الإمارات من الدول المتقدّمة في مجال الاتصال الرقمي، فسكانها وشبابها مؤهّلون رقمياً، ويقدّمون فرصة كبيرة للناشرين ومبتكري المحتوى الرقمي لتنويع أعمالهم والانتقال للأشكال الرقمية؛ مثل الكتب الإلكترونية، والتطبيقات، والكتب المصوّرة والمسموعة، والمعلومات الترفيهية، والتعلّم الإلكتروني. وتدرك الجمعية أنّ هذه الصناعة، كغيرها، تتأثّر بشكل متزايد بالتطوّر التكنولوجي وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا بدّ من استثمار هذه التقنيات، على مستويَي النشر والتوزيع، من أجل استدامة القطاع ودعم أهداف الحفاظ على البيئة ومكافحة تغيّر المناخ؛ لذا فإنها تشجّع الناشرين على الموازنة بين الكتابين الرقمي والمطبوع في ظلّ تزايد انتشار منصّات الكتب الرقمية والمسموعة، فضلاً عن اعتماد التسويق الإلكتروني، فأطلقت مشروع «منصة للتوزيع» لدعم الناشرين الإماراتيين في تسويق إصداراتهم عبر معارض الكتب المحلية والدولية، تزامناً مع إطلاق معارض الكتاب المدرسي في أنحاء الدولة، لتعزيز مفاهيم حب المعرفة والتعلُّم لدى الأجيال الناشئة.
• من موقعكم في الإدارة التنفيذية لـ«جمعية الناشرين الإماراتيين»، ما هي الصعوبات التي تواجهونها؟
- تشكّل القدرة التنافسية لصادرات الكتب أحد التحدّيات الرئيسية؛ كونها عاملاً محورياً في تقدُّم صناعة الكتاب. نركّز على العمل مع المعنيين في هذا القطاع للمساهمة بشكل مؤثر في تنويع صادرات الكتب من الإمارات، عبر زيادة عدد العناوين المنتَجة سنوياً، وتعزيز استجابة الناشرين المحليين في السوق للتكيُّف من الناحية التشغيلية مع صناعة النشر الدولية. كما نواصل تعزيز الحضور والمشاركة في معارض كتب دولية تتيح للناشرين بيع حقوق نشر وترجمة الأعمال المحلية. الأهم، نعمل على نشر الوعي والمعرفة الكافية لدى الناشرين ووكلاء التوزيع الدوليين حول الإصدارات وعناوين الكتب التي ينتجها الناشرون الإماراتيون، مع توفير المعلومات المتعلّقة بإمكانات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، وقّعت «جمعية الناشرين الإماراتيين» اتفاقية شراكة مع شركة «Nielsen BookData» بهدف إعداد قوائم رقمية بعناوين الكتب المطبوعة؛ لتعزيز دقة البيانات الببليوغرافية والالتزام بالمعايير الدولية في التصنيف، لضمان أعلى نسبة ممكنة من الوصول العالمي لتلك البيانات، وزيادة فرص المبيعات للناشرين الإماراتيين. وعبر التركيز على دولة الإمارات، توفر دراسة البيانات الوصفية فوائد عدّة لقطاع النشر، من أهمها: تقديم رؤى قيّمة للناشرين، وتمكينهم من مواءمة محتوى الكتب واستراتيجيات تسويقها مع حاجات السوق، ما يؤدّي إلى زيادة سهولة اكتشاف الكتاب الإماراتي، والوصول إليه، وتحسين مبيعاته وصادراته.