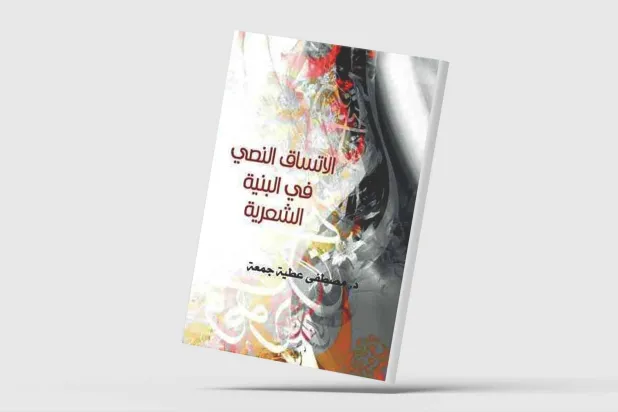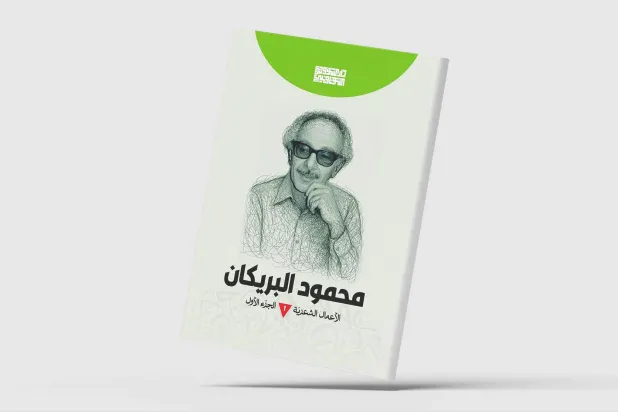الشّعر ملاذ الهويّة الآمن وحصنها الحصين، نظراً لخصوصيّته، وما ينطوي عليه من طاقة متجدّدة على مواجهة تحدّيات العولمة التي باتت تعصف بكلّ شيء ولا تكاد تُبقي على شيء في مكانه. وقد سعيتُ إلى التّحقق من صحّة هذه الفرضيّة من خلال الوقوف على خصوصيّة شبكة العلاقات المتزامنة بين مكوّنات النّسق الشعري؛ بدءاً بعلاقة «الأنا» المتكلّمة بذات المتكلّم الشّاعر، فعلاقة الأنا المتكلّمة بلغة الكلام الشّعريّ، فعلاقتها بموضوع الكلام الشعريّ، فعلاقتها بالمتكلّم إليه (المخاطب)، فعلاقتها بمقام الكلام وسياقه، فعلاقتها بأهداف الكلام الشعري ومقاصده بشكل عام، نظرياً وتطبيقياً، من خلال نماذج من الشعر العربي القديم والحديث، حيث الأصل في علاقة الأنا المتكلّمة بذات المتكلّم الشّاعر، في نسق القول الشعري، أنّها قد تأخذ شكل التّداخل في الذّات والتّطابق معها (كما هو الحال في نسق القول الشعري الرومانسي الذي يجسّد حضور شعريّة التّعالي). وقد تأخذ شكل التّخارج من الذّات، والتّخالف معها (كما هو الحال في نسق القول الشّعريّ الكلاسيكي الذي يجسّد حضور شعريّة التبعية والاستلاب). وقد تأخذ شكل التّداخل في الذّات والتّخارج منها، في الآن عينه (كما هو الحال في نسق القول الشّعريّ الحداثيّ الذي يجسّد حضور شعريّة التّفاعل والجدل).
خصوصية اللغة الشعرية
تتجلّى خصوصيّة اللّغة الشّعريّة، إِنْ على مستوى علاقة الأنا القائلة بلغة القول/ الإنتاج الشّعريّ بعامّة؛ إذ الأصل في القول الشّعريّ، أنّه لا يُقال أو بالأحرى لا يكتب إلّا بلغة القائل الشّاعر الأمّ، لذلك فهو (الشّعر) لا يترجم إلى لغة أخرى غير لغته الأمّ التي ولد في رحمها، لأنّه إذا خرج من رحم هذه اللّغة تهبّأ واندثر، بالقياس إلى تلك اللّغة الأمّ، وإن اكتسب هويّةً أخرى، هي هويّة اللّغة التي تُرجِمَ إليها، فهو يفقد هويّته العربيّة ليكتسب هويّة اللّغة الأخرى: الإنجليزيّة أو الفرنسيّة أو الألمانيّة أو الإسبانيّة... إلخ. أو على مستوى علاقة الأنا القائلة بإمكانات لغتها الأمّ؛ بإمكاناتها النّحويّة والصّرفيّة والصّوتيّة، وقبل ذلك بإمكاناتها المعجميّة: ألفاظها، أو مفرداتها بما تنطوي عليه من محمولات فكريّة أو آيديولوجيّة، تعكس طبيعة السّياق الثقافي الحضاريّ للأمّة التي ينتمي إليها الشّاعر.
وتتجلّى هذه الخصوصيّة من جهة أنّ الأولويّة في نسق القول الشّعريّ عموماً، وفي نسق التّداخل منه خصوصاً، للأنا، لا للأنت أو الهو؛ وللأنا؛ لا فقط كمنظور، أو كزاوية للرّؤية، وإنّما أيضًا، كموضوعٍ وكَهَمٍّ، أو بالأحرى كرغبةٍ مكبوتةٍ في التّحرّر من كلّ سلطة، وتجاوز كلّ وضعيّة استلاب، كما تجلّى لنا ذلك خلال تحليلنا لنماذج من نصوص الشّعر قديمه وحديثه.
تتجلّى هذه الخصوصيّة من جهة أخرى أنّ الأنا المتكلّمة في نسق الكلام الشّعريّ عموماً تعدّ أنا قلقةً متوتّرةً، رافضةً، أو على الأقلّ، غيرَ راضيةٍ، أو غيرَ مطمئنّةٍ إلى وضعها في إطار ما تتكلّم عنه، وما تتكلّم به، وما تتكلّم فيه... إلخ، فهي ممزّقةٌ بين ما هي، وما تودّ أن تكون، أي بين واقعٍ تحياه وممكنٍ ما تنفكّ تتطلّع إليه، ما يحيل لغةَ التكلّمِ الشّعريّ من هذا الأفق، إمكانيّةَ مواجهةٍ مفتوحةٍ مع وضع الأنا المفتوحِ في إطار عالم التّكلّم، أي بوصفها إمكانيّة «تداخل في الذّات»، وإمكانيّة «تخارج من الذّات»، وانفتاح على الآخرين الذين ترفضهم هذه الذّات، وتسعى إلى تجاوز وضعها السّوسيو-أنطولوجيّ في إطارهم، ومن ثمّ، بوصفها إمكانيّة «تمويهٍ» و«تكتّم» على حقيقة موقفها من الآخرين، ورغبتها في تجاوز وضعها في إطارهم.
خصوصيّة الوظيفة الشّعريّة
الأصل في نسق القول الشّعريّ أنّه لا يقال - على الأقلّ حسب أبي تمام - لتحقيق غاية محدّدة تقع خارجه، بل يقال من أجله نفسه، أو من أجل غرض في نفس قائله، بمعنى أنّه لا يقال، في الأصل، لتحقيق غاية محدّدة، هي فقط التّأثير في المخاطَبِ وإقناعه بوجهة نظر الذّات الشّاعرة، بل يقال من أجل فعل القول ذاته، أو لما يحقّقه فعل القول ذاته؛ للمخاطِب والمخَاطَب، المرسل والمتلقّي من متعة وإمتاع؛ المتعة للمخاطِب، والإمتاع للمخاطَب.
لذلك فنحن إذن نسلّم مع فرويد أنّ الوظيفة الرّئيسة لنسق خطاب الفنّ عموماً، داخلاً في ذلك فنّ الشّعر، إنّما تتمثّل في التّمويه، والتّكتّم على رغبة مكبوتة للفنّان، أو في إشباع رغبات الفنّان المكبوتة بطريقةٍ تؤدّي إلى إعادة التّوازن إليه، إلّا أنّنا نختلف مع فرويد، في الوقت نفسه، من جهة أنّه يحصر مفهومَ الرّغبةِ المكبوتةِ، في الرّغبة الجنسيّة (اللّبيدو) فقط، ولا يراها تتجاوز حدودَ هذه الرّغبةِ أو الأفقِ. أمّا نحن فنرى أنّ رغبةَ الفنّان تتجاوز مفهومَ الرّغبةِ الجنسيّةِ، لتشمل، بالإضافة إليها، الرّغبةَ في تغيير الواقعِ القائمِ أو في تجاوزه إلى واقعٍ بديلٍ، والرّغبة في التّحرّر من كلّ سلطة، أو في تجاوز كلّ وضعيّة استلابٍ، فنحن نرى إذن أنّ نسق الخطاب الفنِّي يشبعُ رغبةَ الفنّانِ في تجاوزِ كلِّ ما من شأنه أن يعيقَ، أو يحولَ دون تحقيق رغبتِه في أيّ شيءٍ يمكن أن تتعلّق به رغبتُه. وفي مقدّمة ذلك، رغبتُه في تجاوز وضعه السّوسيو-أنطولوجيّ في إطار الآخرين، أو في نفي واستلاب كلّ ما من شأنه أن يستلب إرادته، ويقيّد حريّته. فالخطاب الفنيُّ إذن، وبخاصّةٍ الخطابُ الشّعريُّ، يخفي رغبةَ الفنّانِ في الانتصار على هذا الـ«ما» يستلب أو يصادر، ويسعى، من ثمّ، إلى التّعبير عن تلك الرّغبة بطرقٍ ملتويةٍ، تتفاوت - من حيث درجةُ الغموضِ أو الوضوحِ - بحسب درجةِ حضورِ ما يرغب هذا الكائنُ في مواجهته سعياً إلى تجاوزه.
* أكاديمي سعودي
والمقال مقتطفات من ورقة ألقيت في المؤتمر الدولي الرابع: عام الشعر 2023، الذي أقيم مؤخراً بجامعة الملك سعود في الرياض