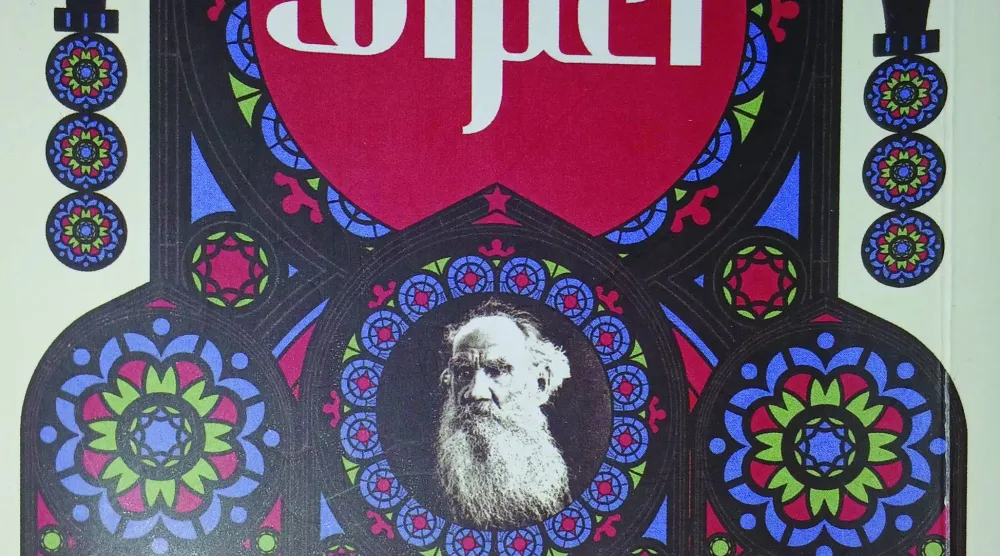«حياتي الآنَ بين يديَّ... في الستين... / أصنعُ ما أشاءُ بها...»
المنصف الوهايبي
قليلٌ منّا حين يدركون الستّين لا يريدون أن يشيخوا بعدها، وقد تلبّسهم في هذا الأوان شعور الحريّة وطلب المغامرة. إن كنتَ لا تعاني علّة، فالستّون هو عمر البلوغ الحقيقيّ للذهن والقلب، ومهما تكن جبلّتك، فإن حسّاً هائلاً من الرضا يتخلّق في داخلك عند بلوغك هذا العمر؛ بسبب استغراقك في خلقتك التي خطّها القدر على جبينك، كما أن أكثرية المشاكل الداخلية مع النفس تكون قد حُلت بعد الستين، أو في طريقها إلى ذلك.
نكون في الستّين متعَبين، لكن نشطاء، ويوصف هذا السِنّ بأنه الحين الذي تصير فيه الذكريات قويّة لا تمحى، كأنها حجر صوان، ويبدأ المرء في تنفيذ مشروعاته المؤجّلة، ويقوم كذلك بأفعال لم تكن عنده الشجاعة سابقاً للقيام بها. لقد توارى الخجل والانطواء، بعد أن أدركنا مقدار خساراتنا بسبب هذه المتلازمة التي لها ألف سبب، لا يصمد أيّ منها أمام أسئلة العقل. في الستّين تكون لك القدرة على الحكم المباشر على الأمور؛ لأن لا سلطان لأحد عليك، وبعد أن كنتَ مجرّد ممثّل لا يعرف أين يضع قدميه على المسرح، أصبحتَ مُخرجَ المسرحيّة ومنتجها ومؤلّفها، ويحتاج المرء إلى خبرة كبيرة وحظٍّ عظيم حتى يكون متفرّداً حقاً، وقائماً على عمل تذكره الأجيال... غارقين في طوفان من العجز عن الحكم والتفكير، لا يجب لوم الشباب أنّ دروبهم يملأها الوحل في كلّ فصول السنة، لو عاد المرءُ في الستّين شاباً لتمكّن من السير على الماء، وحسبه أنه في عقده السادس، وقد نزع عنه جلده القرنيّ، يحلّق بيُسرٍ في الهواء...

على هذا الأساس لا تقل وصلتُ إلى درجة الإشباع لأنني بلغتُ العتبة الأولى من الشّيخوخة، وتعدّ ما تبقى من سنوات البقاء على قيد الحياة، وتحدّق إلى أصابعك؛ ذلك أنك الآن قد بلغتَ منتهى شبابك «الشّباب - العبارة لأوسكار وايلد – ليس ادّعاءً، إنه فنّ»، وهذا يعني إبداعاً في العمل، وإجادة يُدركها من كان له قلب فرِه وذهن متفتّح ونفس شموسة.
هناك جزء في بدني يريد أن ينطفئ، وآخر في طريقه إلى أن يشتعل ويتوهّج بقوّة، فإلى أيّ الجزأين كنتَ تميل أقلْ لك من أنت. إن أردتَ التّوهّج فليس أمامك سوى أن تقلع كلّ عشبة ضارّة تأخذ من حماستك للحياة، وأنت تتأمل أشكال الورود في حدائق أفكارك. مرّة أخرى مع أوسكار وايلد: «مأساة السنّ المتقدمة ليس في كون المرء مسنّاً، بل في كونه شاباً». لا، إن حاجتنا إلى الهواء تتجدّد في كلّ ثانية، وكأن مراحل استحالة الفراشة يمرّ بها البشر كذلك، ولا يستوي المرء كائناً ينطلق سارحاً في أنحاء الكون، ويجوب كذلك فيافيَ روحه التي لها سَعةَ كون صغير، إلّا ببلوغ هذا السِنّ.
ذكرَ البيّاتي الشاعر شيئاً عن اختلاف طعم الماء في أوائل الخريف عنه في بقيّة الفصول، ولي أن أستبدل رأيه بما أنا فيه الآن من نِعمة الستّين، فقد تغيّر كُنْهَ إحساسي بكلّ شيء، وأنا أجتاز هذا الحدّ بين الحبو والطيران. لذّة شُرب الماء زادت أضعافاً، وكذلك مذاق النبيذ والشاي، والرُّضاب من فم الحبيب، والنوم تبدّل كذلك وصار السرير في الليل محلّاً لتجديد حيويّة الروح والجسد، فما إن تستيقظ حتى تشعر بأنك قويّ مثل حجر طلع للتوّ من محجر - الاستعارة من جورج سيفيريس -. هناك إحساس بالمتعة يولد في الحياة متأخراً، وكلّ متعة تحتفظ بأعظم لذاتها لأواخرها، والطاقة الأهمّ لديك يجب أن تذهب إلى نصفك الثاني، وتكون في هذا العمر بالغة لأنها عاشت في أعماقك طويلاً، واكتنزت بحرارة الألوف من شموس الليالي والأيام.

في سبعينات القرن الماضي كانت الانتلجنسيا - الطبقة التي صقلتهم وهذّبتهم الثقافة والتربية - هي عين قلادة المجتمع، تأتي منها اللمعة والحُسن والقيمة، ويرتدي رجالها القميص الأحمر والأخضر وربطة العنق الصفراء، كذلك البنطال الأبيض والبنفسجي والقبعة الزرقاء؛ لاتّقاء شمس الصيف، وربما تجاوز واحدهم السبعين والثمانين، ويستمعون كذلك للموسيقى ويفهمون الشعر والنثر، ويولون احتراماً لنبالة الفنّ، كأنهم يستعيدون بواسطته طاقةً مفقودة. صِفْ لي طعامَك وشرابك أقلْ لك من أنت، وقلْ لي من هي امرأتك أحدّثكَ عن نوع أحلامك، وخبّرني عن ألوان ثيابك لأعرف نوع حياتك. الستّون ليس أوان الثّياب غامقة اللّون والانقطاع إلى زيارة الأماكن المعتمة، تزيد الروح ظلاماً وخراباً فوق رماد السنين.
أصبحتُ الآن رجلاً حصيفاً مثل بحر هائج ثم هدأ، ويدعو القاصّ محمود عبد الوهاب ما نحن بصدده «شعريّة العمر»، وهي: «ديمومة الدهشة التي تجعلنا لا نشيخ، فليس الشباب زمناً معياريّاً للعمر تحدّده السنوات، إنما الشباب حقّاً رؤية متقدمة للعالم تتجاوز إحباط السنوات التي تخترقك. ما لم يخضع العمر لقانون الشّعريّة بهذا المعنى، فإن المرء سيتثاءب حياته ويبصقها من الضّجر».
ولكن هل يستطيع المرء تمديد حجم يومه، أي العيش زمن يومين في نهار واحد؟ الكاتب أنيس منصور كان يحرص على مشاهدة الفجر والغروب من كلّ يوم، في شقّته المطلّة على نهر النيل. اليقظة مع الطير الأول تعطيك فرصة العيش مع مهرجان الألوان هذا، وتبدأ العمل عندها، ويمكن المراهنة في هذا المقام على أمرين: الرياضة والجوع. الأكل الكثير يبلّد حدّة الذهن، وتمنحك رياضة المشي السّريرة الصافية، كما أن المثابرة على الشعور بالجوع تجعل كلّ شيء في الوجود داخل المنظور؛ ولهذا كان الصوفيّون يعدّونه خطوة مهمّة في عملهم لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها بتمرين آخر. ما يُقال عن الفجر يصحّ عن الغروب، ففي هاتين الساعتَين تتلوّن الأشجار والنهر والأشياء بالحبر الصيني، من العتمة الغريبة والمتوهّجة فيه نستلهم الحِكمة والشغف الدؤوب بفنون العيش.
كلّ حياة دون استثناء هي قصيرة، والأدب والفنّ عموماً هو حياة إضافية نحصُل عليها، كما أن لدى الشاعر ذاكرته يمتح منها، وهي تبلغ من الحجم أن أضخم حاسوب لا يتسّع ربما ليوم من هذا العُمر الواسع والفسيح ممّا تضمّه. ذاكرة الشّاعر لا نهائيّة وتؤدي بصاحبها إلى الجنون أو إلى سبيل الشّعر. كم أنا محظوظ لأن قدري سار بي على الطّريق الثّانية، ولم أضِع! يمكننا على هذا الأساس تقسيم الذاكرة إلى ثلاثة أنواع، ذاكرة ضعيفة، وذاكرة قويّة، وذاكرة الشاعر. عندما بلغ بودلير العشرين قال: «أتذكّر أحداثاً وتفاصيل وجزئيّات حياتيّة، كما لو أني عِشتُ آلاف السنين».
الذكريات القديمة لا تمّحي، فهي تسكن في خانة خاصّة في الذهن، ومستقلّة عن الذكرى القريبة، كما أن آلة الذاكرة لا يمكننا استثارتها وإطفاؤها عن عمد؛ لأنها تأتينا بصور وانطباعات عن الأحداث مشحونة بالعاطفة والمتعة والألم، كما أن ليست جميع الذكريات واضحة، بعضها كأنها حدثت لنا في عالم آخر. فجأة أتذكر زقزقة العصافير في ظهيرة شتوية باردة في حديقة بيتي عندما كنت أسكن في حيّ «بارك السعدون» في بداية الألفينات. وكانت الفراشات تستلقي على الأغصان كالأزهار، تصغي إلى حديث كان يجمعني مع ابني «ياسر»، ثم تهبّ الريح فجأة وتطير الأزهار كالفراشات، وتحطّ هذه مثل الأزهار، وتضجّ العصافير بالغناء. كيف لا تنطبع هذه الصّورة في الرّأس ولا تمّحي؟ إذا فتّشنا نفوسنا وجدنا ملايين من هذه الصّور، في السرّاء والضرّاء، تتبادل فيها الأشياء والكائنات الدّور مع ما في الذّكرى السّابقة، ولكني سأكتفي باثنين آخرين لكي أبعد عن الإطالة.
أشتاق في كلّ وقت إلى مشاعري في طفولتي أيام المدرسة، وكنتُ جالساً جنب شبّاك الصف، ناظراً إلى السماء والسغب ينهشني، وفكّرتُ في أن أبعده عن بالي، بأن أنظر إلى البلاط الملوّن، وأفكّر أن الجَمال في النقش على البلاط يفوق حُسن السماء الصافية في النافذة.
وتعود إليّ دائماً ذكرى تلك الظهيرة حين اقتربت منّي امرأة ريفيّة تحمل على رأسها شوالاً من الجتّ، وكان البنفسج يزهر في حقل قريب، ومن فوقه تحمل الريح أنفاس العسل. ظلّت أغصان الجتّ تتحافّ وتصل الصبيّ ذي الأحد عشر عاماً، وبلغه شذى العسل أول مرة، وهذه ذكرى لا تنتهي.