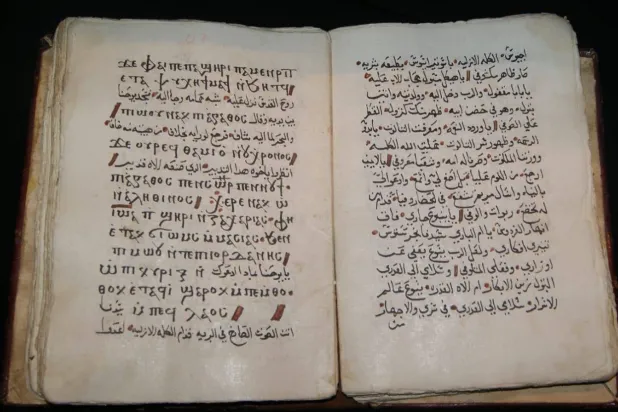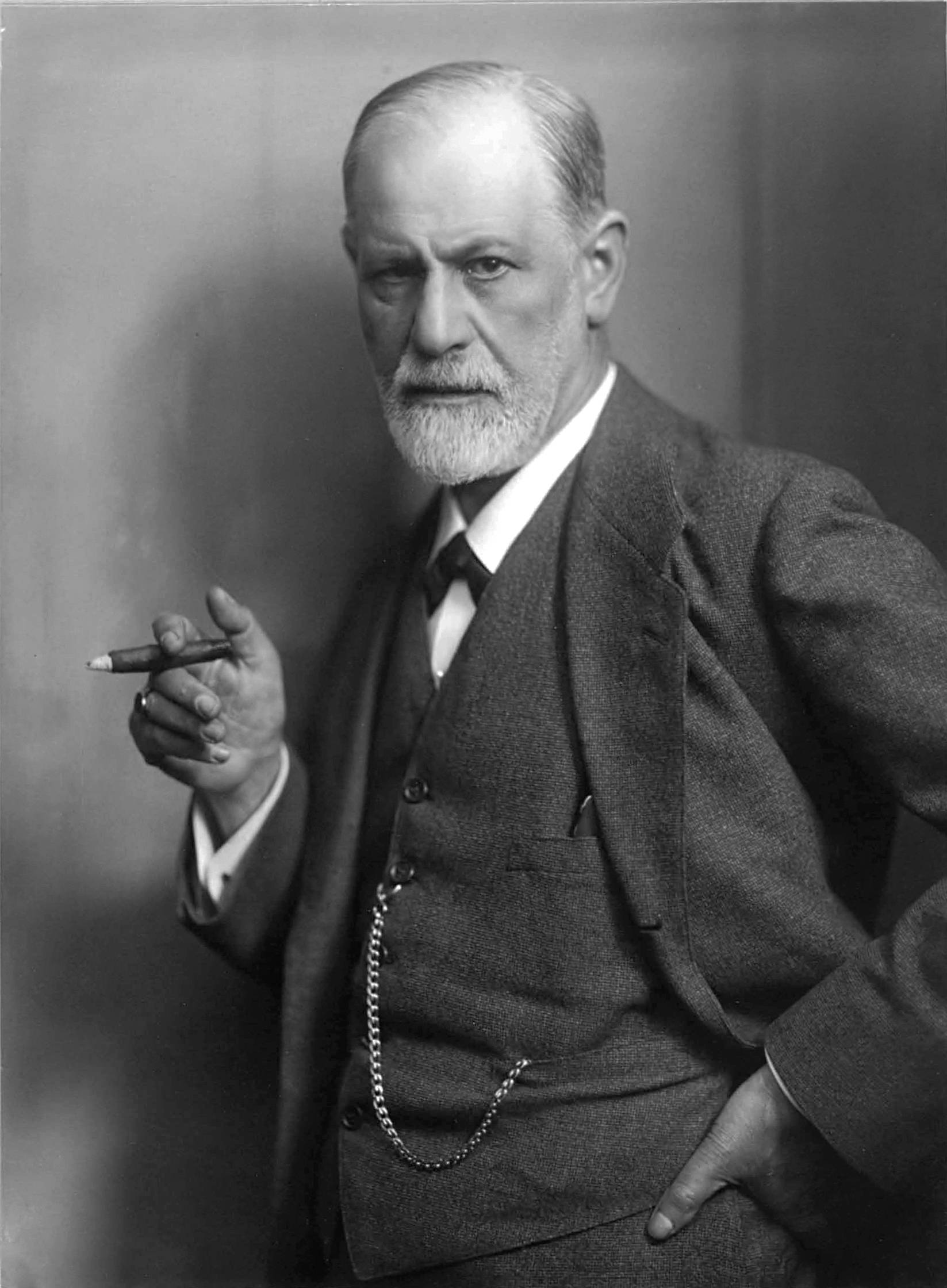يعد الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الأسماء في المشهد الروائي المصري الراهن، نظراً لما تتضمنه أعماله من براعة في السرد وتنوع في الشخصيات وتعدد البيئات الزمانية والمكانية. كما يؤسس مشروعه الأدبي على الانحياز للفقراء والمهمشين وقيم العدالة الاجتماعية. ورغم أنه ارتقى مناصب رفيعة في السلك القضائي، إلا أنه ضحى بكل شيء من أجل التفرغ للأدب والكتابة بحرية. من أبرز أعمالة «ملحمة السراسوة» حصلت على جائزة مؤسسة ساويرس لأفضل عمل روائي فئة كبار الكتاب عام 2010، و«أجندة سيد الأهل»، و«برسكال».
هنا حوار معه حول روايته الجديدة «صاحب العالم» وهموم الكتابة.

* في روايتك الجديدة «صاحب العالم»، ثمة تحذير مكتوب برهافة من سطوة الوسائط التكنولوجية الحديثة، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أصبحت أداة للتجسس على البشر... هل أنت من مؤيدي «نظرية المؤامرة»؟
- إن الأكثر خطورة من تأييد نظرية المؤامرة هو الإقرار بأن العالم خالٍ من المؤامرات، وقد أثيرت على مدى العقود القليلة الماضية الكثير من الأمور المتعلقة بإتاحة البيانات الشخصية للغير من قبل الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، بل بيعها للشركات وللحكومات وغيرها. وهذا يعني ببساطة أن المعلومات التي يظن المتعاملون مع هذه المنصات أنها سرية هي في الحقيقة ليست كذلك، وهو ما دعا المشرعين في كل أنحاء العالم للتدخل لإقرار تشريعات جنائية تجرم هذا المسلك وتفرض عقوبات مغلظة عليه، والتشريعات لا تجرم أعمالاً تخيلية أو مفترضة، وإنما تواجه واقعاً يتطلب التدخل للحد من الجريمة، الأمر إذن ليس تأييداً أو إنكاراً لنظرية المؤامرة، إنه واقع ملموس ومحسوس ويتقاضى الناس بشأنه أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.

* يهرب البطل في نهاية العمل إلى منطقة نائية بعيداً عن ملاحقات شبكات الهاتف أو الإنترنت حيث الطبيعة والعزلة... هل هذه هي «وصفة السعادة» لإنسان العصر برأيك؟
- لقد اخترت للرواية نهاية مفتوحة يلتم فيها شمل الحب بين حبيبين من نوع خاص جداً، أحدهما مهدد بفضيحة تطيح بكل تاريخه وتدمر سمعته وأسرته، والأخرى امرأة لم تعرف في حياتها الحب، وبعد تجربة زواج مريرة لم تجن منها إلا المال عرفت الحب مع هذا الرجل المهدد بالفضيحة. إنه حب صادق عاقل فيه من معاني الأبوة ومعاني الهيام الكثير، وقد اختارت المرأة أن تذهب إليه حيث يختبئ لتكون معه في محنته، لكن هذا لا يعنى أن الانعزال هو وجهتهما، فالرواية لا تتحدث عن الانعزال إلا بوصفه مؤقتاً، حتى يخرج الرجل المهدد بالفضيحة من دائرة اهتمام وانتقام صاحب العالم وأعوانه، أما كيف سيتعاملان مع الأمر بعد تجنب الفضيحة فهذا أمر متروك للمستقبل، إذ إن هذه الإشكالية المتعلقة بإمكانية إتاحة الأسرار لأي جهة تدفع ثمنها لم تُحل عالمياً برغم القوانين التي تجرمها.
* إلى أي حد استفدت من خلفيتك رئيساً أسبق للنيابة في كتابة عالم السجن بنماذجه البشرية الفريدة التي تعج به هذه الرواية؟
- من حسن حظي أنني لم أكن فقط وكيلاً أول للنيابة الكلية ورئيساً للنيابة فقط، كنت أيضاً أحد أعضاء لجنة العُمد والمشايخ على مستوى محافظة الدقهلية، وكنت - وهذا هو المهم هنا - المختص من أعضاء النيابة العامة بالتفتيش على السجن العمومي. وأتاح لي هذا الاختصاص أن أفاجئ السجن بالزيارة في أي وقت وأتجول في أرجائه وأعاين عنابره وزنازينه وأستمع إلى شكاوى السجناء وأحقق منها ما يحتاج إلى تحقيق. ولهذا أقول بكل أريحية: نعم استفدت من كل ذلك ولم أجد أي صعوبة في تخيل الوضع بالسجن، لا من حيث جغرافيته، ولا من حيث تراتب الرتب فيه، ولا أيضاً من حيث العادات التي يسير وفق مجرياتها المحبوسون بتوافق مع الإدارة في بعض الأحيان.

* ما الذي يميز الأديب حين يكون قادماً من خلفية قضائية، كما في حالتك، وهل ندمت على الاستقالة من المناصب الرفيعة التي بلغتها، هل كان الأدب يستحق تلك التضحية؟
- يتميز الأديب القادم من خلفية قضائية بميزة قد لا توجد إلا لدى الكاتب الموهوب جداً، ألا وهي النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة ومتعددة، وهو ما أسميه «ليبرالية السرد الروائي»، الذي يعني بكل أطياف اللون وليس بالأبيض والأسود فقط. وفي النهاية أنا لم أندم أبداً على تركي العمل في القضاء، فالأدب وحريتي ككاتب أثمن عندي من أي منصب، ثم إن المحاماة التي أمارسها حالياً معنى آخر من معاني القضاء، إنها تجسيد لحق الدفاع وهو أقدس حق من حقوق الإنسان، وكل متهم لا بد أن يتمتع به، حتى لو كان الشيطان نفسه.
* في الجزأين الرابع والخامس من عملك الضخم «ملحمة السراسوة» وكذلك رواية «برسكال»، تتناول ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 بشكل عدّه بعض النقاد منحازاً لها ومدافعاً عنها.. كيف ترى الأمر؟

- لقد اعتاد الناس أن يقولوا هذا، ولا أدرى لماذا، وما الذي زكّى هذا القول، وفي الحقيقة فإن أحداً من النقاد الذين كتبوا عن الملحمة، خصوصاً عن الروايتين الأخيرتين، لم يقل بهذا أبداً، لقد كتب عنها عشرات النقاد، هنا في مصر وفي الوطن العربي، وحتى في المطبوعات العربية في أوروبا، ولم يقل أحد ممن كتبوا هذا. أغلب الظن أن هذا القول منسوب إلى بعض من يريدون تسريب هذا وكأنه واقع، تماماً مثلما يلجأ البعض من باب العداء غير المعروفة أسبابه إلى نشر أكاذيب يجري التأكيد عليها حتى تصبح وكأنها حقيقة.
أما فيما يتعلق بثورة يوليو وانتمائي لها، فهذه تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، أنا من أبناء يوليو، وقد عاصرت ورأيت بأم عيني كيف كانت منحازة للفقراء والبسطاء، وكيف انتهجت برامج للتنمية غير مسبوقة، غيرت واقع الناس وحياتهم إلى الأفضل. ورغم ذلك، فإن «ملحمة السراسوة» وجهت نقداً موضوعياً جاداً لتجربة ثورة يوليو، ولو قرأ أصحاب هذا الادعاء العمل لما قالوا هذا، ولهذا أخذت تلك الرواية تحديداً مكانها اللائق في تاريخ الأدب العربي، لست أنا من يقول هذا، الجميع يقولونه.
*هل لا تزال تشعر بأن الآيديولوجية القومية المتعلقة بالعروبة والتي تتبناها جعلت النقاد يتعمدون تجاهلك؟
- لا يمكن إنكار أننا نعيش عصراً من العداء لثورة يوليو وللفكر الاشتراكي بمقارباته كافة، ولا يمكن أيضاً إنكار أن معظم من يمسكون بمقاليد الأمور أو يوجدون في الأماكن المؤثرة هم من الأعداء بالنسبة للفكرة القومية ومن أنصار الفكر اليميني ولديهم في الغالب هوى غربي على نحو أو آخر. ومن أسف فإن انهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ألجأت بعض الماركسيين إلى التمنطق ببعض مقولات الفكر الليبرالي وتمويلاته خشية السقوط في الفراغ، وكذلك وقعوا تحت مطرقة أحد أوجه الفكر السلفي الديني، مطرقة التمويل والانحيازات ضد أعدائهم، فأصبح الجميع يقولون الشيء نفسه، كأنه لم يعد هناك فارق بين الماركسي والليبرالى والسلفي في تقييم ما يجري في العالم. لا ينجو من هذا إلا من رحم ربي، ربما لهذا يشكل كوني قومياً اشتراكياً عائقاً كبيراً لدى من يتأثرون بهذا، وفي الحقيقة هم لم يتجاهلوني، لكنهم يقرأونني لمتعتهم كقراء، جميعهم قال لي هذا.
* لماذا تهاجم عموماً النقد بضراوة وترى أنه مات أو على الأقل يحتضر منذ زمن؟
- هناك فارق كبير بين مهاجمة النقد وبين محاولة البحث عن أسباب ضعف دوره في متابعة ومواكبة وتقييم الإبداع. لدينا على المستوى الفردي نقاد عظام، منهم أساتذة في الجامعات وأستطيع أن أضرب عشرات الأمثلة على ذلك، ومنهم من ليسوا كذلك، ولكنهم لم يطوروا مدرسة نقدية عربية على غرار ما يفعلون في الغرب، ولهذا يختلف التقييم من ناقد إلى ناقد، وربما لا يكون الناقد ملماً بصورة الإبداع كاملة. من يريد للمدرسة النقدية العربية الكمال والازدهار لا يمكن عدّه مهاجماً للنقد، بالعكس أنا أحترم النقد والنقاد وأتمنى أن يتبوأ موقعه الصحيح رمزاً لموضوعية وعدالة التقييم الأدبي غير المبني على الشللية أو الهوى أو حتى المحدودية، أو المدرسية النمطية القديمة.
* أليس غريباً أنه في زمن تُرفع فيه شعارات التكثيف وعصر السرعة، تخرج أنت على الناس برواية ملحمية كلاسيكية متعددة الأجزاء... ألا تخشى اتهامك بمعاداة التجريب؟
- هذا ما حدث، الرواية العربية كانت تفتقر إلى كتابة كهذه «الساجا» أو الملحمة الروائية، لقد أدى هذا اللون من الإبداع دوره في فهم ومتابعة تطور المجتمعات الغربية، بل الشرقية أيضاً، في الصين واليابان مثلاً، أما في العالم العربي وفي مصر بالذات لم يكن لـ«الساجا» وجود ملحوظ، اللهم إلا باستثناءات محدودة للغاية. لم يكن الأدب جزءاً من التأريخ في مجتمعاتنا العربية، لقد أسهمت «ساجا» أو ملحمة «السراسوة» بجهد غير منكور في هذا الاتجاه، ولهذا هي التي دافعت عن نفسها، وشقت طريقها فبدأ الجميع يكتب أعمالاً كبيرة، بعضها نجح وبعضها لم ينجح لأنه يفتقر لشروط الأدب الكبير. أما الزعم بأن التاريخ دفن أشكالاً أدبية وأقام على روحها المآتم فهذا أعده نوعاً من التخريف، وهؤلاء الذين يتكلمون عن الكلاسيكية لا يعرفون عما يتحدثون، أيتحدثون عن الرواية البلزاكية مثلاً؟ جيد، بماذا إذن يصفون معظم الروايات الأخرى؟ هل «عمارة يعقوبيان» لعلاء الأسواني تجريبية؟ هل هي من تيار الرواية الجديدة؟ هل رواية «طيور العنبر» لإبراهيم عبد المجيد تجريبية؟ أنا لا أعادي التجريب، ولكن هذا التجريب يجري منذ خلق الله الإنسان وتكونت المجتمعات، لا أحد يستطيع أن يقاوم التجديد، و«السراسوة» مليئة بالتجريب لمن يقرأها عن وعي.
* تؤكد أن الرواية في محنة وتتعرض إلى مؤامرة كبرى. ما الذي تقصده تحديداً ومن يقف وراء ذلك برأيك؟
- لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال الكبير في عجالة، ولكنني أؤكد على أن الرواية تمر بظروف صعبة بعض الشيء، التجريب يأخذها بعيداً عن مسارها الطبيعي، إلى متاهات لا تمت لعالم الرواية بصلة. فكرة إلغاء الحكاية واحتقار الحبكة ونبذ التراتب وتعظيم وصف الأشياء كما هي وليس من وجهة نظر الإنسان أو بتأثيرها فيه أو تأثرها به وغيرها من الأمور التي لم تستقر على شاطئ حتى الآن تأخذ الفن الروائي بعيداً عن مساره الصحيح، لقد جرى تحديث المدارس الأدبية الروائية بطرق سرد جديدة وأعيد اكتشاف الواقعية مرات ومرات في صور جديدة وبقيت الرواية كما هي مغمورة بسحر الفن، هذا السحر الذي يسعى البعض الآن لتجريدها منه.