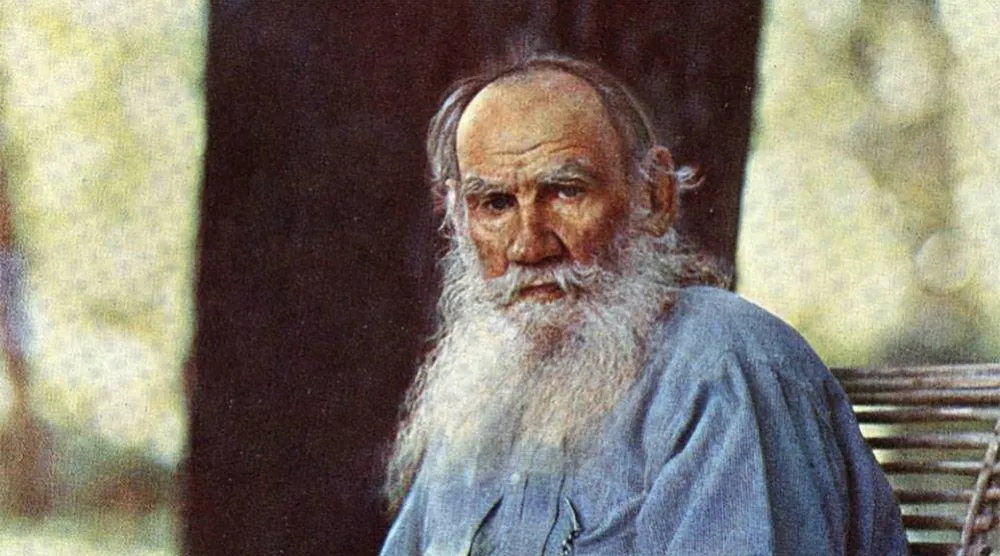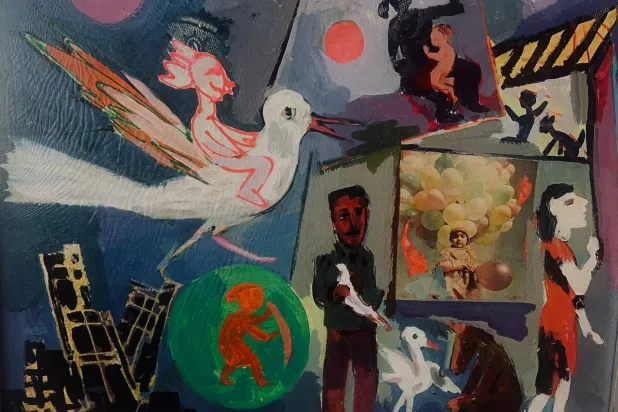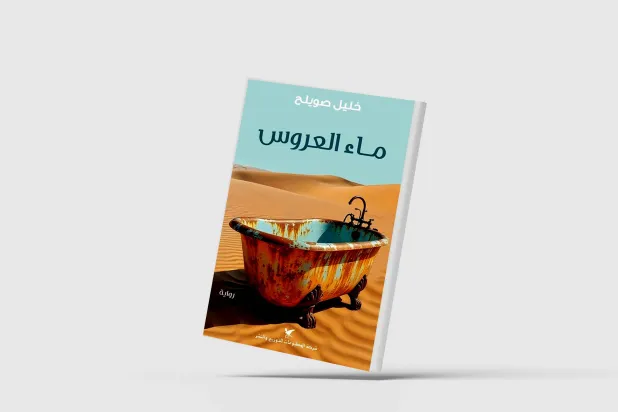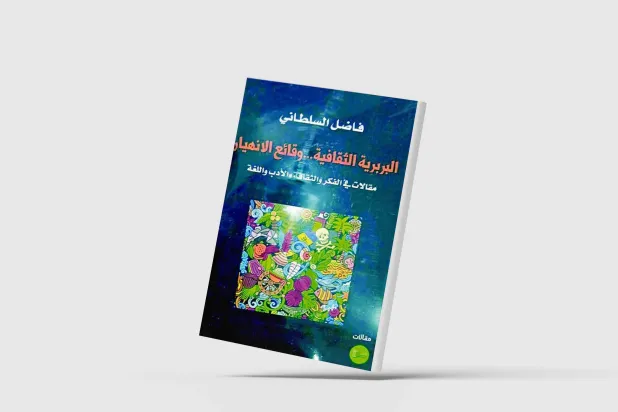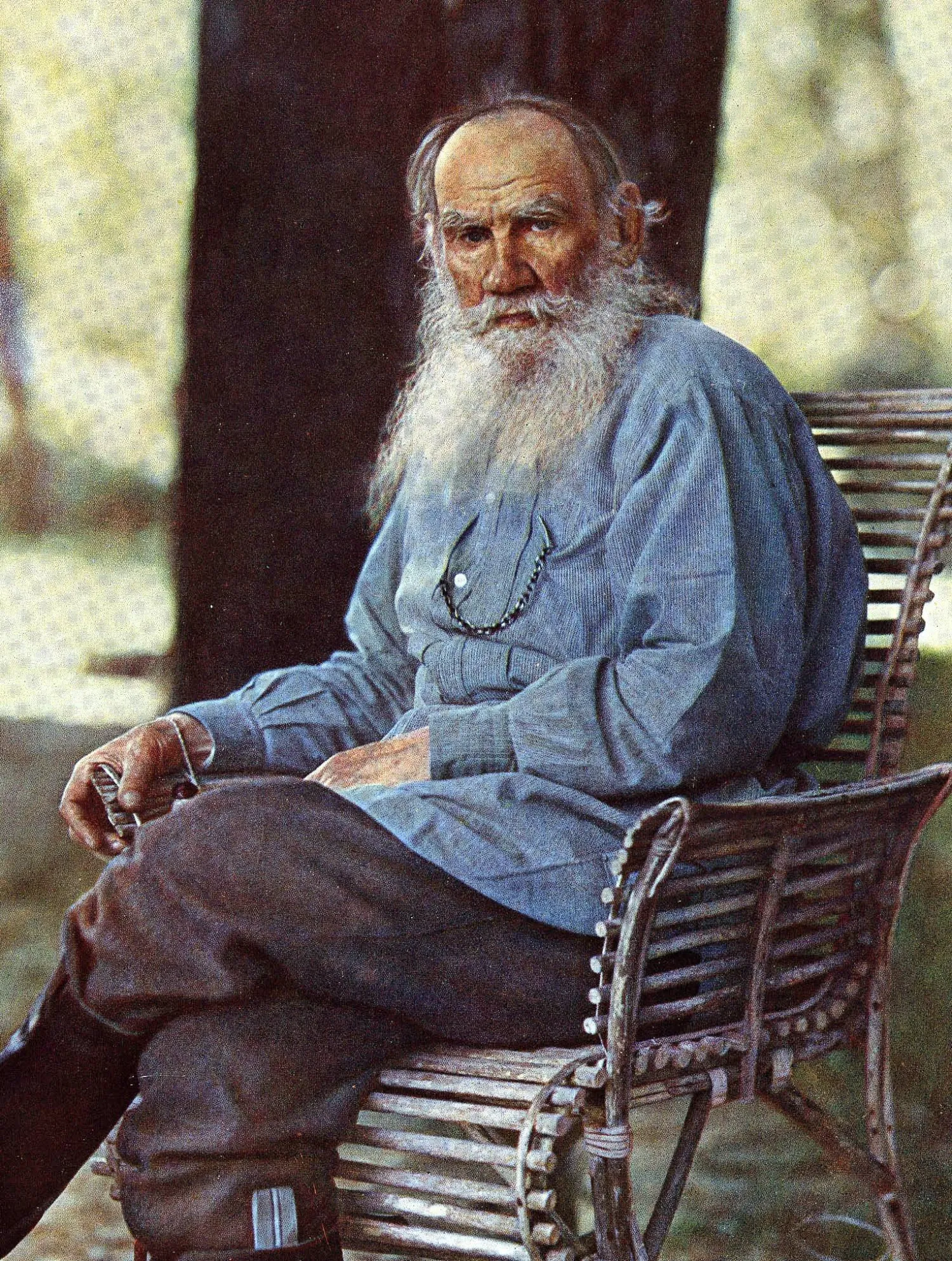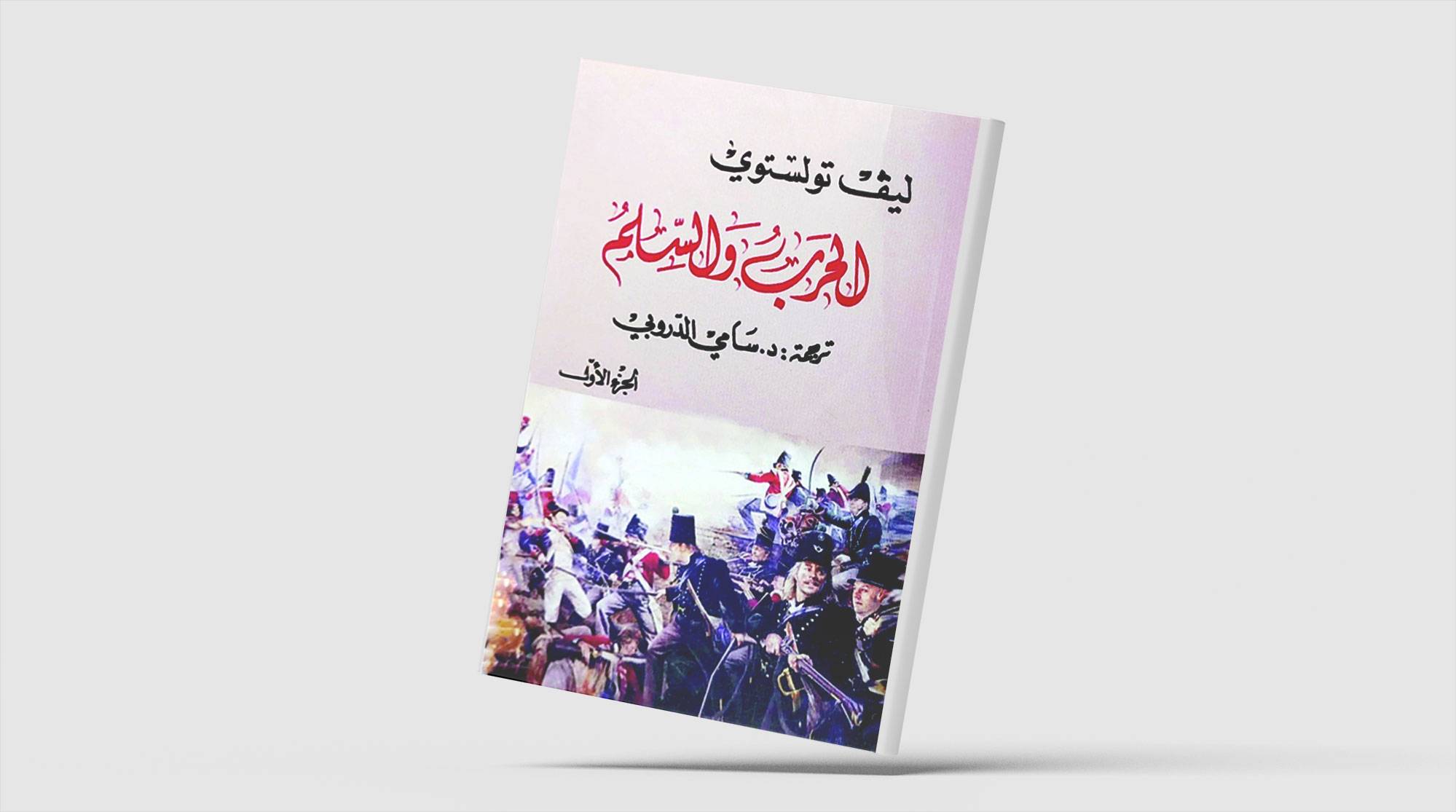يحتفظ مركز مليحة للآثار في إمارة الشارقة بتمثال برونزي من الحجم الصغير يمثل أفروديت، سيّدة الحب والجمال والغواية التي حظيت بشهرة واسعة في العالم اليوناني القديم، كما في العالم الهلنستي الشرقي، حيث تعدّدت صورها وفقاً لنماذج تقليدية ثابتة شكّلت قاموساً فنياً خاصاً بها. يتبع هذا التمثال الذي وصل بشكل غير كامل أحد هذه النماذج كما يبدو، ويشهد لحضور نادر لهذه المعبودة في هذه الناحية في شمال شرقي شبه الجزيرة العربية.
يحمل مركز مليحة للآثار اسم المنطقة الأثرية التي تقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، ويحوي القطع الأثرية المتعدّدة التي خرجت منها. برزت مليحة بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، حيث شكّلت قاعدة لمملكة عُمانية شاسعة عانت في نهاية القرن الثاني، وتضعضعت، ثم ازدهرت من جديد، واستعادت دورها المميّز في التجارة العالمية التي تربط بين أقطار الجزيرة العربية، وحوض البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الهندي، وبلاد الرافدين. توقف هذا الازدهار بشكل صادم خلال القرن الثالث للميلاد، بالتزامن مع صعود الدورة الساسانية وسعيها إلى بسط سلطتها على سائر طرق الخليج، وأدّى هذا التحوّل إلى غياب هذه المملكة عن الخريطة.
فرغت مليحة من سكانها، وطمرت معالمها، ودخلت في النسيان، وبعد زمن طويل، ظهرت من طريق المصادفة في مطلع ستينات القرن الماضي حين شرعت السلطة الحاكمة في الشارقة إلى إقامة جنائن من النخيل في أراضيها المهجورة. شكل هذا الاكتشاف نقطة انطلاق لعمليات المسح والتنقيب المتواصلة التي كشفت عن آثار مليحة وحددت مراحل تاريخها، واتّضح أن هذا الموقع يتميّز بتعدديته الثقافية الاستثنائية، كما تشهد اللقى المتعددة الأشكال والأنواع التي خرجت منه، ومنها تمثال أفروديت البرونزي الصغير الذي لا يتجاوز طوله 11 سنتيمتراً.
يمثّل هذا المجسم امرأة تقف منتصبة، وهي ترفع رأسها نحو الأعلى. الصدر عارٍ، والحوض ملتف برداء طويل ينعقد من حول الخصر، ويتساقط حتى أخمص الساقين، كاشفاً عن قدمين عاريتين. الأسلوب المتبع يوناني كلاسيكي بامتياز، ويتمثّل في محاكاة المثال الواقعي الحي، كما يشهد التجسيم المتقن الذي يتجلى في نحت ملامح الوجه النضر ومختلف أعضاء البدن الأنثوي، كما في نحت ثنايا الرداء الطويل التي تنسكب على مفاصل الساقين بدقة متناهية. الذراع اليمنى منبسطة، غير أنها مبتورة، وما بقي منها يتمثل بالجزء الأعلى منها فحسب. والذراع اليسرى مطوية، وتكشف حركة يدها عن أنها تمسك بأداة ما، ضاعت بشكل كامل. تحيل هذه الحركة على نموذج من النماذج الفنية التقليدية الخاصة بسيّدة الحسن، يُعرف بـ«أفروديت المسلحة»، وهذا السلاح ما هو إلا درع حربي جعلت منه مرآة تتراءى فيها.
بحسب الرواية التي نقلها هزيودوس بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، وُلدت أفروديت في زمن التكوين الأول، من زبد البحر الذي سقطت فيه الأعضاء المبتورة من جسد أورانوس، سيّد السماء في بدء الخليقة، ويشير اسمها إلى هذه الولادة، إذ تعني «أفروس» باليونانيّة الزبد. من هذا الزبد، خُلقت فتاة سبحت نحو جزيرة كيثيرا، ثم بلغت جزيرة قبرص، ومن هناك خرجت سيّدة «ذات بهاء وخفر، يسمّونها أفروديت». وبحسب الروايات المتناقلة التي استعادها كبار الأدباء والشعراء في العالم القديم، شقت أفروديت طريقها نحو جبل الأولمب، مقر أسياد الكون الكبار، وأسرت القلوب بحسنها. ورغب زيوس سيّد الأولمب بالاقتران بها فرفضت، فعاقبها وفرض عليها الزواج بابنه هيفيستوس الذي كان يعاني من عاهة العرج في كلتا قدميه، وكانت أصابع هاتين القدمين في الخلف وعقباهما في الأمام، فزاول مهنة الحدادة التي لا تتطلب تنقّلاً، معتمداً على قوّة ساعديه، فغدا سيّد الحدادة والنار والبراكين والصناعة والبرونز، وعُرف بصناعة الأدوات والأثاث والأسلحة لكبار الأبطال. هكذا تزوجت أفروديت من هيفيستوس، إلا أنّ هذا الزواج لم يمنعها من البحث عن المتع التي لم تجدها إلى جانب قرينها القبيح، فعشقت شقيقه الجميل آريس، سيّد الحرب والهلاك والخراب، فبادلها الحب، وأهدى إليها درعه النحاسي الرهيب، فجعلت منه مرآة لها، وبات هذا الدرع رمزاً من رموزها العديدة.
ينتمي تمثال مليحة إلى الفصيلة الفنية الخاصة بأفروديت والأرجح أنه وصل إلى هذه المقاطعة من الخارج
على مدى قرون من الزمن، تبارى المثّالون والرسامون في إبراز جمال أفروديت الخارق. واللافت أن أقدم ما وصلنا من هذه الصور جاء في صيغة الرمز المجرّد، وكأن هذا الجمال الأنثوي الذي لا يوصف، أكبر من أن يتّخذ صورة محسوسة. هكذا تحتجب أفروديت في هيكلها في مدينة بافوس القبرصية لتحضر سرّياً عبر هرم مخروطي الشكل تحيطه المشاعل، قبل أن تظهر ملتفّة برداء طويل ومتوّجة بإكليل في القرن الرابع قبل الميلاد. وتكشف الكثير من الأعمال الفنيّة التي وصلتنا من تلك المرحلة عن براعة المثالين في إبراز مفاتنها خلف ثنايا القماش الملتف حول جسدها البهي. شيئاً فشيئاً، تنزع الحسناء رداءها لتظهر جمال قوامها الفتان، وتكشف أولاً عن القسم الأعلى من جسدها وهي تلفّ ثوبها المتساقط حول أسفل حوضها وساقيها، ثمّ تخلع رداءها لتظهر عارية تماماً وهي ترخي ذراعها من أمامها.
في هذا السياق، يبرز نموذج «أفروديت المسلحة» التي تتراءى في الترس النحاسي الذي أهداه إليها معشوقها آريس، وقد أشار أبولونيوس الرودسي في القرن الثاني للميلاد إلى هذا النموذج، حيث وصف في الكتاب الأول من منظومته الشهيرة «آرغونيكا»، تمثالاً يجسّد أفروديت وهي تحمل بين يديها ترساً انطبعت فوق سطحه صورة وجهها المنعكسة عليه. نقع على تماثيل عدة تتبنى هذا النموذج، أشهرها تمثال محفوظ في متحف أنطاليا الأثري في تركيا، وآخر محفوظ في متحف كابوا في إيطاليا.
ينتمي تمثال مليحة إلى هذه الفصيلة الفنية الخاصة بأفروديت، والأرجح أنه وصل إلى هذه المقاطعة من الخارج، مشكّلاً حضوراً استثنائياً لهذه المعبودة في هذه الناحية البعيدة الواقعة في شمال شرقي جزيرة العرب.