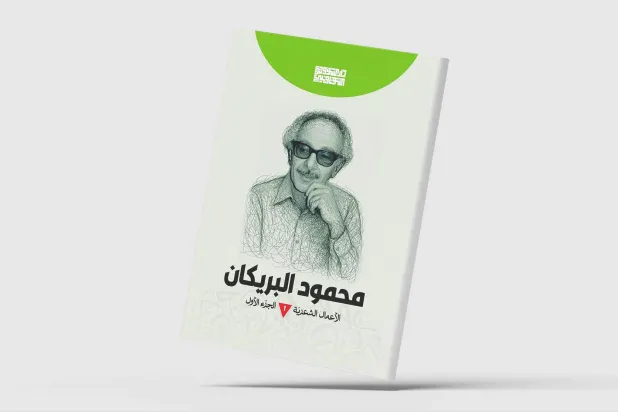يصادف غداً مرور 24 سنة على رحيل الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي، أحد رواد الشعر العربي الحديث، إلى جانب بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، الذي توفي في العاصمة السورية دمشق عام 1999، ودفن في «مقبرة الغرباء» إلى جانب محمد مهدي الجواهري ومصطفى جمال الدين وغيرهما، بعد حياة قضى نصفها في المنافي.
الكاتب التونسي حسونة المصباحي يروي هنا ذكريات شخصية معه في العاصمة الإسبانية، مدريد، حيث عاش من 1980 إلى 1998:
* كان سلاحه الوحيد التهكّم على أهل الثقافة والسياسة بالخصوص... فلا يكاد أحد من هؤلاء يسلم من لسانه الحادّ
خلال الثمانينات من القرن الماضي، تعوّدتً أن أزور إسبانيا كلّ صيف، خصوصاً الأندلس التي لا أشبع من جمالها، ومن مُتعها، وملذّاتها. وكلّما عدت إليها شعرت كما لو أنّني آتيها للمرّة الأولى. وفي مساء يوم 30 يوليو (تموز) 1999 جلست في مقهى صغير في مدينة «طريفة» في أقصى جنوب إسبانيا، والتي منها يمكن أن ترى جبال الأطلس، وطنجة على الضفّة الأخرى من المضيق، مُنتظراً حلول الليل. جميع الزّبائن شيوخ طاعنون في السنّ. البعض منهم كانوا يلعبون الورق... آخرون كانوا يشربون، ويدخّنون صامتين ينظرون بعيون مُتعبة إلى السّاحة الجميلة أمام المقهى حيث شابّات يتضاحكن زاهيات بجمالهن. في الرّكن القريب من باب الخروج، شيخ في نحو الثمانين من عمره يَنُوسُ أمام كأسه، وبين أصابعه سيجارة تحترق ببطء... وجدتُني أتمعّن فيه لسبب لا أدريه... بعد لحظات انتبهت إلى أنه يشبه عبد الوهّاب البيّاتي بشكل مثير، ومُدهش؛ نفس تسريحة الشّعر، نفس العينين الصّغيرتين حيث يلمع الدّهاء، والفطنة، نفس الأنف الغليظ، نفس الملامح الدّالّة على قوّة داخليّة هائلة، نفس الأصابع، أصابع الفلاّح الذي خبر الحياة، وسبر أغوار الأرض... أنهى الشيخ الإسباني كأسه وحيّا أصدقاءه بحرارة ثم انصرف وهو يعرج قليلاً تماماً مثل البيّاتي عندما تقدّمت به السنّ. عقب ثلاثة أيّام، كنت في طنجة، في شقّة صديقي محمد شكري، وكنت أحدّثه عن العجوز الإسباني في طريفة لمّا رنّ الهاتف، وجاءنا الخبر الفاجع معلناً وفاة عبد الوهّاب البيّاتي في دمشق، لتكون آخر محطّات منافيه الكثيرة...
اللقاء الأول
التقيت عبد الوهّاب البيّاتي أوّل مرّة في مدريد في شتاء 1982، وذلك اللّقاء كان الأساس المتين لعلاقة حميمة امتدّت لعقدين كاملين. في تلك الفترة، كان عبد الوهّاب البيّاتي يعمل ملحقاً ثقافيّاً لبلاده في العاصمة الإسبانيّة، غير أنه لم يكن يذهب للعمل إلاّ نادراً، ومُكرهاً على ذلك. وكان يقضي كامل النّهار في بيته، فلا يخرج إلاّ في الخامسة ظهراً ليجلس في مقهى «الفيّوما» في «الغران فيّا» على مرمى حجر من «بوارتا دال صول»، قلب مدريد النابض بالحياة ليلاً نهاراً. وفي ذلك المقهى يبدأ سهراته التي تنتهي آخر اللّيل. وكان عبد الوهّاب البيّاتي يأتي دائماً إلى المقهى بأناقة أمير... ومنذ البداية زالت حواجز الكُلفة بيننا. ورغم فارق السنّ، كان كلّ واحد منّا يتعامل مع الآخر تعامل صديق مع الصديق الذي معه تقاسم الحلو والمرّ على أرصفة الشّوارع. والحقيقة أن البيّاتي رجل نادر يصعب على مسطّحي الذّهن، وفقراء الخيال، سبْرَ أغوار شخصيّته العذبة، والتقاط المعاني الخفيّة لدعاباته السّوداء، وتهكّمه اللاّذع الذي لا يسلم منه أحد، قريباً كان أمْ بعيداً! فيه شيء من الاعتداد بالنّفس عند المتنبّي، ومن التحدّي عند امرئ القيس، ومن فنّ الهجاء عند الحُطيئة، ومن الإقبال النَّهِم على ملذّات الحياة عند أبي نوّاس، ومن المرارة عند المعرّي. وشخصيّته جذّابة في كلّ الأحوال. وأعتقد أن كثرة أعدائه لا يعود فقط إلى صراحته، وسلاطة لسانه، وإنّما لأنه كان شاعراً أصيلاً وموهوباً... من كلماته البسيطة يشعّ نور الحبّ والحرّية، بعيداً عن الحذلقة، والافتعال. كما أنه كان يرفض دائماً الانتساب إلى ما كان يسميها «المافيات» الثقافيّة التي أفسدت (وتفسد الثقافة العربيّة إلى اليوم) بمؤامراتها، ودسائسها. وبحزم، كان يتصدّى للعقليّات المريضة، وللسلوكيّات القبليّة المتفشية في الذّهنيّة العربيّة. سلاحه الوحيد التهكّم على أهل الثقافة، والسياسة بالخصوص... فلا يكاد أحد من هؤلاء يسلم من لسانه الحادّ مثل سكّين مشحوذ جيّدا.
وفي مدريد كان البيّاتي يقتني كل الصحف والمجلات العربية. ومن خلالها يُتابع مختلف الأحداث التي تجدّ في العالم العربي مشرقاً ومغرباً، مُعلقاً عليها بسخرية مرة. وكان يحتفي بكل أديب عربي يزور العاصمة الإسبانية. كما أنه كان يتردد على النوادي الثقافية الإسبانية رغم أنه لم يكن يعرف من لغة سرفانتس سوى بعض الكلمات. ومرة أخذني إلى حفل الاحتفاء بالشاعر الكبير رافائيل ألبرتي بعد إحرازه جائزة سرفانتس الرفيعة. ورغم أنه كان قد تجاوز سن الثمانين، فإن رافائيل ألبرتي الذي لم يعدْ إلى بلاده إلاّ بعد وفاة الجنرال فرانكو. كان يبدو بشعره الفضّي الطويل، وبملابسه الشبابية أقل من سنّه بعقد أو أكثر من ذلك. وكان مُحاطاً بصبايا جميلات. راح عبد الوهاب البياتي ينظر إليه صامتاً، ثم همس لي باسماً: «أود أن أكون مثله محاطاً بالجميلات بعد أن أبلغ سن الثمانين».
اللقاء الأخير
وكان البياتي يحب أن يحدِّثني في سهراتنا التي تمتدّ إلى الفجر أحياناً عن القاهرة أيّام عبد النّاصر، وعن بيروت قبل حربها الأهليّة. ومن موسكو في فترة ذوبان الجليد الستاليني، يسافر بي إلى باريس التي يعشق شعراءها، أو إلى إسطنبول، مدينة صديقه ناظم حكمت. وفي إحدى السهرات في مقهى «الفيّوما»، حدّثني البيّاتي عن طفولته في بغداد، وعن جدّه الذي كان أوّل من زرع فيه حبّ الشّعر، وعن سنوات الغليان التي سبقت انهيار النّظام الملكي عام 1958، وعن ناظم حكمت في السّنوات الأخيرة من حياته في موسكو. كما روى لي الكثير من مغامراته الغراميّة في مختلف المدن التي عاش فيها، أو عبرها سريعاً.
مطلع شتاء 1999، التقيت البيّاتي في القاهرة في أثناء معرض الكتاب. بدا حزيناً، مُحبطاً، يائساً من نفسه، ومن العالم. وكانت نوبات الرّبو قد اشتدّت عليه مُعكّرةً سهراته مع الأصدقاء... وأكثر من مرّة نام هكذا أمام أعيننا ونحن نلهو، ونغنّي، ونرقص... آخر اللّيل، شاهدته يسير وحيداً متّجها إلى فندق «باراميزا» وهو يعرج قليلاً، مطأطئاً رأسه كأنّه يُعلن عن استسلامه للقضاء والقدر... قلت لصديق كان إلى جانبي: «أظنّ أنّي لن أرى البيّاتي مرّة أخرى».