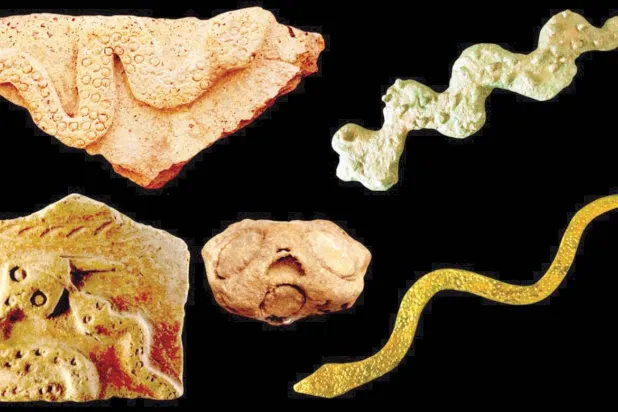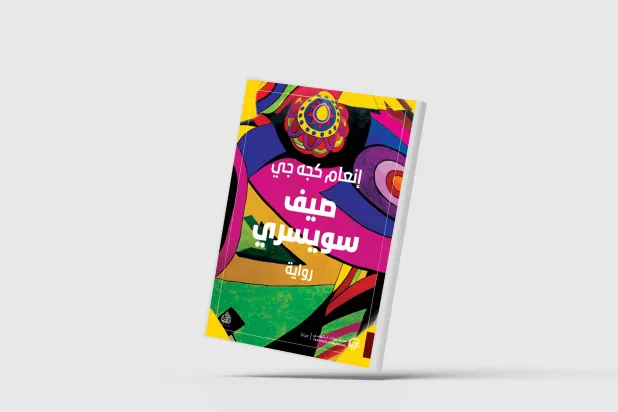من قوة إلى قوة تسيرُ سلسلة «دراسات إدنبرة في الأدب العربي الحديث»، التي تصدر باللغة الإنجليزية عن مطبعة جامعة إدنبرة في أسكوتلندا، ويشرف عليها الدكتور رشيد العناني، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة إكستر البريطانية. فبعد أن أصدرت السلسلة، اعتباراً من عام 2013، 29 كتاباً تغطي شتى مجالات الأدب العربي منذ القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا، ها هي ذي تصدر في هذه الأيام كتابها الثلاثين، وعنوانه «جبران خليل جبران في سياق الأدب العربي العالمي» (Gibran Khalil Gibran as Arab World Literature)، من تأليف غزوان أرسلان (Ghazouane Arslane)، المحاضر في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة العربي التبسي- تبسه في الجزائر.

جبران (1883 - 1931) كما هو معلوم أشهر أدباء المهجر الأميركي الشمالي، يحتل مكانة لا ينازعه فيها سوى أمين الريحاني وميخائيل نعيمة (عندي أن هذا الأخير أنبغ الثلاثة). فجبران ركن أدبي مكين من أركان النهضة الأدبية الحديثة، شاعر وقاص ومسرحي وكاتب مقالة وكاتب رسائل باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن كونه فناناً تشكيلياً له لوحاته ورسومه. لقد كان كتابه «النبي» الصادر بالإنجليزية في 1923 (ونحن نعرف مدى ولع الأميركيين بكل صرعة جديدة في الفكر والحياة والفنون) من أكثر الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية. وقد ترجم الكتاب إلى 104 لغات وله ثماني ترجمات مختلفة إلى اللغة العربية. وصلت شهرة جبران إلى الصين، وكان رئيساً لـ«الرابطة القلمية» في أميركا حتى وفاته، وحظي في العالم العربي بتقدير مفكرين وباحثين ونقاد وأدباء مهمين مثل أدونيس ويوسف الخال وخليل حاوي وحليم بركات وغيرهم. وما زال حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بعد مرور قرابة قرن من الزمن على رحيله، إذ يُعقد مؤتمر دولي يحمل اسمه، وتؤلف عنه دراسات وأطروحات جامعية وكتب أحدثها هذا الكتاب.
وحين ترجم الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، عدداً من أعمال جبران المكتوبة بالإنجليزية (ظهرت ترجمته لكتاب «النبي» في 1959)، كتب الدكتور لويس عوض قائلاً إن صدور هذه الترجمات مؤشر إلى انبعاث للحركة الرومانسية، خصوصاً وقد تزامن صدورها مع صدور كتاب من النثر الغنائي عنوانه «المساء الأخير» للقاص يوسف الشاروني، وديوان من الشعر المنثور للشاعر المستشار حسين عفيف. وفي فترة لاحقة قدمت الروائية والأكاديمية المصرية الراحلة الدكتورة رضوى عاشور إلى جامعة القاهرة رسالة ماجستير عن «جبران وبليك»، وترجم ماهر البطوطي من مهجره الأميركي مسرحية جبران المكتوبة بالإنجليزية «الأعمى» وقُدّمت على خشبة «مسرح السلام» بالقاهرة.
وكتاب غزوان أرسلان (الذي يحمل درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة كوين ماري في لندن) عمل أكاديمي جليل يشهد بتمكن مؤلفه من موضوعه ويمتاز بتحليله الدقيق لنصوص مختارة من جبران. وإذ يبدأ كتابه بسؤال: لماذا وكيف ينبغي أن نقرأ جبران اليوم؟ فإنه يختمه بمحاولة لوضعه في سياق الأدب العالمي لا الأدب العربي - الأميركي وحده. وفيما بين المقدمة والخاتمة يعالج الصلات في حالة جبران بين جماليات الأدب وعلم الأخلاق والسياسة، والبعد الديني والصوفي في عمله، وأوجه حداثته وتجديده، وتعامله مع اللغتين، وحسه القومي، وموقعه من النهضة الأدبية الحديثة.
مما يحمد للمؤلف أنه على محبته لجبران لا يُغفل الجوانب السلبية في إنجازه
ومما يحمد لأرسلان أنه، على محبته لجبران، لا يغفل الجوانب السلبية في إنجازه. فهو يذكر مثلاً أنه ينحو أحياناً إلى العاطفية المسرفة (السنتمنتالية) وإلى النزعة التعليمية وإلى التبسيط المسرف في نسج خيوط الحبكة ورسم الشخصيات وإلى استخدام الكلشيهات المحفوظة. ويأخذ أرسلان على جبران أنه، وهو المناصر لمنح المرأة حقوقها، قصر الدعوة إلى التعليم على الذكور دون الإناث. كما أخذ عليه خطأ لغوياً في نحو اللغة الإنجليزية حين جعل «builded» ماضياً للفعل «build» (ص 194) بدلاً من «built». وفي رسالة من جبران إلى ماري هاسكل في 1922 يزعم جبران أنه تلقى لغته الإنجليزية من شكسبير والترجمة الإنجليزية للكتاب المقدس وهاسكل ذاتها! فيتساءل أرسلان محقاً: ألم يتلقها أيضاً من بليك وكيتس وشللي وكارلايل وويتمان، وهو ما تثبته كتاباته ورسائله الأخرى؟
ويورد أرسلان آراء نقاد جبران ما بين مادح مثل الشاعر الآيرلندي جورج وليم رسل، وقادح مثل مصطفى لطفي المنفلوطي الذي انتقد جبران من منظور أخلاقي، وعباس محمود العقاد الذي كتب عن قصيدة جبران «المواكب» في 1922 فأخذ عليها أموراً منها ما يتصل بالمحتوى الفكري وما يتصل باللغة والأسلوب.
وبدوره لا يخلو كتاب أرسلان، على مزاياه الملحوظة، من هفوات. إنه يكتب مثلاً: «those who do not deprive themselves from the gifts» (ص51)، وصواب حرف الجر «of» لا «from» (واضح أن أرسلان كان يفكر هنا باللغة العربية حيث نقول «محروم من..»). ويسمى أرسلان مؤلف رواية «موبي ديك» Henry Melville (ص 228) وصواب اسمه الأول Herman. ويذكر أن لجبران كتاباً عنوانه «Sand and Form» (ص 109) وهو خطأ مطبعي بلا شك صوابه «Sand and Foam» (رمل وزبد). هنات تغتفر لكتاب على حظ كبير من العمق الفكري ونفاذ البصيرة ومتانة الأسلوب وإحكامه.