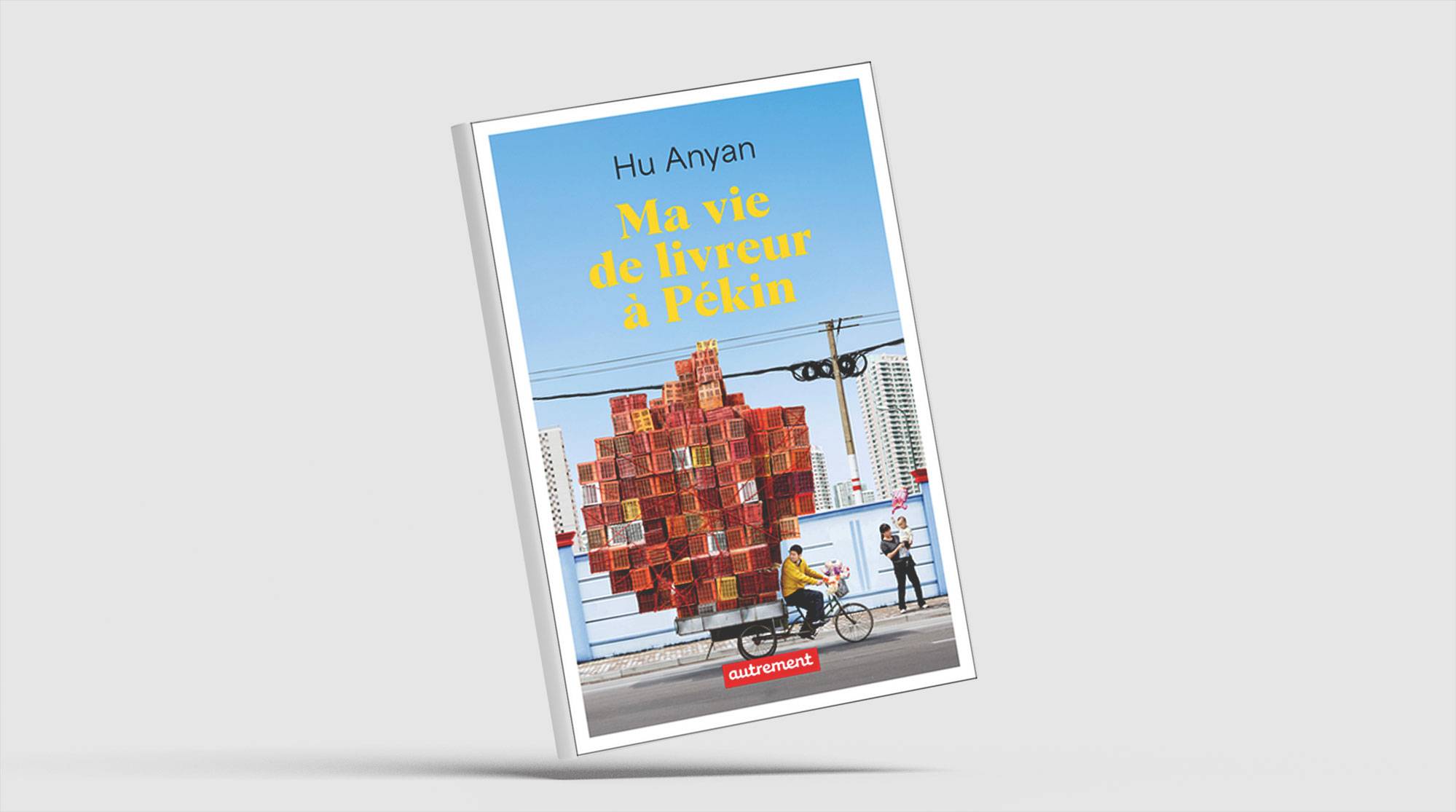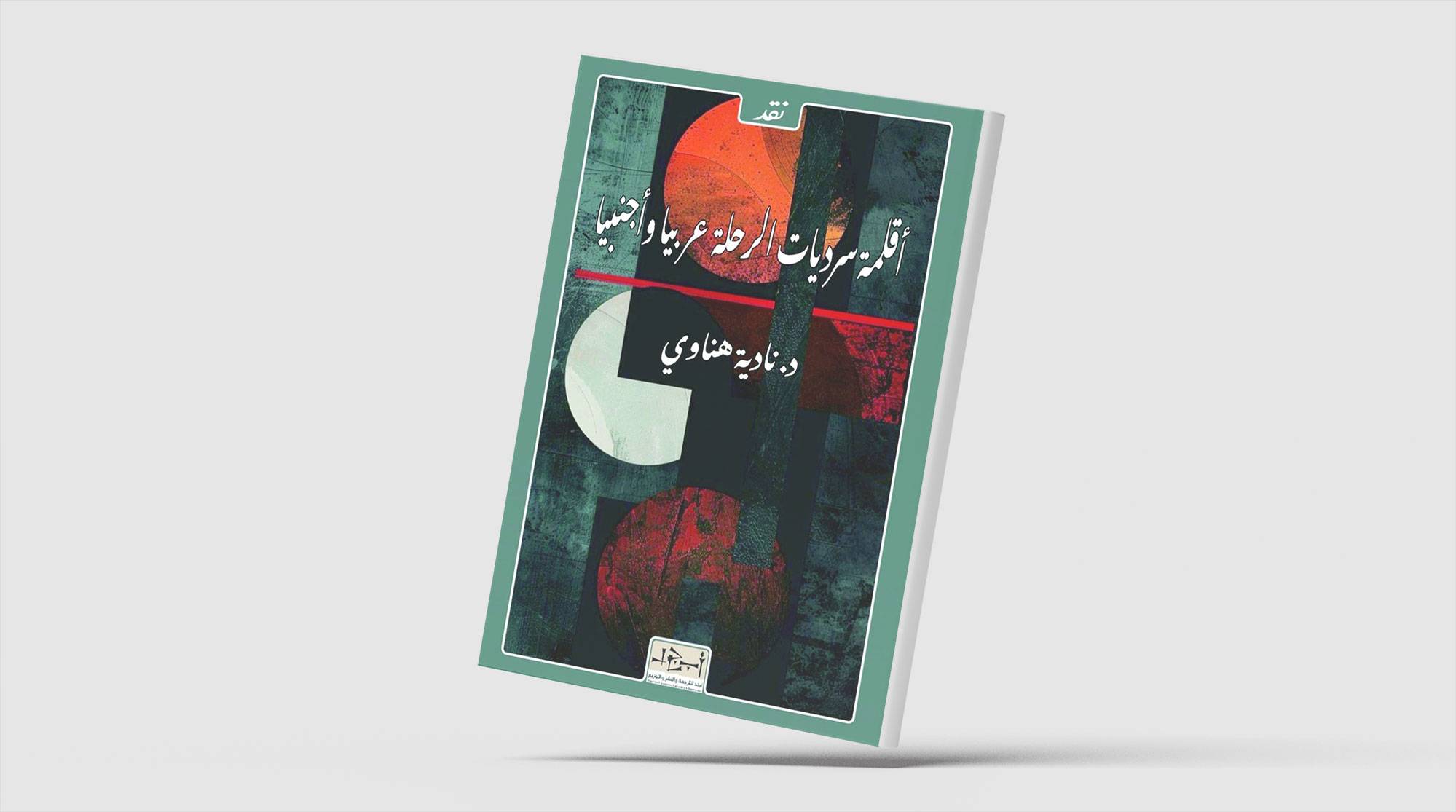أربعة أمور أساسية كانت وراء المشهد المختلف لعالم رواية «صيف سويسري» لإنعام كجه جي - منشورات تكوين/ الرافدين 2024 - يتَّصل الأول بالذاكرة السردية لمشروع الكاتبة كله. والثاني خاص بمنطق الأمثولة المفارق، حد الصدام، في هذه الرواية. والثالث كامن في الصياغة الكلية لعظة المكان الغريب. والرابع حاضر بصيغ الاعتراف المهيمنة في النص كله. فماذا عن بنيات الإخفاق الأصيلة؟ إنها، كما نفترض، بعض صيغ المجاز الكلي للرواية برمتها. لماذا لا نقول إنها بعض صيغ الذاكرة السردية؛ ربما، سوى أن عنوان الرواية «صيف سويسري» يهيئنا، ابتداءً، لتلقي عوالم سردية جديدة، في طليعتها ألا ننتظر حكايات كبرى، لا آمال كبيرة؛ نحن ذاهبون إلى «صيف سويسري» فحسب. في الأقل هذا ما نفهمه من عنوان متقشف بلا مزاعم مسبقة!
الذاكرة السردية المقترحة
أربع شخصيات عراقية يجري انتقاؤهم بعناية فائقة من قبل ممثلي شركات الأدوية السويسرية ليذهبوا إلى «سكن جامعي: لنقل إنه دار إيواء أو مصح» بطرف مدينة «بازل» في سويسرا؛ في رحلة علاج صيفية مجانية، أواخر الألفية، من مرض مستعص اسمه الذاكرة العراقية وأوهامها، لا سيَّما الإدمان العقائدي. ويبدو تحديد الزمن ذا وظيفة تأويلية ذات أهمية بالغة؛ فالرحلة قبل احتلال البلاد بأعوام قليلة. وهؤلاء هم حسب ظهورهم وأهميتهم في الرواية: حاتم الحاتمي، بعثي قومي هارب من بلاده. بشيرة حسون صاج آل محمود، سجينة شيوعية تعرضت للاغتصاب في المعتقل، فكانت ابنتها سندس نتيجة للسجن والخديعة. وغزوان البابلي، المتدين الشيعي والمعتقل السابق في سجون دولة البعث أيضاً. ودلاله شمعون الآشورية المبشِّرة الدينية ليهوه، الإله المختلف عن دين طائفتها، ويُكلف الدكتور بلاسم بعلاجهم في دار الإيواء الخاصة هناك. نحن، هنا، إزاء قسمة عادلة إلى حد ما؛ رجلان وامرأتان. هؤلاء الأربعة سيقدِّمون أربع صيغ مختلفة، وربما متعارضة، من الذاكرة السردية العراقية في رواية «صيف سويسري». لكن أقدار هؤلاء تختلف في الرواية؛ إذ ستحتل حكاية الحاتمي، وهو ضابط أمن بعثي ذو أصول جنوبية ريفية، مكانة كبرى في الرواية؛ فهو الشخصية المركزية في الرواية، والوحيد في الرواية الذي يصلنا السرد عبر ضميره المتكلم، فلا شخصية أخرى تمتلك هذا الامتياز السردي سواه. وهذا أمر ذو دلالة بالغة في فهم النص كله. وعلى مستوى المساحة الكلية للرواية فقد تألفت من ست وعشرين فقرة. شغلت قصة «الحاتمي» منها خمس عشرة فقرة. وجاءت بعدها قصة الدكتور المعالج «د. بلاسم» بأربع فقرات، ثم قصة بشيرة بفقرتين، ثم قصص «البابلي» و«دلاله» بفقرة واحدة لكل منهما. وهناك فقرتان للمقهى «الوفاق» ثم «الشقاق»، وفقرة أخيرة تحمل اسم سندس بعد السقوط. ولكن بماذا تُفيدنا هيمنة منظور «الحاتمي» على الرواية في سياق الحفر في موضوع الذاكرة السردية؟
زمن الرواية
لنعد إلى زمن الذاكرة، أقصد زمن الرواية؛ ما دام الزمن هو منطق السرد الأول. ثمة إشارتان زمنيتان تحددان السياق الزمني للرواية، ومن ثمَّ للذاكرة السردية وحكاياتها كلها. الأولى أن زمن الحكاية الأصلية يبدأ من لحظة صعود «القاتل» وتحكمه بـ«الحزب» والحياة، وهي ذاتها لحظة الفتك الجماعية بالرفاق المغضوب عليهم، وبحلفاء الأمس الذين انتهى دورهم. «لماذا لا نقول إنها لحظة قاعة الخلد عام 1979؟». الثانية أن زمن رحلة العلاج المشكِّلة لخطاب الرواية كان أواخر الألفية. وقد يعني التحديد الأخير أن الذاكرة السردية محدَّدة سلفاً، وهي ذات مقاصد مخصوصة تتعلَّق بما يمكن تسميته بأمثولة الضحية ذات الروافد المتآلفة، مع بعض، فيما يمكن أن نصطلح عليه بالسردية الأصيلة والنسق المكرَّر الغالب عليها؛ فقصص المظلوم الضحية تتكرَّر من حالة «بشيرة» إلى «غزوان» فـ«دلاله»، لكن الضحية تتلبس بقناع الوهم الآيديولوجي مؤلفة «أمثولة» زائفة تبدأ بالذات المفردة، ولا تنتهي بمزاعم الجماعات المظلومة الضحية. وليس صعباً على القارئ، بعدها، أن يرى في عذابات «بشيرة» صيغة كلية عن فتك «البعث» بالشيوعيين واغتصابهم. وفي «غزوان البابلي» صيغة مبكرة عن السرديات الصاخبة للشيعة المظلومين في عراق البعث - صدام. لكن «دلاله» نموذج سردي فاضح لأمثولة الضحية؛ فهي آشورية مسيحية، وهي «مُبشِّرة» بإله «جديد» عن ملتها. حالة «دلاله» تعيد رسم حدود الواقع عن «الوهم»، ووضعها في سياق أمثولة الضحية المتداولة بالنسبة للشيوعيين والمتدينين الشيعة المعارضين لنظام البعث، إنما يعري مزاعم مظلومية «الضحية» وأوهامها.
سرديات القاتل
لكن «صيف سويسري» هي رواية «القاتل» الهارب إلى لحظة الاعتراف بجرمه. وليس القاتل هنا سوى الحائز على القسم الأعظم من الرواية. إنه «حاتم الحاتمي». هل ثمة مبالغة في استعمل صفة «القاتل» ووسمه به؟ لا أظن؛ فالشخصية تنبني على أساسين متعارضين. الأول، قتل المعارضين للحزب والقيادة. والقتل ذاته يقود الحاتمي إلى لحظة الحب الأصيلة المفضية إلى طلب الغفران؛ بإنقاذ «بشيرة» من فتك «قتلة» آخرين، هم رفاق القاتل. لا تنشغل الرواية بتفاصيل القتل ذاته، فهي تميل للتقشف والتلميح في سرد وقائع القتل. إنها تكتفي، مثلاً، بالترميز المقصود، مثل أن تقاطع الزوجة زوجها وترفض معاشرته، أو بالعنونة أحياناً؛ كأن تسمي الفقرة «حفلة إعدام». يقابل هذا التقشف بذخ لا تنكره الرواية بالتفاصيل الخاصة بحياة الحاتمي، لا سيَّما ما يتعلَّق منها بصلته بالسلطة، وبحب عمره «بشيرة» أيضاً. فهل تنتهي قصة القاتل عند هذا الحدّ؟ لا أظن؛ فهذه القصة تتصل بمنطق السرد كله ومشروعيته القائمة على جدوى اعتماد قصة القاتل في استعادة ودعم أمثولة الضحية؟ لا إجابات، فالحاتمي، شأن راويه الملتزم بمراقبة صاحبه، كأنه ظله، ملتزم بدوره بصفته القاتل طالب المغفرة باسم الحب، وملتزم كذلك بصفته وموقعه المحيط بكل رفاق رحلة العلاج. وفي هذه النقطة ثمة مفارقة أساسية لا ينبغي علينا تفويتها، تتعلَّق بالحدود المفترضة لهيمنة قصة الحاتمي على القصص الأخرى؛ إذ لا حدود تنتهي عندها «سلطة» الحاتمي وقصته؛ فهي مسيطرة حتى على المساحة النصية للقصص الأخرى، فنجد وظيفة الحاتمي تتداخل مع دور الراوي، ويأخذ عنه وظيفته الأساسية بنقل الأخبار والحكايات عن الشخصيات الأخرى، لا سيَّما ما يتصل بقصة البابلي. فهل صرنا أمام تسويغ مقنع لأهمية قصة الحاتمي وتغليبها على القصص الأخرى في الرواية؟
أقنعة المعترف
ثمة «تلذذ» يصل، ربما، إلى حالة متقدِّمة من «تشهَّي» الاعتراف؛ ففي دار العلاج في بازل يتساوى الجميع؛ القاتل وضحاياه، فهم مستدعون كي يعالجوا من أوهام الذاكرة العراقية بالاعتراف. فالاعتراف هو الموضوع المركزي في الرواية. وقد نقول إنه لا موضوع آخر يفوقه، أو حتى يقترب منه. لكن «الاعتراف» لا تتحقق مقاصده من دون شروطه «الموضوعية». وهي كما تقدِّمها الرواية، المكان الغريب بعظته المختلفة عن هوس الذاكرة المحتدمة. وهو الغريب المنضبط حد الملل. ويظل الاعتراف، حتى هناك، بلا موضوع حقيقي ما لم نسمع الصوت السردي للمتكلِّم المعترف. وهذا شأن اعتراف حاتم الحاتمي، الذي تركه الراوي المراقب، غالباً، يتحدَّث لنفسه، لنا، ويروي ما حصل. والاعتراف بمنطق المتكلم امتياز لم توفِّره الراوية سوى للحاتمي، فمن أصل خمس عشرة فقرة خاصة بقصة الحاتمي، كان هناك تسع فقرات وصلتنا أحداثها عن طريق الراوي المتكلم. وهذا ما لم يحصل مع أي شخصية أخرى، سوى «سندس» التي تولَّت، في فقرة أخيرة، وعبر صوتها الخاص، إخبارنا عن المصائر الأخيرة للشخصيات.
قد لخصت لنا قصة ارتباط «زواج» الحاتمي بأمها، مثلما أخبرتنا عن زواجها وولادتها لابنها جاد، وهي كذلك من عادت بنا إلى بغداد، بعد احتلالها، وقدمت لنا موعظتها الأخيرة المختلفة، جذرياً، عن موعظة العائدين إلى أوهامهم «غزوان البابلي ودلاله وأضرابهما الكثيرون»، عن المعنى الأخير لبلادها الأولى التي من الممكن أن تعود إليها، صحبة ابنها وزوجها؛ فهو مكان مُسَّلٍ يصلح لقضاء العطل والمناسبات تحت الشمس وبعيداً عن ثلوج أوروبا. نحن، هنا، أمام استخدام مختلف للراوي المتكلم؛ فـ«سوسن» ليس لديها ما تعترف به؛ فلا أوهام ولا ذاكرة عراقية متورِّمة، ومن ثمَّ، لا توهم آيديولوجي. وهذا كافٍ لتسويغ الاختلاف عن «تكلُّم» الحاتمي. موقع الحاتمي يختلف، بتعمُّد، حتى عن «بشيرة حسون»، الشيوعية المغتصبة؛ وأكثر الشخصيات تمثيلاً لأمثولة الضحية، إذ لم يُترك لها حق الكلام بمنطق المتكلِّم؛ وتكفَّل الراوي المراقب بالأمر كله. وقد نقول إن حرمانها من «التكلُّم» الذاتي أعطاها حق قبول «الاعتراف» من رفضه؛ فهي الضحية، وهذا موقع أبعدها كثيراً عن لحظة الاعتراف، سوى أنها رفضت، شأن الآخرين، فكرة الذاكرة البديلة؛ فللضحية قصتها الأصيلة وذاكرتها المتورِّمة. وفي المحصلة، فإن سردية الاعتراف تؤدي وظائف أساسية في الرواية، بل إن «صيف سويسري» رواية اعتراف بامتياز متفرد. وهذا أمر يندر أن يحصل بعيداً عن الحاضنة الثقافية الدينية للاعتراف، أن يتخلص السرد من فخ «التقية» المتأصلة في كلامنا وسردنا وثقافتنا، وهو ما نجحت به رواية «كجه جي» المتفرِّدة حقاً.
* ناقد عراقي