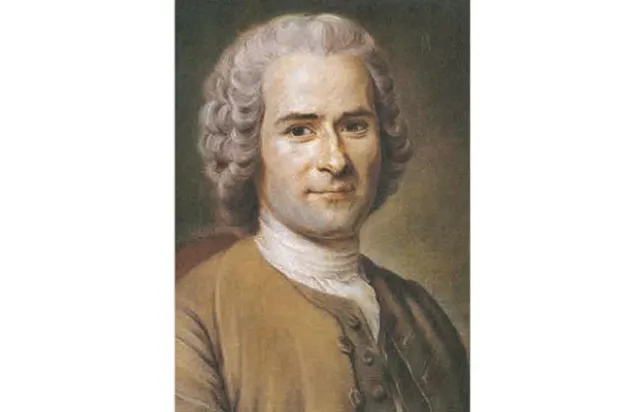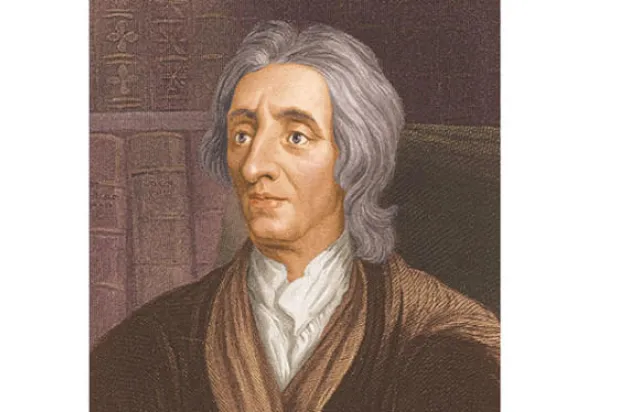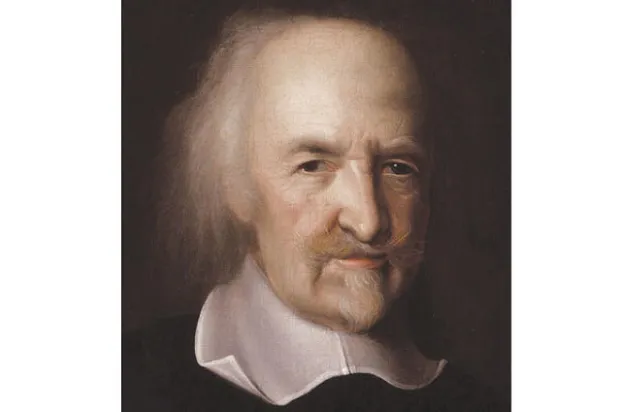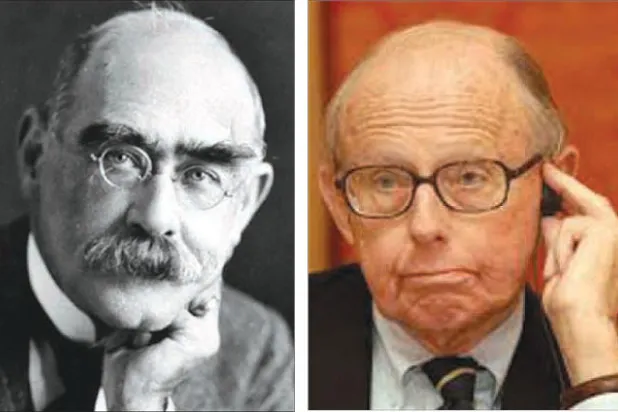د. محمد عبد الستار البدري
إذا كان الفيلسوف الإنجليزي هوبز هو الذي قد وضع قاعدة الفكر السلطوي، ونظيره لوك قد شيد أسس المنظومة الليبرالية، كما تابعنا في المقالين السابقين، فإن الفيلسوف السويسري - الفرنسي، جان جاك روسو، يمثل قاعدة أو انطلاقة فكر ليبرالي مختلف تماماً وصل في دعواته أو تطبيقاته إلى حد الشمولية السياسية، فعانت من أفكاره فرنسا في مرحلة الثورة، اعتباراً من عام 1792، لتتحول شعاراتها الرنانة الداعية إلى «الإخاء والمساواة والحرية» إلى نظام شمولي تحكمه نخبة متطرفة على يد اليعاقبة (Jacobins)، تستند في صياغة وتشريع الهيكل السياسي الثوري لفرنسا إلى أطروحات روسو بشكل يكاد يكون لفظياً، بل إن روبسبيير مهندس هذا النظام كا
لا خلاف على أن التراث الليبرالي اليوم يمكن إرجاع جذوره إلى العصر الإغريقي، خصوصاً كتابات «أرسطو» وغيره من الفلاسفة، ولكن المرجعية الفكرية الليبرالية في العصر الحديث دائماً ما تبدأ بالمفكر الإنجليزي العظيم «جون لوك» الذي يمثل الانطلاقة الفلسفية والعملية للفكر الليبرالي، فقد شيّد الأساس الذي بُنيت عليه المنظومة الليبرالية على المستوى الدولي إلى يومنا هذا منذ أن نشر كتابيه المعروفين بـ«الأطروحتين حول الحكومة المدنية»، واللذين تم نشرهما عام 1690، وفي هذين الكتابين وضع هذا المفكر العبقري القواعد الأساسية لما ينبغي أن تكون عليه فلسفة وأساليب الحكم الليبرالي والتي أصبحت الركيزة الأساسية التي بُني علي
لا خلاف على أن فلسفة الفكر السياسي تأثرت كثيراً بثلاثة كتاب وضعوا الإطار العام لمستقبل نظم الحكم في الغرب خلال الفترة من منتصف القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، وهم توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو، أو رواد الفكر السلطوي والليبرالي والرومانسي - الشمولي على التوالي، فلم يخرج أي نظام سياسي غربي عن النماذج الثلاثة التي وضعوها على مدار أكثر من مائتي وخمسين عاماً. وقد استهل الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز هذه السلسلة من خلال كتابه الشهير «ليفياثان Leviathan» أو «المارد» الذي وضع فيه فسلفته السياسية بشكل منمق، مبرراً أهمية الحكم المطلق لحماية المجتمعات السياسية من الفوضى.
بعد مرور خمس وعشرين سنة على انهيار الاتحاد السوفياتي، في تقديري إننا لا نزال حتى اليوم نعاني من حالة عجرفة فكرية من قبل بعض المفكرين الغربيين، مرتبطة بما يمكن تسميته بحتمية التجربة الغربية، من خلال تناثر الهياكل الفكرية القائمة على محورية، بل وضرورة تصدير بعض محطات هذه التجربة للبلدان الأخرى، خصوصاً الشرق الأوسط.
أوضحت خلال مقالي السابق انزعاجي من مقولة شخصية غربية مثقفة «بأن عالمكم العربي في حاجة إلى ثورة تنوير كالتي كانت في أوروبا في القرن الثامن عشر؛ لأسباب ترتبط بالواقع والتاريخ العربيين»، وقد نوهت في المقالة السابقة لاختلافي مع هذه المقولة على أسس تاريخية، مؤكداً «أننا لو أمعنا التدقيق في الخلفية التعيسة للعلم والعلماء، التي بررت ميلاد عصر التنوير ضد الكنيسة والدين معاً في أوروبا، فإن هذه المقولة تتهاوى جذورها أمام البحث المقارن»، واليوم فإنني أخوض في الجزء الأهم والأخطر من هذه المقولة، وهي حاجتنا في العالم العربي إلى عصر تنويري على غرار الأوروبي، فأؤكد بداية اقتناعي الكامل ببطلان هذه الفكرة ليس ع
ما زلت منزعجاً بعض الشيء من تعليق سمعته من شخصية غربية بأن «عالمكم العربي في حاجة إلى ثورة تنوير كالتي كانت في أوروبا في القرن الثامن عشر لأسباب ترتبط بالواقع والتاريخ العربي»، ويقصد هنا بعصر التنوير الزمن الذي انتشرت فيه الأفكار التي تدعو إلى العلم والعقل والفكر كوسائل للتطور وحدها دون أي بُعد آخر خصوصاً الدين.
لا خلاف على أن الفكر دائماً ما يسبق السلوك، فهذه قاعدة علمية محسومة. والشيء نفسه ينطبق على الأديب، فالتجربة العاطفية لديه تكون المحرك الأول لقلمه، خصوصاً في الشعر. ولكن يبدو أن لهذه القاعدة بعض النماذج الشاذة في الشخصية التي تربط بين العمل الأدبي والممارسة السياسية.
يبدو في مناسبات كثيرة وجود بعض التناقض بين الشخصية الفنية والتاريخية، ولا أجد مثالاً أكثر وضوحاً من رواية «الفرسان الثلاثة»، للكاتب الفرنسي العظيم «ألكسندر دوما»، في تجسيد شخصية «الكاردينال ريشيليو» إبان حكم الملك لويس الثالث عشر، الذي يصفه الكاتب لنا على اعتباره شخصية مريضة بالسلطة، لا ترتبط من قريب أو بعيد بمفهوم الأخلاق، فهو دائماً ما يحوم حول السلطة في سعيه لجمع أطراف خيوط اللعبة السياسية في يده، فيواجهه في المقابل الفرسان الثلاثة «أراميس» و«أثوث» و«بورسوس»، أبطال الرواية الذين يسعون دائماً لإفشال مخططاته السياسية، التي تتعارض مع الأخلاق والمبادئ الأدبية العظيمة، فيحولها «دوماً» إلى صراع أ
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة