كانت النبذة الماضية عن فلسفة هيدغر وتشعبها، عن مفاهيمه الأساسية، لكن - كما أشرت من قبل، فإن سيرته الحياتية خطيرة، ذلك أنها بحد ذاتها نظرية، كانت سيرته متسقة مع فلسفته إلى حد كبير. وربما كانت من أفضل السير التي كتبها تلميذ عن أستاذه السيرة التي كتبها الفيلسوف الألماني والتلميذ الأبرز لهيدغر وأعني به «هانز جورج غادامير»، التي طبعت في كتاب «طرق هيدغر»، بالإضافة إلى كتابه «التلمذة الفلسفية»، وهما مترجمان إلى العربية. وحين يحضر اسم هيدغر ينعطف قلم غادامير ليكتب ببشاشة وزهو عن ذلك «الأستاذ» الذي يجلس على موقده وهو يتحدث في أكثر الموضوعات إشكالا، وربما جلس صامتا. وحين أهدى بول ناتورب لغادامير بحثا لهيدغر عن أرسطو في أربعين صفحة هتف: «لقد أصبت بصعقة كهربائية»، من لحظتها كان هيدغر أستاذا فعليا لغادامير، بل وصديقا له فيما بعد.
كما تقدم، كانت حياته هي فلسفته، وعن «الدروب المتعددة» العبارة الشهيرة له؛ كان يذكر بها طلابه في أيام «التزلج» - تلك الرياضة التي يعشقها ويقنع بها الآخرين. ألقى ذات مرة محاضرة وهو يلبس سترة التزلج، افتتحها بعبارة هيدغرية: «يستطيع المرء التزلج فقط على المنحدرات ومن أجل المنحدرات»، وكان تلاميذه يطلقون عليها تندرا «السترة الوجودية».
وفي معرض تقديم تلميذه الفيلسوف هانز جورج غادامير لكتاب هيدغر «أصل العمل الفني»، يكتب أن بوادر الظهور التاريخي لهيدغر كانت واضحة منذ أن بدأ بنقد الفلسفة المنبرية السائدة آنذاك. يكتب: «كانت لغته القوية العنيفة غير العادية، التي كان صداها ينطلق من فوق المنصة الفرايبورغية، تدل على أن قوة أصيلة للتفلسف على وشك الظهور، فعن طريق الاتصال الخصب المتوتر مع العلوم البروتستانتية، التي تمكن منها هيدغر عام 1923 من خلال استدعائه للتدريس في جامعة ماربورغ، نشأ كتاب هيدغر الأساسي (الوجود والزمان)، الذي قدم في 1972 لدوائر متسعة من الرأي العام بصورة مفاجئة شيئا من الفكر الجديد».
كانت سطوته في تاريخ الفلسفة الحديث لا تقل عن منعطفات كبرى كالتي رسمها ديكارت وكانط وهيغل ونيتشه، كان مفصلا أساسيا في العصر الحديث. يبالغ بعض عشاق فلسفته وأسلوبه ونمط تنظيره فيقولون: «مع هيدغر انتهت الفلسفة». لكن المنعطف الذي رسمه هيدغر أحيا الفلسفة، ولا تزال مفاهيمه فاعلة ومضيئة وحية، وعلى رأسها مفهوم «التقويض» الذي أسس لجيل من الفلاسفة الأهم في القرن العشرين، مثل دريدا وفوكو ودلوز وليوتار.
كان فلاحا، وحين تعب من وطأة التهم السياسية، يمم وجهه في بيت جبلي (كوخ) في توتناوبرغ، وثمة علاقة بين آلام الفلاسفة والجبال، وقد رأيت من خلال التتبع أن «هيراقليطس، وفيلوكتات، وبرموثيوس، وأمبيدوكل، ونيتشه، وهيدغر» كلهم لجأوا إلى الجبال للتفكير والتأمل، وكل دروب أولئك كانت صادمة، ذلك أن الوجود في الجبال هو «وجود الأعالي» بتعبير نيتشه.
كان موقفه الذاتي قويا حين كتب النص ذائع الصيت، الذي كتبت عنه مرارا وترجمه بجمال «حسونة المصباحي»: «وحدها الغابة السوداء تلهمني»، وذلك بعد أن تلقى العرض الثاني لشغل الأستاذية في الفلسفة بجامعة برلين، فكتب نص الرفض، الذي انتصر فيه للفلاحة والحقل، وأذيع نصه الشاعري بعد كتابته في «الإذاعة». كان قد كتبه في كوخه على ارتفاع 1150 مترا، في بيت من (6 إلى 7) أمتار. جاء في نص الاعتذار للجامعة: «في ليل الشتاء العميق، تنفجر عاصفة ثلجية حول البيت، وتأخذ في تغطية مواراة كل شيء، عندئذ يبدأ زمن الفلسفة... والعمل الفلسفي لا يتم بعيدا كما لو أنه فريد من نوعه، إن كان يوجد وسط عمل الفلاحين، عندما يجر المزارع الشاب المزلاج الثقيل المحمل بحطب أجار الزان، على طول المنحدر الوعر، والخطر باتجاه ضيعته... أجلس مع الفلاحين على مقعد أمام المدفأة أو حول طاولة، هناك في الركن، وفي أغلب الأحيان لا أتحدث معهم وهم لا يتحدثون أيضا، فقط ندخن الغليون بصمت، ومن حين إلى حين تسقط منا كلمة لنقول مثلا إن قطع الخشب في الغابة يقترب من نهايته، وإن السمور في الليلة الماضية داهم قن الدجاج وأتلف الكثير منه، وأنه من المحتمل أن تلد البقرة».
ويضيف في نصه: «في السنة الماضية، كنت قد قضيت أسابيع بأكملها وحدي في البيت، صعدتْ تلك العجوز البالغة من العمر 83 عاما المنحدر الوعر من أجل مقابلتي، وقالت إنها تود التحقق من أنني ما زلت موجودا ومن أن اللصوص لم يأتوا لسرقة بيتي في غفلة مني، وقد أمضتْ ليلة موتها في نقاش مع أفراد عائلتها، وقبل نصف ساعة من رحيلها إلى العالم الآخر كلفتهم إبلاغ تحياتها إلى (الأستاذ). إن ذاكرة كهذه في رأيي أكثر قيمة من أي (روبرتاج) حتى ولو كان جيدا في أي صحيفة مشهورة في العالم حول فلسفتي المزعومة».
انعزل هيدغر طويلا في بيته الريفي، لكنه توفي في 26 مايو (أيار) 1976 بمسقط رأسه مسكرش، وإذ تطير الغربان في يوم موته الكئيب ترفرف روح والده أمين خزانة الكنيسة، ليترك هيدغر الإرث الصعب، مما جعل بعض مؤرخي الفلسفة يعدونه أهم فيلسوف في التاريخ، استطاع أن يبدأ مشروع إنقاذ الفلسفة من قبضة هيغل، كان هذا هو المشروع الذي سيستأنفه من بعده ميشيل فوكو.
لقد عاش هيدغر عصب فلسفته من تزلجه إلى تمرده السياسي إلى كوخه، وفي نص من شعره يكتب:
الكوخ سطر مكتوب في الكتاب
أي أسماء أستقبل قبل اسمي
أمل في قلبي... وممر الغابة متعرج
8:25 دقيقه
حياة هيدغر.. هي فلسفته
https://aawsat.com/home/article/8873
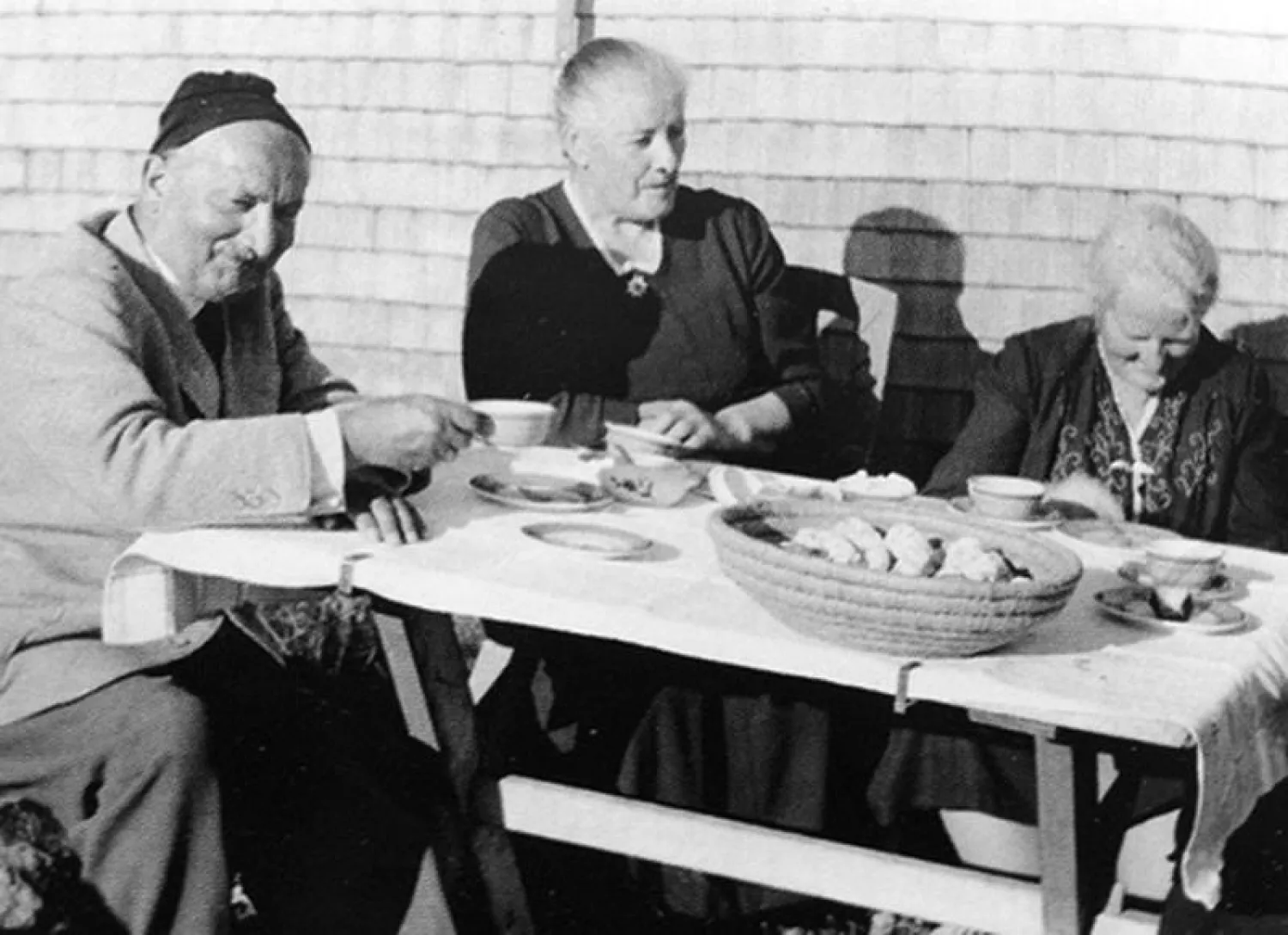

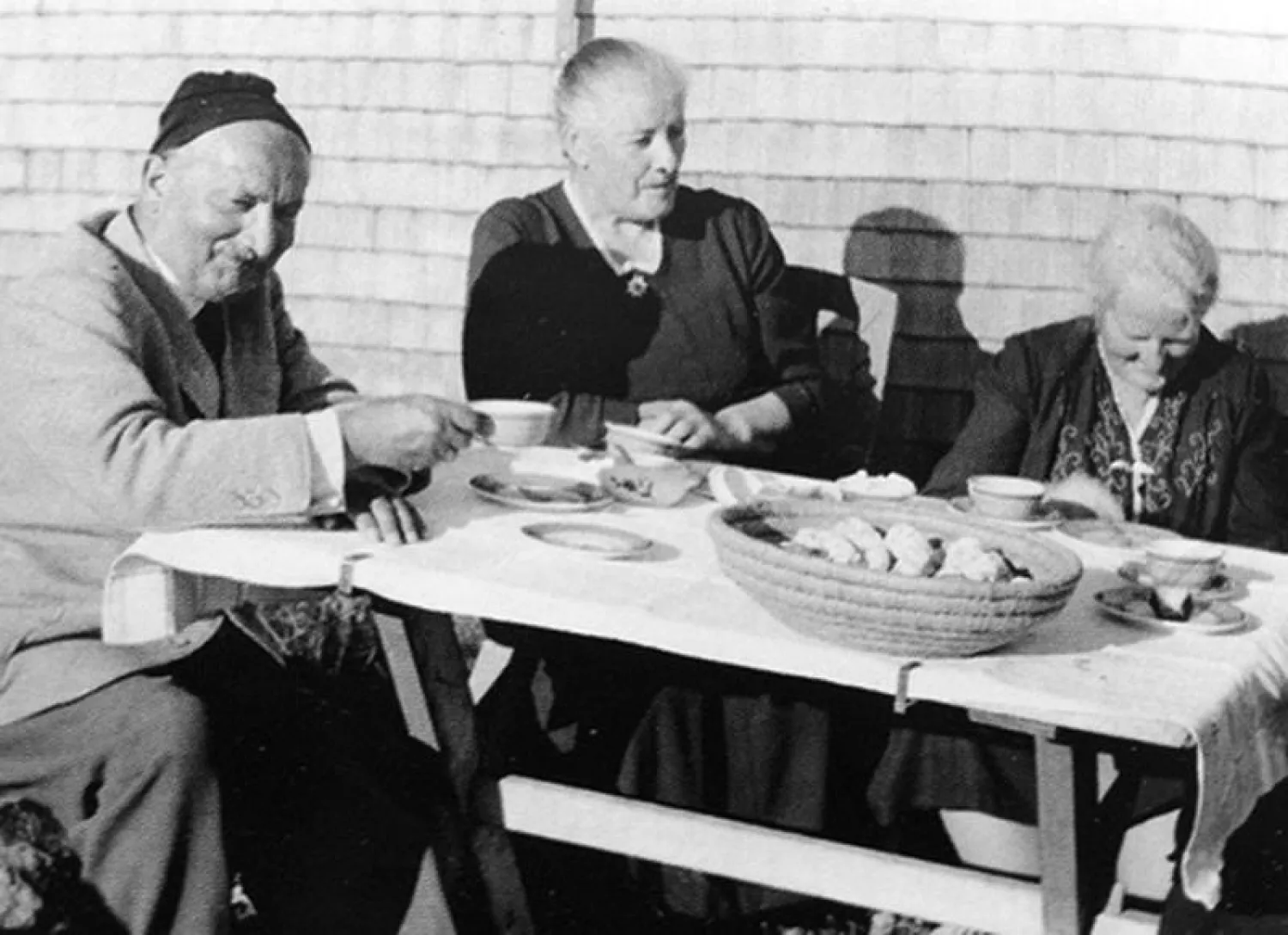
حياة هيدغر.. هي فلسفته
فضل الحقل على شغل كرسي الأستاذية في الفلسفة بجامعة برلين
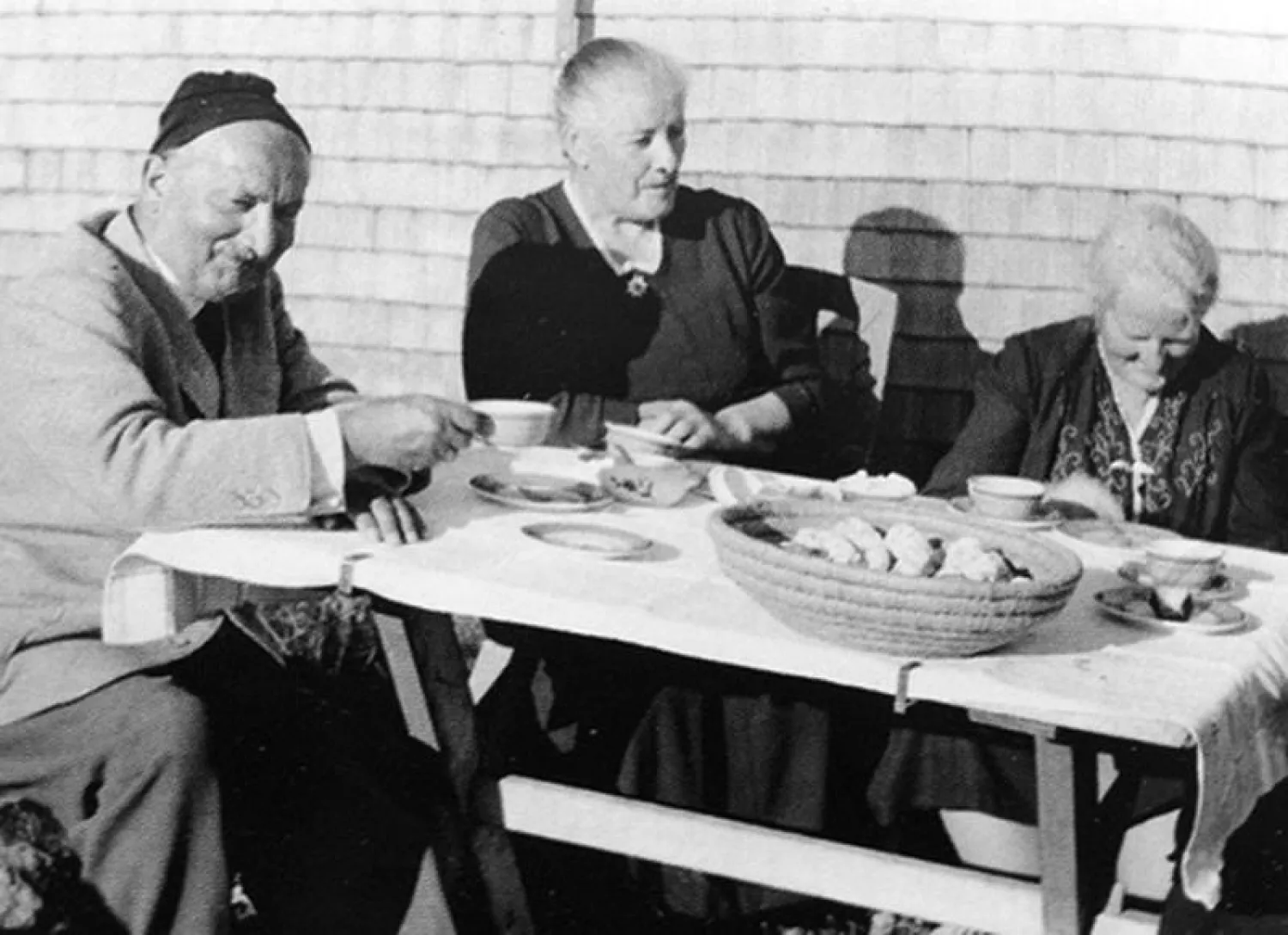

حياة هيدغر.. هي فلسفته
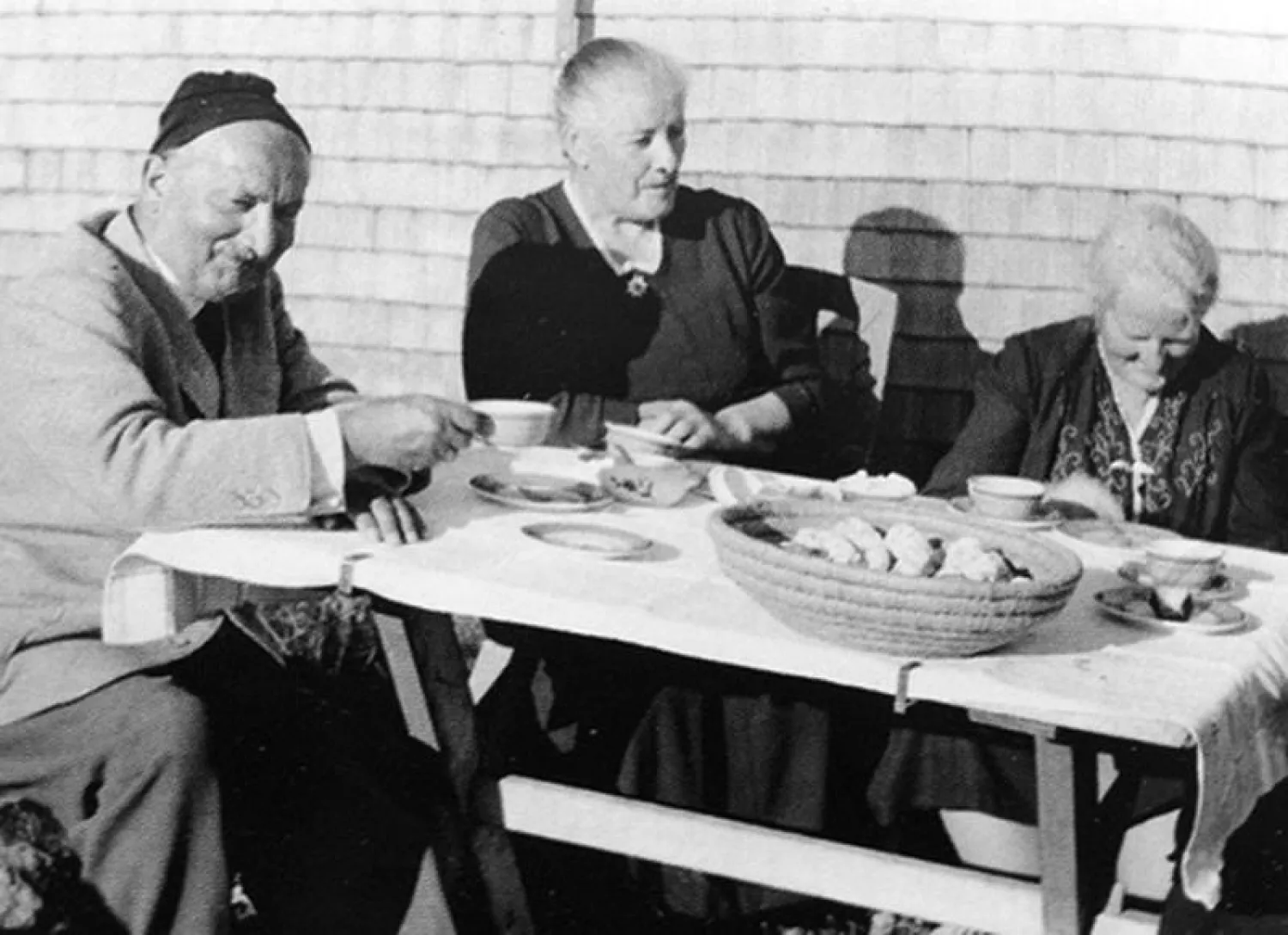
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










